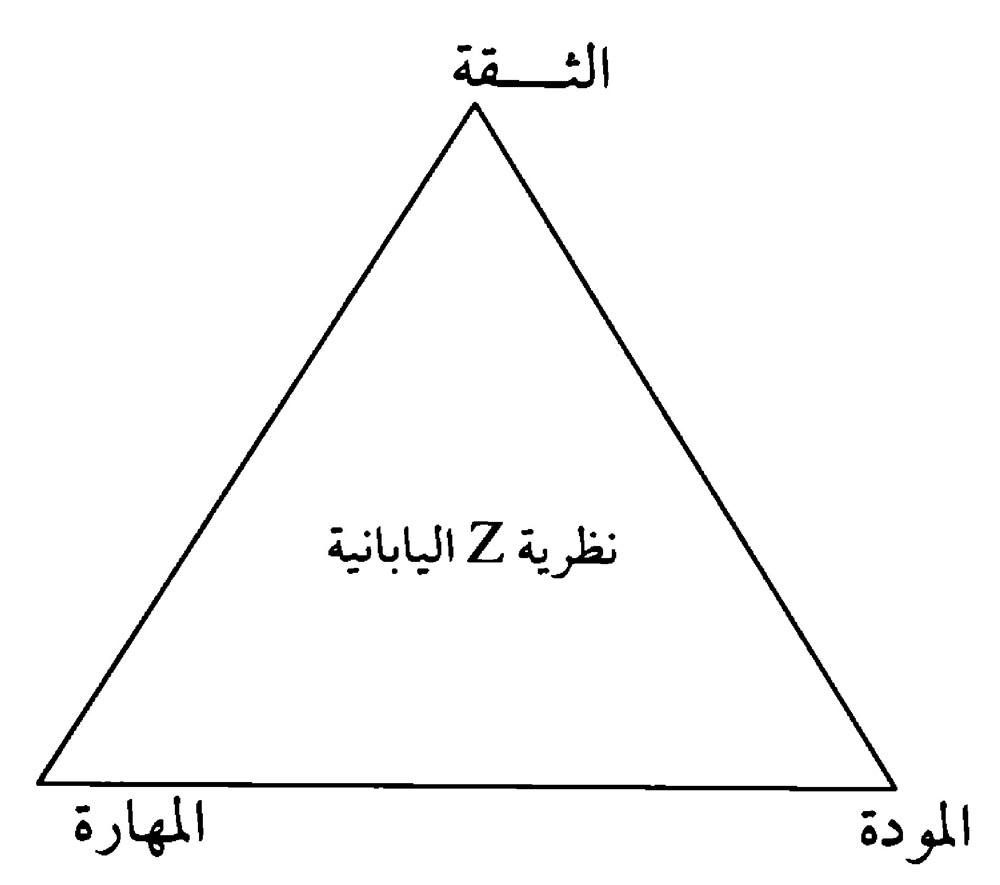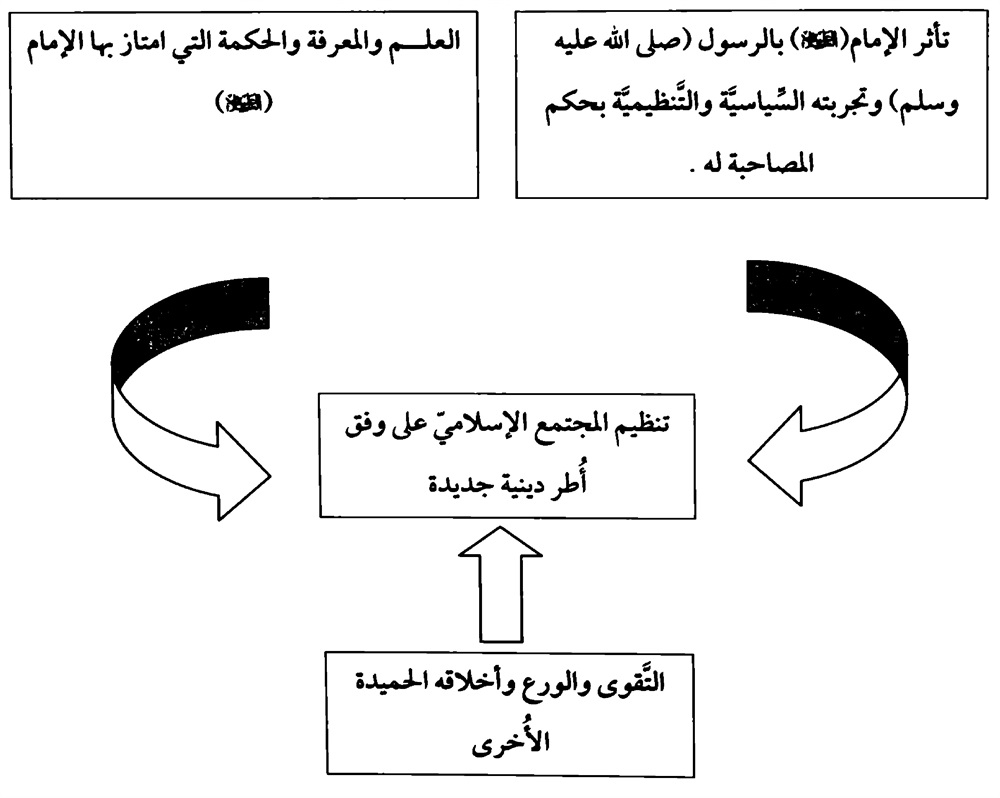نهج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي
هوية الکتاب
رقم التصنيف: 412
نهْجُ البَلَاغَةِ فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللَّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ
نعمة دهش فرحان الطائيّ
الواصفات: / البلاغة العربية//فقه اللغة/
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2015/3/1292)
ردمك 9 - 14 - 608 - 9957 - 978 ISBN
عمان - شارع الملك حسين - مجمع الفحيص التجاري
هاتف 96264611169+ ص ب 922762 عمان - 11192 الأردن
DAR ALMANHAJIAH Publishing - Distributing
Tel: + 962 6 4611169 P.O.Box: 922762 Amman 11192 - Jordan
E - mail: info@almanhajiah.com
جميع الحقوق محفوظة للناشر. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر
All rights Reserved. No part of this book may be reproduced. Stored in a retrieval system. Or transmitted in any form or by any means without prior written permission of the publisher.
محرر رقمي : روح الله قاسمي
ص: 1
اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
صَدَقَ اللهُ العَظیم
نَهجُ البَلاغَة
في ضَوءِ عِلمِ اللُّغَةِ الاِجتِماعيّ
ص: 3
نَهْجُ البَلَاغَة
في ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغة الاجْتِمَاعِيِّ
نعمة دهش فرحان الطائيّ
الطبعة الأولى
1437 ه - 2016 م
الدار المنهجية
للنشر والتوزيع
ص: 5
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)
سورة الحجرات الآية: 13
ص: 6
الفهرس
تقديم ... 11
المقدمة ... 13
التمهيد
مصطلحات ومفاهيم أساسية
التعريف بعلم اللغة الاجتماعيّ ... 19
علم اللغة الاجتماعيّ والعلوم الأخرى ... 26
التفكير الاجتماعيّ عند اللُّغويين العرب القدامى ... 38
الفصل الأول
سمات الإمام (علیه السلام) السّلوكيّة وأثرها في المجتمع
المبحث الأول / لغة التنشئة الاجتماعيّة في (نهج البلاغة) ... 57
المبحث الثاني / الأنماط السّلوكيّة عند الإمام (علیه السلام) في نهج البلاغة ... 83
سمات الأنماط السّلوكيّة في نهج البلاغة ... 83
الازدواج السّلوكيّ للأنماط (صراع الوظائف) ... 97
المبحث الثالث / اثر المجتمعات في تنوع الوظائف اللغوية ... 99
المجتمع المكيّ ... 99
المجتمع المدينيّ ... 100
المجتمع الكوفيّ ... 101
المجتمع الشّاميّ ... 101
المجتمع البصريّ ... 112
مجتمع الزّنج ... 114
ص: 7
الفصل الثاني
البنيةُ الاجتماعيّةُ ونُظُمُ اصلاحها
المبحث الأول / النظامان: (الإداريّ والاقتصاديّ) ... 127
النظام الإداري ... 127
أثر الكتّاب في إدارة الدولة ... 132
الضمان الاجتماعي ... 137
الكوارث الطبيعية ومسؤولية الدولة ... 140
النظام الاقتصاديّ ... 141
ظاهرة الاحتكار ... 147
النظرة العامة للحرف والصناعات ... 149
الزراعة والأرض والزرّاع ... 152
المبحث الثاني / النظامان: (السياسي والقضائي) ... 155
النظام السياسيّ ... 155
لغة المواثيق والاتفاقيات ... 166
إصلاح النظام السياسي عند الإمام (علیه السلام) ... 174
النظام القضائيّ ... 175
الرقابة ... 181
الحصانة الاقتصادية ... 182
استقلال القضاء ... 182
المبحث الثالث / التصنيفات الاجتماعيّة ... 189
التصنيف الطبقيّ ... 189
التصنيف النفسيّ ... 201
التصنيف العلميّ ... 204
التصنيف الإنسانيّ ... 205
التصنيف الإيمانيّ ... 205
ص: 8
الفصل الثالث
الظواهر الاجتماعيّة في نهج البلاغة
المبحث الأول / الظاهرة التّنظيميّة (الأسرة والعشيرة والقبيلة) ... 213
الأسرة ... 214
العشيرة والقبيلة ... 229
المبحث الثاني / الظاهرة الثقافيّة (الاعراف والعادات والتقاليد) ... 243
المبحث الثالث / الظاهرة السِّياقيّة (المُحرَّم اللغويّ - تابو - ) ... 265
ما يختصُّ بالموت ومقدماته وأسبابه وعلاماته ومتعلقاته ... 266
ما يختصُّ بالأمراض والأوبئة ... 273
ما يختصُّ بدنس الفاحش من الألفاظ ... 275
ما يختصُّ بألفاظ السياسة وعلائقها ... 282
الفصل الرابع
البنية اللغويّة وأثرها في المتلقي
المبحث الأول / البُعد التواصليّ (تحليله، أنماطه) ... 295
المبحث الثاني / وسائل الإقناع التداوليّ ... 315
المبحث الثالث / وسائل التأثير التّداوليّ ... 331
الازدواج اللغويّ (اللهجيّ) ... 349
الخاتمة والاستنتاجات ... 357
المصادر والمراجع العربية والأجنبية ... 363
ملخص الأطروحة باللغة الانجليزية ... 381
ص: 9
تقديم
العلّامة الأستاذ الدكتور
نعمة رحيم العزاويّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)
أتى على (نهج البلاغة) حين طويل من الدهر، يحسبه الأدباء والنقاد كتابًا فنيّا حسب، لا يُنظر فيه إلّا من الجانبِ البيانيِّ والبلاغيِّ، ولم يكن هؤلاء الناظرون بمخطئين، فالنهج يُعدُّ في الذروة من البيان، كما يُعدُّ الكشف عن جمالياته غايةَ ما يطمحُ إليه الدارسون ونقاد الأدب. ومنذُ زمنٍ قريبٍ اتجه اللغويون إليه؛ ليدرسوا بنيته اللغويَّة، وما يتركب منه هذا النصُّ الإبداعيّ من أصواتٍ وصيغٍ وتراكيب، وهذا يعني أنَّ كلا هذين الفريقين من الدارسين لم تجذب اهتمامهم مضامين نهج البلاغة، وما اشتمل عليه من قيمٍ اجتماعيَّةٍ هدفها بناء المجتمع الإسلاميّ في زمن الإمام علي (علیه السلام) والأزمان التي تلته حتى يومنا هذا.
وبعد ظهور ما يعرف ب (علم اللسانيات الاجتماعية) الذي يدرس النصوص الإبداعية في ضوء علاقتها بالمجتمعات التي تُنشأ فيها، طافت ببعض الأذهان فكرةٌ ليست بالسهلةِ أو اليسيرةِ، وأعني بها تحليل النصوص الأدبية الرفيعة، وعلى رأسها (نهج البلاغة)، في ضوء الظواهر والقضايا التي يُعالجها هذا الضربُ من العلم اللغويِّ الجديد.
ومن هؤلاء الدارسين الذين استثار هذا النحو من التحليل الاجتماعيّ للغة الأدب، هو الدكتور نعمة دهش الطائيّ، فعرض عليّ ما اعتزم أن يكون موضوعًا لأطروحته، وهو: (سوسيو لسانيات نَهْجُ البَلَاغَةِ) فاستحسنت هذا الموضوع؛ لجدته وطرافته، وليكون بداية منهج جديد، تُدرس نصوص الأدب القديم والحديث في ضوئه. ولكني أعلمت الدكتور نعمة دهش حينئذ أنَّهُ لن يجد كتابًا واحدًا قد سبقه إلى هذا الضرب من الدرس الاجتماعيّ للغة النصوص، اللّهم إلّا كتابًا عنوانه: (أبو العلاء ناقدُ المجتمع) للدكتور زكيّ المحاسنيّ الذي صدر عام 1962 م، ولا يخفى أنَّ الفكر
ص: 11
الاجتماعيّ للإمام عليّ (علیه السلام) يفوق ما عند أبي العلاء المعريّ من هذا اللون من الفكر؛ لشمول فكر الإمام واستيعابه أهم ما ينهض بالمجتمعات، ويعرج بها في مراقي الفضل والكمال.
لقد كان الإمام علي (علیه السلام) قد شخَّصَّ الأدواء التي تعصف بالمجتمع، وتسلبه السعادة، والقدرة على النهوض، فاختار أنْ تكون السنواتُ القليلةُ التي حكم فيها فرصةً سانحةً، يعالج خلالها أوصاب المجتمع، ويهدي رعيته إلى ما يبرئهم من تلك الأوصاب، فجاءت خطبه البليغة التي ضمَّها النهج علاجًا شاملًا ناجعًا، يضمن لمن سمعها في حين إنشائها، ولمن يقرؤها وهي مدوّنة سعادة الدنيا، وخير الآخرة.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الكتاب، فهو وثيقة تاريخية، ترسم لنا معالم المجتمع الذي ولي الإمام (علیه السلام) أمره، وصار مسؤولًا عن قيادته، وتضع أمامنا الصورة المُثلى لما يجب أنْ تكون عليه المجتمعات في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
وبعد فإنَّ هذا الكتاب الذي أقدمه إلى القرّاء، كتابًا جديدًا في فكرته، وفي المنهج الذي سلكه فيه مؤلفه، سيكون نقطة مضيئة في التأليف اللغويّ الأدبيّ في هذا العصر.
والله ولي التوفيق ...
ص: 12
المقدمة
قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ) الروم 22
صدق اللّه العلي العظيم
الحمدُ لله الذي بَطَنَ خفيّات الأمور، ودلّت عليه أعلامُ الظّهور، وانطقَ لسانَ الإنسانِ، فأفصحَ بعجيبِ البلاغةِ وسحرِ البيان، والصّلاةُ والسّلامُ على مَنْ تبوأَ من الفصاحةِ ذروتَها، واقتعدَ من سمو الخلقِ الرفيعِ عواليَ المعالي، محمّدٍ المجتبى شجرةِ الإيمانِ، وعلى آلهِ ولا سيّما (عليّ) أمير البيان، وصحبه الأبرار ومن اتبعهم بإحسان.
أما بَعْدُ ...
فسببُ اختياري كتابَ (نهج البلاغةِ) موضوعًا للكتاب هو أنَّهُ يمثل رافدًا ثرًّا من روافد العربية، فقد رُكَّبَ من فنون الفصاحة ووجوه البلاغة أعلى ذروة السّنام وبهما أراد الإمام (علیه السلام) أنْ يؤثّر في سامعيه لكي يلبّوا ما يريد منهم، فكان يستعمل مفردات القبائل العربية التي انضوت تحت لوائه وتراكيبها، إذ لم يكن جيشه في الغالب حجازيًّا، فما ألقى من المفردات في كلامه لقبيلةٍ معينةٍ غَرُبَ عن الأُخرى وهكذا.
فوجدتُ أفضل ما يمكن دراسته في هذا الجانب من فروع علم اللّغة هو علم اللّغة الاجتماعيّ، الذي يُعدُّ برزخًا بين الدّراسات اللّغويّة والدّراسات الاجتماعيّة.
اقتضى منهج البحثِ أنْ يقسم على أربعةِ فصولٍ، في كلِّ فصلٍ منها ثلاثة مباحث، سبقتها مقدمة تمهيدية، تمثّلت بدراسة المصطلحات والمفاهيم الأساسيّة في علم اللّغة الاجتماعيّ، وانطلاقاً من نظريةِ (الواعظِ المتعظِ) التي طبّقها الإمام (علیه السلام) في مجتمعه جعلتُ الفصلَ الأوّلَ خاصًّا ب (السمات السلوكيّة للإمام علي (علیه السلام) وأثرها في المجتمع)؛ لأنَّهُ لا يمكن دراسة مجتمع ما على وفقِ نصوصٍ أدبيةٍ من غير دراسة الفرد المُنشئ إياها والظّروف المحيطة بالنَّصِّ، فجاءَ الفصلُ في ثلاثة مباحث، خصصتُ المبحث الأوّل منها: للتنشئة الاجتماعية للإمام علي (علیه السلام) التي منها استطاع
ص: 13
الإمام (علیه السلام) تطبيق النظريّة الإسلامية على نفسه أوّلًا، ثم على مجتمعه. وجاء المبحث الثاني بعنوان (الأنماط السِّلوكيّة وأثرها في لغة نهج البلاغة)، وهذا المبحث يُعدُّ التّطبيق العمليّ الاجتماعيّ لما أنْشِئَ عليه الإمام (علیه السلام). أما المبحث الثالث فخصصته ل (أثر المجتمعات في تعدد الوظائف اللغويّة عند الإمام) وما يوجد من تأثرٍ وتأثير فيما بين تلك الأنماط والمجتمعات، وتأثير ذلك في لغة نهج البلاغة.
أما الفصلُ الثاني فخصصتهُ (اللغة والبنية الاجتماعيّة)، وفيه ثلاثة مباحث، خصصتُ المبحث الأوّل للنظامين (الإداريّ والاقتصاديّ) وخصصتُ المبحث الثاني للنظامين (السِّياسيّ والقضائيّ)، في حين خصصتُ المبحث الثالث للتصنيفات الاجتماعيّة، التي جاءت في نهج البلاغة، وبيان ما فيها من طبقات مترابطة ترابطًا عضويًا.
ويمثل هذا الفصل البناء الاجتماعيّ في حكومة الإمام (علیه السلام) على وفق النظرّية الإسلاميّة، متضمناً إصلاح الأنظمة المنحرفة، بعد الكشف عن أسباب تلك الانحرافات، ويضم هذا الفصل جملة من القضايا اللّغوية، منها: تنظيم السّياسة اللّغوية للمجتمع، وتنظيم لغة التّعاقد والتّعاهد بين الأُمم والحكومات وبيان الألفاظ المتداولة في كلِّ طبقة من طبقات المجتمع.
أما الفصل الثّالث الموسوم ب (الظّواهر الاجتماعيّة في نهجِ البلاغةِ) فقد جاء على ثلاثةِ مباحث عقدتُ مبحثه الأوّل للظّاهرة التنظيميّة على وفقِ ثلاثةِ محاور: هي: (الأُسرة والعشيرة والقبيلة)، وعقدتُ المبحث الثّاني للظّاهرة الثّقافيّة، ودراسة الظّواهر التّراثيّة فيها، في ضوءِ الأعراف والتّقاليد والعادات، التي قيلتْ في تلك المجتمعات الجاهليّة القديمة، التي ضمنها الإمام (علیه السلام) في كلامه. في حين عقدتُ المبحث الثالث لظاهرة المُحرَّم اللّغويّ (تابو - tabo)، التي تبيّن في ضوئها إتباع الإمام (علیه السلام) النّهج القرآنيّ في تجنب التّلفظ بالاسم الصّريح للمُحرَّم، وإبداله بلفظٍ حسنٍ مُوحٍ بمضمونِهِ.
ص: 14
أما الفصل الرّابع فقد تناولتُ فيه (البينة اللّغويّة وأثرها في المتلقي)، وفيه ثلاثة مباحث، خصصتُ الأوّل منها للكشف عن (وسائل الإقناع التّداوليّ)، وخصصتُ المبحث الثاني (وسائل الاستمالة التداوليّة)، في حين خصصتُ المبحث الثّالث ل (البعد التّواصليّ - تَحْلِيلُهُ، وَ أَنْمَاطُهُ)، والجدير بالذّكر أنّني التقيتُ بالدّكتور الأُستاذ محمد الأوراغيّ صاحب النّظريّة النّسبيّة في اللّسانيات الحديثة، الذي خُصص للإشراف على البحث في أثناء بعثتي الدّراسية لدولة المغرب وأطلعتُهُ على الفصول الثّلاثة الأولى، وقد أظهر استحسانه وإعجابه بفكرة البحث وخطته، ثم وضع لي خطة الفصل الرّابع واطلعتُ مشرفي عليها هاتفيًّا فاستحسنها، وبعد الانتهاء من كتابة هذا الفصل عرضتُه على الأُستاذ الأوراغيّ، فشجعني عليه وهنأني بإتمامه.
ومن الصّعوبات التي واجهت البحث قلة المصادر والمراجع في علم اللّغة الاجتماعيّ وتكرار المباحث في تلك الكتب، وعدم وجود دراسة في ضوء هذا العلم تناولت المجتمعات القديمة من طريق تراثها الأدبيّ، ممّا أوجب عليّ تأسيساً جديداً في جانب من جوانب هذا العلم.
وإن حداثة قلمي في الكتابات اللغويّة الاجتماعيّة، استدعت مني الحذر، حسبي أنني توخيتُ فيما كتبت الصوابَ ما استطعت ولا أدعي أنَّ هذه الصفحات قد بلغتْ درجةً من الإتقانِ، تعصمها من الزلل والوقوع في الخطأ؛ لأنَّ صاحبَها في حيثياتِه وإبعادِه ليس بالكاملِ ولا المعصوم، فكيف هي؟ بيد أنَّ ما يثير بي الأمل، ويشعل من وهج نشاطي ويقلل من لوم نفسي لنفسي أنّي ما ادّخرت جهدًا، وما استبقيت ذخرًا من أجل الوصول إلى المادة العلميّة النافعة التي تخدم الكتاب، فإنْ نجحتُ ف (ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) المائدة / 54، وإنْ كان في البحث هناتٌ وهفواتٌ فمن نفسيّ وتقصيريّ، والله الهاديّ إلى طريق الصوابِ، قال تعالى: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 14 وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ)القيامة / 14 - 15.
وقبل أنْ أطوي اللّسان وأُریح القلم من سيره ما أحوجني إلى أنْ أُلبي نداءَ الرحمن في قوله: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) إبراهيم / 7،
ص: 15
فالحمد لله والشّكر لله على نعمته الّتي مَنَّ علي بها، وأُجهر بما أضمر في نفسي من شكرٍ و امتنانٍ لأقدمه بين يدي المُفكر اللّغويّ أ.د. نعمة رحيم العزاويّ، الذي تكرم بالتقديم لهذا الكتاب، وتلطف برسم معالمه، وأردف لتقويم معوجه، فضلاً عن أنَّهُ قد أفادني من غزيرِ علمِهِ، وهداني إلى الصواب بسديدِ رأيهِ للوصول إلى هذه الحصيلة العلميّة، فجزاهُ اللهُ خيرَ الجزاءِ، وأجزلَ لهُ في العطاءِ، وبوّأهُ مقامَ الصالحين، إنَّهُ نعم المُولى ونعم المُجيب.
والحمدُ للهِ ربِّ العالمين ...
ص: 16
نهج البلاغة
في ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغة الاجْتِمَاعِيِّ
التمهيد
ص: 17
التمهيد
مصطلحاتٌ ومفاهيمُ أساسيّةٌ
- التّعريفُ بعلم اللغةِ الاجتماعيّ:
يُعدُّ علم اللغة الاجتماعيّ فرعاً مهماً من فروع علم اللغة العام أو علم اللسانيات، فهو يهتم بدراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع؛ لأنَّه ينظم كلَّ جوانبِ بنيةِ اللغةِ وطرائِق استعمالها، التي ترتبط بوظائفها الاجتماعية والثقافية، وليس المقصود بهذا العلم أنَّه تركيبة أو توليفة من علمي اللغة والاجتماع، أو أنَّهُ مزيجٌ منهما أو تجمع لقضاياهما ومسائلهما، وإنَّما هو الذي يبحث عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع (1)، فهو ينظر في التغييرات التي تطرأ على بنية اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعيّة المختلفة، مع بيان هذه الوظائف وتحديدها، لذا يمكن تعريفه بأنَّهٌ لعلم الذي يبحث في التفاعل بين جانبي السلوك الإنسانيّ، أي استعمال اللغة والتنظيم الاجتماعي للسلوك (2)، ويركِّز في موضوعات ترتبط بالتنظيم الاجتماعيّ لسلوك اللغة وسلوكيات مستعمليها.
من المعلوم أنَّ علم اللغة العام على قسمين: أولهما النظريّ، والآخر التطبيقيّ، وينتمي علم اللغة الاجتماعيّ إلى الأخير، فهو يدرس مشكلات اللهجات الجغرافيّة والاجتماعيّة أو الطبقيّة من حيث خصائصها الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة والدلاليّة وتوزيعها في داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات الاجتماعيّة المختلفة، ويدرس مشكلات الازدواج اللغويّ، مثل الفصحى والعامية واللغة الرسميّة وغير الرسميّة،
ص: 19
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ - المدخل - ، د. كمال محمد بشر - / 47، دار غريب للطباعة والنشر - (ب.ت).
2- ينظر: نفسه / 41.
لذا هو أحد مجالات النمو والتطور في الدراسات اللغويّة من منظور مناهج
والدراسة (1).
إنَّ القدر الأكبر من هذا النّمو والتّطوّر قد حدث في نهاية الستينيات، وبداية السبعينيات من القرن الماضي نوعاً من نفض الغبار وتجميع الشتات لأهم النقاط والمسائل المتوصل إليها، والسعي إلى الكشف عن كثيرٍ من الغموض الذي كان يغشى طبيعة اللغة وطبيعة المجتمع (2). ونجد ذلك زاخراً في مؤلفات برلينك (Burling) 1970 م، وبرايد (Pride) 1971 م، وفيشمان (Fishman) 1972 م، ... وسواهم (2).
ولا يعني هذا أنَّ دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع من ابتكار مرحلة الستينيات، بل إنَّ هناك تراثاً قديم العهد في دراسة اللهجات ودراسة السياق الاجتماعيّ، وهو من قبيل العلاقات بين معاني الكلمات والثقافات المختلفة، وسياقات الموقف، وكلُّ ذلك وغيره من السِّياقات الاجتماعية يقع ضمن علم اللغة الاجتماعيّ. وفي وقتنا الحاضر ازداد الاهتمام بدراسة اللغة اجتماعيّاً، للكشف عمّا كان غامضًا من طبيعة اللغة وطبيعة المجتمع؛ لأنَّ اللغة سلوك اجتماعيّ، ولا يمكن لأية لغة أن تحيا إلا في ظلِّ مجتمع إنسانيّ، وهذه الحقيقة عبر عنها فندريس بقوله: " في أحضان المجتمع تكوّنت اللغة ووجدت يوم أحسّ الناس بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم " (3)، بل الأمر أوسع من ذلك فاللغة سرُّ بقاء المجتمع على الرغم من مرور الزمن (5)؛ لأنَّ التواصل بين الأفراد هو.
ص: 20
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د.هدسن / 12، ترجمة: د. محمود عياد، عالم الكتب، القاهرة، ط 2، 1990م. (2) ينظر: نفسه / 16.
2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، هدسن/ 16 - 17.
3- اللغة، فندريس / 35، ترجمة: الدوخليّ والقصاص، القاهرة، 1950 م، وينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة، د.نعمة رحيم العزاويّ، منشورات المجمع العلميّ العراقيّ (1421 ه - 2001 م) / 48. 5 ينظر: اللغة في المجتمع، م. م لويس جاكسون، ترجمة: د. تمّام حسان/9.
سبب الإحساس بانتماء أفراد الأسرة إليها وأفراد المجتمع إليه أيضاً، فاللغة إذًا ظاهرة اجتماعيّة لا يستطيع فرد من الأفراد أو أفراد معينون أن يضعوها، وإنَّما تخلقها طبيعة المجتمع، وتنبعث عن الحياة الجمعيّة، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطر وتبادل للأفكار، فاللغة بهذا الوصف تؤلف موضوعاً من موضوعات علم الاجتماع فكلُّ فرد ينشأ فيجد بين يديه نظاماً لغوياً يسير عليه مجتمعه، فيتلقاه عنه تلقياً بالتعلّم والمحاكاة، مثلما يتلقى عنه سائر النظم الاجتماعيّة الأُخرى، ويصبُّ أصواتَهُ اللغويّة في قوالبِهِ، ويحتذيه في تفاهمه وتعابيره (1)، وقد نبّه العالم الاجتماعيّ اللغويّ (دوركايم) (2) في أوائل القرن الماضي، على أنَّ الظاهرة اللغويّة صنو الظاهرة الاجتماعيّة، يمكن أن تُرصد وتُلحَظ كما يَلحظ عالم الطبيعة (الشيء) ويتخذه موضوعاً لدراسته (3)، لذا يصح أنْ نقول: إنَّ أغلب مباحث علم اللغة ولد في أحضان علم الاجتماع، وكان صدى لمباحثه التي أسبغ عليها (دور كايم) صفة العلم، ونقلها إلى مصافّ العلوم الطبيعية من حيث الموضوعية، واتباع المنهج العلميّ في دراستها (4).
ثم جاء سوسير متأثرًا ب (دوركايم) فاتخذ اللغة موضوعاً لدراساتهِ، وأسس نظامًا معرفيًا متكاملًا ومتماسكًا، أصبحنا من طريقه نفرق بين اللغة (langue) والكلام (language) واللفظ (parole)، بعد أن كانت هذه المصطلحات غارقة في الغموض، ذلك أنَّ علماء النفس من أتباع المدرسة السلوكيّة كانوا لا يميزون بين اللغة والكلام، بل يعدون اللغة الكلام المنطوق فعلاً، وقد عدوا التفكير نوعاً من السلوك 9.
ص: 21
1- ينظر: اللغة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي، ص / 4 - 5، دار نهضة مصر - للطباعة، القاهرة (1971).
2- أميل دور كايم (1858 - 1917م): عالم فرنسيّ، تأثر بمؤلفات العالم (أو غيست كونت) في الفلسفة والتاريخ، ويعدّ مؤسساً لعلم الاجتماع بعد أن خلصه من التأملات الفلسفية العميقة، وجعله علماً قائماً بذاته. (ينظر: معجم أعلام التربية والعلوم الإنسانية / 89).
3- ينظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبده الراجحيّ / 26، دار النهضة العربية، 1989م.
4- ينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة، د. نعمة رحيم العزاويّ / 49.
الداخليّ المنطوق، وتابعهم العالم اللغويّ النفسيّ - سكينر (skinner) (1) الذي يرى أنَّ التفكير نوع من السلوك البشريّ، كالسلوك اللغويّ تماماً، لذلك ذهب إلى عدم التمييز بين اللغة والكلام (2)، أما سوسير الذي ميّز بين الكلام الإنسانيّ وهو (التحدث) و (اللسان) وهو اللغة المعيّنة، فقد حدد میدان كلِّ واحد منهما، فالكلام الإنسانيّ عنده له أشكال كثيرة غير متشابهة، تبعاً لمجالات مختلفة، فهو فيزيائيّ ونفسيّ وتشريحيّ في الوقت نفسه، ويتبع - فقه - فضلًا عن ذلك - المجال الفرديّ والمجال الجماعيّ، ولا ينتظم في فصيلة من العلاقات الإنسانية، لأنَّنا لا نعرف كيف اشتقت وحدته، لذلك يقال: إنَّ (الكلام الإنسانيّ) لا يمكن أنْ يكون موضوعاً لعلم اللغة؛ لأنَّهُ،فرديّ، أما اللغة المعيّنة (اللسان) فهي التي تُدرس؛ لأنَّها اجتماعيّة.
لذا قرر سوسير أنَّ اللغة المعيّنة (اللسان) جزءٌ اجتماعيّ من الكلام الإنسانيّ، مستقل عن الفرد لا يمكن أن يخلقها ولا أن يغيرها بنفسه وحده، فهي تنشأ على أساس نوع من الاتفاق بين الجماعة (3) لذا يمكننا أنْ نقول: إنَّ اللغة عند سوسير هي نظام، أما الكلام في منظوره؛ فنشاط، أو إنَّ اللغة " نظام من الرموز الصوتيّة المتفق عليها في البيئة اللغويّة الواحدة، وهي حصيلة الاستخدام المتكرر لهذه الرموز التي تؤدي المعاني الصوتيّة، أما الكلام فالكيفية الفردية للاستخدام اللغوي" (4)، وقد أوجز تمّام حسّان الفروق بين اللغة المعيّنة (اللسان) والكلام الإنسانيّ (التحدث) بقوله: " الكلام عمل واللغة حدود هذا العمل والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك، والكلام نشاط.
ص: 22
1- سكينر (1904 - 1990) عالم نفس أمريكي شغل درجة أستاذ في جامعة أوكسفورد لغاية وفاته (ينظر: معجم أعلام التربية والعلوم الإنسانية / 121).
2- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د. نايف خرما / 216، مكتبة اللغة العربية، بغداد - شارع المتنبيّ - 1978 م.
3- ينظر: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، بريجيته بارتشت / 56، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ترجمة: أ. د. سعد حسن بحيريّ، القاهرة، ط 1، 2004 م.
4- علم اللغة العربية، د. محمود حجازيّ / 26.
واللغة قواعد هذا النشاط والكلام حركة واللغة مظاهر هذه الحركة، والكلام يُحسُّ بالسمع نطقاً والبصر كتابةً، واللغة تُفهم بالتأويل في الكلام، والكلام هو المنطوق وهو المدوّن، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد والمعجمات ونحوها، والكلام قد يكون عملاً فردياً، ولكنَّ اللغة لا تكون إلَّا اجتماعيّة " (1).
وهكذا توالت الدراسات حتى أصبح لعلم اللغة الاجتماعيّ موقع خاص في اللسانيات، كما لو كان فرعاً مستقلاً من علم اللغة العام، ولكن يبقى هذا الاستقلال نظريًا، إذ من الصعب أن نجد حدوداً فاصلة بين ذلك التشابك والتداخل الذي تعانيه مسألة المدارس والعلوم والمناهج في وقتنا الحاضر.
والجدير ذكرهُ أنَّ قُبالة علم اللغة الاجتماعيّ قد يسمى علم الاجتماع اللغويّ، ومهما كانت التسمية فموضوعها دراسة المجتمع في علاقته باللغة كي يدرك دارسو المجتمع الحقائق اللغويّة التي من الممكن أن تزيد من فهمهم للمجتمع، لأنَّنا لا نستطيع أن نجد في خصائص المجتمع ما يميّزه أكثر من لغته، وأنَّ جميع الظواهر اللغويّة الاجتماعيّة تحدث بالضرورة تغيرًا لغويًا في لغة المجتمع، لأنَّ هذا التغيّر اللغويّ (التطور) هو ضرب من ضروب التغير في التقاليد والأعراف الاجتماعيّة، وقد أفاد تفریق سوسير بين اللغة والكلام في دراسة التغيّر اللغويّ " وهذا معناه أنَّ التغّير اللغويّ يبدأ عند فرد ما، أي على مستوى الكلام، فإذا وجد هذا التجديد قبولًا من المجتمع، أصبح بمضي الوقت عرفًا لغويًّا سائدًا " (2)، فالتجديد الحاصل كي يكون مفيدًا يستلزم قبول المجتمع به، " أما التجديد الذي يرفضه المجتمع فيبقى خارج مجال علم اللغة، لأنَّ علم اللغة يبحث اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعيّة، وليس كلُّ تغيّرِ لغويٍّ عند فردٍ ما أو مجموعة أفراد يقبل اجتماعيّاً، فإلى جانب تغيرات بدأت على مستوى الفرد ثم أصبحت على مستوى البيئة اللغويّة كلّها، هناك تجديدات ظلّت مرتبطة.
ص: 23
1- اللغة العربية معناها ومبناها د. تمّام حسّان / 91، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973م،
2- علم اللغة العربية، د. محمود حجازي /27.
بمجموعة أفراد ولم تقبل اجتماعيًّا" (1)، فمدار التّطوّر اللغويّ في مجتمع ما هو قبول المجتمع وتداولهُ إياهُ، لذا تُعدُّ العوامل الاجتماعيّة وأثرها في خصائص اللغة وتطوّرها من أبرز مباحث علم اللغة الاجتماعيّ، فاللغة تتأثر أيمّا تأثر بحضارة الأُمة ونظمِها وتقاليدِها وعقائدِها واتجاهاتها العقليّة، ودرجة ثقافتها ونظرتها إلى الحياة وشؤونها الاجتماعيّة العامة ... وما إلى ذلك، فكلُّ تطوّر يحدث في ناحية من نواحي العوامل الاجتماعيّة يتردد صداهُ في أداة التعبير، لذلك تُعدُّ اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب، فطبقيّة اللغة والمراحل التي مرَّتْ بها كلُّ طبقة هي الكاشفة عن الأدوار الاجتماعيّة التي مرَّتْ بها الأُمة في مختلف مظاهر حياتها (2)، ومن هنا فاللغة والمجتمع وجهان لعملة واحدة في علم اللغة الاجتماعي، فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به " فكلُّ لغة تعدُّ مرآة المجتمع الذي يتكلمها، وتظهر على صفحاتها ما يتسم به ذلك المجتمع من حضارة أو بداوة، ومن رقي أو انحطاط، وما يخضع له من نظم وعقائد واتجاهات فكريّة وفنيّة واقتصاديّة وغير ذلك " (3)، لذلك ترمي الدراسات اللغويّة الاجتماعيّة الحديثة إلى دراسة العلاقة بين اللغة والظواهر الاجتماعيّة، وبيان أثر المجتمع ونظمه وتاريخه وتركيبه وبنيته ... وسواها، في مختلف الظواهر اللغويّة، فضلّا عن أنَّها تشارك في فهم كثيرٍ من القضايا اللغويّة، من قبيل (4):
1 - إنَّ دراسة الألفاظ ودلالاتها تتم في إطار اجتماعيّ حضاريّ.
2 - إنَّ التغيّر اللغويّ لا يُفسر إلّا في ضوء الظروف الحضاريّة والاجتماعيّة.
3 - إنَّ المواقف الاجتماعيّة تؤثر في مستوى اللغة، وهذه المستويات اللغويّة تساير التغيّر اللغويّ الذي يحدث في المجتمع. 7.
ص: 24
1- نفسه / 27.
2- ينظر: اللغة والمجتمع، د. علي عبد الواحد وافي/ 10.
3- مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة / 49.
4- ينظر: المجتمع وقضايا اللغة، د. محمد السيد علوان/ 27.
4 - دراسة قضايا انتشار بعض اللغات وتطورها وصراعها مع غيرها واندثارها.
و من الدراسات اللغوية الاجتماعيّة ما قام به (هدسن) (1)، الذي افترض وجود ثلاثة أنواع مختلفة من المجتمعات هي:
أ - عالم من الخيال تحدده حدود طبيعية لا يمكن تخطيها، وهو انغلاق هذا المجتمع على نفسه، فلا يوفد ولا يستقبل من المجتمعات الأخرى.
ب - عالم واقعيّ غريب، مثل عالم شمالي غربي الأمازون، الذي يبلغ سكانه 10,000 آلاف نسمة، معظمهم من الهنود الأصليين يُقسمون على عشرين قبيلة، تُقْسَم كلُّ قبيلةٍ على خمسِ عشائر، وكلُّ قبيلةٍ تتحدث بلغة مختلفة عن اللغات الأخرى، إذ إنَّ القبائل الأخرى لا تفهمها وفي بعض الأحيان تكون اللغة الواحدة ذات أصل لغويّ يختلف عن أصول اللغات الأخرى وإنَّ الفرد لا يمكنه أن يتزوج من قبيلته، وعلى الزوجة أن تتكلم بلغة زوجها.
ج - عالم واقعيّ مألوف: توصل هدسن إلى أنَّهُ ليس هناك سوى قليلٍ ممّا نستطيع أنْ نقوله عن اللغة في معزل عن السِّياق الاجتماعيّ في العالم الأوّل وأنَّ هناك كثيرًا ممّا يمكن أنْ نقوله عن اللغة في علاقتها بالمجتمع في العالمين (الثاني والثالث)، مع التفاوت في الكثرة بين المجتمعين، والنتيجة التي استخلصها هدسن هي: " لو كان علم اللغة العام يتميز من علم اللغة الاجتماعيّ بافتقاره إلى التّطوّر الاجتماعيّ فإنَّ علم اللغة العام سيصبح من ناحية موضوعه محدداً للغاية، ونستطيع أن نؤكد أنَّ دراسة اللغة من دون الرجوع إلى السِّياق الاجتماعيّ جهد لا يستحق العناء " (2)؛ لأنَّ إهمال السِّياق الاجتماعيّ قد يؤدي بفروع علم اللغة النظريّ كلّها (الوصفيّ و التاريخيّ ... وسواها) إلى القصور؛ لذلك تُعدُّ الإنجازات والاكتشافات 2
ص: 25
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د.هدسن / 42 - 43.
2- علم اللغة الاجتماعيّ، د. هدسن / 42
القيّمة التي قدّمها علم اللغة العام بمعزل عن السِّياق الاجتماعيّ قاصرة، وكذلك النظريات اللغويّة التي ظهرت في العقود المنصرمة تبقى تعاني أخطاء فادحة جرّاء الموقف غير الاجتماعيّ الذي اتخذه المدافعون عنها (1)، وفي قُبالة ما للسَّياق الاجتماعيّ من تأثير في اللغة، نجد أهمية اللغة في حياة المجتمعات لا تقل شأناً، فقد ذهب (تشيس) إلى أن يقول: " لولا اللغة لتوقفت الحياة الإنسانيّبة ولزالت الحضارات" (2) أما الباحث (امبرتوايكو) فقد عدَّ اللغة مؤسسة اجتماعية (3) فضلاً عن ذلك هي الفارق الحقيقيّ والعلامة الفارقة الرئيسة التي تميِّز الإنسان من الحيوان؛ لأنِّها أكثر رقيّاً وكمالًا واختزالًا وتدوينًا وقابليّةً على الخزن والتغذية والتذكر والنسيان، فهي صورة مُظهِرة لأنشطة العقل كلها (4).
علم اللغة الاجتماعيّ والعلوم الأخرى:
ليس المقصود من علم اللغة الاجتماعيّ أنَّهُ الوحيد الذي يفي بغرض دراسة اللغة وعلاقتها بالثقافة والمجتمع، بل هناك علوم أُخرى تتناول هذا الموضوع بالنظر والدرس، تحت أسماء مختلفة؛ لأنَّهُ حقل واسع، وهو أمر ينفي أحقيّة علم واحد بالقيام بهذه المسؤولية وتولي شؤونها، على الرغم من التشابك والتداخل بين تلك العلوم، ومن هذه العلوم التي يتفق بعضها في المضمون بنحوٍ أو بآخر مع علم اللغة الاجتماعيّ ما يأتي (5):
ص: 26
1- ينظر: نفسه / 43
2- Chase.stuart.power of words.harcourt brace and world. Inc. NEWYORK, 1954, p.6 - 3
3- نفسه.
4- ينظر: المنحى الاجتماعيّ في لسان العرب، محمد صنكور / 41.
5- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال بشر / 41.
أ - علم الاجتماع اللغويّ The souology of language.
ب - علم الانثروبولوجيّ Anthropological.
ج - علم الانثروبولوجيّة اللغويّة linguistic anthropology.
د - علم اللغة الاثنولوجيّ Ethno linguistics.
وفيما سبق تكلمنا على الفارق بين علم اللغة الاجتماعيّ وعلم الاجتماع اللغويّ على أنَّ هناك من يجعل العلمين مترادفين في كلِّ شيءٍ (1)، ونحن نذهب إلى التفريق بينهما، وكذلك اعتمدنا على (علم اللغة الاجتماعيّ) في دراستنا الحالية لالتصاقه بعملنا دالاً ومدلولاً؛ لأنَّهُ العلم الذي يدرس الواقع اللغويّ في إطار المجتمع.
أما العلمان الآخران، وهما: (علم اللغة الانثروبولوجيّ) و (علم الانثروبولوجيّة اللغويّة) فيجري استعمالهما الآن في أغلب الميادين مترادفين، بمعنى دراسة التنوعات اللغويّة، وكذلك في علاقتيهما بالأنماط الثّقافيّة ومعتقدات الإنسان بوجه عام، وهذان العلمان يتداخلان إلى حدّ ما مع (علم اللغة الانثرلوجيّ)، الذي يعنى بدراسة اللغة في علاقتها بالبحوث الخاصة بأنماط السلالات البشرية وأنماط سلوكها.
وهذه العلوم الثلاثة اجمالاً تقع تحت مظلّة علم الاجتماع، وتتصل بنحو أو بآخر ب (علم اللغة الاجتماعيّ) على أساس أنَّها منسوبة إلى المجتمع وإنْ اختلفت عنه في ميادين الاهتمام.
إذًا: فعلم اللغة الاجتماعيّ يأخذ كثيرًا من قضاياه من العلوم المذكورة يتداخل بعضها مع بعض، فتكون وظيفة علم اللغة الاجتماعيّ تبعاً لهذا التفسير " البحث في الكيفيات التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع، إنَّه ينظر في التغيرات التي تصيب اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعيّة المختلفة، مع بيان هذه الوظائف وتحديدها" (2)، ويرتبط علم اللغة الاجتماعيّ بعلم اللغة العام على الرغم من شيوع رأي على نطاق واسع.
ص: 27
1- ينظر: نفسه / 43.
2- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 47.
بوجود اختلاف بين العلمين، وإنَّ هذا الاختلاف يكمن في أنَّ علم اللغة العام لا يهم إلَّا ببنية اللغة من أن يهتمَّ بالسِّياقات الاجتماعيّة التي تكتسب فيها اللغة وتستعمل، أي أنَّ علم اللغة عندهم ينحصر اهتمامه في البحث في بنيتها وخواصها التركيبيّة بوصفها بناءً أو هيكلًا أو شكلًا أو جهازًا - بعبارة بعضهم - منعزلًا عن صاحبه أو مصدره من غير التفات إلى السِّياق غير اللغويّ الذي يجري فيه التعامل اللغويّ الفعليّ الحادث بين الأفراد في مجتمعهم (1)، ويمثل هذا الرأي مباني المدرسة البنيويّة كلّها في علم اللغة، وهي المدرسة التي سيطرت على التفكير اللغويّ في علم اللغة في القرن الماضي، وتضم المنحى التحويليّ والمنحى التوليديّ الذي ابتدعه تشومسكي منذ عام 1957 م، ويمثل المدارس والاتجاهات التدريسيّة للغات الأجنبية في بريطانيا وفي أوربا، التي حذت حذو بنيويّة سوسير في أصل معناها الدقيق (2)، وبحسب هذا الرأي تكون مهمة علم اللغة العام هي اكتشاف قواعد أية لغة وتحديدها، حتى يستطيع دارسو علم اللغة الاجتماعيّ بعد ذلك بيان علاقة هذه القواعد بالمجتمع مثلما يحدث مثلاً عندما يكون هناك مجموعة من البدائل اللغويّة (بدائل التعبير اللغويّ) التي تستعملها المجموعات الاجتماعية المختلفة للتعبير عن شيءٍ واحدٍ، أو " كأن ينظروا فيما يقع من تنوعات لغويّة واقعة بين الأفراد أو المجموعات المختلفة في البيئة اللغويّة للتعبير عن الفكرة الواحدة أو ترجمة للقاعدة اللغويّة التي يفصح عنها ذلك البناء أو الهيكل أو اللغة في مقابل الكلام بوصف اللغة ملكاً للجماعة كلّها، والكلام ملك للفرد المعيّن وهو صاحبه، ومن ثم يعمل علماء الاجتماع على ربط هذه التنوعات الكلاميّة بمصادرها وهم الأفراد من حيث طبقاتهم الاجتماعيّة والثّقافيّة والحرفيّة ... وسواها، إذ تستعمل هذه التنوعات أساسَا للكشف عن هذه الطبقات أو الفئات وتعيّن مواقعها في المجتمع، وبيان خواصّها المميّزة لها لغويًّا واجتماعيًّا " (3)، إذًا نستنتج أنَّ هذا الرأي الذي يمثل الثنائي (دي سوسير، 0.
ص: 28
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 50.
2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، هدسن/ 20.
3- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 50.
وتشومسكي) ومن تبعهما لا يولي الجانب الاجتماعيّ أي اهتمام، بل يركِّز جهوده في الجانب العقليّ والنفسيّ في دراسة اللغة، على أنَّ هناك رأيّا آخر يخالف الرأي المتقدم، إذ يرى أصحابه أنَّ دراسة اللغة من غير الإشارة إلى المجتمع فيها قصور في الرؤية، شأنها في ذلك شأن من يدرس (الصداقة) من غير أن يربط سلوك أحد الصديقين بسلوك الآخر، وهؤلاء يرون أنَّ (علم اللغة الاجتماعيّ) تبعاً لهذه النظرة يمثل عندهم واجهة من واجهات علم اللغة أو هو علم اللغة من وجهة نظر اجتماعيّة، ويُعدُّ (فيرث) - مؤسس مدرسة لندن - أحد أبرز أنصار هذا الرأي، وتابعه (مايكل هاليدي) و (براون وليفنس وهدسن)، إذ يرى الأخير أنَّ كُلًّا من (علم اللغة العام) و (علم اللغة الاجتماعيّ) ينتمي إلى حقلٍ مختلفٍ، مع ملاحظة التقائهما في كثير من القضايا والنقاط (1)، وتابع كمال محمد بشر أصحاب الرأي الثاني لقبوله من وجهين،هما (2):
الأوّل: عدم إمكان التكلم أو دراسة لغة ما في فراغ؛ لأنَّ اللغة ظاهرة اجتماعية منسوبة لقوم معينين.
الآخر: إنَّ الكلام الذي أخرجه دي سوسير من الحسبان، ويقابله الأداء عند تشومسكي له وظيفة اجتماعيّة، إذ هو العملة المتداولة بين الأفراد في حياتهم العامة والخاصة وهو المرآة الكاشفة عن هوية الأفراد وبيئاتهم وفئاتهم المختلفة وعزلنا وإخراجنا إياهُ من النظر اللغويّ يحرمنا من فرصة الوقوف على طبيعتِهِ وخواصِّهِ، ويفقد فرصة التفسير الاجتماعيّ للظواهر اللغويّة، وهي ظواهر لها قيمتها وأهميتها لغويّاً واجتماعيّاً.
أما المدرسة البنيويّة الأمريكيّة (المدرسة السلوكيّة) التي أسسها (بلومفيلد) فقد أهملت الجانب الاجتماعيّ في اللغة على الرغم من أنَّ أصحابها لم يفرقوا بين اللغة والكلام بالمعنى الذي حدده دي سوسير، وعلى الرغم من أنَّهم نظروا إلى اللغة والكلام 1.
ص: 29
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د هدسن / 20 - 21.
2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 51.
على أنّها مادة، أي أحداث فعليّة وليست مجموعة من القواعد المجردة كما قرر سوسير إلَّا أنَّهم اتبعوا المنهج السلوكيّ في علم النفس في التحليل اللغويّ، ولم يعطوا الجانب الاجتماعيّ أي اهتمام ولم يعيروا أيضًا التنوعات اللغويّة الحادثة بين الأفراد أي اهتمام يذكر، وهكذا أهملت البنيويّة الأمريكيّة البُعد الاجتماعيّ للغة، وأغفلت الربط بين البنى اللغويّة، والبنى الاجتماعيّة، والثّقافيّة لمجتمع اللغة، على أنَّ هذا الربط هو الشغل الشاغل لعلماء اللغة الاجتماعيين وعلماء الاجتماع اللغويين، إذ نظر كلٌّ منهما في هذا الربط من الزاوية التي تتسق مع حاجاته واهتماماته (1) والمدرسة التوليدية التحويلية أيضا مبنية على ثنائيّة تشومسكي الكفاءة والأداء، وتعني الكفاءة معرفة الإنسان بلغته وهي معرفة عقليّة أو هي نظام القواعد الذي يسيطر عليها الإنسان سيطرة لا شعوريّة وغير خاضعة للملاحظة الاختياريّة، أما الأداء فهو التوظيف أو الاستعمال الفعليّ للغة في المواقف الحياتية الفعليّة (2).
فهي ترى أنَّ دراسة الكفاءة، تُعدُّ الوظيفة الأساسيّة لعلم اللغة، وعلى اللغويّ أن يستعين بمادة الأداء، للكشف عن النظام العميق للقواعد التي يسطير عليها (المتكلم - السامع)، فهذه النظرية عقليّة صرف، تهمل الجانب الاجتماعيّ لمتكلم اللغة إهمالًا تامًا، فهي نظرية تنطوي على مثالية على رأي بعض المحدثين (3)، والأظهر أنَّها لم تهمل الجانب الاجتماعيّ؛ لأنَّ الكفاءة: شخصية وهي تابعة للتميز على أفراد المجتمع، ولم تكن كفاءة لولا موازنتها بالآخرين. والأداء: شخصي وهو مع المجتمع، فكيف يكون أداءًا لو لم يؤدي إلى المجتمع شيئًا..
ص: 30
1- ينظر: نفسه / 52.
2- ينتظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 58.
3- ينظر: علم اللغة المعاصر، د. يحيى عبابنة و د. آمنة الزعبيّ / 57.
لعل هناك أسبابًا أدت إلى اختلاف وجهات النظر في دراسة اللغة وطبيعتها وأنتجت تنوع المدارس وتعدد النظريات اللغويّة، وعزا كمال محمد بشر (1) سبب ذلك إلى ثلاثة أمور هي:
1 - اللغة مرآة الإنسان، بل هي الإنسان نفسه، والإنسان كائنٌ معقدٌ، من أي جهة نظرت إليه وجدت جديداً يستحق النظر والتأمل، وكذلك لغته، فهو صانعها
2 - اختلاف الزمان والمكان ممّا أدى إلى اختلاف في نظم السياسة اللغويّة، وهذا الاختلاف ظهر في طرائق التفكير وأساليب التعامل في الحياة أو مع اللغة والإنسان، فللغرب منهجه وللشرق أسلوبه، ولأوربا رؤية ولأمريكا أُخرى وللعرب طريقة، وللهنود أُخرى، وهكذا الأمر في بقية البقاع والأصقاع.
3 - اختلاف مناحي الفكر وأنماط الثقافة وضروب المعرفة السائدة في المجتمع المعين.
وفي وقتنا الحاضر، أجمع العلماء المحدثون - تقريبًا - على أنَّ أية دراسة علمية للغة والاتصال الكلاميّ تتطلب أسسًا نظرية يظهر فيها الفعل الحاسم للعوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة كافة، وهي حقيقة أدركها العالم الاجتماعيّ اللغويّ مالينوفسكي (Malinowski) (2) منذ وقت مبكر، حينما أكد أنَّ المعضلة الحقيقية التي تواجه اللغويين تتمثل في تركيزهم الزائد في الكلمات. والسؤال الذي شغل بال هذا المفكر هو: إذا كانت الوظيفة الرئيسة للكلام هي توجيه العمل الجماعيّ أو النشاط الإنسانيّ،).
ص: 31
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ / 60 - 62
2- برونسيلاف كاسير ما لينيوفسكي (1884 - 1942 م): وهو عالم بولنديّ من علماء القرن العشرين الذين برزو في (علم الانسان) ويعدُّ من رواد علم الانسان التطبيقي، ومؤسس (الجمعية البولنديَّة للآداب والعلوم في أمريكا)، وبفضله اصبحت كلية لندن للاقتصاد من ابرز مراكز تدريس علم الانسان في العالم. (ينظر: المعجم في اعلام التربية والعلوم الإنسانيّة / 180).
فكيف إذن نفصل ذلك الكلام عن سياقات مختلفة المواقف، وما تبديه من مغازٍ ودلالات؟
لقد وجد هذا المفكر نفسه غارقاً في الدراسات اللغويّة إيمانًا منه بأنَّنا، لكي نصل إلى ما وراء ظاهر الأشخاص، لا بُدَّ من تعرف لغاتهم، ومعرفة الظروف الاجتماعيّة المختلفة التي استعملت فيها هذه الكلمات والكيفيّة التي تتغير فيها معانيها بتغير المواقف والأشخاص (1)، والمعروف أنَّ مناقشات هذا الاجتماعيّ اللغويّ الجادة قد بلورت ما يعرف اليوم بنظرية السِّياق، التي يقصد بها - بنحوٍ عامٍ - أنِّ اللغة نشاط اجتماعيّ، ولا يكون للكلمة أي معنى إذا عُزِلتْ عن هذا السِّياق أو عن هذا النشاط الذي أُلقيت فيه.
إنِّ تعدد مظاهر الحياة الاجتماعيّة وألوان السلوك الإنسانيّ فيها، يوجبان تعدد وظائف اللغة الاجتماعيّة، ومنها:
1 - استعمال اللغة لتأكيد الشعور بالانتماء إلى المجتمع، كاستعمالها في ألفاظ التحية بأنواعها، والألفاظ والعبارات التي يؤديها في المناسبات الاجتماعيّة المختلفة التي لا تحتاج إلى توصيل الأفكار أو المعلومات من فردٍ إلى آخر، ففي بعض الأحيان يشعر الفرد منّا بأنَّه قريب الصلة من شخص آخر يجلس إلى مائدة أخرى في بلد أجنبي عندما يسمعه يتكلم بلغته (2)، وتشير هذه الوظيفة بطريقة غير مباشرة إلى المركز الاجتماعيّ، والطبقة الاجتماعيّة التي ينتمي إليها الأفراد من حيث إنَّ كلماتٍ معيَّنةٍ تكون أكثر انتشاراً في طبقات معيَّنة. 0.
ص: 32
1- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع، د. محمود أبو زيد / 153، دار غريب للطباعة والنشرب القاهرة، 2006 م.
2- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 210.
2 - استعمال الفرد اللغة في الوظيفة الدينيّة؛ لتأكيد انتمائه إلى نظام دينيّ معيّن، إذ إنَّنا نَلْحَظُ عند النطق بمفرداتها التمايز والاختلاف بين دين وآخر، كلغة الأدعية والأوراد والطقوس الدينيّة والسحر والشعوذة، وأنَّ لها وظيفة فرعيّة، هي تمتين أواصر الصلة بين أبناء المجتمع الذي يدين بدين واحد، بغض النظر عن استعمال اللغة بمعناها الحرفيّ، بل المهم مجرد استعمال صيغ معينة موحَّدة متعارف عليها بين الأفراد، وتشمل اللغة المستعملة في القسم والسؤال واستفتاح الكلام أو الكتاب ولغة الصوفية والزاهدين، وتمتاز هذه اللغة غالباً بالغموض، واستعمال الرموز والمجاز، والمحافظة الشديدة على صيغتها مئات السنين من دون تغيير أو تبديل وقصر - عباراتها مع ثبات مدلولها مع مرور الزمن (1)، ويعود سبب ذلك إلى غموض المعنى الحرفيّ لهذه الصيغ، فاللغات اللاتينيّة المنقرضة ظلّت تستعمل حتى عهد قريب في الطقوس الدينيّة للطوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة جميعها، واللغة (السنسكريتيّة) البائدة ما زالت تستعمل عند الهنود في طقوسهم الدينيّة و استعمال الأقباط للغتهم الميتة، واستعمال المسلمين غير العرب اللغة العربية في ممارساتهم الدينيّة (2).
3 - استعمال اللغة في المناسبات الرسمية ذات الطابع القانونيّ، كاللغة المستعملة في المحاكمات والبيع والشراء والزواج والطلاق.
4 - استعمال اللغة للسيطرة على ظرف ما بنحوٍ منظمٍ دائمٍ، أو التحكم في تصرفات الآخرين لتوجيههم نحو مصلحة المتكلم أو ما يريده وتتمثل هذه اللغة باستعمال العبارات التي فيها نواهي الفرد وأوامره أو طلب اعتياديّ، كالرجاء والاستجداء والسؤال..
ص: 33
1- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 211.
2- ينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة / 52 - 53.
5 - استعمال اللغة في الوظيفة الإعلامية ومن ذلك مواقف قوليّة أو كتابية لا يكون الغرض منها مجرد نقل الأفكار والمعلومات، وإنَّما التأثير في المخاطبين أو استمالتهم أو إقناعهم كاللغة المستعملة في الخطب السياسيّة والدينيّة الوعظيّة للقادة والمفكرين في الأعمال الأدبية والإعلانات (1).
6 - استعمال اللغة للتنفيس عن المشاعر والعواطف والأحاسيس، التي تختلج في النفس أو تخامر القلب، فيما يتعرض له الفرد من مواقف هيَّاجه كالعبارات التي تقال في الأفراح أو الأحزان أو الغضب أو الآلام أو العناء، وهذه العبارات لا تحتاج بالضرورة إلى من يسمعها (2).
7 - استعمال اللغة أو السلوك الكلاميّ غاية في ذاته، ولا تكاد تختلف في هذا الجماعات المتأخرة أو المتقدمة بالنظر إلى حاجة كلِّ كائنٍ بشريٍّ إلى العيش مع سواه ونفوره من الوحدة. فالكلام هنا أقرب الوسائل لهذه الحاجة، وسيلة للمشاركة وخلق الروابط الاجتماعية وتقويتها، وهو ما أطلق عليه مالينوفسكي بالمخالطة المتآلفة (Phatic communion) (3).
8 - استعمال اللغة في التآلف والتعاطف، فالحديث العابر عن (الطقس) مثلًا أو (الأحوال) عادة ما يكون الغرض منه أبعد من نقل الأفكار، فالأوصاف التي تجري على ألسنة المحدثين شائعة وملموسة، وتكاد تكون محفوظة ومتوارثة، والأغلب في ذلك أن ينقطع الحديث أو ينتقل إلى موضوعات أخرى وقد أصبح المتحدثون في ألفة من مجرد متعة الكلام والاستماع (4). 5.
ص: 34
1- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 212 - 223.
2- ينظر: نفسه / 52 - 53.
3- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 154.
4- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 155.
9 - استعمال اللغة كعلامة ومُميّز فرديّ (1)، إذ من الملاحظ أنَّ الأصوات الطبيعية تختلف فيما بينها اختلافاً بيّناً، ويذهب علماء اللغة الاجتماعيون إلى أنَّ هذا الاختلاف يميّز منشأ الصوت من غيره، يذهب هؤلاء العلماء أيضًا إلى أنّ اللغة الإنسانيّة تختلف من فرد إلى آخر، فهي تمزج بين الجنس الذكريّ والأنثويّ، والشيخ والشاب، والرصين والمثير للاستهزاء، ممّا يكاد الفرد منَّا ما إن يسمع صوتًا حتى يعلم بأنَّهُ (فلان)، فكما أنَّ الأفراد يتمايزون بالطول والقصر والبياض والسمرة، كذلك يتمايزون بالصوت، فالتمايز الصوتيّ يرد عادة إلى عوامل عضوية تكسبه صفته المميزة؛ إلَّا أنَّ الحقيقة الاجتماعية تؤكد أنَّها فطريّة وليست مكتسبة في الأصل، فالأصوات من العوامل المهمة التي يتخذها أصحابها والتي يتخذها الآخرون اتجاههم، فقد يكون الصوت أجش مثلاً أو فيه ما يدعو إلى السُّخريّة، أو قد يكون رائقًا ومثيرُا للإعجاب، وفي كلتا الحالتين يختلف الأمر عند السامعين، وعند صاحب الصوت. فقد ينفر الناس من صاحب الصوت الأجش ويبتعدون منه، ممّا يثير مشاعر الحزن والألم والانطواء والعزلة، وقد يقبل الناس على صاحب الصوت الرائق، ممّا يفتح أمامه فرصًا أوسع للتعارف والعمل والعيش في الحياة.
و للصوت الطبيعيّ وظيفة مهمة في التربية الاجتماعيّة، إذ نجد في بعض الأصوات ما يدفع إلى الاحترام، كأنما الصوت نفسه يحدد علامات لمظاهر السلوك التي ينبغي له الخروج عليها، وهو ما نجده غالباً عند القادة والزعماء، وهو أمر يساعد على نجاح العمل الجماعيّ، ويرى (فيرث) أنَّ للصوت أثرًا في تأدية الوظيفة الاجتماعيّة: نفسها، فهو يساعد على تكيف العلاقات بالمجتمع الذي يعيش المرء فيه..
ص: 35
1- نفسه / 156.
10 - استعمال اللغة علامةً مُميّزة للطبقة الاجتماعيّة (1)، إذ تستعمل اللغة للكشف عن التفاوت بين طبقات المجتمع وتحديد المكانة الاجتماعيّة التي يحتلها الأفراد بالنظر إلى انتماءاتهم الطبقيّة، لذلك نرى تفاوتّا واضحًا بين لغة المثقفين ولغة العامة، وبين لغة المتعلمين ولغة غير المتعلمين (الأميين) وكذلك نرى تفاوتاً بين المتكلمين من طبقة المتعلمين أنفسهم، تبعًا لاختلاف ثقافاتهم وتنوعها وعمقها، فما يكاد الفرد يسمع حديث فرد آخر حتى يتبيّن له من فوره مدى التمايز في لغته، وهو ما يطلق عليه باللهجات الطبقيّة (class dialect)، الذي يُعدُّ من أمتع نواحي الدراسة الاجتماعيّة للغة، لارتباطه الوثيق بظاهرة الكلام المحظور والكلام اللائق، فما من مجتمع من المجتمعات الإنسانيّة إلَّا يعرف هذه الظاهرة التي تحرم بعض الموضوعات وتمنع تداول بعض العبارات والألفاظ، " فإنَّ للكلمات من النفوذ والسلطان على نفوسنا، ما يجعلنا ننطق ببعضها التماساً للقوة وطلباً للحماية، ونتجنب نطق بعضها دفعاً للأذى أو ترفعاً لما يرتبط بتلك الألفاظ من معاني الدنس والقذارة، أو ما يخدش الحياء ويجرح الشعور" (2)، ويطلق على هذه الظاهرة (بظاهرة التابو) (3) taboo أو الكلام المُحرّم أو المحظور تداولهُ، غير أنَّ بعض الجماعات لجأت إلى مخالفة هذا التجنب مستعملة ألفاظاً بديلةً لها تكون بمنزلة القناع الذي يخفي وراءه اللفظ أو المعنى الأصليّ الممنوع استعماله، وهو أسلوب شائع في اللغات كلّها، وجاء استعماله في القرآن الكريم، وأطلق عليه تمّام حسّان (أسلوب العفة في البيان)، على أنَّ من العلماء.
ص: 36
1- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 157.
2- ينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة / 56.
3- وهي كلمة استعملها أول مرة الكابتن كوك في أثناء اكتشافه جزائر الارجينيل، وتعني الممنوع ثم انتقلت إلى المجتمعات الاوربية لتعبر عن التحريم والمنع. (ينظر: المُحرَّم اللغوي، د. محمد كشاش، المقدمة).
العرب القدامى من تنبّه عليه وسمّاهُ (تحسين اللفظ) وهو ابن فارس، إذ قال: " إِنَّهُ يُكنّى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسينًا للفظ أو إكرامًا للمذكور، وذلك قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا) فصلت/:21. قالوا إنَّ الجلود في هذا الموضع كناية عن آراب الإنسان ... وقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) النساء / 43، المطمئن من الأرض، كلّ هذا تحسين " (1)، فالمحرم الغويّ بهذا المعنى كناية اضطرارية، وسمّاه كمال محمد بشر ب (حسن التَّعبير) (2)، وأطلق عليه أحمد مختار عمر (تلطيف التَّعبير) (3).
ومن الصعب تفسير الدوافع والأسباب التي تدفع إلى وجود هذه الظاهرة بنحو موحد في ج المجتمعات الإنسانية كافة، فلكلِّ مجتمع دوافعه وأسبابه، ولكن الملاحظ أنَّها موجودة في المجتمعات الإنسانيّة كلها، بصرف النظر عن درجة تحضرها أو تأخرها، لذا تُعدُّ ظاهرة إنسانيّة عامة، يرجعها بعضهم إلى الذخيرة الثّقافيّة المتوارثة وإلى عوامل التراث القديمة التي ما زال لها بعض التأثير في المجتمعات الإنسانيّة كلها (4).
ومن الأمثلة على ذلك أنَّ كثيراً من الشعوب لا تكاد تلفظ كلمة (الموت) صراحةً أو هي في الأقل تتحرز من ذكرها، وتكتفي بما يشير إلى ذلك ضمناً، فنسمع كلمات مثل: (انتقل إلى رحمة الله) أو عبارة: (تعيش أنت) أو (قضى نحبه) ... وما إلى ذلك.
إنَّ مقاييس اللياقة أو عدم اللياقة مسألة نسبيّة تختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف المناطق والثقافات الفرعيّة واللهجات، إلَّا أنَّ هناك عوامل أساسيّة تتداخل في تحديدها من قبيل السِّنِّ والجنس والظروف، التي قد يسمح فيها لمثل هذا الكلام ونقصد به أنَّه يسمح للرجال بقول أو نطق ما لو نطقت به النساء لكان أمرًا غير لائقٍ.
ص: 37
1- الصاحبيّ في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها / 160.
2- ينظر: دور الكلمة في اللغة، استيفان اولمان/ 177، ترجمة: د. كمال محمد بشر.
3- ينظر: علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر / 240، ط 1، 1982 م.
4- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 158.
كما قد يؤذن للنساء في نطق ما لو نطقه الرجال عدّ أمراً شائنًا (1)، وعلى الرغم من أنَّ معايير اللياقة في المجتمع الكلاميّ تُعدُّ مسألة معقدة، لا يمنع هذا من القول بأنّها متغيرة بطبيعة الحال، فما كان غير لائق في مجتمع ما قد يصبح لائقًا في المجتمع نفسه بعد مدة أو في مجتمع آخر، ويدلُّ هذا بوضوح على المراحل الانتقاليّة في حياة بعض المجتمعات التي يحدث فيها الاختلاط بين الجنسين، فيصبح الكلام المحظور لائقًا؛ نتيجة لاختلاط الجنسين، وعُدُّ ذلك أمرًا اجتماعيًّا مقبولًا، وهذا يعني أنَّ للشعور الاجتماعيّ والثقافيّ أثرًا بارزًا في تحديد هذه المسائل والتغيرات الحاصلة في المجتمع الجديد.
التفكير الاجتماعيّ عند اللغويين العرب القدامى:
إنَّ النظرة المعياريّة التي ظهرت بعد تقعيد القواعد والأحكام اللغوية عند اللغويين العرب الأوائل جعلت من تلك القواعد والأحكام ما لا يجوز الخروج عنها، وقد سلكوا مسالك شتى في إخضاع المادة اللغويّة بعد جمعها لإعمال المبادئ الفلسفيّة والمنطقيّة والتعليل والتأويل والافتراض، كما لو كانت لغتهم جامدة لا يصيبها تطوّر ولا تغيّر، ثم زادوا في ذلك حين قصروا واقع اللغة على زمن معين ينتهي بمنتصف القرن الثاني الهجري فيما يخصُّ الحواضر.
كان همهم هو استنباط أحكام اللغة العامة وقواعدها الكلية التي تصونها من التفرّق والتوزّع وتحميها من اللحن والتحريف، وهو موقف يبدو في ظاهره أنَّهُ خالٍ من المنحى الاجتماعيّ للغة، ولم يؤخذ في النظر أي تنوعات كلاميّة تبدو هنا أو هناك، بوصفها آثاراً فعليّة واقعيّة من آثار تنوع البيئة والجماعة والثقافة وسياق الحال الذي يقع فيه الكلام، بل إنَّ تحديد مدة الاستشهاد وبيئته وأصول المادة التي كانوا يستنبطون منها قواعدهم الكلية وطرائق جمع المادة اللغويّة ومبادئ الأخذ منها كلها إشارات دلاليّة
ص: 38
1- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 159.
واضحة تؤكد أن عملهم في مجمله لم يُحْرَمْ من النظر الاجتماعيّ بنحوٍ أو بآخر، سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد (1).
والظاهر في دراساتهم أنَّهم لم ينصّوا على أنَّهُ مبدأ من مبادئ التقعيد أو أصل من الأصول اللغويّة. إنَّهم نظروا في تراثهم اللغويّ على أنَّهُ ضرب من النشاط الإنسانيّ الذي يتفاعل هو ومحيطه وأحواله، مع مراعاة تغير صوره تبعاً لتغير محيطه وأحواله حتى عدَّهُ أحد الدارسين المحدثين أصلًا من أصول نظريتهم حين صرح: " نعدُّ هذا الملمح الاجتماعيّ أصلًا يضاف إلى أصول نظرية النحاة العرب، فإنَّهُ أصل مستأنس لديهم باطرادٍ مستشعر في تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدر عنهم وإن لم يصرحوا به تصريح اللسانيات الاجتماعيّة والحقول الملابسة لها في هذه الأزمنة" (2)، فالمتأمل في تراثهم اللغويّ يجد أنَّهم قد فطنوا إلى أنَّ كلام العربيّ له وظيفة ومعنى في عملية التواصل الاجتماعيّ، ولهذه الوظيفة ولذلك المعنى ارتباطٌ وثيقٌ بالسِّياق الاجتماعيّ وما فيه من شخوص وأحداث، لذلك عمدوا إلى الأخذ من (الكلام) الحي المنطوق، والكلام بهذه الصفة لا يتصور وقوعه ولا حدوثه إلَّا في مسرح لغويّ متكامل الجوانب، من مرسلٍ ومتلقٍ وأحوالٍ وملابسات متصلة بموضوع الحديث.
فالقرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر المادة اللغويّة، نزل على النبي محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) منطوقاً منجمًا بحسب الأحوال، موزعة آياته وسوره على الزمان والمكان المحددين بمدة النزول أي مكة والمدينة ثم نلحظ فروقًا مهمة بين الحالتين في لغته من حيث الألفاظ والتراكيب وأساليب الخطاب في مضامينها الموجهة إلى الناس هنا وهناك بلا تمييز في جنس ولا ثقافة ولا أعراف ولا نظم سياسية ولا تقاليد اجتماعية مع شموله بعض الظواهر اللهجيّة (أصواتا، وألفاظًا، وتراكيب)؛ لشيوع هذه الظواهر في بيئاتها أو.
ص: 39
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 79 - 82.
2- الأعراف أو "نحو اللسانيات الاجتماعية في العربية" د. نهاد الموسى / 12، بحث منشور في المجلة العربيّة للدراسات اللغويّة، المجلد الرابع، العدد الأول (ذي القعدة، 1405 ه).
لتنوع أساليب الخطاب؛ لتنوع المستقبلين له وتنوع محصولهم اللغويّ. وكذلك الحديث النبويّ الشريف فهو ذو خصوصية؛ لأنَّهُ ملك لصاحبه، وهو مرآة شخصيته وموقعه يرسله في ظرفه وملابساته فهو وسيلة مهمة من وسائل التواصل بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، وقومه على أساس فكرة التواصل بين المرسل والمستقبل
وما يميّز هذا الحديث أنَّ كلماته وأساليبه جاءت مطابقة للحال والغرض الذي يقصد إرساله أو التعبير عنه أو توصيله إلى الناس بعامتهم أو إلى فئة خاصة أو طبقيّة منهم، لغرض معين وفي وقت محدد وإنْ كان مضمونه يمتد إلى الآخرين وينطبق عليهم بغض النظر عن الزمان والمكان.
أما كلام العرب (نثره وشعره) في مرحلة التقعيد فهو أيضًا لا يخلو من البُعد الاجتماعيّ؛ لانَّ الشاعر أو الناثر يصدر عن ذات نفسه تبعًا لثقافته وحياته الاجتماعيّة، وللغرض الذي تناوله والمقام والمسرح اللغويّ (الاجتماعيّ) المعيّن الذي تكلم فيه "، فكلّ إنسان مهما بلغت درجة لغته من الانضباط والحفاظ على جوهريات أو ثوابت قواعدها لا بُدَّ أن يقع في أدائه الفعليّ للكلام قدر من التنوعات في ترجمة هذه القواعد عند التوليد منها وتحويلها إلى واقع مكتوب أو مسموع هذا من جهة، ومن جهة أخرى تفرض الظروف التي تلف الرسالة النثريّة أو الشعرية أن يطعم المرسل (الناثر أو الشاعر) أو يلونها ألوانًا لغويّة جديدة، بوصفها أوقع في نفس المُستقبِل (السامع) وأقرب إلى فهمه وموقعه الثقافيّ والاجتماعيّ " (1).
ومن أنماط التفكير الاجتماعيّ ومظاهره في الدرس اللغويّ عند العرب ما سلكهاللغويون - في جمع لغتهم للدرس والتحليل والتقعيد - من مسالك اللغويين الاجتماعيين للكشف عن الحقائق اللغويّة في إطار المجتمع وما ينتظمه من ثقافات وأنماط سلوك تبعًا للبيئة الخاصة أو الحرفة أو الصنعة أو الموقع الاجتماعيّ وهو مسلك يعرف اليوم ب (البحث الميدانيّ)، ويعني أنْ يجري البحث على أرض الواقع بالمعايشة 2.
ص: 40
1- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 82.
والاختلاط بأصحاب المادة المرغوب في جمعها، والنظر فيها، وهو ما فعله علماء العربيّة في مرحلة جمع جمع المادة من مشافهة أهل البوادي، لأنَّ الكلام عندهم – في حينها – منظم الخواص الصوتيّة وما يصحبه من صدق الواقع ودفء الحقيقة، ومن الحركات والإشارات الجسميّة، التي تيسر عملية التواصل بين المرسل والمتلقي.
وبهذا فإنَّ اللغة العربيّة في مرحلة جمعها كانت منوعة تنوع أهليها وبيئاتهم وثقافاتهم الاجتماعيّة، فاتخذت لنفسها بُعداً اجتماعياً وموقعاً في الدرس اللغويّ الاجتماعيّ، وإنْ لم تدرس دراسة اجتماعيّة مستقلة، تنبئ بخواصها وأسرارها وقيمتها في التوظيف اللغويّ الاجتماعيّ، وكان من نتائج ذلك فقدان حقل دراسيّ مهم من شأنه أنْ يربط بين البنيتين اللغويّة والاجتماعيّة بطريقة علميّة صحيحة على الرغم ممّا وعاهُ عددٌ من المفكرين كالجاحظ وابن خلدون، وأصحاب المقامات.
و من المناحي الاجتماعيّة عند العرب في درسهم اللغويّ مراعاة المقام أو سياق الحال - Non - linguistic context - أو ما سُمِّيَ ب (المسرح اللغويّ) (1)، في قُبالة سياق مكونات النصِّ وما يحيط بالكلام من جوّ خارجيّ، مشتملاً على ظروف وملابسات وأحوال، تتمثل عناصره الأساسيّة في شخصيّة كلِّ من المتكلم والسامع وما بينهما من علائق، أثر الخطاب الكلاميّ في المشتركين في المسرح اللغويّ إلى غير ذلك حتى عدّ المقام قاسماً مشتركًا بين النحاة والبلاغيين، فالنحاة راعوا المقام بنحوٍ أو بآخر، وإنّ لم ينصّوا على ذلك نصًّا إلَّا في حالات محددة، واعتمدوا في كثير من الحالات عليه في تقعيد القواعد وضبط المواد عمومًا، هناك من النحاة من أشار إلى سياق الحال عند كلامه على الفهم والإفهام بقوله: " إنَّ الكلام ما تحصل به الفائدة، سواء لفظًا أو خطًا أو إشارةً أو ما نطق به لسان الحال " (2). م.
ص: 41
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 96.
2- شرح شذور الذهب، ابن هشام الأنصاريّ / 38، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، ط1، 1978 م.
أما البلاغيون فأولوهُ من الاهتمام ما لا يخفى على أحد حتى عُدَّ في المستوى البلاغيّ ركناً أساسًا في الصحة الخارجية للنصِّ، أي الانتقال به من الفصاحة إلى البلاغة المتمثلة في وجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فقد يكون النصُّ صحيحًا من الناحية الداخليّة، أي من حيث دواخله التركيبيّة وقواعده اللغويّة، ولكن لا يكون بليغاً إلَّا إذا وافَقَ مقتضى الحال وما ينتظمه من أجواء اجتماعيّة وثقافيّة تحيط بالنصِّ.
ولم يقف النظر الاجتماعيّ عند اللغويين، بل تعداهم وامتد إلى عدد من المفكرين ورجال الأدب وفنونه، ولا سيما اثنين منهم، هما: (الجاحظ وابن خلدون) لعمق نظرتهما في هذا المضمار، وتنوع ما أتيا به من مادة على نحو بحوث مستقلة.
فكان الجاحظ ذا نظر عميق في رؤيته للغة وتنوعاتها تبعاً لتنوع بيئاتها وأهليها، وله إشارات متناثرة في كتبه (الحيوان والبيان والتّبيين والبخلاء، ورسائله الأدبية) فقد تحدث بحديث متناثر في أعماله عن لغة الفصحاء والبلغاء والأعراب والمولدين والنبطيين والخرسانيين والحكماء من فلاسفة ومتكلمين والعامة من سواد الناس وتحدث عن السمات العامة للهجات ولغات تلك المجتمعات المذكورة آنفًا، ووقف وقفة الباحث المدقق الفاحص عند بعض الظواهر المُميّزة لهذه الفئة أو تلك، ولا سيما مجال الأصوات ومستويات النطق، محاولا بذلك ربط البنية الصوتيّة بالبنيتين الاجتماعيّة والثّقافيّة، ومن كلماته في هذا المجال قوله: " وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة، بالعربيّة المعروفة، ويكون لفظه متخيرًا فاخرًا ومعناه شريفًا كريمًا ويعلم مع ذلك السامع لكلامه ومخارج حروفه أنَّهُ نبطيٌّ، وكذلك إذا تكلم الخرسانيُّ على هذه الصفة، فإنَّك تعلم مع إعرابه، وتخير ألفاظه في مخرج كلامه أنَّهُ خرسانيٌّ، وكذلك إذا كان من كتاب الأهواز" (1)، ويقول أيضاً: "النَّخَّاس يمتحن لسان الجارية.
ص: 42
1- البيان والتّبيين، الجاحظ 96/1، طبعة هارون.
إذا ظنَّ أنَّها روميّة وأهلها يزعمون أنَّها مولدة، بأن تقول: (ناعمة)، وتقول (شمس) ثلاث مرات متتالية " (1).
وينصرف الجاحظ في أماكن أُخر من كتابه لرصد عدد من السمات الصوتيّة (اللُّكْنَة) فيقول: "إنَّ صهيباً الروميّ يقول: إنَّك لهائن بالهاء عندما يريد قول: إنَّك لخائن بالخاء" (2)، وهكذا فإنَّ ما ذكرناه قليل من كثير يكشف عن براعة الجاحظ في رصد العلاقة بين حركة اللغة في أوساطها الاجتماعيّة وبيئاتها الثّقافيّة، والنظر في هذه العلاقة ورصد أنماطها، التي تُعدُّ سمة من سمات علم اللغة الاجتماعيّ ووظائفه
أما ابن خلدون؛ فقد كان مُميّزًا وسابقًا لعصره في هذا المجال، بل امتدت ملحوظاتُهُ إلى قضايا لغويّة أُخرى ذات نسب قريب باللغة العربيُة على وجه الخصوص، فتكلم على اللغة واللسان ومفهومها وطبيعة كلٍّ منهما، وتناول قضية التّطوّر اللغويّ، والإعراب ووظيفته وحقيقته من حيث الطبع والصنع، وأشار إلى الفصاحة والبلاغة، التي تُعدُّ أساس العمل في علم اللغة الاجتماعيّ. وتناول بالنظر العميق علاقة المجتمع، وطبيعة هذه العلاقة ومردودها البادي فيما نسمّيه ب (التّنوع اللغويّ) أو بعبارة أدق محاولة الكشف عن مدى المواءمة بين البنية اللغويّة والبنية الاجتماعيّة.
عرَّف ابن خلدون اللغة بأنَّها: "عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل السانيّ، ناشئة عن القصد لإفادة الكلام، فلا بُدَّ أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كلِّ أُمة بحسب اصطلاحاتهم" (3)..
ص: 43
1- نفسه 1/ 72.
2- نفسه.
3- المقدمة 3 / 1264، دار النهضة، مصر، 1979م.
فإذا تأملنا هذا النصَّ وجدناه يشير إلى عددٍ من القضايا اللغوية التي تتصارع الآراء من حولها في القديم والحديث، كالكلام على مفهومي (اللغة) و(اللسان)، أهما مجتمعان أم منفردان؟ أ يعدّان خاصية إنسانيّة جماعيّة أم فرديّة؟ ... وسواها.
وركَّز ابن خلدون في نقطة مهمة، وهي اصطلاحيّة اللغة أو عرفيتها المُعبَّر عنها في التعريف السابق، بقوله: (وهو في كلِّ أُمة بحسب اصطلاحاتها)، فاللغة عنده عرف أو تقليد أو اصطلاح وليست توقيفيّة أو وراثيّة أو غريزيّة، وليست مفروضة فرضًا على أصحابها وليست من صنع جماعة معينة ولا فرد معين وإنَّما هي اصطلاح يجري على السنن المتعارف عليها في الأُمة أو الجماعة اللغويّة المعيّنة، والاصطلاح يأتي اتفاقاً بحسب البيئة والظرف والحاجة حتى يؤدي ما اصطلح عليه أنَّهُ توظيف أمثل؛ لكي يحصل التواصل والتفاهم بين المصطلحين؛ ولكي يؤدي هذا الاصطلاح وظيفته والاصطلاحيّة بهذا المفهوم تعني (1):
1 - أنَّ اللغة اصطلاح، أي اتفاق أشبه بالعقد الاجتماعيّ بين أفراد البيئة (الأُمة).
2 - أنّ الاصطلاح اللغويّ قابل للتجديد، والتغيير، والتحديث، والخروج على الأنماط التقليديّة، وهو ما أشار إليه ابن خلدون بقوله: " إعلم أنَّ عرف التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليست بلغة مُضر القديمة، ولا بلغة أهل الجيل، بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة من لغة مُضر - وعن لغة هذا الجيل العربيّ، الذي لعهدنا وهي عن لغة مُضر أبعد" (2).
إنَّ توظيف ابن خلدون للمصطلح على أنَّهُ عرفٌ، دليل واضح على أنَّ اللغة - عنده - ظاهرة اجتماعيّة، شأنها شأن أنواع السلوك الاجتماعيّ الأخرى، فكلّها تخضع للاتفاق والافتراق - بحسب الظرف والحال - كذلك نرى ابن خلدون يركّز في عامل 3.
ص: 44
1- ينظر: نفسه، ج / 3، ص / 1264.
2- المقدمة 1384/3.
الزمن مؤكداً بذلك سمة التنوع اللغويّ، ولاسيما في مقولته: "كلٌّ منهم - يعني أهل المغرب والأندلس والمشرق - متواصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عمّا في نفسه" (1).
3 - اللغة اصطلاح، فهي وسيلة التواصل بين أفراد المجتمع ولا يتم التواصل ولا يكون إلَّا بالوقوف على أرض مشتركة من الثقافة والرؤية بين المتكلم والسامع.
ولا يفوتنا بيان أنَّ ابن خلدون قد وضع عدة عوامل اجتماعيّة لها تأثير مباشر وغير مباشر في حال اللغة، وحدةً وتنوعًا، وقوةً وضعفًا، وغنيً وفقرًا ... وغيرها، وهي عوامل مزدوجة الأطراف، أبرزها (2):
السلطان والدين.
الاختلاط والعزلة.
الزمان والمكان.
ومن إيجاز ما تقدم تبيّن لنا أنَّ ابن خلدون كان رائداً من رواد الفكر اللغويّ الاجتماعيّ، الذي تعمقت أبعاده، واتسعت جوانبه، وأسّس ما يعرف في العصر الحديث العلم المعروف ب (علم اللغة الاجتماعيّ).
وممّا يؤكد هذه الحقيقة اتفاق ابن خلدون مع علماء اللغة الاجتماعيين في أساسيات هذا العلم وجوهرياته، ومن وجوه هذا الاتفاق ما يأتي (3):
1 - اللغة ظاهرة اجتماعيّة أو هي عرف واصطلاح.
2 - العلاقة بين اللغة والمجتمع علاقة تأثير وتأثر.
3 - تنوع اللغة بتنوع المجتمعات وما تنتظمه من عوامل اجتماعيّة وثقافيّة.
ص: 45
1- المقدمة 1384/3.
2- ينظر: نفسه 1/ 900 - 904.
3- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 135 - 136.
كالحكم والدين والزمان والمكان، والاختلاط والعزلة.
4 - وحدة اللغة دليل على وحدة الثقافة، وتنوعها دليل اختلاف الثقافات، وهو أمر يؤدي إلى ضعف الهوية القوميّة أو انهيارها.
5 - اللغة مرآةٌ مُظهِرة لحياة الناس وأنماط سلوكهم وأعرافهم وتقاليدهم، وقديمًا قالوا: " إذا فتحت فاك عرفناك" (1)، أي أنَّنا ندرك من أنت وما وضعك الاجتماعيّ، وما نوع ثقافتك، وما نوع صنعتك، بمجرد أن تبدأ بالكلام. على أنَّ الإمام علياً (علیه السلام)، سبق ابن خلدون في إيضاح هذه الحقيقة حين قال: " تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَحْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ " (2)، تلك المقولة الواردة في نهج البلاغة، الذي يمثل بحق أكثر النصوص الأدبية ثباتًا وديمومةً وانتشارًا في فكرنا الإسلاميّ بعد القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف؛ لأنَّ مضامينه تستجيب للحالات المختلفة في المواقف الإنسانية، من قبيل صراع الإنسان استتثارًا لكرامته وتقدمه، وفي تعاونه مع المجتمع، وفي تصنيف الفئات وبيان روابطها ... وسواها، ممّا سوف يكشف عنه قابل هذا البحث إنْ شاءَ الله تعالى.
إنَّ أغلب الآثار الأدبيّة والثّقافيّة وقتيّة ومحدودة؛ لأنَّها تصدر بتأثير عوامل اجتماعيّة معيّنة، فتلبي حاجات عقليّة واجتماعيّة، ثم تفقد قيمتها بزوال ذلك العامل المُحفِّز، ولا يكون لها من الأصالة والعمق والعموميّة ما يهيئ لها أن تتعدى محيطها الخاص زمانًا ومكانًا، لكن لا يمنع هذا أن تكون لبعض الأُمم آثار أدبيّة وثقافيّة تبقى خالدة لا ينال من جدتها الزمان؛ لأنَّ البحث فيها يدخل في الكيان الصميميّ لتلك الأُمم، فهي لذلك تُعدُّ عند هذه الأُمم خالدة ما دام لها كيانٌ، وصفوةُ تلك الآثار ما.
ص: 46
1- مثل عربيّ قديم لم أجده في مجمع الامثال للميداني (ت 518 ه).
2- نهج البلاغة، حكمة: 392 / 546.
يُعدُّ ملكاً للإنسانية كلّها، في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فهي لم توضع لفريقٍ دون آخر، ولم يراعَ فيها شعبٌ دون شعبٍ، وإنَّما خوطب بها الإنسان أنَّي وجد وكائن من كان.
يُعدُّ نهج البلاغة من الآثار القليلة في عددها العظيمة في قيمتها، وسواء نظرنا له شكلًا أو مضمونًا، وجدناه أثرًا تقل نظائره في التراث الإنسانيّ الضخم، فقد قيل في بيان عظمته: "إِنَّهُ دونَ كلامِ الخالقِ، وفوقَ كلامِ المخلوقين" (1)، فهو كتاب إنسانيّ " تتحول الأفكار فيه إلى أنغام، وتتحول الأنغام فيه إلى أفكار، ويلتقي عليه العقل والقلب، والعاطفة والفكرة، فإذا أنت من الفكرة أمام كائن حي متحرك ينبض بالحياة، ويمور بالحركة ... وهو إنسانيٌّ باحترامه للإنسان والإنسانيّة، وإنسانيٌّ باعترافه للإنسان بحقوقه في عصرٍ كان الفرد الإنسانيُّ فيه عند الحكّام هباءةً حقيرةً، لا قيمة لها ولا قدر، إنسانيٌّ بما يثيره في الإنسان من حب الحياة والعمل لها في حدودٍ، تضمن لها سموها ونقاءها " (2)، ولهذا وغيره يبقى (نهج البلاغة) على الدهر أثراً من جملة ما يحويه التراث الإنسانيّ من الآثار القليلة التي تعشو إليها البصائر، إذ تكتنفها الظلمات.
ولما كان ابن خلدون قد سجَّل في (مقدمته)، حدثاً علمياً فيما يخصُّ فكرة المجتمع، حينما جعل منها علماً قائماً بنفسه، يفترق عن الفلسفة في مادته، وهي الحياة الاجتماعيّة، ويفترق عنها أيضاً في منهجه، وهو الملاحظة، ويفترق عنها في غايته، وهي تعرّف أحسن الوسائل لتنمية الحياة الاجتماعيّة. ولما كان (أوغست كنت) (3) عالم).
ص: 47
1- شرح نهج البلاغة 24/1.
2- دراسات في نهج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين / 17، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، ط 1،2007م.
3- أوغست كونت (1857 - 1798) فيلسوف فرنسيّ، أسس المذهب الوضعيّ القائم على تمجيد العلم ورفض الميتافيزقيا بمعناها التقليديّ، فالعصر في نظره عصر فوضى فكرية، لذا كان يرى أنّ الاصلاح الفكريّ هو أكثر الاعمال اهتماماً، وله كتبٌ، منها: (مشروع الاعمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع) وكتاب (دروس في الفلسفة الوضعيَّة) وكتاب (مذهب السياسة الوضعيَّة). (ينظر: معجم في اعلام التربية والعلوم الإنسانيَّة / 28).
الفلسفة الوضعيّة في عصرنا الحديث قد أعطى فكرة المجتمع الشيء الكثير، حتى أصبح لها دوائر خاصة تعرف اليوم بدوائر المعارف الاجتماعيّة يبقى التساؤل قائماً عن صلة (نهج البلاغة) بهذا كلِّهِ.
إنَّ فكرة المجتمع في نهج البلاغة لها مكان مرموق بين ما اشتمل عليه من نصوص، فسِرُّ عظمة هذا الكتاب هو إيمانُ مُنشئهِ المُطلق بكرامة الإنسان، وحقِّهِ المُقدس في الحياة الحرَّة الشريفة، وأنَّ هذا الإنسان مُتطوّر أبداً، وأنَّ الجمود والتقهقر والتوقف عند حال من أحوال الماضي أو الحاضر ليست إلّا نذير الموت ودليل الفناء، وقد عبر عن قاعدة التّطوّر هذه بقوله: " لا تفسروا أولادكم على أخلاقكم فإنَّهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم" (1)، ومثل هذه القاعدة الاجتماعيّة التي تتناول المسلك الإنسانيّ كلَّهُ، توجِّه كلَّ نشاطٍ، وتراقب كلَّ عملٍ، قال الإمام علي (علیه السلام): " من تساوى يوماه فهو مغبون" (2)، فالتصريح بأنَّ الغبن لا يلحق الجماعة من الناس إلّا إذا استوى حاضر هم وأمسهم، ولا يكون ذلك إلّا بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يهدأ.
وقليل جدًا من عظماء التاريخ من أسس نظريات في الاجتماع بلغةٍ مُعبرةٍ مُقتضبةٍ واعيةٍ. فهو القائل: " الاحتكاك جريمة " (3)، و: " مَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ " (4)، و: " الذنب الذي لا يغتفر هو ظلم العباد بعضهم لبعض" (5)، ثم وصف الإمام الناس بأنَّهم: " طَبَقَاتٌ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ" (6) وغير ذلك من الأقوال التي تثبت حقيقة أنَّ الإنسان مدني بالطبع، أي أَنَّهُ خُلِقَ خلقة لا بُدَّ معها من أن يكون منضمّاً إلى أفراد من بني جنسِهِ، ومتمدناً في مكان بعينِهِ..
ص: 48
1- شرح نهج البلاغة، 1/ 210.
2- نهج البلاغة 20/ 36.
3- نفسه 20/ 113.
4- نهج البلاغة 328/ 534.
5- نفسه، 23/19.
6- نهج البلاغة، كتاب / 432/53.
فإذا راح المحدثون من علماء الاجتماع يضعون القوانين وينظمون الدساتير على أساس هذا الوعي الكريم، وينسبون اختراع (علم الاجتماع) إلى ابن خلدون أو إلى (أوغست كنت)، ويثبت ذلك في الدوائر الاجتماعيّة، فإنَّنا لا نريد أن ننسب ذلك إلى الإمام علي (علیه السلام)، لأنَّهُ لم يقصر نفسه على اختراع العلوم وإنْ كان قد شارك في هذا المجال الإبداعيّ، فاخترع علم الكلام وعلم العربيّة، بل كان همّه الكبير تطبيق المثل العليا الإنسانيّة والصيغ الصحيحة في بناء المجتمع الأمثل المتكامل، لقد فكر الإمام (علیه السلام) في المجتمعات التي حكمها وفكر في أفضل الطرائق والوسائل التي تنمي حياتها الاجتماعيّة، وترتفع بها إلى الذروة من الرفاهية والقوة والأمن مع ملاحظة أنَّها تدين بالإسلام، وأنَّ شؤونها واقتصادها وحربها وسلمها وعلائقها الاجتماعية تخضع كلّها لقوانين الإسلام " وقد هداه تفكيره إلى نتائج باهرة في التنظيم الاجتماعيّ، فالحكم وضرورته والنزعة القبيليّة وعقابيلها وشغب الغوغاء ونتائجه ودعامات المجتمع ومقوماته والطبقات الاجتماعيّة وآلياتها، كلُّ ذلك خصَّه بمزيد من البحث والتفكير " (1) ويقيناً لو أنَّ الرضي جامع (النهج) قد دوَّنَ لنا ما وقع إليه من كلام الإمام علي (علیه السلام) ولم يؤثر الفصيح الباذخ وحده لانتهى إلينا من ذلك شيء عظيم، ومع ذلك جاءت ألفاظ (نهج البلاغة) مشحونة بطاقة إيحائيّة تعبيريّة عالية، فأثارت فجوة ذهنيّة في الأنساق اللغويّة معتمداً بذلك على ثقافة المتلقي وما يحمله من موروث، وخبرات وتجارب تساعده على الوصول قدر الإمكان إلى الفكرة التي يريد الإمام إيصالها في أطار اجتماعيّ معين، بمعنى أنَّهُ ليمكننا الحديث عن سمات المجتمعات التي عاش فيها الإمام من غير الحديث عن لغةِ كلِّ مجتمع وثقافته، يؤثر فيها ويتأثر بها؛ لأنَّ اللغة عاملٌ أساسيّ في كلِّ التنظيمات الأساسية للمجتمع كالدين والتربية والعدل ... وسواها.
ومن الانجازات العامة للإمام علي (علیه السلام) في المجتمعات التي عاش فيها، تأسيسه جهاز (الشرطة)، وقد سمّاهم بهذا الاسم؛ لأنَّهُ شارطهم على الجنة (2) وهو أول.
ص: 49
1- دراسات في نهج البلاغة / 24
2- ينظر الفهرست، ابن النديم / 223، تحقيق: رضا تجدد، قم.
من أشار إلى استعمال التاريخ الهجريّ الذي كانت بدايته من أول هجرة النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) (1) وهو الذي أشار على الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين (2) وأمر كذلك بسك العملة في البصرة سنة (40 هجرية) (3)، وهو الذي نقل عاصمة الخلافة الإسلاميّة من المدينة إلى الكوفة في العراق ممّا جعلها رسالة عاجلة لإفهام الذين جاؤوا، أنَّ التّطوّر الحضاريّ إنَّما يأتي من التغيير، وهو أول حاكم أصرَّ على تطبيق حقوق الإنسان.
ومن خصائص الإمام تطويره المفهوم الأخلاقيّ للحرب، فهو لا يبدأ بحرب إلّا إذا هوجم ولا ينازل أحدًا إلّا إذا دعاهُ لذلك، وكان يبدأ الحرب بالموعظة الحسنة ثم الحجة القاطعة ثم يدين فعل أعدائه، فإذا لم ينفع ذلك كلُّهُ بدأ بالحرب (4).
وفي السياسة طبق الإمام السياسة المثاليّة الواقعيّة لا النفعيّة التبريريّة، وهو أوّل من فرق بين الشهود بقوله: أنا أوّل من فرق بين الشاهدين إلّا النبي دانيال (علیه السلام) (5) وهو أوّل من وضع صناديق وغرفا للشكوى (6)، وأسس الدفاتر ودواوين الخراج والأموال (7) وغير ذلك.
لذا تبرز أهمية هذه الدراسة من ناحيتين، هما:.
ص: 50
1- ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (علي بن الحسين / ت 571 ه) 1/ 43، تحقيق: علي شيريّ، دار الفكر، بيروت، 1415 ه.
2- ينظر: تاريخ الأمم والملوك، الطبريّ 278/3، الاعلمّي، بيروت.
3- ينظر: الإمام علي أسد الإسلام وقديسه، روكس بن زايد العزيزيّ / 152، ط 2، بيروت، (1399 ه - 1979 م).
4- ينظر: ملامح من عبقرية الإمام، مهدي محبوبة / 128، ط 1، بيروت، (ب.ت).
5- ينظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر اشوب 2/ 193 (محمد بن علي / ت:588)، المطبعة الحيدريّة، النجف 1376 ه / 1956م.
6- ينظر: ملامح من عبقريّة الإمام، مهدي محبوبة / 128.
7- ينظر: أعلام نهج البلاغة، السّرخسيّ - علي بن ناصر، (ت/ ق 6) / 30، ط 1، طهران، 1415 ه.
1 - إنَّ علم اللغة الاجتماعيّ مازال في حيّز التنظير وقد كُتِب فيه عدد من الكتب و البحوث أبرزها:
أ - علم اللغة الاجتماعيّ، د هدسن، ترجمة محمود عياد.
ب - علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر.
ج - مجموعة من كتب (اللغة والمجتمع).
ولم تغادر هذه الكتب ميدان التنظير لأُسس (علم اللغة الاجتماعيّ)، وتأتي هذه الدراسة لتنقل هذا العلم إلى حيّز التطبيق، وهو الواقع الحقيقيّ لميدان هذا العلم؛ لأنَّهُ فرع من (علم اللغة التطبيقي).
2 - تناولت هذه الكتب بعض خصائص المجتمعات الحديثة في جوانبها الميدانية بخلاف هذه الدراسة التي تناولت اللغة الأدبية في نصوص (نهج البلاغ) بالبحث والدراسة، كاشفةً عن البنى الاجتماعية لتلك المجتمعات التي قيلت فيها، فظهرت تقاليد هذه المجتمعات وعاداتها وأعرافها وثقافاتها وتاريخها وغير ذلك من المضامين الاجتماعية في لغة (نهج البلاغة).
ويوُّد الباحث أنْ يبيّن أنَّ هذه الدراسة في الأغلب، دراسة مضامين وليست دراسة أشكال أو تراكيب إلّا فيما يتعلق بالمضامين نفسها من معان أو علائق، بخلاف ما وقع بين يدي الباحث من رسائل و اطاريح لغويّة ذات منحى اجتماعيّ، مثل: (الألفاظ الاجتماعيّة في لسان العرب) لمحمد صنكور، و (الألفاظ الاجتماعيّة في المعلقات السبع) لندى الشايع، التي ركَّزت في الشكل لا المضمون، واطلع الباحث على دراستين مهمتين في هذا الميدان، الأولى: (اللغة في الثقافة والمجتمع، مع تصور مبدئي لمشروع أطلس اللهجات الاجتماعيّة في مصر) للدكتور محمود أبو زيد، والأُخرى: (اللغة والجماعة في المغرب العربيّ) لجلبيز عزانغيوم، ولكن تبقى هذه الدراسات مقصورة على المجتمعات الحديثة أما المجتمعات القديمة فلا سبيل لمعرفتها إلّا من لغة النصوص التي قيلت فيها، ولهذا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تُعدُّ الأنموذج الأوّل لدراسة علم اللغة الاجتماعيّ (أسسه ومفاهيمه) في ضوء نصِّ أدبيِّ
ص: 51
عالٍ هو (نهج البلاغة)، الذي يظهر واقع المجتمعات التي قيلت فيها، فهو ميدان واسع وباب مفتوح للباحثين في تراثنا الأدبيّ على وفق مفهوم علم اللغة الاجتماعيّ؛ للكشف عن واقعيّة المجتمعات التي أنشئ فيها النهج.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ مبادئ مدرسة النقد الجديد التي ظهرت في فرنسا عام 1965 م، تقترب من النقد الذي وجهه الإمام علي (علیه السلام) في خطبه للمجتمعات عموماً وللأفراد والفئات والطبقات في كلِّ مجتمع خصوصًا، إذ ترى هذه المدرسة أنَّ النقد الأدبيّ (أسسه، ومفاهيمه) الرئيسة ليست حقائق مطلقة تصدق في كلِّ مكانٍ، بل هي تتغير مرة تلو الأُخرى؛ نتيجة التغيرات التاريخيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة، ففي فرنسا مثلاً مرَّ النقد الأدبيّ بسلسلة من التغيرات الجوهريّة عبر مراحل التغير الاجتماعيّ المتعددة لذلك البلد، لذا نرى أنَّ النقد الأدبيّ المعاصر يتميّز باعتماده على العلوم الاجتماعيّة مثل: علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة اعتماداً يكاد يكون كاملاً.
وظهرت على أساس مدرسة (النقد الجديد) عدة دراسات انصبت أغلبها على دراسة (راسين)، ومن أبرز هذه الدراسات دراسة (مارسيل بلوم) الموسومة ب (الموضوع الرمزيّ في مسرح راسين)، معتمدةً على أساس التحليل الاجتماعيّ لأعمال راسين، ومحاولة فكّ رموزها معتنقة في ذلك حقيقة مسلمة رئيسة مؤداها: إنَّ العمل الأدبيّ يكشف عن جوهر شخصيّة خالقه من جهة، وعن ثقافة المجتمع الذي قيل فيه من جهة أُخرى (1).
إذًا ليس من المعقول أن يكون (نهج البلاغة) قد ولد نتيجة اختراع فرديّ من غير اعتمادٍ على معطيات اجتماعيّة للفرد والجماعة، ومن غير المعقول أيضًا أنَّ شكلًا أدبيًا كنهج البلاغة تميّز بهذا الغنى الاجتماعيّ، قد وجد وبقي قرونًا طويلة، ودرسه كتاب وعلماء وباحثون يختلف بعضهم مع بعض اختلافًا بالغًا، وينتمون إلى بيئات مختلفة وإلى قوميات متباينة عبر سلسلة من الزمان، من غير أن توجد علاقة دالة بين مضمون هذا الشكل الأدبيّ وأكثر الجوانب أهمية في الحياة الاجتماعيّة..
ص: 52
1- التحليل الاجتماعيّ للأدب، السيد يسين / 24 - 25، ط 3، مكتبة مدبوليّ، القاهرة، 1988م.
نهج البلاغه
فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ
الفصلُ الأوَّلُ
سماتُ الإمامِ (علیه السلام) السّلوكيّة وأثرُها في المُجْتَمَعِ
ص: 53
الفصلُ الأوَّلُ
سماتُ الإمامِ (علیه السلام) السّلوكيّةُ وأَثرُهَا فِي المُجْتَمَعِ
مدخل:
لقد انفرد كتاب نهج البلاغة بسمات قلما نجد لها مثيلًا في أي نصِّ إسلاميِّ آخر سوى القرآن الكريم والسُّنّة النبويّة الشريفة، فهو اليوم، وبعد أربعة عشر قرنًا من عهده، يحافظ على الحلاوة والطلاوة، والقدرة نفسها على تحريك العواطف والأحاسيس، تلك التي كانت في زمانه، على الرغم من كلِّ ما حدث من تحوّل في الأفكار والأذواق والثقافات وتغيّرها؛ لأنَّ كلماته لا تحدُّ بزمانٍ أو مكانٍ، لما اشتملت عليه من اللفظ المنتقى والمعنى المشرف في تأدية الوظائف الاجتماعيّة واللغويّة، ولما احتوتهُ من جوامع الكلم في أسلوبٍ متساوق الأغراض، ويُعدُّ في الذروة العليا من النثر العربيّ الرفيع، ووظائفه عالميّة الوجه إنسانيّة الهدف من حيث إنَّها تتجه إلى كلِّ إنسانٍ وكلِّ مجتمع، ولكلِّ زمان ومكان.
إنَّ مضامين كلمات (نهج البلاغة) وتراكيبه شغلت الإنسان بكلِّ أبعاده، فرمت تحريره من ربقة الجهل، وأنارت عقله بالعلوم والمعارف، تمهيداً لإيقاظه من سباته، وبعثه على التأمل في الكون وما فيه من أنظمة ونواميس وما يحمله من إرادة خفيّة دقيقة التنظيم، ليخلص من ذلك كلِّه إلى الإيمان بالله خالق الكون وواهب الحياة.
وإنَّ المضامين الخالدة في البناء اللغويّ توحي إلى الإنسان أن يتقي الله في دنياه، ويعمل لدنياه ولآخرته، ويعيش في حياته ببساطة وقناعة في ظلِّ علاقات اجتماعيّة وروابط حيويّة تنبع من المسؤولية بالتعهدات الاجتماعيّة والمطالب الحياتيّة للناس كافة.
ص: 55
هذه المشاركة في الحياة، فرضت على الإمام علي (علیه السلام) أنْ يعيش لغيره كما عاش لنفسه في مستوى واحد من الحماسة والاهتمام، فاتخذ وظائف اجتماعيّة متعددة، ظهرت في بنائه اللغويّ، تبعًا للأحوال والأحداث التي تحيط بالنصِّ.
يضم هذا الفصل من الدراسة عرضًا لسمات الإمام (علیه السلام) السلوكية وأثرها في المجتمع، وهي في ثلاثة مباحث:
ص: 56
المبحثُ الأوّلُ / لغةُ التنشئةِ الاجتماعيّةِ في (نهجِ البلاغةِ)
حين دراسة وظيفة أية لغة من اللغات يمكننا الانطلاق من مظهرين: احدهما في عدِّ اللغة وسيلة تواصل؛ لتمكين الأفراد من تبادل المعلومات بعضهم مع بعض، وهذا المظهر واقعيّ، يمكن إدراكه بسهولة؛ لأنَّهُ المظهر الأكثر تلمسّا في اللغة، ومن شأن الاهتمام به في المقام الأوّل أن يقودنا إلى الحديث عن المظهر الأخر: الجماعات اللغويّة؛ لأنَّها جماعات بينها تفاهم لغويّ، يمكن ربطه بعناصر اجتماعيّة أُخرى كمستوى العيش والسكن والنشاط المهنيّ ... وسواها، وفي هذا المستوى تنجز الدراسات السُّوسيولسانيّة (اللغويات الاجتماعيّة)، الخاصة باللغة والتواصل.
وهذه الوظيفة مهمة جداً في دراستنا، ولكننا سنتحدث عنها في الفصل الرابع من هذه الدراسة إنْ شاء الله تعالى. أما في هذا الفصل فسنتناول المظهر الثاني من وظيفة اللغة، الذي يقدم لنا تصوراً أكثر شموليّة من المظهر الأوّل؛ لأنَّ اللغة إنْ كانت تَصلحُ للتواصل فهي تصلح أيضًا - وربما أساسًا - للوجود. فالفرد يشيّد هويته داخل هذه العلاقة من التواصل والوجود.
ومن المظهر الآخر هذا، تُحقق التنشئة الاجتماعيّة للفرد وهيكلة وجوده الاجتماعيّة، هذه اللغة التي تدخل الفرد في علاقته في المجتمع، وتدخله في عملية مزدوجة، إذ يعترف له بهوية - هوية عضو في داخل المجتمع - ويحصل على اعتراف مقابل قبول قانون الجماعة، بهذا المعنى؛ فاللغة هنا تعني تحديد البنية الرمزيّة للجماعة (1).
تُعدُّ عملية التنشئة الاجتماعيّة من العمليات الحيويّة المستمرة التي لا تقتصر على مرحلة عمريّة معيّنة، فهي تلازم الفرد من المهد إلى اللحد.
ص: 57
1- اللغة والجماعة في المغرب العربيّ، جلبير غرانغيوم / 2، ترجمة: محمد اسليم، كتاب منشور على شبكة الانترنیت موقع http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/communaute.htm
وتعرف بأنَّها العملية التي يكتسب منها الفرد المعارف والمهارات (القدرات) التي تمكنه من التواصل الاجتماعيّ مع الجماعة، وهي من أبرز العمليات الاجتماعيّة وأخطرها في حياة الفرد، فعليها تعتمد مقومات شخصيته، ومن طريقها يتكيف الفرد أو لا يتكيف مع بيئته. وهي كذلك عملية تربويّة لا تتم في المنزل فقط، بل يشارك المعلمون وأفراد المجتمع فيها، وهي عملية مستمرة ولا سيما انتقال الفرد فيها إلى مجتمع جديد، ويطلق عليها التنشئة الاجتماعيّة في الطفولة، والتَّطبيع الاجتماعيّ في المراهقة والكبر.
يكتسب الفرد اللغة والعادات والتقاليد، ويكوّن اتجاهات وقيماً. وتتأثر التنشئة الاجتماعيّة بعدة عوامل منها: المعتقدات السائدة، والظروف السياسيّة، والمستوى الاقتصاديّ والتعليميّ والفكريّ للآباء.
ووظيفة التنشئة الاجتماعيّة هي نمو الفرد اجتماعيًّا، بحيث يتكيف فيها مع المجتمع ويتشرب عاداته وسلوكياته، ويصبح عضوًا منتميًا إليه ومواليًا له، وتشتمل هذه الوظيفة على عدة مستويات، هي:
1 - اكتساب الفرد ثقافة المجتمع في أثناء اكتسابه اللغة والعادات والتقاليد وأنماط السلوك السائدة والقيم الخاصة بالمجتمع، وبذلك تحدد هويته الاجتماعيّة ويتحول إلى كائن اجتماعيّ حامل لثقافة المجتمع، قادر على نقلها للأجيال الأُخرى فيما بعد مثلما نقلت إليه.
2 - إشباع الفرد حاجاته، فإذا لم تلبِّ حاجات الفرد المعرفيّة والوجدانيّة والمهاريّة في ظلِّ الثقافة السائدة في المجتمع ظهرت هناك فجوة بين الفرد ومجتمعه، إذ يميل عدد من الأفراد إلى العزلة والاغتراب والانطواء والهجرة في كثير من الاحيان.
3 - التَّكيّف مع الوسط الاجتماعيّ.
4 - تحقيق عملية التَّطبيع الاجتماعيّ التي ترتبط بوظيفته (نمط السلوك) التي يؤديها الفرد في المجتمع أو بالوظيفة التي يشغلها
ص: 58
لذا لا يمكن أنْ تحقق التنشئة الاجتماعيّة بغير اللغة، فللكلمات رموز أو علامات تشير إلى أشياء في مواقف وتحمل معاني الأشياء في تلك المواقف، ومن طريق هذه الرموز يستطيع الفرد أن يستجيب للأشياء حتى في حالة عدمها في مجاله الحسِّيّ ِ المباشر، ومن طريق اللغة يتمكن الفرد من تحديد سلوكه سلفًا فيما يخصُّ المواقف المستقبليّة، وهذا هو أساس عملية التفكير (1).
لقد شاركت في دراسة اللغة كثير من العلوم الإنسانيّة، ومنها: (علم النفس الاجتماعيّ، وعلم الاجتماع، وعلم نفس النمو، والفلسفة وعلم اللغة الاجتماعيّ) ويكتسب الأخير منها أهمية كبيرة في دراستنا؛ لأنَّهُ الكاشف عن الخبرات والتنبيهات التي يتعرض لها الفرد في سني عمره الأولى، حتى اكتمال تشكيل شخصيته في المستقبل من طريق لغته وسلوكه الكلاميّ الكاشف عن الإمكانات والاستعدادات الموروثة، وما يحصل لها من تفاعل مع البيئة، يكتسب الفرد في أثنائها السلوك الاجتماعيّ المناسب للبيئة الاجتماعية والثقافية، وهذا يعني أنّها عملية تعلم اجتماعيّ، تجعل الفرد المتعلم عضوًا في أُسرته أو مؤسسته أو مجتمعه.
ولا يخلو نهج البلاغة من التوجيهات التربويّة التي تعنى بتشكيل عقل الطفل وشخصيته، وتنمية ملكته، هادفةً من ذلك إلى تنشئة الطفل تنشئة إسلاميّة صحيحة، (فتكبر) معه الفضائل.
تنشئة الإمام الاجتماعية:
انطلق الإمام علي (علیه السلام) في تنشئته للمجتمع من منظور إسلاميّ، تجسد في نشأتِهِ (علیه السلام) الاجتماعيّة؛ إذ ولد في بيئة محطمة روحياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يسفك أهلها الدماء، ويقطعون الأرحام، ويعبدون الأصنام، ويتفشى فيهم الجهل والفتنة (2).
ص: 59
1- ينظر: أساسيات التوافق النفسيّ والاضطرابات السلوكية والانفعاليّة (الأسس والنظريات) د. صالح حسن أحمد الداهريّ / 322، ط 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2008 م.
2- ينظر: التاريخ الإسلامي العام، د. علي إبراهيم حسن / 125، ط3، القاهرة، 1963م.
كما جاء عنه (علیه السلام): " إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينِ، وَفِي شَرِّ دَارٍ، مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ، وَحَيَّاتٍ صُمٍّ، تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ، وَتَأْكُلُونَ الْجشِبَ، وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ، وَالْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ " (1).
لقد سمته أمهُ (حيدره) فغيّرهُ أبوهُ وسمّاهُ (علياً) (2)، وقد ذكر المؤرخون أنّ اسمه بالعبرانيّة (الهيولى) وبالسِّريانيّة (مينا)، وفي التوراة (إيليا)، وفي الزبور (أريا) (3).
وكَفَلَه النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد أن أشار على العباس بن عبد المطلب أن يخففا عن كاهل عمه أبي طالب، فأخذه النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ليربيه، وقد وصف الإمام (علیه السلام) حاله قبل أن يحتضنه الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) قائلًا: " مازلتُ مظلوماً مذ قبضه الله حتى يوم الناس هذا، ولقد كنت أُظلم قبل ظهور الإسلام، ولقد كان أخي عقيل يذنب جعفر فيضربني " (4)، هذه المظلوميّة التي جعلت من الإمام رائدًا في الأدب والإبداع، إذ إنَّ الإنسان الذي يعاني هو نفسه الإنسان الذي يبدع، وهو في نظر (برجلر) أكثر الناس معاداةً للنظم الاجتماعية الظالمة؛ لأنَّهُ يكتب ليحلَّ صراعاً داخليّاً، سببته تلك النظم السائدة (5).
أقام الإمام (علیه السلام) مع النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنتي عشرة سنة قبل النبوة، وثلاثًا عشرين سنة، ثم عاش ثلاثين سنة بعد وفاة النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) (6)..
ص: 60
1- نهج البلاغة، منتدى دار الإيمان، مركز الإشعاع الإسلاميّ 26 / 69.
2- ينظر: مقاتل الطالبين علي بن الحسين الملقب بأبي الفرج الأصفهاني (ت 356 ه) / 14، تحقيق: كاظم المظفر، ط2، المكتبة الحيدرية، النجف.
3- ينظر: الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبيّ (ت 334 ه) / 92، ط 4، موسسة البلاغ، لبنان، 1411 ه، 1991م.
4- السيرة النَّبويَّة، ابن هشام محمد بن إسحاق المطلبيّ (ت 151 ه) 1 / 162، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1383 ه.
5- ينظر: التفسير النفسيّ للأدب، د. عز الدين إسماعيل / 7، دار المعارف، مصر، 1963 م.
6- ينظر: تاريخ أهل البيت كبار المحدثين والمورخين / 7، تحقيق: رضا الحسينيّ، ط 1، 1410 ه.
وهي سيرة طويلة كان الإمام (علیه السلام) فيها دائم الصلة بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) منذ طفولته التي يصفها في نهج البلاغة بوصفها أبرز مرحلة من مراحل التربية والتعليم بقوله: " وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَ أَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ يَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْ ءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ (صلی الله علیه وآله) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ، وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالاقْتِدَاءِ بِهِ. وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ.
وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ (صلی الله علیه وآله)، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ" (1)، إذا كان الطفل يدخل عملية التنشئة الاجتماعية، منذ مرحلة انعقاد النطفة في الرّحم، وتشكيل الجنين، فإنَّ هذه العملية في الواقع لا تتحقق بعمق إلّا بوصوله إلى اللغة، وهو أمر يتم في المحيط الأول، أي في المحيط الأُسريّ، فالطفل لا يحصل على صفة عضو في الأُسرة إلّا بالكلمات التي يسمعها ثم يرددها، وفضلًا عن ذلك فإنَّ تسميته نفسها تعود إلى هذا المظهر بالضبط؛ إذ يقال له (In Fans) (الذي لا يتكلم) (2)، فالإمام علي (علیه السلام) حين يصف علاقته بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) يبدأ فيها منذ أن أصبح ولدا قادرًا على التكلم وترديد العبارات؛ لذلك وصف علاقته بالنبي بما حملته له ذاكرته الدالة على سنهِ آنذاك، فالعبارات: (القرابة القريبة) و(المنزلة الخصيصة) تدلُّ بنحوِ لا يقبل الشكّ على شدّة قربه من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، ذلك القُراب الذي لا يدانيه فيه أحد من العالمين..
ص: 61
1- نهج البلاغة خطبة 192/ 301.
2- ينظر: اللغة والجماعة في المغرب العربي، جلبير غرانغنيوم / 7.
إنّ الاندماج التدريجيّ للطفل في محيطه، لايتم بمحاكاة خالصة أو بمجرد ترويض، بل يتم أساسا باللغة أي داخل هذا المكان الذي توجد فيه الجماعة الأُسرية، واللغة الأم في آن واحد، وهذا ما عبر عنه الإمام (علیه السلام) في قوله المتقدم: "وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالاقْتِدَاءِ بِهِ". وهي مرحلة (تكوين الذات)، إذ يكتسب الطفل فيها سماته الخاصة التي تميّزه من باقي الأطفال، أو تكوّن له (ذاتًا) مختلفة عن ذوات الآخرين تبدأ هذه المرحلة عندما يدرك الطفل أنَّ اسمه يختلف عن أسماء الآخرين، ثم يتعلم تدريجيّاً كيف يستجيب للمؤثرات ويستكشف العالم،ونظمه، ثم تأتي مرحلة استعماله اللغة وهي مرحلة مهمة، إذ يشعر بأنَّهُ يستطيع أن يتفاعل مع الآخرين وينقل لهم أفكاره وحاجاته.
إنَّ مرحلة (تكوين الذات) تتمثل في مرحلتي التقليد والمناغاة، فالتقليد نوع من أنواع السلوك الذي تميزت به كثيرٌ من الكائنات الحيَّة، ومن ضمنها الإنسان، فالتقليد سلوك مكتسب، وهذا الاكتساب يمدّهُ،اجتماعيًّا، فالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) كان يشجع الإمام عليًّا (علیه السلام) على تقليده، وهذا يعني أنَّ مسيرته مع النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) كانت مسيرة موجهة توجيهاً صحيحاً، تشرب فيها الإسلام في روحه وجسده حتى ملك مشاعره وأحاسيسه وقدراته كلَّها، فأصبح هو الدين نفسه، فما يقوله ويفعله هو الحق، لا شيء غيره، وأنَّهُ المعيار الذي تحتكم إليه الأفكار، فهو يمثل الفيصل الحاسم بين (الحق والباطل).
إنَّ فعل التفكير يقتضي - من الطفل أن يتخلى عن عمله المتخيل، متمثلًا في الأشياء، لا يقول منه إلّا ما يسمعه من الكلمات التي منحه إياها محيطه؛ لكن التخلي عن الأشياء هو امتلاك لها من طريق تسميتها بحضور رمزيّ للاسم، وهذه التجربة يعيش فيها الطفل مع أُسرته؛ لأنَّها أبرز الموضوعات عنده، وينتقل منها من عالم الفرديّة إلى: عالم الجماعيّة؛ لأنَّ الأُسرة أوّل جماعة يعرفها الفرد، وهذه التنشئة الاجتماعيّة تتم باللغة أوّلًا في داخل هذه الجماعة، على أنَّنا لا ننكر أنَّ هناك روابط أُخرى لهذه الجماعة، تُعدُّ أسبق من اللغة كرابطتي الدم والنسب.
ص: 62
إنَّ العلاقة بين اللغة والجماعة تنشئ الطفل على وفق ثقافة الجماعة، وتتم عند الطفل حينما يتبنى لغة الجماعة بالمعنى الكامل، فقول الإمام (علیه السلام): " وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ" يدلُّ دلالةً قاطعةً على تخلق الإمام (علیه السلام) بأخلاق النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) قولاً وسلوكاً، وهذا التخلق يعني قبول القانون الثقافيّ للجماعة الفاضلة، التي تكسبه هويته، وتضمن له عضويت، هو الأمر الذي أتاح للإمام أن يعثر على نقطة ارتکاز خارج نفسه وفي واقع الجماعة، نقطة ليست مُتخلية (فرديّة)، وإنَّما عاد بها إلى نقطة واقعية (جماعيّة) من طريق الكلمات، ف " اللغة هي القانون الذي تفرضه الجماعة على الفرد، وهي الشرط الذي تضعه الجماعة أمام الفرد؛ كي يحصل على هوية اجتماعية معترف بها " (1)، بهذا المعنى يجب أن يكون لكلَّ جماعة لغة خاصة بها تعبر عن ثقافتها، أي عن مجموعة القيود التي تفرضها على الفرد، لذلك وضح الإمام السلسلة الاجتماعيّة الإسلاميّة التي امتزجت عبر لغة الوحي والنبوة والإمامة، وهي لغة خاصة تمثل في مجملها التنشئة الإلهيّة الربانيّة، ويتجلى ذلك بوضوح في قول الإمام (علیه السلام): "وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ (صلی الله علیه وآله) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ، وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالاقْتِدَاءِ بِهِ".
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الإمام (علیه السلام) استعمل الحواس الخمس كلّها في النصِّ على وفق تأثيرها في عملية التنشئة الاجتماعيّة، فجاءت العبارات الآتية: (وضعني في حجره وأنا ولد يضمني الى صدره ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده) للدلالة على حاسة اللمس، التي تمنح الطفل الحنان والعاطفة والطمأنينة، تمثل هذه المرحلة مرحلة (الأمان العاطفيّ)؛ إذ يحتاج الطفل إلى الامان والحب كما يحتاج إلى الأكل والشرب، وهي المرحلة التي يحتاج فيها الطفل إلى المدح والثناء، كي لا يشعر بأنَّه غير قادر على التصرف، فالعبارات الواردة آنفاً تدلُّ دلالةً قاطعةً على أبرز الوظائف الاجتماعيّة فيما.
ص: 63
1- اللغة والجماعة في المغرب العربيّ / 4.
يخصُّ تنشئة الطفل، ثم قال الإمام (علیه السلام): (ويشمني عَرْفَه) إشارةً لحاسة الشَّمِّ التي وردت في هذه العبارة، وأكدت في نهاية الفقرة، حينما قال الإمام (علیه السلام) (واشمُّ ريح النبوة)؛ لأنَّ الإمام (علیه السلام) كان يعلم أنَّ رسول الله كان نبياً منذ أنْ كان فطيمًا، قرن الله به جبرائيل واصفًا إياه ب (أعظم ملك من ملائكته)، وهذه المقابلة بين شمِّ الرسول وشمِّ الإمام تعطي النصَّ امتزاجًا عطرًا من عطر النبوة والإمامة، تدلُّ على التنشئة الربانيّة الصالحة لكلِّ منها منذ الولادة. وكذلك ذكر الإمام حاسة (التذوق) مرة واحدة في قوله: (وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه).
ثم جاءت الحاسة الرابعة (الرؤية) فقال (علیه السلام): (فأراه ولا يراه غيري)، وربما كان القصد أنّ الإمام يرى النبي حال مناجاة ربه وحال نزول الوحي عليه، ويثبت ذلك ما سبق من قوله (علیه السلام): (ولقد كان يجاور من كلِّ سنة بحراء) هذه الرؤية مرة أخرى تشير أيضا إلى رؤية نور الوحي والرسالة، فجعل عبارة: (أرى نور الوحي والرسالة) متممةً لرؤية الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، لكي تكتمل الرؤية الإلهيّة للمشروع الربانيّ.
وجاء بالحاسة الرابعة (السمع) حين قال: (ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه (صلی الله علیه و آله و سلم)) للدلالة على أنَّ السمع والرؤية متقاربان في تنشئة الطفل اجتماعيًّا من حيث درجة الأهمية، مع ملاحظة أنَّ السمع يسبق الروية في النشأة عند الطفل، ففي الوقت الذي يرى فيه عناصر الحدث الكلاميّ في البعثة النبويّة (الوحي، والرسالة، والرسول) كان يسمع رنة الشيطان، حين نزول الوحي، لذلك بادر الإمام إلى سؤال النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) الدال على التربية والتعليم بالاستفسار (ما هذه الرنة؟)؛ لأنَّ الإمام حينما يرى يوقن، لكنه حينما يسمع لا يوقن إلّا بعد استيضاح الأمر من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، وهنا يتحول الإمام (علیه السلام) من مرحلة (تكوين الذات) إلى مرحلة (تكوين الشخصية)، إذ تبدأ هذه المرحلة حينما يبدأ الطفل بالتفكير مع نفسه، ليطرح أسئلة واستفسارات عمّا يجول في خاطره، ليكوّن مخزونًا من المعلومات والمهارات التي تساعده على التكيف وتعرّف المواقف المختلفة، إنّ استعمال أدوات التوكيد في النصّ تشير إلى أنّ التوجيه ليس ترفاً اجتماعيًا اقتضته ضرورات العلاقة النسبيّة والسببيّة بينهما، بل هو تشريع إلهيّ
ص: 64
محض لا يمكن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أن يتفوّه به لو لم يكن مأموراً به من الباري عزّ وجلّ، وإلّا فما الداعي لأن يتقول على أحدٍ، وجواز الأمور الصغيرة كجواز الأمور الكبيرة في وضع الانتحال، إنْ كان هناك وضع فعلًا (1)، لذا قال الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) في إجابته عن سؤال الإمام (علیه السلام) قال: (إنّكَ تَسمَعُ ما أسمَعُ، و تَرى ما أرى، إلاّ أنَّكَ لَستَ بِنَبيٍّ، و لكنَّكَ لَوَزيرٌ، و إنّكَ لَعَلى خَيرٍ)، فقدم السمع على البصر على وفق أصولِ التنشئةِ الاجتماعيّة الواقعيّة، مخالفاً لما ورد في نصِّ الإمام (علیه السلام) المتقدم من حيث الترتيب، ويبدو للباحث أنَّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) قدم الإجابة عن السؤال أوّلًا، لذا خصَّ السمع لتعلق السؤال به، ثم ذكر الرؤية تعزيزًا وتوكيدًا لما كان يراه الإمام (علیه السلام) هذا من جهة، ومن جهة ثانية تيمنًا بالقرآن الكريم الذي قدم السمع على البصر، قال تعالى: (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) هود: 20، قَالَ (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ) الحجر: 18، وقال (أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ) يونس: 31، وقال: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) الإسراء: 36، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ) المؤمنون: 78، وقال: (ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ) السجدة: 9 وقال: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ) الملك: 23، ومن جهة ثالثة تستدعي الموازنة الإلهيّة أنْ يكون في قُبالةِ العبادةِ إغواءٌ، وفي قُبالةِ العقلِ النفسُ الأمارةُ بالسوءِ، لذلك أعقب الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) كلامه بذكر الرؤية التي تناسب الحقيقة، لكيلا يفهم أنَّ الإمام كان يسمع رنة الشيطان من غير أنْ يرى نور الهدايا الإلهيّة، وهذا يعني أنَّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) والإمام (علیه السلام) كانا يسمعان رنة الشيطان، ويريان نور الوحي، ولا ضير في القول إنَّهما كانا يسمعان كلَّ شيء ويريان كلَّ شيء أيضًا، في كلِّ زمان ومكان؛ لأنُّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم يحدد بقرينة لفظية، فيقول: ما دمت معي أو إنَّ هذا في.
ص: 65
1- ينظر: الخطاب والوعي، دراسة تحليلية في بنية الخطاب في نهج البلاغة، د. عبد الحسنيّ عبد الرضا العمريّ / 38، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة البصرة.
حياتي، وإنَّما استمرارية الفعل والزمان والمكان؛ لأنَّ مظاهر وصف الكلام من زاوية المتقبل للرسالة الإخباريّة الذي هو سمة الاستكشاف، التي يكتسبها الحدث اللغويّ لما يقرره السارد للخبر" ... وَ إِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيِّي وَ إِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً" (1)، وقوله (علیه السلام): " ولقد قبض رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، وإنّ رأسه لعلى صدري، ولقد سالت نفسه في كفي، فأمررتها على وجهي، ولقد ولَّيتُ غسله (صلی الله علیه و آله و سلم) والملائكة اعواني، فضجَّت الدار والأفنية، ملأُ يهبط، وملأُ يعرج، وما فارقت سمعي هينهةٌ منهم، يصلون عليه، حتى واريناه في ضريحه، فمن ذا أحقُّ به منّي حيّاً ميتاً" (2).
إنَّ المنظومة الذهنيَّة للإمام (علیه السلام) لم تتغير ولم تتبدل عبر مراحل عمره الشريف، دلالة على اليقين الذي كان يملأ قلبه وكيانه، فهو القائل لمعاوية: "فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَ أَخِيكَ وَ خَالِكَ شَدْخاً يَوْمَ بَدْرٍ وَ ذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي وَ بِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي. مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً وَ لَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِيّاً، وَ إِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ دَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرَهِينَ" (3)، هذه البنية التي نشأ عليها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وصفها (علیه السلام) بقوله: " وَ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَ أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَعْمَامَنَا، مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً وَ مُضِيّاً عَلَى اللَّقَمِ وَ صَبْراً عَلَى مَضَضِ الْأَلَمِ وَ جِدّاً فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ" (4).
إنَّ عبارات النصّين تعطي المتأمل تقابلّا بين البنية الذهنيّة للإمام (علیه السلام) والبنية الذهنيّة للمنافقين، ثم أنّ الإمام (علیه السلام) لم يترك هذه البنية التي يحملها إلّا أوضح أحكامها للمكلفين من أتباعه في كلِّ زمان ومكان، إذ قال (علیه السلام): "أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ.
ص: 66
1- التفكير اللسانيّ في الحضارة العربيَّة، د. عبد السلام المسديّ / 98، الدار العربيَّة للكتاب، لبنان، 1981م
2- نهج البلاغة، خطبة/ 143/97.
3- نفسه، كتاب/ 10 / 371.
4- نفسه، كتاب / 56 / 92 - 93 واللقم هو الطريق الجاد الواضح، والمضض هو لذع الألم.
بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ؛ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ، فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي، فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ.
أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ؛ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ، فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي، فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ." (1).
إنَّ دلالة النصِّ الاجتماعيّة تؤكد أنَّ أصل الإمامة امتداد لأصلي التوحيد والنبوة كأصلٍ آخر من أصول الدين، حينما فرّق الإمام (علیه السلام) بين لفظتي (السب والبراءة) مع أنهما عند أغلب فرق المسلمين بحكم واحد، بل عند بعضهم أنَّ السَّبَّ: أفحش من التبرؤ، ومن هذه الفروق ما يأتي:
1 - إنَّ لفظة (البراءة) لم ترد في القرآن الكريم إلّا عن المشركين قال تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) التوبة / 1. وقال تعالى (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ التوبة / 3. فأصبح لفظ البراءة بحسب العرف الشرعيّ لفظة مطلقة على المشركين خاصة، فحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظة (البراءة) على لفظة (السّبّ) وإنْ كان حكمها واحداً عند المعتزلة
2 - إنَّ الإكراه على السّبِّ يبيح إظهاره، ولا يجوز الاستسلام للقتل معه، أما الإكراه على البراءة، فإنَّهُ يجوز معه الاستسلام للقتل، ويجوز أن يظهر التبرؤ، والأولى أنْ يستسلم للقتل، كما هو في عقيدة الباحث. فضلاً عن أنَّ إباحة السَّبِّ عند الإكراه جائزٌ إقتداءً بالنهج الإسلاميّ ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالإِيمَن) النحل / 106. على أنَّ التلفظ بكلمة الكفر أعظم من التلفظ بسب الإمام (علیه السلام)؛ لذلك علل الإمام جواز هذا السَّبَّ، لما يحصل عليه المؤمن والإمام من مكاسب آخرويّة، فنجاة المؤمن من القتل إذا اظهر السِّب زكاة للإمام في الوقت نفسه، لأمرين، هما:
1 - ما ورد عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أنَّ سبَّ المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته. 3.
ص: 67
1- نهج البلاغة، خطبة/ 57، ص / 93.
2 - إِنَّ السبَّ من القتل المعنويّ، وهذا النوع من القتل يزيد صاحبه شرفاً وعلوّ قدرٍ، وشياع ذكرٍ، فمجيء لفظة (الزكاة) مناسبة وانتشار الصِّيت والسمعة؛ لأنَّ الزكاة تعني النماء والزيادة، ومنه سُمِّيَتْ الصدقة المخصوصة زكاة؛ لأنَّها تنمي المال المزكي، وكذلك انتشار الصِّيت نماءً وزيادةً.
أما قول (علیه السلام): (فإنّي ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة"، فتعليل للنهي عن البراءة منه)، مع أنَّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) قد صرح بذلك على كلِّ مولود في الكون: " كلُّ مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه " (1)، فذلك أنَّه (علیه السلام) علل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل، وهي أنَّهُ على الفطرة، وأنَّهُ سبق إلى الإيمان والهجرة، ولم يعلل بآحاد هذا المجموع؛ لأنَّ الإمام (علیه السلام) لم يولد في الجاهليّة، لما ورد في الأخبار الصحيحة أنَّ النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) مكث قبل الرسالة سنين عشراً، الصوت ويرى الضوء، ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصًا لرسالته (صلی الله علیه و آله و سلم)، فحكم تلك السنين العشر حكم أيام رسالته، وهي السنون التي ولد فيها الإمام (علیه السلام)، وتربى في كنف الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، حتى أنَّ ابن أبي الحديد ذكر أنَّ الرسول كان يتيمن بتلك السنة وبولادته (علیه السلام) فيها، ويسميها سنة الخير والبركة، وقال لأهله ليلة ولادته وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإلهيّة، ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئاً: " لقد ولد لنا هذه الليلة مولود يفتح الله علينا به أبواباً كثيرةً من النعمة والرحمة " (2).
تُعدُّ التنشئة الاجتماعيّة للإمام (علیه السلام) وحياته الشريفة هما الفارق بين ولادته (علیه السلام) على الفطرة وولادة غيرهِ من الناس على الفطرة أيضاً، فهو هنا شابه النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) في تنشئته الاجتماعيّة، فيكون توجيه المسالة أنَّ قوله (علیه السلام) ولدتُ على الفطرة التي.
ص: 68
1- الكافي 2/ 13.
2- أخرجه البخاريّ، كتاب الجائر، باب ما قيل في أولاد المشركين (1385)، دار الجيل، بيروت، (د.ت).
لم تتغير، ولم تحلْ بتربية الوالدين وعقيدتهما كما في غيره ممن ولد على الفطرة التي هيأها الله بالعقل الذي خلقه فيه، وبصحبة الحواس والمشاعر؛ لأنَّهُ (علیه السلام) يعلم التوحيد والعدل، ولم يجعل فيه مانعاً يمنعه من ذلك، وهذا ما توصلت إليه الدراسات الحديثة من أنَّ الأطفال الذين يعيشون في مجتمع لغويّ معين، مثلاً المجتمع الناطق بالانجليزيّة في كندا، يستطيعون أن يميزوا الأصوات التي تنطق بالهنديّة (Hindi) في الشهر السادس من العمر، ولكن هذه القدرة تتلاشى بعد شهرين من العمر، وتوحي هذه النتائج أنّ الآليات الإدراكيّة اللغويّة فطرية، ولكن هذه الآليات الفطريّة تتحول وتتغير حين التعرض إلى لغة الكبار (1).
وقد أظهرت إحدى الدراسات أنَّ أطفال الكيكويو (2) في أفريقيا، في الشهر الثاني من العمر يميزون بين صوت / p / b /، ومثل هذا التمييِز غير موجود في لغتهم، كما هو الحال في اللغة العربية، ولكن أطفال الكيكويو يفقدون هذه القدرة بعد السنة الأولى، أو أبكر من ذلك (3) فتأثيرات البيئة الاجتماعيّة في الفرد الذي ترعرع فيها، لها الأثر العظيم في تنشئته الاجتماعيّة (processes of socializetion)، ونموه، ومن تأثير ذلك في عملية التنشئة الاجتماعيّة، التي تعني التَّطبيع الاجتماعيّ للإنسان وبناء مقومات شخصيته، وإذ يتحول فيها من كائن (بايولوجيّ) إلى كائن (اجتماعيّ) social being (4)، يتعلم ممّن سبقوه في الحياة.
ص: 69
1- ينظر: علم اللغة من منظور معرفي، د. موفق الحمداني / 38، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط 1، (1425 ه - 2004).
2- الكيكويو: عشائر كينية سيطرت على شؤون البلاد مدة طويلة من الزمن، وقد أحرقت العشائر الأخرى أطفال عشائر الكيكويو عقاباً لهم، وثاراً لما فعلوه بهم في أثناء مدة حكمهم. (ينظر: الأسباب الحقيقيَّة وراء العنف في كينيا، جاكلين كلوب / 3، ترجمة: أمل الشرقيّ، منشور على شبكة الانترنت: موقع / تخاطب.
3- The organization and reorganization of human speech perception Annual Review of Neuroscience,377.
4- ينظر: نفسه / 402.
وتستمر عملية الاكتساب هذه من جميع مراحل عمره، إلّا أنَّها تتخذ أنماطًا متباينةً في مراحل عمره، ولعل أخطرها هي مرحلة الطفولة، التي اختلف العلماء في تفسير طبيعة سلوك الفرد فيها، وانقسموا على فريقين: فريق عزا الأصل في السلوك الإنسانيّ عند الطفل إلى الفطرة، ويقف على رأس هذا الفريق أرسطو (384 - 322 ق.م) الذي رأى أنَّ الإنسان يولد وهو مزود بغرائز تسيره، ولا يمكن تغيير طبيعته، ولا يمكن تغيير المجتمع (1) للتشابه الذي وجده بين الناس في المدن اليونانيّة آنذاك في أنماط سلوكهم، وهي نظرة سطحية (2)، لأنَّنا نرى أنَّ اللغة تختلف عن أنماط السلوك الأُخرى ولاسيما أنماط السلوك اللغويّ (الإشارات والإيماءات والأصوات الانفعاليّة)، فتلك الأنماط مشتركة بين جميع البشر على اختلاف أجناسهم وأمُمَهِم فكلّهم يضحكون ويبكون ويعبرون عن الراحة بطريقة واحدة لا تختلف اختلافا كبيرًا من مجتمع إلى آخر، أمّا التّعبير اللغويّ الذي نحن بصدده، فإنَّهُ يختلف من أُمّة إلى أُخرى، وهذا الاختلاف يوضح لنا الأثر الاجتماعيّ في نشأة اللغة، ويدلُّ على أنَّ كلَّ مجتمعٍ ينشئ لغته الخاصة به، وعزاه الفريق الآخر إلى المجتمع، ويترأسه أفلاطون (427 - 347 ق. م)، إذ يرى أنَّ الناس تسلك السلوك الذي تعلموه من ثقافتهم، إذ يولد الأفراد ولديهم القدرة على تعلم طرائق السلوك، والسلوك في اللغة، يعني سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه (3) أما في الاصطلاح فيمثل:
1 - فيما يفعله الإنسان وما يقوله.
2 - فيما يدركه الإنسان،بحواسه، وما يدركه ويفكر فيه أو يتخيله أو يتذكره أو يتعلمه وغير ذلك من العمليات العقليّة.
3 - كلُّ ما يشعر به أو ينزع إليه، أو يريده، أو يرغب فيه، أو يعزف عنه، أو).
ص: 70
1- ينظر: الانثر بولوجيا التربوية، د. مجيد حميد عارف / 83.
2- ينظر: نفسه / 36.
3- ينظر: المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية في القاهرة) 1/ 44، مادة (سلك).
يخاف منه، أو يغضب له أو ينفعل به، وغيرها من الأحوال الوجدانيّة والانفعاليّة (1).
و ممّا تقدم نجد اللغة الركن الأساس في أنماط سلوك الفرد، فالاستجابة عموماً وسطها الناقل هو اللغة، ومظاهر التأثير الأُخرى بين المتحاورين كردِّ فعل للتعبير عن أفكارهم ترافقه اللغة والنشاط العقليّ أحد رموزه اللغة وغير ذلك من أنماط السلوك الأولى في التنشئة الاجتماعيّة، وقد أشار الإمام (علیه السلام) في عدد من كلماته إلى القابلية الفطريّة للغة، فحينما يصف خلق الإنسان بعد نفخ الروح يقول: " ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً " (2)، وفي هذا القول دليل على مسألة فطريّة اللّغة وأصالتها، وتعني أنَّ ملكةَ النطقِ واحدةٌ، ثم تشعب في افتراض العالم (جومسكي) لاختلاف اللّغات العالميّة اختلافًا سطحيًا، وهذا ناتج من انشقاقات وانعكاسات لعلم قواعديّ عام وعالميّ (3)، ويمكن أن يكون سبب هذا الاختلاف هو التأثير البيئيّ ما دام الإمام يقول بتأثير الصفات الجسميّة في النفسيّة عند الإنسان (4)، فاللغة إذًا " ليست من الأمور التي يضعها فرد معين أو أفراد معنيون، وإنَّما تخلقها طبيعة الاجتماع، وتنبعث عن الحياة الجمعيّة، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطر وتبادل للأفكار، وكلُّ فردٍ منّا ينشأ فيجد بين يديه نظامًا لغويًا يسير عليه مجتمعه، فيتلقاه عنه تلقياً بطريقة التعليم والمحاكاة كما يتلقى عنه سائر النظم الاجتماعيّة الأُخرى ...، وكلُّ خروج عن نظام اللغة ولو كان عن خطأ أو جهل، يلقي من المجتمع مقاومة تكفل ردّ الأمور إلى نصابها الصحيح، وتأخذ المخالف ببعض أنواع الجزاء ... وإذا حاول فرد أن يخرج كلّ الخروج على النظام اللغويّ، بأن يخترع لنفسه لغة يتفاهم بها، فإنَّ عمله هذا يصبح.
ص: 71
1- ينظر: علم النفس الصناعيّ، د. أحمد عزة راجح / 16.
2- نهج البلاغة، خطبة/ 83 / 113.
3- ينظر: علم النفس التجريبيّ، وليم باينز / 126.
4- ينظر: الاتجاه الفكريّ عند الإمام (ع)، د. رحيم محمد سالم / 295، ط1، مركز دراسات الشهيدين الصدرين، بغداد، 2007م.
ضرباً من ضروب العبث العقيم" (1). لقد فصل (الإمام (علیه السلام) اللغة بشكلها العام بأنَّ مغرسها القلب، ومستودعها الفكر، ومقومها العقل، ومبديها اللسان وجسم الحروف، وروحها المعنى، وحليتها الإعراب، ونظامها الصواب (2).
ويؤكد الإمام أنَّ غريزة الكلام مغروسة في القلب (مركز النفس الإنسانية) وهو لا يعني ذلك العضو الإنساني، أي أنَّ هناك استعداداً فطريّاً عند الطفل لتلقي اللغة الاجتماعيّة، لذا حدد الإمام (علیه السلام) قيمة الإنسان، بقوله (علیه السلام): " قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحسِنُهُ " (3)، أما قول الإمام (علیه السلام) (ومستودعه الفكر)؛ يعطي صفة الملاصقة بين اللغة والفكر، وهو ما أثبتته النظرية اللغويّة الحديثة التي ترى أنَّ اللغة ليست مجرد التعبير عن الفكر، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية التفكير و تكوينه، وأنَّ عملية الفكر مستحيلة من غير اللغة (4)
لعل ذلك ما يجعلنا نرى الطفل والحيوان لا يستطيعان النطق والتفكير، لما وصف الإمام (علیه السلام) عقل الطفل ب (حلوم الأطفال) بقوله: " يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ " (5)، عنى أنَّ مقوم الكلام هو العقل، وأنَّ للطفل قدرة قليلة أو غير متكاملة على التعقل والفهم، وهذا مصداق لعلاقة العقل باللغة والفكر.
ولما كان مقام الكلام عند الإمام (علیه السلام) هو التَّعقل، جاء عنه قوله (علیه السلام): " المرْءُ تَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ " (6)، وقوله (علیه السلام): " لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ.
ص: 72
1- اللغة والمجتمع، د. علي عبد الواحد وافي / 4 - 5.
2- ينظر: نهج البلاغة الثاني، الشيخ جعفر الحائري / 314 ط1، مؤسسة دار الهجرة،(ب.ت)، 1410 ه.
3- شرح نهج البلاغة 48/19.
4- ينظر في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغينة 1/ 408.
5- ينظر: نهج البلاغة، خطبة / 30/27.
6- نهج البلاغة، حكمة / 148/ 298.
لِسَانِهِ " (1)، ويشمل ذلك العلاقة الجدليّة التي قررها الإمام علي (علیه السلام) بقوله: " إذا تم العقل نقص الكلام " (2).
ويمكننا أن نقول: إنَّ إشارة الإمام (علیه السلام) السابقة والمختصة بمنهج الإنسان إلى
القابلية الفطريّة تعني تفنيداً لآراء (دارون) التطوريّة، فإذا كان الإنسان قد تطور عن الحيوان، فإنَّنا نلحظ أنَّ اللغة لم تتطور في تخاطب الحيوان منذ بدايتها حتى اليوم.
وهكذا يتآزر عند الإمام علي (علیه السلام) العاملان المهمان في وجود اللغة، وهما الاستعداد الفطريّ الطبيعيّ في الإنسان، والضرورة الاجتماعيّة التي تفرض ضرورة الاتصال اللغويّ.
تأثر الجاحظ في قول الإمام (علیه السلام) بفكرة الاستعداد الفطريّ اللغويّ عند الإنسان حين قال: " وإنَّما تهيأ وأمكن الحاكية بجميع مخارج الأُمم لما أعطى الله الإنسان من الاستطاعة والتمكن، وحين فضّله على جميع الحيوان بالمنطق والعقل والاستطاعة فبطول استعمال التكلف ذلت لذلك جوارحه ومتى ترك شمائله ولسانه على سجيتها، كان مقصوراً بعادة المنشأ على الشكل الذي لم يزل فيه " (3).
إنَّ هذا الاستعداد يمثل قدرة بشريّة عامة، إذ زود بها الإنسان في طبيعة خلقه، ولكي يجد هذا الاستعداد القلبيّ وسيلة لأداء وظيفته المنوطة به بدلًا من الممارسة والتدريب، أي استعمال التكلف على حدِّ تعبير الجاحظ.
وبطبيعة الحال فإنَّ هذا التكلف تزداد درجات صعوبته عند محاولة تعلم أنظمة لغويّة غير لغة المنشأ، وإنْ كانت هذه الصعوبة لا تعني التعذر، لما لهذا الاستعداد القلبيّ من المرونة وقدرة التكيف. 1.
ص: 73
1- نفسه، حكمة / 40/ 476.
2- نفسه، الحكمة/ 481/71.
3- البيان والتبين، أبو عثمان الجاحظ 40/1.
واليوم قد أصبح القول بالاستعداد الفطريّ اللغويّ مكوّنًا من مكوّنات نظرية اللغة الإنسانيّة، إذ نجد كثيرًا من اللغويين المحدثين والبيولوجيين، وعلى رأسهم (نعوم تشومسكي) و(لينبرج) يذهبون إلى القول بأنَّ العقل الإنسانيّ لا يولد صفحة بيضاء (Nativism) كما كان يزعم من قبل، بل إنَّهُ مزود بقدرات فطريّة داخليّة محكومة بيولوجيّاً، وهذه القدرات تمثل نسقاً للتعرف والتصنيف، وقياس الأنماط، ويطلق على هؤلاء ب (أصحاب النزعة الفطريّة) (1).
لقد وصف الإمام (علیه السلام) قلب الحدث بالأرض الخالية، لما لهذه الأرض من استعداد فطريّ، لتقبل ما تُلقى فيها، إذ قال وهو يوصي ابنه الحسن (علیه السلام): "أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْناً، بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي، دُونَ أَنْ أُفْضِيَ إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفْسِي أَوْ أَنْ أُنْقَصَ فِي رَأْيِي كَمَا نُقِصْتُ فِي جِسْمِي، أَوْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَ فِتَنِ الدُّنْيَا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ، وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ، فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ" (2)، المبادرة هنا تعني أنَّ الإمام (علیه السلام) أراد أنْ يغتنم الفرصة، والإسراع في العمل قبل أن يضيع الزمن ويضيع معه الهدف، فأقام الإمام (علیه السلام) سباقاً بين الخير والشر إلى قلب الطفل الخالي الذي لا يسع إلّا أحدهما، ما دامت الغلبة لمن سبق، إنْ دخل الخير أولًا استنصر، وإنْ سبق الشر سيطر على حركات الإنسان وفعاله وحينئذ يصعب ترويضه وتقويمه، وإعادته إلى الخير، ويصبح كالفرس النفور، الذي لا يقبل الترويض.
إنَّ الأسلوب المشرق للغة تجلى بأروع اشراقاته في اللغة الجماليَّة لهذا النصِّ فعبارة: (غلبات الهوى) هذا الإسناد المجازيّ القائم على (الحَيْد) في نسبة الغلبات إلى الهوى، يعطينا إضاءة تضع (غلبات الهوى)، أي الغرائز النفسية في دائرة مكشوفة، 1.
ص: 74
1- ينظر: انفتاح النسق اللسانيّ، محيي الدين محسب / 77، ط 1، دار الكتاب الجديد، 2008 م.
2- نهج البلاغة، رسالة / 394/31.
وتشير إليها تدليلاً على الانحرافات الكثيرة التي تتمكن من الإنسان، فتدفعه إلى (حيْد)، مثلما جاء الحيْد من الإسناد اللفظيّ.
أما التشبيه ب (صعب النفور)؛ فيكون ارتدادًا إلى البيئة، مقدمة المعنى من صورة تضج بالحركة (كالصعب النفور)، ثم تأتي الثنائيات المتعاندة لتتسع دائرة التشبيه، ف (الأرض الخالية) ثنائيّة ممكنة، تبسط جناحيها للتحليق في الأجواء التي يختارها الصغير بإشراف الأهل، ثنائيّة ممكنة؛ لأنَّها تولد الخير إنْ زرعناه و تعطى الشرّ - إنْ غرسناه، ثم نرى الإمام عليًا (علیه السلام) يركّز في التربية الإيمانيّة للطفل، منذ أوّل صرخة من ولادته، حينما يأخذه الأب، ويؤذن في يمناه، ويقيم في يسراه، وتحمل موجات الأثير إلى ذاكرة الطفل كلمات: الله اكبر وشهادتي التوحيد الخالص والنبوة الخاتمة، وتلبية الصلاة والفلاح، وخير الأعمال، فيضٌ من كلمات تركِّز في التربية الإيمانيّة للطفل، وتؤلف ترسيماً للحظة تربويّة وإيمانيّة وتعليميّة وأخلاقيّة، تتواصل وتتلاحم مع حقوقه الاجتماعيّة الجديدة، يقول الإمام (علیه السلام): " وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ" (1).
ولما كانت التنشئة الاجتماعيّة ترمي إلى إكساب الفرد أنماط السلوك السائدة في مجتمعه، يدرك معها ثقافة المجتمع، الذي ينتمي إليه، وقيمه ومعاييره، وتصبح قيماً ومعايير خاصة بالفرد، ويسلك مسالك تتفق مع هذه القيم والمعايير، وتحقق له مزيداً من التوافق النفسيّ، والتكيف الاجتماعيّ، فقد دفع ذلك بالإمام (علیه السلام) إلى أن يوضح لبعض الولاة ثقافة المجتمعات التي يوليهم عليها، ومن ذلك قوله لمالك الاشتر: " ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ ... " (2)، والنصّ يكشف عن تاريخ مصر - الحضاريّ وتعاقب الدول عليه فشعب مصر وأرضها يختلفان عن بقية الشعوب العربية وأراضيها..
ص: 75
1- نهج البلاغة، حكمة / 399 / 547.
2- نفسه، رسالة / 53/ 428.
لقد لحظ الإمام (علیه السلام) هذه الخصيصة، فجعل لها هذا العهد بما يشتمل عليه من نظم، وقوانين، وتعاليم (أخلاقيّة وسياسيّة وإداريّة) تنبههم على طبيعة المجتمع المصريّ وظروفه التاريخيّة وخلفيته الثّقافية والحضاريّة، وفي قوله (علیه السلام): " أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ وَ سَدَادَ طَرِيقٍ، فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ؛ أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَ تُخْطِئُ السِّهَامُ وَ يُحِيلُ الْكَلَامُ وَ بَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ وَ شَهِيدٌ. أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ" (1)، لقد بيّن الإمام بعبارات مُوجزة إحدى الطرائق لردِّ الغيبة، أملاً من ذلك في إشاعة أجواء الثقة بين أفراد المجتمع والابتعاد عن الآثار السيئة للغيبة وتحري العيوب.
ولا شكّ في أنَّ هناك فروقاً واضحةً في استعمال الحركة الجسميّة داخل المجتمع الواحد، إذ إنَّ الإنسان إنْ عرف أحداً بحسن السيرة والورع والتقوى، كان عليه أنْ يوقن بخطأ ما يقال فيه من أمور مخالفة، لأنَّ المواد المشكوك فيها غالباً ما تحمل على المواد المعلومة، بل هي تموت ولا تعني شيئًا أمام الماد المعلومة؛ لأنَّ الشك لا يبقى أمام الحقيقة والواقع، وعلى حدِّ التعبير المشهور: (الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب)، فلا تبنى التنشئة الصالحة على الظنّ والشكّ والحدس؛ لعدم مطابقتها الواقع غالباً، ويؤكد هذا المضمون قوله (علیه السلام) المتقدم: " أما وأنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ... والله سميع شهيد "، الذي يشير إلى ظاهرة اجتماعيّة خطيرة وهي آفة أغلب الناس الذين لا يلتزمون كلام الحق، ويتفوهون بكلّ ما يرد على ألسنتهم، وقد أشار الإمام (علیه السلام) إلى ذلك بقوله: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ" إلى قضية تصديق الخبر أو تكذيبه بلغة رمزيّة، تدلُّ على صورة المتحدث المؤثرة في وجدان المخاطب، هذه اللغة الرمزية التي أولاها علماء اللغة الاجتماعيون اهتماماً خاصاً في دراستهم لمجموعة الإشارات والحركات الجسميّة التي تصاحب الإشارة اللغويّة لتحقيق التواصل بين الناس. 8.
ص: 76
1- نفسه، خطبة / 41/ 198.
لقد تمخض اهتمام العلماء المحدثين بدراسة هذه الإشارات والحركات الجسميّة وتحليلها عن علم حديث يعرف اليوم ب (علم الحركة الجسميّة أو (الكينات kinesice)، ولهذا العلم مبادؤه العامة، شأنه شأن سائر العلوم (1).
ويُعدُّ العالم الانثربولوجيّ (راي بيردوسيل) من أشهر المحدثين الذين اهتموا بدراسة الحركات الجسميّة، التي يستعملها الإنسان في عملية التواصل أو التي تصاحب لغته المنطوقة بما يفيد في فهم العملية اللغويّة نفسها، ويفيد أيضًا في فهم ظواهر البناء الاجتماعيّ للجماعة المعنيّة، فالحركات الجسميّة تمثل جانبًا من لغة الإشارة التي تفصح عن مكنونات لا تتجلى بلغة اللسان المنطوقة، وهي ليست مجرد حركات عضويّة يستعملها الإنسان كيفما اتفق إنَّما هي نظام يتعلمه الإنسان في داخل مجتمعه، على وفق الجنس، أو المهنة، أو المستوى الثقافيّ، أو التقليد والاعراف الخاصة بكلِّ طبقة من طبقات المجتمع، أو المركز الاجتماعيّ للفرد (2).
ومن مظاهر علم الإشارات والحركات الجسميّة عند شعوب العالم، ما نراه من الفرد الانكليزيّ، أو الروسيّ، أو الفرنسيّ، أو الألمانيّ، وكذلك الفرد العربيّ، فكلّهم يهزون أكتافهم، بمعنى (لا أعرف)، أما حركة الرأس إلى الأعلى من الغربيّ فتعني (الرفض)، وهناك حركات للوداع وللتقدم وللسباب وغيرها.
وفي كثيرٍ من الأحيان قد لا تؤدي اللغة المنطوقة وظيفتها في التواصل، ممّا يضطر المتكلم إلى استعمال لغة الرموز والإشارات، وهذا ما حصل من الحاضرين تُجاه قول الإمام (علیه السلام)، فبادروه بالسؤال عمّا جهلوه من قول، فجمع الإمام أصابعه، ووضعها بين أذنه وعينه، ثم قال: (الباطل أنْ تقول: سمعتُ، والحق أنْ تقول: رأيتُ)، فهذه الإشارة اللغوية التي استعملها الإمام (علیه السلام) بين مقدار المسافة بين الصدق والكذب.
ص: 77
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ عند العرب، هادي نهر / 154، الجامعة المستنصرية، ط 1، 1988م.
2- ينظر: أصوات وإشارات - دراسة علم اللغة، أ. كوند رانوق / 13، نقله عن الانكليزية ادور يوحنا، بغداد 1970 م.
وهي مسافة قصيرة جدًا إذا تأملها المتأمل، على أنَّ مراد الإمام (علیه السلام) هنا هو المعنى الإشاريّ المتداول بشأن الشائعات.
ومن مضامين التنشئة الاجتماعيّة عند الإمام علي (علیه السلام) استعماله المواد الطبيعية في صحة الإنفاق والبذل والعطاء، إذ يقول:" فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، وَ لْيَفُكَّ بِهِ الْأَسِيرَ وَ الْعَانِيَ، وَ لْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَ الْغَارِمَ، وَ لْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَ النَّوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ، فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّنْيَا وَ دَرْكُ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) ذكر الإمام ستة موارد للإنفاق والبذل، وفي مقدمة من يستحق الإنفاق ذوو القربي، لأنَّ هؤلاء مقدمون على غيرهم لما ورد من الآيات والأخبار الصحيحة عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) في تقديمهم، ومنها ما قاله (صلی الله علیه و آله و سلم) في جوابه عن سؤال أحدهم: أي الصدقة أفضل؟ فقال (صلی الله علیه و آله و سلم): (على ذي الرّحم الكاشح) (2).
ثم ركّز الإمام (علیه السلام) في قضية الضيافة لما تؤدي من إشاعة أجواء المودة والمحبة بين الناس، وتزيل الأحقاد وتوطد العلاقات العاطفيّة والاجتماعيّة، إنَّ التعبير ب (فوزاً) وهو مصدر بصيغة النكرة يفيد حقيقة أنّ هذا البذل وإنْ كان قليلاً فإنّه يوجب عزّة الدنيا ورفعة الآخرة، لما لهذه الصيغة من الشموليّة والعموم والسعة.
ثم ينتقل الإمام (علیه السلام) من بيان الاستعمال الصحيح للثروة والمال، إلى بيان أهمية سعة الدار في تنشئة الفرد اجتماعيّاً على وفق المنظور الإلهيّ، لما بين الموضوعين من ترابط وثيق، إذ إنَّ (سعة الدار) بمنزلة الجزء من الكلِّ في قُبالة الثروة والمال؛ لأنَّهما سببان رئيسان في سعة الدار، فضلاً عن تلاقي عناصر التنشئة الاجتماعيّة (موارد البذل) في مضمون النصِّ، إذ دخل الإمام علي (علیه السلام) ذات مرة على العلاء بن زيد الحارثيّ، وهو من أصحابه في البصرة يعوده، فلما رأى سعة داره قال (علیه السلام): "مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا وَ أَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ؛ وَ بَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ 0.
ص: 78
1- نهج البلاغة، خطبة/ 142/ 199.
2- أصول الكافيّ، الكلينيّ 4/ 10.
تَقْرِي فِيهَا الضَّيْفَ وَ تَصِلُ فِيهَا الرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا، فَإِذاً أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ " (1)، نجد في النصِّ عبارات ذات مضامين اجتماعيّة مهمة، فقوله (علیه السلام): (وَبَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ) يأخذ مدى واسعاً في البلاغة والفصاحة، وكأنه (علیه السلام) قد استدرك، وقال: بلى على أنَّك قد تحتاج إليها في الدنيا لتجعلها وصلة إلى نيل الآخرة، وبأنْ تقري فيها الضيف، والضيف هنا لفظ يقع على الواحد والجمع، وقد تجمع على ضيوف وأضياف.
وهنا مفارقة لطيفة في التقديم والتأخير بين موارد البذل في النصّين السابقين، ففي النصِّ الأول قدم (ذي القربى) على (الضيف)، وفي النصّ الثاني قدم (الضيف) على (ذي القربى)، ويبدو للباحث أنَّ هذا التقديم والتأخير جاء بحسب أهمية الموضوع، فلما كان سياق الحديث عن الثروة والمال، قدم (ذا القربي) وأخر (الضيف)،بالبذل فضلاً عن أنَّ (الشخص) قد يكون رحماً وضيفاً في آنٍ واحد.
أما في النصِّ الآخر فقد جاء سياق الحديث عن (سعة الدار)، ويناسب هذه السعة سعة الضيافة سواء كان من (ذي القربى) أم من غيرهم، لذا قدم العام على الخاص، وهذا التناسب اللفظيّ قابله تناسب اجتماعيّ في المضمون، وقد يكون تقديم (الضيف) في النصِّ الثاني جاء مناسبة لمقتضى الحال، حينما صدر الكلام عن الإمام، إذ كان الإمام (علیه السلام) ضيفا في دار العلاء ابن يزيد الحارثيّ، الذي حوَّل الخطاب نتيجة للحدث اللغويّ بينه وبين الإمام (علیه السلام) إلى مضمون اجتماعيّ مضاد بحسب الظاهر، إذ نراه يرد قول الإمام (علیه السلام) المتقدم بقول جديد مضمّناً إياه (شكوى) على أخيه عاصم. فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد: " قَالَ وَمَا لَهُ؟ قَالَ: لَبِسَ الْعَبَاءَةَ وَتَخَلَّى عَن الدُّنْيَا. قَالَ: عَلَيَّ بِهِ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الخَبِيثُ، أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ أَتَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ..
ص: 79
1- نهج البلاغة، خطبة / 325/209.
قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأْكَلِكَ. قَالَ: وَيْحَكَ، إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ، كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ" (1).
تضمّن النصُّ المتقدم عدة عناصر من التداوليّة، كلّها ذات دلالات ومضامين اجتماعيّة، منها العطف والاستدراك في لفظة (وبلى) التي تمثل الرابطة التداوليّة بين مختلف الأقوال والأزمنة النحويّة، والتي تُمكّن من تحديد موقع حدث خط الزمن بالقياس إلى معلم محدد - غالباً - في قول سابق. ومنها قوله (علیه السلام): (عليَّ به) أي أحضره، والأصل: أعجل به عليَّ، فحذف فعل الأمر، ودلَّ الباقي عليه، بعد إجراء تغيير في ترتيب ما بقي من الجملة، فالحذف اختزال للأداء الكلاميّ، ممّا يعطي النصَّ تأويلات وتفسيرات نثريّة مضموناً، وهو مسلك تحليليّ جامع يتسق والنهج التداوليّ المتبع في المعالجة اللسانيّة الحديثة، فالحذف يساعد على " التحليل الفرديّ والتحليل النصيِّ، ويتجاوز المعاني الظاهرة في النصِّ إلى إيحاءاته الكاشفة " (2).
إنّ كثيرًا من حالات الحذف تعتمد في وقوعها وتحليلها على المقام أي واقع الحال، وكذلك تعتمد على سياق المقال، سواء كان الحذف قد وقع في سياقات الحوار أم تبادل الحديث المباشر بين المتكلم والسامع كمقامات النداء والاستفهام، واللقاءات الاجتماعيّة، والتهنئة والدعاء والتعليق بالقبول أو الرفض ... وسواها (3).
ومنها: النداء المطعم بالتصغير، في قوله (علیه السلام): (ياعُديَّ نفسه)، وعُدي تصغير (عدو)، وقد يراد به التحقير المحض ها هنا، ويُمكن أنْ يراد به الاستفهام لعداوته لها، ويمكن أنْ يخرج مخرج التحنن والشفقة. كقولك:" يا بُني ". 0.
ص: 80
1- نهج البلاغة، خطبة / 325/209.
2- التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، محمد مفتاح / 159، المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت، ط1، 1994 م.
3- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 109 - 110.
هذا السياق الاحتماليّ أعطى العبارة مدى من السعة والحرية في التحرك لثراء النصِّ بالمضامين الاجتماعيّة، التي تبيّن شدّة الموقف وقوة العلاقة بين المرسل والمتلقي. ممّا يعطي الحدث اللغويّ سمة البروز والظهور على مسرح الحياة.
ومنها: استعمال الإمام (علیه السلام) المحرّم اللغويّ في عبارة (واستهام بك الخبيث)، ويعني بالخبيث (الشيطان) لشدّة خبثه، بحيث صور لهذا العابد أنَّ سوءَ فعله حسنات له، وجاءت لفظة (استهام) هنا ذات البعد الاجتماعيّ بمعنى: جعلك هائمًا و (الباء) أصلية في اللفظ، ودلالتها: أنَّ الشيطان قد اتخذ منك عَلَمًا يتبع فجعل منك قائدًا له في هذا الهيْم.
إنَّ ما يميّز هذا النصَّ هو ما تضمنه من حدث لغويّ ذي سمات تداوليّة مهمة (الحذف، والنداء، والتصغير، والمُحرّم اللغويّ، والتعجب، واستعمال الضمير المخاطب، والأفعال الكلاميّة وغيرها) كلّها تؤكد فكرة (الاقتضاء) التي أثارها (غرايس) التي تعدَّ من المفاهيم الأساسية المهمة التي يقوم عليها التداول، إذ تمتاز هذه الفكرة بقدرتها على تقديم تفسير تداوليّ لقدرة النصِّ على البوح بسلسلة دلاليّة متواصلة عبر إجراءات مختزلة؛ لشيوعها بين أفراد المجتمع الواحد، وامتلاكهم خلفيّة ثقافية معرفيّة بشأنها، ولا تختلف العيّنة الأدائيّة المختزلة التي حللها وفسر بنيتها الدلالية بحسب مقتضيات التداوليّة الاجتماعيّة (1).
وما يُظهر الدهشة والغرابة دلالة الأسلوب التقابليّ التعجبيّ في الحدث اللغويّ إذ يستفهم الإمام (علیه السلام) متعجبًا: (أنت أهون على الله من ذلك؟!) أي إنَّ الأشرار جميعهم أهون على الله تعالى من يحل لهم أمرًا مجاملةً واستصلاحًا للحال معهم وهو يكره منهم فعله. يقابل هذا التعجب تعجب مضاد في قول عاصم (هذا أنت في خشونة م.
ص: 81
1- ينظر: الاقتضاء في التداول اللسانيّ، عادل فخوريّ / 141، مجلة الفكر، الكويت، م / 20، ع / 3، 1989 م.
ملبسك، وجشوبة مأكلك!) هذا التقابل التعجبيّ في النصِّ يُظهر مفارقة مهمة في ذهن المجتمع - فعاصم أحد أفراده - والتقدير: (ها أنت كذلك، فكيف تنهى عنه؟!).
لذا يمكننا القول: إنَّ هذه المفارقة هيأت للإمام فرصة بيان التكليف بين مقام المتحدث ومقام المتلقي، و بين مقام الراعيّ وبين مقام الرعية في مكان وزمان وموقف واحد قوله: ويحك! لتعطي قوة في الدلالة، وتوقع أثرًا في النفس، فيثير في المتلقي كوامن خلجاته، وتهيء سمعه وجوارحه لتلقي الردّ القابل (وَيْحَكَ، إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ، كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ) استعمل الإمام الضمائر: (ياء المتكلم، تاء الفاعل، أنت) في عبارة: (إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ) دلالة على الاختزال والتقليل في الكلام كلاختزال والتقليل في إظهار النعم كيلا يتهيج الفقراء والمحتاجون، مبيّنًا تكليف الإمام العادل في أن يشبه نفسه، في لباسه وطعامه بضعفة الناس، معللّا ذلك كيلا يهلك الفقراء من الناس، فإنّ هم إنْ راوا إمامهم بتلك الهيأة، وبذلك المطعم، كان أدعى لهم إلى ترك لذات الدنيا، والصبر عن شهوات النفوس.
ص: 82
المبحث الثاني / الأنماطُ السَّلوكيّةُ عندَ الإمامِ (علیه السلام) في نهجِ البلاغةِ
يمثل المجتمع نظامًا مركبًا، من مجموعة من الأنظمة الاجتماعيّة الصغرى المرتبط بعضها ببعض اجتماعيًّا، ولكلِّ نظام من هذه الأنظمة الصغيرة مجموعة من العناصر (الأشخاص) تربطهم علاقات اجتماعيّة معيّنة، هذه العلاقات تتأثر بعمليات التفاعل الاجتماعيّ، التي تجري بينهم في المواقف الاجتماعيّة المتعددة، والسلوكيات التي يسلكها الفرد في الوسط الاجتماعيّ الذي يعيش فيه، أو ينتمي إليه، تسمى (أنماطًا سلوكيّة)، وتعدُّ اللغة أبرز عناصر السلوك الاجتماعيّ عند الفرد (1).
وللنمط السلوكي عدة تعريفات، يمكن إجمالها بالآتي: " تصور سلوكيّ يرتبط بشخص معين، وبصفة من صفاته الشخصية (اللغة)؛ لأنَّهُ يعبر عن حاجات الشخص تُجاه الجماعة " (2)، إنَّ مجموعة هذه الأنماط السلوكيّة تشكل المركز الاجتماعيّ ويعني مجموعة العلاقات الرابطة بين الأنماط السلوكيّة للفرد التي يؤديها في مراحل حياته المختلفة، لقد تجسدت في شخصيّة الإمام علي (علیه السلام) أنماطٌ سلوكيّة متعددة اختلفت وتنوعت بحسب المجتمعات التي عاش فيها، ومن ثم ظهر هذا الاختلاف والتنوع في الوظائف اللغويّة التي استعملها الإمام في المواقف الكلاميّة المختلفة.
سماتُ الأنماطِ السلوكيَّةِ في نهج البلاغةِ:
1 - الاتسام بالجبر والاختيار: تختلف الأنماط السلوكيّة عمومًا واللغويّة خصوصًا بحسب مواقف الجبر والاختيار فبعض المواقف الكلاميّة
ص: 83
1- ينظر: علم النفس الاجتماعيّ، د. شاكر محاميد / 215، ط 1، مطبعة المدى، الأردن، عمان، (1422 - 2003 م).
2- نفسه / 216.
مفروضة على الإمام (علیه السلام) وبعضها يقع ضمن دائرة الاختيار، ولذا نجد في لغة الإمام هذين النمطين، ففي قوله (علیه السلام): "إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ، مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُهُ، وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ أَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ، ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله) لِقَاءَهُ وَ رَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ وَ أَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبَلْوَى فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً (صلی الله علیه و آله و سلم)، وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَ لَا عَلَمٍ قَائِمٍ، كِتَابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ وَ خَاصَّهُ وَ عَامَّهُ وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ مُفَسِّراً [جُمَلَهُ] مُجْمَلَهُ وَ مُبَيِّناً غَوَامِضَهُ " (1).
نجد أنَّ أسباب الجبر واضحة في معانيها، لا يمكن للإمام أنْ يُغيّر مضامينها، فقوله (علیه السلام): (لَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ) سُنَّة من السُّنن الإلهيّة التي فرضها الله سبحانه على الأنبياء، حينما يفارقون أُممهم، لذا جاء نمط السلوك الكلاميّ خالياً من الاختيار؛ لأنَّ الله فرض طاعته على جميع خلقه ومنهم الإمام (علیه السلام) وألزم الأُمّة إتباع كتابه وما يتضمنه من فرائض وأحكام، فصَّلها النصُّ المتقدم، ونهج البلاغة مملوء بهذا النمط. (2)
أما نمط السلوك الاختياريّ فهو ما نجده في كلام له فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان ، إذ قال: "وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ ا.
ص: 84
1- نهج البلاغة، خطبة 45/1.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 1/ 199، 2/ 290،3/ 144 ... وغيرها.
فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ " (1) وذكر ابن أبي الحديد أنّ عثمان قد اقطع كثيرًا من بني أميّة وغيرهم من أصحابه قطائع (2) من أرض الخراج وقد كان عمر أقطع قطائع ولكن لأولي العناء في الحرب والآثار المشهورة في الجهاد ثمناً عمّا بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه، وعثمان أقطع القطائع صلة لرحمه، وميلًا إلى أصحابه، عن غير عناء في الحرب والأثر (3)، إِنَّ كلَّ مجتمع يتعرض في كلِّ يوم إلى تغييرات قد تكون خاطفة أو بطيئة أو غير ملحوظة، هذه التغييرات هي على درجة من التوافق مع تاريخه، وتتبع هدفًا على قدر من الوضوح، فالمجتمع ليس (فعلًا) اجتماعيّاً لعدد من الأشخاص، ولا يتلخص بهذا الشكل أو ذاك من أشكال التنظيم الاجتماعيّ، إنَّما هو حركة تغيير لجماعة كلية عبر الزمن (4). ويؤكد لنا النصُّ المتقدم مفهوم: (كارل ماركس) للتاريخ، وهو أنَّ تاريخ أي مجتمع إنَّما هو تاريخ لصراع الطبقات فيه ... هذه الطبقات تتولد من التوزيع غير المتساوي للثروات (5)
لقد سلك الإمام علي (علیه السلام) في هذا نمطاً سلوكيًا جديداً، اختار فيه وظيفة الوالي العادل مع مدار الموقف، وما سيؤل إليه من أمور، وتفسير الكلام: هو أنّ الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره، فهي في الجور أضيق عليه، لأنَّ الجائر مَظَنَّةٌ أن يُمنع ويُصدُّ عن جورِهِ.
ويتسم هذا النمط السلوكيّ عند الإمام بالقوة وتطبيق الشريعة الإسلاميّة السمحة، والعودة إلى العمل بالأحكام القرآنيّة المعطلة بعد إهمالها، وهو نمط سلوكيّ 6.
ص: 85
1- نهج البلاغة، خطبة 58/15.
2- القطائع: ما يقطعه الامام بعض الرعيَّة من ارض بيت المال ذات الخراج، ويسقط عنه خراجه، ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج. ينظر شرح ابن أبي الحديد، ج/ 1، ص / 178.
3- ينظر: نفسه 1/ 179.
4- ينظر مدخل إلى علم اجتماع الأدب، د. سعدي ضاويّ / 65 - 66، دار الفكر العربيّ، بيروت، ط 1، 1994 م.
5- ينظر: نفسه، ص / 66.
اختياريّ، تمثل في أولى مراحل خلافته المباركة، لذا نجد سلوكه اللغويّ قد تأثر بسلوكه الاجتماعيّ، فابتدأ بأسلوب القسم (والله) واستعمال (قد) التي تفيد التحقيق و (لام التوكيد) و (إنَّ) المؤكدة المسبوقة ب (فاء) السببية، ومجيء الفعل الماضي مبنياً للمجهول (تُزُوِّجَ، ومُلِكَ) فضلاً عن الثنائيّة اللفظيّة في التقابل بين (العدل، والسعة) و (الجور، والضيق) المسبوقة ب (من) الشرطية، دلالة على أنَّ المُضيّ في أمر الخلافة العادلة يشترط سعة في العدل، وضيقاً على الجائرين.
هناك بعض الأنماط السلوكيّة قد اتسمت بالجبر والاختيار في وقتٍ واحدٍ، تمثل ذلك في أثر (الزهد)، فهو عند الإمام واجب على وفق التكليف الإلهيّ، وعند الآخرين مباح كما رأينا فيما سبق من حديث بينه وبين عاصم بن زياد، إذ قال (علیه السلام): "وَيْحَكَ، إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ، كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ " (1).
ومن مواطن الزهد الاجتماعيّ المهمة قوله (علیه السلام) في الحث على التزود للآخرة: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا [قَدْ] أَدْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ. أَلَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّارُ" (2).
إنَّ أسلوب التفصيل الذي اعتاد الإمام (علیه السلام) البدء به في خطبهِ من الأساليب الاجتماعيّة في اللغة، التي تدلُّ على التواصل الكلاميّ بين المتكلم والمتلقي، وهو يدلُّ على أنَّ هناك كلاماً قد انتهى به الخطيب فيما سبق، وأراد بهذا الأسلوب التواصل بينه وبين ما يقوله في الحال، فابتدأ كلامه ب (أمّا) التفصيليّة.
إنَّ الأسلوب الوعظيّ عند الإمام لم يكن داعياً فيه إلى مذهبٍ زهديّ، يقف موقفًا سلبيًّا من الحياة الدنيا والعمل لها والاستمتاع بها، وإنَّما كان بمواعظه الزهدية وتوجيهاته.
ص: 86
1- نهج البلاغة، خطبة / 209 / 325.
2- نفسه، خطبة / 72/28.
الفكريّة بنحوِ عامٍ، يدعو إلى مواجهة الحياة الواقعيّة بصدق، محذرّا من اللهاث المجنون وراء الآمال الخادعة والأخلاق الكاذبة، التي ليس لها في واقع الحياة سند ولا أساس.
قال الشريف الرضي (رحمه الله): " إِنَّهُ لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا، ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعًا لعلائق الآمال، وقادحًا زناد الاتعاظ والازدجار، فمن أعجبهُ قوله (علیه السلام): (أَلَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّارُ)، فإنَّ فيه مع فخامة اللفظ، وعظم قدر المعنى وصادق التمثيل، وواقع التشبيه، سرًا عجيبًا، ومعنىً لطيفًا، وهو قوله (علیه السلام): (والسبقة الجنة والغاية النار) فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين، ولم يقل: (السبقة النار)، كما قال: (والسبقة الجنة)؛ لأنَّ الاستباق إنَّما يكون إلى أمر محبوبٍ وغرضٍ مطلوب، وهذه صفة الجنة، وليس هذا المعنى موجوداً في النار، نعوذ بالله منها! ولم يجز أن يقول: (والسبقة النار) بل قال: (والغاية النار)؛ لأنَّ الغاية قد ينتهي إليها من لا يسَّرهُ الانتهاء إليها، ومَنْ يسره ذلك، فصَلُحَ أن يعبر عن الأمرين معاً، فهي في هذا الموضوع كالمصير والمال، قال تعالى: ﴿ققُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) إبراهيم / 30. ولا يجوز أن يقال: فإنّ سبقتكم إلى النار، فتأمل ذلك، فباطنه عجيبٌ، وغورهُ بعيدٌ لطيفٌ (1).
والمضمار هنا هو الزمان الذي تضمر فيه الخيل للسباق، وفيه دلالة المشاركة بين اثنين أو أكثر، فهو من الألفاظ الاجتماعيّة التي تدلَّ على الشموليّة والمدى الواسع البعيد لجميع البشر من الأوّلين والآخرين، والخوض فيه إلى قيام يوم الدين، فالثنائيات (والسبقة الجنة) و (الغاية النار) تعطي تقابلاً دلالياً اجتماعيّاً يشترك فيه جميع الناس، فلا يخلو فرد من أفراد المجتمع إلّا وكان على طرفٍ من طرفي هذا التقابل، قال تعالى: (سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) الحديد: 21.
ص: 87
1- شرح نهج البلاغة 2 / 291.
ونجد مثل هذا في قوله (علیه السلام) متعجبًا: " ألا وإنّي لم أرَ كالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها "(1)
2 - الاتسام بالشُّموليّة: - وهو أن تتسم الأنماط السلوكيّة عند الإمام بالشموليّة من حيث إنَّهُ فردٌ من أفراد الجماعة من جهة، ومن حيث أنَّهُ قائد في الجماعة من جهة أُخرى، بغض النظر عن أن تكون الجماعة نفسها أم جماعة أُخرى.
إنَّ نصوص نهج البلاغة حافلة بكثير من الإشارات الدالة على الشمولية في الخطاب، إذ لا يمكننا تفسير تلك الإشارات ما لم يتم الاستعانة بالتفصيلات الخارجيّة (أنماط السلوك الاجتماعيّ)، فكما أنَّ هناك بنية داخليَّة للنصِّ متناسقة ومنسجمة، هناك بنية خارجيَّة للنص أيضًا، يفترض أن تكون متناسقة ومنسجمة أيضًا، وهذا ينطبق على التوجه المنهجيّ للبنيويَّة التكوينيَّة، التي تعني إجمالاً أنَّها تتعامل مع النصَّ بوصفه حدثًا اجتماعيًّا (2).
ومن النصوص الأدبيّة التي عبر بها الإمام عن البنية الكليّة للجماعة تُجاه الأحداث والمواقف ما نجده في خطبته (علیه السلام) المشتملة على النداء الإلهيّ من حيث الفرائض والحكام والتكاليف الشرعيّة وإنْ كان خليفة المسلمين، وكذلك مشتملة على الشعور الاجتماعيّ للفرد، إذ يقول الإمام (علیه السلام) في بعض مقاماته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح والإرشاد في أحداث مقتل الخليفة الثالث موازنًا بين تلك المقامات والمواقف ومقامات المهاجرين ومواقفهم، الذين لم ينكروا، ولم يواجهوا عثمان بما كان يواجهه به وينهاه عنه: " فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَ تَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا وَ نَطَقْتُ حِينَ تَعْتَعُوا وَ مَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا، وَ كُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً وَ أَعْلَاهُمْ فَوْتاً، فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا " (3) تميز السلوك الإماميّ هنا.
ص: 88
1- نفسه 2/ 290.
2- ينظر: البنيويَّة التكوينيَّة والنقد الادبيّ / 456 (مجلة آفاق)، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، ط 1، 1984 م.
3- نهج البلاغة، خطبة/ 81/37.
بنمط فريد، بوصفه إنسان الجماعة المميز برهافة الحسِّ واتساع الخيال وبعد الرؤية، فكانت وظيفته (علیه السلام) وظيفة الفاعل لا وظيفة المتفرج، وبهذا المضمون جاء(سارتر)، إذ قال: " مادام الكاتب لا يملك أي وسيلة للهرب من عصره، فإنَّنا نريده أنْ يعانق عصره بنحو وثيقٍ، فهو فرصته الوحيدة، إِنَّهُ صُنِعَ من أجلهِ كما صُنِعَ هو مِنْ أجل عصرِهِ" (1).
لذا تكون الفئة الاجتماعيّة ومفاهيمها الثَّقافيَّة، هي التي تفرض نفسها على الكاتب وليس العكس، والكاتب العظيم هو الذي يملك رؤية كونيَّة تعبر عن أقصى وعي لتوجهات الفئة أو الطبقة الاجتماعيَّة، فجاءت على وفق ذلك مضامين النصِّ المتقدم؛ لتبيّن وعي الإمام للبنية الذهنيَّة التي تحملها جماعة المهاجرين موازناً بين موقفه - وهو فردٌ من الجماعة - وموقف الجماعة نفسها تُجاه الخليفة ، وقد تضمن النصُّ مضامين التأثر بسلوكيات المجتمع وظواهره وعاداته، فقوله (علیه السلام) في نهاية النصِّ: (فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا، وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا) يدلُّ دلالةً واضحةً على انتشار ظاهرة (سباق الخيل) في المجتمع الإسلاميّ، ولعل سبب ذلك اتساع فكرة نشر الدين على البلدان والأمّم، وتلك الفتوحات التي توجب الاستعداد الجيد للحرب والمنازلة، على أنَّ الإمام (علیه السلام) ممّن جاء بهذه الاستعارة اللطيفة، التي تدلُّ على سبق الإمام (علیه السلام) بالنصيحة للخليفة عثمان .
أما قوله (علیه السلام): (وَنَطَقْتُ حِينَ تَعْتَعُوا، وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا، وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا) (2). إشارة ذاتيّة إلى التواضع ونفي التكبر عن نفسه.
وإذا تأملنا النصَّ اللغويّ وجدنا أنَّ الإمام (علیه السلام) المستعملا (العطف) في فقرات النصِّ كلِّها، فأصبح النصُّ مترابطًا ومتسلسلًا، استعمل الضمير الجماعيّ (واو الجماعة)،.
ص: 89
1- ماهو الأدب؟، جان بول سارتير / 16، ترجمة: جورج طرابيشي - المكتب التجاريّ، بيروت.
2- يقال: تعتع فلان، إذا تردد في كلامه من عيِّ أو حصر، ويقال: تقبع الرجل، أي اختبأ، وضده تطلع.
في نهاية الفقرات الأربع الأولى، وهذا الاستعمال يضفي على النصِّ دلالةً اجتماعيَّةً، على وفقِ أسلوب (الحكاية عن الغائبين) وكأن الإمام (علیه السلام) يتكلم بالذات الجماعيَّة (النحن)، إذ إنَّ تجربة الفرد ليست إلّا وجهًا جزئياًّ في الإبداع، إذ إنَّ المبدع الحقيقيّ هو (النحن)، وهو الذات الجماعيَّة التي كان يتكلم بها الإمام (علیه السلام) بقدرته على استيعابها فضلًا عن الذات الشخصية، وهو بيان لحاله (علیه السلام) مقابل حال قومه، إذ إنَّه أظهر ما لديه في نهاية الأمر الذي عجز فيه قومه عن إظهار ما لديهم. وهذا ما يؤكده (غولدمان) حينما يتحدث عن طبقة اجتماعيَّة وعن الرؤية التي يلقيها على العالم من أنَّ هذه تتحقق بوساطةٍ، فرد معين بنحوٍ خاصٍ، فهو يرى أنَّ الفرد يتصرف على وجه العموم انطلاقًا من البنيات الذهنيَّة التي تسود الجماعة (1)، ثم انتقل النصُّ من دلالة الموقف إلى دلالةٍ الوصف، فتغير أسلوبه في الفقراتِ الأربع الأخيرة، فاستعمل الضمير الجمعيّ للغائبين (هم) بدلًا من (واو الجماعة) مع استمرار الخطاب لضمير المتكلم (تاء المتكلم) على طول النصِّ؛ لأنَّ الموقف و الوصف واقعان عليه (علیه السلام)، فتميَّز هذا النمط من السلوك عند الإمام (علیه السلام) بالأمانة والنصح والاستشارة والصدق.
وفي الخطبة نفسها يبيّن الإمام (علیه السلام) نمطًا آخر من السلوك، فهو يشبه نفسه (علیه السلام) - وهو خليفة للمسمين - بالجبل؛ لشموخه وعلو شأنه قائلًا: " كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ وَ لَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ مَهْمَزٌ وَ لَا لِقَائِلٍ فِيَّ مَغْمَزٌ. الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ" (2).
نرى هنا تبدل نمط السلوك عند الإمام من النصح والاستشارة إلى البروز وقوة الموقف، مع اشتراك النمطين السلوكيين بالأمانة والصدق والعدل، لأنَّها صفات ثابتة بالنمطين، وإنَّما اختلف النّمطان بحسب متطلبات كلِّ مرحلة من هاتين المرحلتين وسلوكيات المجتمع حينها، إذ يتجلى من نمط السلوك هذا أدب الإيثار، فكأنه (علیه السلام).
ص: 90
1- ينظر: البنيوية التكوينية والنقد الأدبيّ / 45، مجلة آفاق، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط 1، 1984 م.
2- نهج البلاغة، خطبة / 37/ 87 - 88.
ينتظر إنجازًا من قومه، كان يتمنى أنَّهُ يرقى إلى ما يستطيع هو إنجازه، فلما لم يجد ذلك عبر بعد نصحه وإرشاده عن قومه وحاله التي تعدُّ فردية في عصره بين قومه ...
أظهر هذا النمط من السلوك من ألفاظ النصّ وتراكيبه ما له دلالة موحيّة قوية، كقوله (علیه السلام): (كَالجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ، وَلَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ) فالقواصف والعواصف يعنيان الرياح الشديدة (1)، وإنَّما جاء تكرار المعنى للتأكيد الدال على الشدَّةِ والقوة والصلابةِ، ومثله في العبارة الأُخرى: (لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ مَهْمَزٌ، وَلَا لِقَائِلِ فِيَّ مَغْمَزٌ)، فالمهمز والمغمز، يعنيان العيب (2) والتكرار يضفي على النصِّ تماسكًا عجيبًا، يلائم نمط السلوك الحاليّ عند الإمام، فقد جمع هذا النصُّ ما يريد بيانه من أنه صلب عند الآخرين مهابٌ ويُخشى منه، فهذا يجمع الناحية المادية، ومن أنَّهُ يمثل صورة النزاهة والخلق وحُسن السيرة الراقية التي لا مثيل لها، وهذا يجمع الناحية المعنوية.
ثم يتحول الحديث في خاتمة النصِّ إلى أعلى درجات العدالة الاجتماعيَّة حينما يصرح الإمام (علیه السلام): (الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَ الْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ) تقابل في الموقف والصورة، تتجسد فيه العدالة الاجتماعيَّة في أروع صورها، ولاسيما أنَّها صادرة عن الإمام العادل والخليفة الصالح.
ومثلما رأينا التَّدريج اللغويّ في الشدَّةِ والقوةِ بما يلائم التَّدرُّج السِّلوكيّ في موقف الإمام (علیه السلام)، كذلك نجد التَّدرُّج في الاستعمال الضميريّ من (الأنا) المتكلمة إلى (الأنا) الغائبة إلى (ياء النسب)، وفي نهاية الخطبة نفسها يمزج الإمام (علیه السلام) نمطه السِّلوكيّ بمكانته الشرعيَّة والاجتماعيَّة من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حينما يصرح: " فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لغيري " (3) ويدلُّ النصُّ على أنَّهُ كان معهوداً إليه ألّا ينازع في الأمر أو يثير فتنة، بل يطلبه بالرفق، فإنْ حصل له وإلّا امسك. 1.
ص: 91
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 2 / 250.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 2/ 248.
3- نهج البلاغة، خطبة/ 88/31.
إنَّ مكانته من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) التي يبيّنها الإمام في النصِّ المتقدم حددت نمط السلوك الذي يجب أن يسلكه فيما بعد وفاة النبي (صلی الله علیه و آله و سلم)، وتمثل ب (حق الطاعة)، فيقول (علیه السلام): فإذا طاعتي لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أي وجوب طاعتي، فلا سبيل إليه إلى الامتناع من البيعة، لأنَّهُ مأمور بالطاعة.
أما قوله: (فإذا الميثاق في عنقي لغيري)، أي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أخذ علي الميثاق بترك الشقاق والمنازعة، فلم يُحِلَّ لي أنْ أتعدى أمرهُ أو أُخالف نهيهُ، وهذا ينم عن خُلقٍ سامٍ جدًا مؤداهُ حفظ كيان الأمة ما أمكن، فهو سلوك إيثارٍ وتهدئه لا سلوك جبنٍ وضعفٍ.
وممّا تقدم يتبيّن لنا عبقريَّة الإمام (علیه السلام) حينما استطاع دون غيره من أفراد مجتمعه أن يعبروا عن رؤيته الشموليَّة لجماعة المهاجرين بفضل تكوينه النفسيّ وسيرته الذاتيَّة، فالأديب العبقريّ هو " ذلك الذي حساسيته هي الأكثر اتساعاً والأكثر ثراءً، والأكثر إنسانيّةً " (1).
وبالنتيجة إنْ كان الذات الجمعيّ هو العامل الحاسم في تحريك التاريخ والمواقف، فإنَّ الفرد المُبدع يستطيع بالوقوف على بنية الذات الجمعيّ، أن يتأمل المواقف والأحداث، وأن يختار ما يريد من المقولات الاجتماعيَّة التي تشع من أفق ذلك المُبدع من حيث أن المُبدع العبقريّ يُعدُّ في طليعة الأفراد الذين يحاولون تكوين ذات جماعيَّة تتجاوز الذات الفرديَّة.
3 - الاتسام بمدى تحديد السلوك: ونقصد به سعة المجال، الذي يتحرك به الإمام (علیه السلام) لتأدية وظيفته الاجتماعيَّة في التغيير، وهذهِ الوظيفة مجموعة الواجبات التي يفرضها الموقع على الفرد وكذلك مجموعة الوظائف التي يجب القيام بها (2).
ففي النصِّ المتقدم نجد وظيفة الإمام متسمةً بالتقيّد، لتحديد سلوكه على وفق العهد والميثاق الذي قطعه عليه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)..
ص: 92
1- البنيويَّة التكوينيَّة والنقد الأدبي / 29، مجلة آفاق، مؤسسة الأبحاث العربيَّة، بيروت، ط1، 1984 م.
2- ينظر: مدخل إلى علم اجتماع الأدب / 178.
وهناك بعض الأنماط السِّلوكيّة اتسمت بالسعة والمرونة، ففي قوله (علیه السلام) لما أرادوا بيعتهِ بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان : "دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ، وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً" (1).
اتخذ الإمام هنا نمطًا من السلوك، جعل فيه الخيرة للأمة فيمن توليه أمرها، فلم يحدد سلوكها فيمن تختار، مع أنَّهم جاؤوا المبايعته، ثم أَنَّهُ (علیه السلام) جعل بيعته مشروطة بنمط من السلوك لا يتعداه ولا يحوّل عنه أبدًا، مهما كان قول القائل وعتب العاتب. إنَّ في كلماتِ النصِّ المتقدم من الرمزيّة ما يجعلنا نقف عند باطنها ونغور فيها غورًا عميقا، فهي من أخبار الغيب، ما يعلمه هو، ويجهلونه هم: (المتعاقدون على البيعة).
فالإمام (علیه السلام) ينذر القوم بحرب بعضهم بعضًا؛ لاختلاف كلمتهم وظهور الفتنه، لذلك ابتدأ قوله ب (دعوني والتمسوا غيري)؛ لأنَّ نمط سلوكه (علیه السلام) لو تسلم الخلافة لسلك سلوكًا محددًا، تكون نتيجتهُ اختلاف الكلمة في ظهور الفتنة؛ لأنّ الذين عقدوا عليه البيعة أرادوا أن يسير فيهم سيرة أبي بكر وعمر، فاستعفاهم الإمام (علیه السلام) وسألهم أن يطلبوا غيره، ممّن يسير سيرتهما فقال لهم هذا الكلام الرمزيّ: (فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ).
فعناصر النصِّ غير اللغويَّة من (حال المبايعين) وظروف المقام، أخذت بالنصِّ إلى تلك اللغة الرمزيَّة، مع أنَّ الإمام قد صوّر لهم ما سوف يقع لو أجابوه على البيعة بقوله: (وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمُحَجَّةَ قَدْ تَنكَّرَتْ)، أي أنَّ الشبهة قد استوت على العقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي؟ لذلك استعمل الإمام أسلوب التوكيد ب (إنَّ) لتوكيد وقوع الفتنة، واستعمل الفعلين الماضيين: (أغامت 7
ص: 93
1- نهج البلاغة، خطبة / 92/ 137
وتنكرت) دلالةً على وقوع الأمر في المستقبل كوقوعه في الماضي زيادة في التوكيد، وكأنه (علیه السلام) يقول للمبايعين: " فأنا لكم وزيرًا عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، أفتي لكم بشريعته وأحكامه خير لكم مني أميراً محجوراً عليه مدبراً بتدبيركم، فإني أعلم أنَّهُ لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) في أصحابه، مستقلاً بالتدبير، لفساد أحوالكم، وتعذر صلاحها " (1). ومعلومٌ أنَّ الأمة قد تغيرت بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بدليل النصّ القرآنيّ: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ آل عمران: 144. فحال سياستها أيامه هي غير حال سياستها بعده.
وقد حمل بعضهم كلام الإمام (علیه السلام) على السخط من أفعال المبايعين الذين عدلوا عنه من قبل، واختاروا غيره، فلما طلبوهُ فيما بعد، أجابهم جواب الساخط العاتب.
وحمل قوم منهم كلامه على وجه آخر فقالوا: إنَّهُ أخرجه مُخرج التهكم والسخريَّة، أي: أنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا فيما تعتقدونه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) الدخان/ 49: أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده (2).
ويرى الباحث أنَّ جميع تلك الآراء المحتملة تلائم مجتمع الإمام (علیه السلام) وحال المبايعين وظروف المقام، وربما كانت كلّها معبرة عن نفسه (علیه السلام) تُجاههم، كما عبر عنها هو (علیه السلام) حينما كشف عن مشروعه الإصلاحي فيما بعد: " أَيَّتُهَا النُّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ، الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ. أَظْأَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَدِ. هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ " (3)..
ص: 94
1- شرح ابن أبي الحديد 26/7.
2- ينظر: ابن أبي الحديد المعتزلي 7 / 27 - 30.
3- نهج البلاغة، خطبة / 189/131.
4 - الإتسامُ بالسُّهولةِ والصُّعوبةِ: - تختلف الأنماط السِّلوكيّة عند الإمام بين السُّهولة والصُّعوبة ويظهر ذلك في الأداء اللغويّ سهولةً وصعوبةً أيضاً، ففي قوله (علیه السلام) في توقي البرد: " تَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ، أَوَّلُهُ يُحْرِقُ وَ آخِرُهُ يُورِقُ" (1).
تحول هذا القول إلى مثل شعبيّ يردده الناس (البرد سببُ كلِّ علةٍ)، يدلُّ النصُّ على تأثيرات فصلي الربيع والخريف في الإنسان، وهي حقيقة علميّة معروفة قبل زمن الإسلام، ذكر ابن أبي الحديد أنَّ هذه المسألة طبيعيَّة، وقد ذكرها الحكماء قديمًا، فقالوا: لما كان تأثير الخريف في الأبدان وتوليده الأمراض كالزكام والسعال وغيرها أكثر من تأثير الربيع مع أنَّهما فصلا اعتدالٍ، فأجابوا بأنَّ برد الخريف يفاجأ الإنسان وهو معتاد لحرّ الصيف فينكأ فيه، ويسدُّ مسام دماغه؛ لأنَّ البردَ يُكثف ويسدُّ المسام.
أما المُنتقل من الشتاء إلى فصل الربيع، فإنَّه لا يكاد برد الربيع يوذيه ذلك الأذى، لأن جسمه قد اعتاد بردَ الشتاءِ، فلا يصادف من بردِ الربيع إلّا ما قد اعتاد ما هو أكثر منه، فلا يظهر لبردِ الربيعِ تأثير في مزاجهِ (2).
إنَّ نمط السلوك الذي سلكه الإمام هنا تمثل بوظيفة الحكيم المرشد؛ لينبّه على حقيقة علميَّة، قد يكون الناس قد اعتادوها وعرفوها قبل زمن الإمام، لذا اتسم هذا النمط بالسهولة واليسر حتى في لغته المستعملة، فجاءت العبارات على وفق اللغة الجماليّة الممزوجة باللغة التبليغيّة، فابتدأ بالطباق؛ ليلج منه إلى المقابلة بين حالتين: المهن والعافية، والسقم والصحة، بدأ بفعل (توقوا) وهو فعل الأمر للجماعة الحاضرة، وقابل بفعل (تلقوا) وهو فعل أمر للجماعة الحاضرة أيضاً، وكأني بالإمام (علیه السلام) وقد اختار الفعلين اختياراً دقيقاً، يناسب مع المعنى اللغويّ للجذر: (وقى)، الذي يبدأ بحرف علة وينتهي بحرف علة أيضاً، وكأن البرد كالفعل (وقى) من حيث أوّله علة، إن سرت طلعت علة حتى النهاية، في حين أنَّ الجذر (لقى) بدأ بحرف صحيح، دلالةً على الصحة في تلقي البرد في آخرهِ..
ص: 95
1- نهج البلاغة، الحكمة / 128/ 492.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 11/ 38.
وقد سارت الحكمة جماليّاً حتى غايتها حين أكمل المقابلة بقوله: (أوله يحرق وأخره يورق) مرَصّعًا في تسجيعاته (توقوا - تلقوا - ويحرق - يورق)، ومقرنًا هذه المقابلة بلون آخر من ألوان البديع، ليشاركها في البهجة والرونق وهو: (التسجيع) الذي قدم شحنةً موسيقيَّةً، أسمعتنا حسيس النار في (يحرق)، وتفتق أكمام الورد في (يورق)، واستكمالا لعناصر الصور الجماليَّة استعان الإمام (علیه السلام) بلونٍ بيانيٍّ، هو: (التشبيه التمثيليّ)، فشبّه حال الأبدان في تعرضها لأوّل البرد وآخره بالأشجار، فأوّل البرد يعتري من أوراقها، وآخره تبرعم وحياة، أشار النصُّ إلى تأثيرات الفصول الأربعة من غير أنْ يصرح بذكر ألفاظها.
إنَّ استعمال اللغة الجماليّة في النصِّ متأتٍ من تأثيرات المجتمع آنذاك، الذي تتميَّز لغته بالفصاحة والبلاغة والبيان؛ لقربه من عهد الرسالة الخالدة.
وهناك أنماط من سلوك الإمام تتسم بالصُّعوبة والعسر، فجاءت ألفاظ النصِّ متناغمة مع صعوبة النمط، فحين رفض الإمام (علیه السلام) التخلق بأخلاق خصومه الشاميين قائلًا: " وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي، وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ؛ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ، وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ، وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَة" (1)، جاء في النصِّ أسلوب القسم مرتين باللَفظ نفسه (والله)، فَضلًا عن الاستدلال التَّدريجيّ الذي اعتاد الفلاسفة والمناطقة والمفكرون نهجه (وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ، وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
وعند الإعداد للحرب المفروضة، ومظاهر المسيرة إلى ساحة القتال لإرهاب العدو كان ينهي عن البدء بالقتال، وكان يترك مباشرتها للخصم، حتى يبوء وا بإثمها، قال لعسكره قبل لقاء العدو بصفين: " لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ، وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ (2) وقال ذات يوم لابنه الحسن (علیه السلام): " لَا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَ إِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ؛ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا بَاغٍ، وَ الْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ " (3). 5.
ص: 96
1- نهج البلاغة، حكمة / 374/14.
2- نهج البلاغة، حكمة / 333 / 510.
3- شرح نهج البلاغة 3 / 15.
إنَّ الحدث الكلاميّ في النصِّين السابقين يدلُّ على أدبيات الحرب والقتال، ولما كانت تلك الأدبيات والأخلاقيات أشدُّ صعوبة من الحراب والقتال، جاء نمط سلوك الإمام من الناحية العمليَّة صعبًا جدًا، وتبعاً لذلك جاءت عناصر الحدث الكلامّي من حيث اللغة بتلك الصعوبة نفسها، فضلًا عن وجود التفاتة فنية رائعة أراد بها الإمام (علیه السلام) إظهار طريقة الخصم في القتال أو الهجوم، وآلية خوضه المعركة ممّا يفسح المجال واو على وجه السرعة أمام المتحدَّث إليه ليستجلى ما عليه خصمه ثم يستعد له بعد تحديد مكامن قوته ومواضع اعتماد عدته. وقد ناسبت صعوبة أجواء المعركة صعوبة ما عبر به.
الازدواجُ السِّلوكيّ للأنماطِ اللغويّة:
تكلمنا فيما سبق على نمطين سلوكيين سلكها الإمام (علیه السلام) في موقف لغوي واحد، كان ذلك في كلامه (علیه السلام) مع العلاء بن زياد الحارثيّ وأخيه عاصم بن زياد الحارثيّ، إذ ذم أصحاب الدنيا تارةً، ووبّخ الزاهد تارةً أُخرى، مبيّنًا إفراط وتفريط كلٍّ منهما، ومُفرقاً بين تكليف الإمام وتكليف العامّة.
وتكلمنا فيما سبق أيضاً على نمطين سلوكيين للإمام جمعهما نصّ لغوي واحد، وكان ذلك في حديثه (علیه السلام) عن موقفه من الخلفية الثالث عثمان في أيام خلافته: وعن موقفه حينما تصدى للخلافة، فظهر في النصّ نمطان سلوكيان مختلفان، وهذا ما نسميه بالازدواج السلوكيّ.
فصراع الأدوار أو ما نسمِّيه ب (الازدواج السِّلوكيّ للأنماطِ) كثير في نهج البلاغة، ومن أبرز ما تميّز به هذا الصراع في أنماط السلوك عند الإمام، ما نراه من ذمه الدنيا وزهده في عيشها، وقد كاد هذا النمط يكون هو الغالب على شخصيَّة الإمام الاجتماعيَّة اللغويَّة.
لكننا نجد في نصِّ واحدٍ من نهج البلاغة أنَّ الإمام (علیه السلام) يزجر فيه رجلًا يسمعه يذمُّ الدنيا فيقول له: " أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا، أَ تَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتَى غَرَّتْكَ؟ أَ بِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى؟ كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَّيْكَ وَ كَمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ؟ تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ وَ تَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ غَدَاةَ، لَا يُغْنِي عَنْهُمْ
ص: 97
دَوَاؤُكَ وَ لَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ، لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ وَ لَمْ تُسْعَفْ فِيهِ بِطَلِبَتِكَ، وَ لَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ وَ قَدْ مَثَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ وَ بِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا؛ مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ؛ اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ؛ فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا وَ نَعَتْ نَفْسَهَا وَ أَهْلَهَا، فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَلَائِهَا الْبَلَاءَ وَ شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ، رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ وَ ابْتَكَرَتْ بِفَجِيعَةٍ تَرْغِيباً وَ تَرْهِيباً وَ تَخْوِيفاً وَ تَحْذِيراً؛ فَذَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ وَ حَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيَا فَتَذَكَّرُوا وَ حَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا" (1)، هذا الكلام كلّه في مدح الدنيا، وهو ينبئ عن اقتداره (علیه السلام) على ما يريد من المعاني؛ لأنَّ كلامه في نهج البلاغة كلّه في ذمِّ الدنيا، وهو هنا يمتدحها، وهو صادق في ذاك وفي هذا، وهنا مصداق لمل ورد في القرآن الكريم، (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) القصص: 77. وورد عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنَّهُ قال: " الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها " (2) وقد ذكر ابن أبي الحديد حديثاً منسوبًا إلى لإمام (علیه السلام) يقول فيه: " الناس أبناء الدنيا، ولا يُلامُ المرء على حب أمه " (3) فاخذ هذا الكلام محمد بن وهب الحميريّ، فقال (4).
ونحن بنو الدنيا خُلِقْنَا لَغِيْرِهَا *** وما كنت منهُ فَهْو شيءٌ محببُ 1.
ص: 98
1- نهج البلاغة، حكمة / 131/ 493_494
2- كتاب الذكر والدعاء، مسلم (2742)، وكتاب الفتن، للترمذيّ / 44، باب ما جاء وما اخبر به النبي أصحابه وهو كائن (2191) وأحمد في مسنده (10773).
3- شرح نهج البلاغة 18 / 387.
4- البيت الشعريّ في مدح المأمون والمعتصم. ينظر: معجم الشعراء، المرزبانيّ (ت384 ه) 111/1.
المبحثُ الثالثُ / أثرُ المجتمعاتِ في تنوّع الوظائف اللغويّة
يتناول الباحث هنا المجتمعات التي أثرت في تنوّع الوظائف اللغوية بحسب التدرج العقيديّ:
1 - المجتمعُ المكيُّ:
لما كانت مكة حرم الله، ومنها انطلقت الدعوة الإسلاميَّة، وفيها بيت الله العتيق، تأثر النمط السلوكيّ للإمام بذلك المجتمع، وظهر ذلك في نصوص نهج البلاغة في المجتمع المكيّ، فبرز الوعظ والإرشاد والتذكير والحجيج والصلاة والإفتاء والجلوس للناس في المجلس، ومصاحبة المنبر بعد الصلاة ... وغير ذلك، ففي كتابه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة يقول: " أَمَّا بَعْدُ، فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ "وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ، فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِمَ؛ وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَ لَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ وَ لَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا، فَإِنَّهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وِرْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائِهَا. وَ انْظُرْ إِلَى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَاصْرِفْهُ إِلَى مَنْ قِبَلَكَ مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ وَ الْمَجَاعَةِ مُصِيباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ وَ الْخَلَّاتِ، وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَلَنَا. وَ مُرْ أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنٍ أَجْراً، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ) الحج / 25، فَالْعَاكِفُ الْمُقِيمُ بِهِ وَ الْبَادِي: الَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ، وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ لِمَحَابِّهِ؛ وَ السَّلَامُ " (1).
نجد مضامين هذا النصِّ جاءت تبعًا لخصائص المجتمع المكيّ، فظهر في السلوك اللغويّ للإمام الحج، وما يتعلق به، لوجود بيت الله الحرام، لم يذكر السياسة والأمور
ص: 99
1- نهج البلاغة، كتاب/ 67، ص / 458.
السلطانيّة، والجهاد والحرب، لأنَّ مكة حرم الله ومستقر عباده، فأمر إليه أن يقيم للناس الحج، وأن يذكرهم بأيام الأنعام وأيام الانتقام؛ لتحصل الرغبة والرهبة، ثم أمره بمجالسة الحجيج في الغداة والعشي، مقسمًا ثمرة جلوسه على ثلاثة أقسام: إما أن يفتي مستفتيّا من العامة في بعض الأحكام، وإما أن يُعلم متعلماً يطلب الفقه، وإما أن يذاكر عالماً ويباحثه.
ثم نهاهُ عن توسط الحجاب (الوسطاء) بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يكون سفيره لسانه، وحاجبه وجهه؛ لأنَّ ذلك يضفي على الوالي التواضع للرعية، ويوفر على الرعية الوقت، مخافة الإخلال في النقل لكيلا يضيع حق أحد منهم، وتدلُّ العبارة: "وَلَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ وَلَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ" على مخالطة الناس ومقابلتهم وجهًا لوجه، والاستماع لهم وسماعهم كما فعل الأنبياء من قبل، وقد ورد عن الإمام (علیه السلام) في عهد لمالك الاشتر قوله (علیه السلام): " وَأَمَّا بَعْدُ، فَلاَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِيَّتِکَ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ، وَقِلَّةُ عِلْم بِالاُمُورِ" (1).
جاءت الأفعال بصيغة الأمر وصيغة المضارع المنهيّ عنه دلالة على الوجوب والإلزام في مضامين النصِّ، وتفصيل الأحكام للوالي والرعية في ذلك المجتمع تبعًا للموضوعات المذكورة فيه، وفي قوله (علیه السلام): (وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ، وَذَاكِرِ الْعَالِمِ) إشارة دلالية إلى التربية والتعليم، فالدرس والمدرسة من أبرز عناصر المجتمع المتحضر، وبهما يرتقي المجتمع نحو الفضيلة والتقى.
2 - المجتمع المدينيّ:
ونقصد به مجتمع المدينة المنورة، وقد تلخص بنمط من السلوك عند الإمام تُجاه الخلافة وشوؤنها، والبيعة وما يتعلق بها، وما تمخّض عنها من أحداث ووقائع، ومن كلامه (علیه السلام) يصور فيه سلوكه تُجاه طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة، وقد عتبا عليه من ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بها، قال (علیه السلام):" لَقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً وَ أَرْجَأْتُمَا
ص: 100
1- نهج البلاغة، كتاب/ 53 / 442.
كَثِيراً؛ أَلَا تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَكُمَا فِيهِ حَقٌّ دَفَعْتُكُمَا عَنْهُ، أَمْ أَيُّ قَسْمٍ اسْتَأْثَرْتُ عَلَيْكُمَا بِهِ، أَمْ أَيُّ حَقٍّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعُفْتُ عَنْهُ، أَمْ جَهِلْتُهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ؟ وَ اللَّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَ لَا فِي الْوِلَايَةِ إِرْبَةٌ، وَ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا وَ حَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ وَ مَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ (صلی الله علیه وآله) فَاقْتَدَيْتُهُ، فَلَمْ أَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَى رَأْيِكُمَا وَ لَا رَأْيِ غَيْرِكُمَا، وَ لَا وَقَعَ حُكْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُمَا وَ إِخْوَانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَ لَا عَنْ غَيْرِكُمَا " (1).
وفي موضع آخر يصفهم قائلا: " وَ اللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً وَ لَا جَعَلُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ نِصْفاً، وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ " (2).
ثم يقول في الخطبة نفسها وهو يصفهم حال البيعة: " ففَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا، تَقُولُونَ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ، قَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُمُوهَا وَ نَازَعَتْكُمْ يَدِي فَجَاذَبْتُمُوهَا. اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَ ظَلَمَانِي وَ نَكَثَا بَيْعَتِي وَ أَلَّبَا النَّاسَ عَلَيَّ، فَاحْلُلْ مَا عَقَدَا وَ لَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا وَ أَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَّلَا وَ عَمِلَا " (3).
والنصوص بهذا المضمون كثيرة جداً، ملأت صفحات نهج البلاغة كما ملأت قلب الإمام علي (علیه السلام) ألمًا وقيحًا.
3 - المجتمع الكوفيّ:
أسِّسَت الكوفة إبانّ نهضة الإسلام الكبرى، حين كان المسلمون ينطلقون إلى الفتوحات، فاختاروها لتكون قاعدةً ومقراً للقيادة، وكان لهم من مناخها المتميز بسماء مجلوة، وماء عذب، ونسيم ساحر، ما وَفَّرَ لها شروط الراحة والاستقرار، فكانت (كوفة الجند)، وهذا مبدأ تكوينها التاريخيّ.
ص: 101
1- نفسه، خطبة / 205 / 323.
2- في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية 2/ 291، ط 1، 1427 ه. ت مطبعة ستار - قم.
3- نهج البلاغة، خطبة / 196/137.
و قلب الكوفة هو مسجدها العظيم، مصلّى الأنبياء (علیه السلام) والقطب الذي تحلّقت حوله القبائل العربيَّة، تلتمسفيه فخرًا إلى فخرٍ لتصبح الكوفة معه (كوفة القبائل) أيضًا.
لذلك اختارها الإمام (علیه السلام) عاصمة لخلافته، وقد اتخذت خطبه (علیه السلام) نمطين من السلوك تبعًا لمرحلة خلافته فيها، تمثل النمط السلوكيّ الأوّل بالثناء والمدح، وكان ذلك في بداية خلافته، حينما استنصر هم (علیه السلام) لقتال الناكثين في معركة الجمل بعد ما تمادى هؤلاء في معارضتهم وعصيانهم، وتمردهم على الشريعة والقائد الحق.
أراد الإمام أن يعدَّ العُدة لمواجهة الأخطار المحدقة، فوجد أنَّ المدينة المنورة لا تتوافر فيها عوامل النجاح العسكريّ والسياسيّ، بعكس الكوفة التي امتازت بمزايا استراتيجيَّة وعسكريَّة، جعلت الإمام يخاطبهم لنصرته حين خرج من المدينة إلى البصرة لمقاتل الناكثين، فوجه كتابًا إلى أهل الكوفة، قال فيه: " مِنْ عَبْدِ اللَّهَ عَلِيٌّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ جَبْهَةِ الْأَنْصَارِ وَسَنَامِ الْعَرَبِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ، حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ. إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ، فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ، وَأُقِلْ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنيفُ، وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَهُ غَضَبٍ، فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، وَبَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ، وَلَا مُبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخَرِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا، وَقَلَمُوا بها، وَجَاشَتْ جَيْشَ الْمِرْجَلِ، وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ. فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ، وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ " (1)
إنَّ نمط سلوك الإمام في هذه المرحلة تمثَّل في استنهاض هم أهل الكوفة، لنصرته في معركة الجمل، فأظهر النصُّ عبارات ذات مضامين اجتماعيَّة، مثل: (جبهة الأنصار، وسنام العرب) الدالة على الرفعة وعلو الشأن؛ لأنَّ (جبهة الأنصار) مأخوذةٌ من جبهة الإنسان، وهي أعلى أعضائه، فضلًا عن أنَّ لفظة (الأنصار) هنا 4.
ص: 102
1- نهج البلاغة، خطبة / 1 / 364.
تعني: (الأعوان)، ويمكن أن يُراد بها هنا: (الجماعة)، فإنّ الجبهة في اللغة تعني الجماعة، ويمكن أن يُراد بها سادة الأنصار وأشرافهم (1)، ويبدو للباحث أنَّ المراد هنا جميع أهل الكوفة لما رأيناه من توجيه الخطاب لأهل الكوفة في البدء حين افتتح كلامه بقوله: (مِنْ عَبْدِ اللَّه عَلِيًّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ)، وهو خطاب شامل وعام، يلائم والغرض العام من الكتاب.
ولعل الإمام قالَ: (جبهة الأنصار) ولم يقلْ الجماعة أو غيرها ذلك مناسبة لقوله: (فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ) لِيدلّ على أنَّ المجتمع الإسلامي بني على أساس تلك الطليعة الأولى من المهاجرين والأنصار، وما تنطوي تحته من مبادئ الأخوة الإيمانية، ولا سيّما حينما تكون تلك الأخوة في أوجّ حالاتها عند النصرة والاستغاثة، وعبارة: (فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ) تبعث على التواضع أمام الجماعة المؤمنة، فحينما يخاطب مُستغيثاً بجبهة الأنصار، وهو فرد واحد من تلك الجماعة المهاجرة في سبيل الله، فمن الطبيعيّ أنْ تكون تلبية النداء من جبهة الأنصار في أوجّها؛ لأنَّ المُستغيث فردٌ وليس الجماعة كلّها، فتكون حاجته إلى النصرة أشدَّ وأعظمَ.
إنَّ في ذلك من التخلّص والتبرؤ ما لا يخفى على المتأمل، فإنّهُ لم يُبقِ عليه في ذلك حجة الطاعن، إذ جعل نفسه (علیه السلام) واحدًا من عُرْض المهاجرين، الذين ينفرٍ منهم انعقدت خلافة أبي بكر وهم أهل الحل والعقد، وإنّما كان كلامه (علیه السلام) حجة على السامع.
ولكي تكتمل الصورة لأي مجتمع ناجح لا بُدَّ من توافر ثلاثة مقومات أساسية، هي: (القيادة، والقاعدة الجماهيريّة، والأرض)، وقد تمثلت في المجتمع الإسلاميّ الأوّل بالرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) وخلفائه، والجماهير المؤمنة، والمدينة المنورة)، فالمدينة المنورة وما تمر به.
ص: 103
1- ينظر: القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ (ت/ 729 - 817 ه) / 1146 - مادة (ج ب ه)، إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشيّ، دار أحياء التراث العربيّ، بيروت - لبنان ط 2، (1424 ه - 2003م).
من أحوال سيئة واضطرابات، جعل الإمام يذكرها في خطابه لأهل الكوفة؛ لأنّها الركن المهم في مقومات المجتمع الإسلاميّ، إذ قال الإمام واصفًا حالها: (وأعلموا أنّ دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها) أي فارقت أهلها وفارقوها، فالباء في الموضع الأول زائدة، وفي الموضع الثاني بمعنى (من) ويكون الكلام: قلعت أهلها وقلعوا منها، إشارة إلى الاضطراب وعدم الاستقرار، بسبب الفتنة التي ضربت أطنابها المجتمعات الإسلامية، كما وصفها الإمام (علیه السلام) بقوله: (وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ)، وكما نبّه الإمام (علیه السلام) على خطر الفتنة على المدينة المنورة، كذلك نبّه على الخطر الذي يحدق بالخلافة فقال مستنجدًا: (فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ وَ بَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ).
ومن المضامين الاجتماعيَّة الأُخرى، ما نجده في عبارة: (أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ، وَأُقِلُّ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِ هِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ).
فالاستعتاب هو طلب العتبى والرضا، وكأنه يقول: كنتُ أُكثِرُ طلبَ رضاهُ، وأقُلُّ عتابه وتعنيفه في الأمور، بخلاف طلحة والزبير فكانا شديدين عليه، ويدلُّ على ذلك لفظ (الوجيف) بمعنى: سير سريع، وهذا مثل للمشهورين في الطعن عليه، حتى أنَّ السّير السريع ابطأ ما يسيران في أمره (1).
كان موقف الإمام من أهل الكوفة في بداية خلافته على هذا النحو، ونجح بنمطه السلوكيّ هذا في استنهاض هممهم، وقد تحقق الغرض من استنهاضهم بعد انتصار الإمام (علیه السلام) في معركة الجمل، ويؤكد هذا القول ما جاء عنه (علیه السلام) من قول: " ... وَجَزَاكُمُ الله مِنْ أَهْلِ مِصْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ وَدُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ) (2)..
ص: 104
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 224/14.
2- نهج البلاغة، كتاب/ 1 / 365.
وذكر ابن أبي الحديد أنَّ قوله: (من أهل مصر) نصب على التمييز وتقديره: وجزاكم الله متمدنين أحسن ما يجزي المطيع، وإنْ كان التمييز هنا قد جاء مشتقّا، فإنَّ العرب أجازت مجيء التمييز مشتقًا، قال الأعشى:
بانت لتحزننا عفاره *** يا جارتا ما أنتِ جاره (1)
أما (ما) فيجوز أن تكون بمعنى (الذي) ويكون قد حذف العائد إلى الموصول، وتقدير الكلام أحسن الذي يجزي به العاملين (2)، والشاهد هنا أنَّ السبك والتأويل والحذف أمارات على المناحي الاجتماعيَّة في لغة العرب وأساليب متعارف عليها بين المرسل والمتلقي في لغة التخاطب.
أما النمط السلوكيّ الآخر فتمثل في مرحلة خلافته الأخيرة بالتوبيخ والزجر و التعنيف، دلالة على موت إرادتهم، إذ يقول (علیه السلام) في إحدى خطبه:: " أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَظْهَرَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لِإِسْرَاعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي، وَ لَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي. اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا وَ أَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا وَ دَعَوْتُكُمْ سِرّاً وَ جَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا؛ أَ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ وَ عَبِيدٌ كَأَرْبَابٍ أَتْلُو عَلَيْكُمْ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا وَ أَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا وَ أَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ قَوْلِي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَيَادِيَ سَبَا، تَرْجِعُونَ إِلَى مَجَالِسِكُمْ وَ تَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ. أُقَوِّمُكُمْ غُدْوَةً وَ تَرْجِعُونَ إِلَيَّ عَشِيَّةً كَظَهْرِ الْحَنِيَّةِ عَجَزَ الْمُقَوِّمُ وَ أَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ، أَيُّهَا الْقَوْمُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَى بِهِمْ أُمَرَاؤُهُمْ. صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ تَعْصُونَهُ وَ صَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللَّهَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ. لَوَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَنِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أَعْطَانِي رَجُلًا 7.
ص: 105
1- الصحاح، الجوهري 2/ 591. وشرح ابن عقيل 1/ 668.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 4/ 237.
مِنْهُمْ.یا أَهْلَ الْكُوفَةِ مُنِيتُ مِنْكُمْ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَيْنِ، صُمٌّ ذَوُو أَسْمَاعٍ وَ بُكْمٌ ذَوُو كَلَامٍ وَ عُمْيٌ ذَوُو أَبْصَارٍ، لَا أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَ لَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلَاءِ. تَرِبَتْ أَيْدِيكُمْ يَا أَشْبَاهَ الْإِبِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّقَتْ مِنْ آخَرَ، وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي بِكُمْ فِيمَا إِخَالُكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ حَمِيَ الضِّرَابُ، قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا، وَ إِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِيِّي وَ إِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطُهُ لَقْطاً" (1).
امتازت خطب الإمام (علیه السلام) بأسلوب القسم، حتى أصبح هذا الأسلوب سمةً من سمات شخصيته الخطابية، ولا سيّما حينما يتحدث عن الغيبيات، مثلما جاء القسم هنا بنصرة أهل الشام على أهل العراق، وقد يكون ذلك نابعاً من أمرين:
الأمر الأول: غيبيّ لعلمه بالغيبيات وصلته بالمستقبل.
الأمر الآخر اجتماعيّ؛ لأنَّ أهل الشام أطوع لأميرهم، ومدار النصرة في الحرب، إنَّما هو على طاعة الجيش وانتظام أمره، لا على اعتقاد الحق، فإنَّه ليس يغني في الحرب أن يكون الجيش محقًا في العقيدة إذا كان مختلف الآراء، غير مطيع لأمر المدبر له، ويستدلُّ على هذه الظاهرة الاجتماعيَّة بما نجده من نصرة أهل الشرك - في الغالب - على أهل التوحيد (2).
يتجسد النمط السلوكيّ عند الإمام في المجتمع الكوفيّ في هذه المرحلة في أوجّ حالاته، حينما يقول (علیه السلام): " وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي"، إذ أصبحوا من حيث البنيويَّة العقليَّة والأُسس الانثروبولوجيَّة على ثقافة واحدة، وهي أن يدعو بعضهم بعضاً بالطبائع، وليس بالقول والإشارة فقط، فهم في هذه المرحلة النفسيَّة السلوكيَّة أصبحوا لا يراعون الانتباه، لأنَّهم فقدوا الإحساس بالحياة، بل تجرؤوا على الله ورسوله وخليفته بأفعالهم وسلوكياتهم، فجاء الفعل.
ص: 106
1- نهج البلاغة، خطبة / 97/ 142 - 143.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 52/7.
(أصبح) في النصّ مقصودًا؛ دلالة على الكشف والتجلي الظاهر الذي لا يغطيه شيءٌ، ولا يستر عليه حجاب من اتباع الرعيةِ نهجًا مخالفًا لنهج المجتمعات الأخرى، فالمعروف أنَّ الرعية تنقم على أمرائها بسبب ظلمهم، والغريب هنا أنَّ الأمير هو من ينقم على رعيته بسبب ظلمهم إياهٌ، فكان الإمام كالمحجور عليه، لا يتمكن من بلوغ ما في نفسه، لأنَّ العارفين بحقيقة حاله قليلون، والسواد الأعظم لا يعتقدون الأمر الذي يجب اعتقاده فيه، ويرون تفضيل من تقدمه من الخلفاء عليه، ويظنون أنّ الأفضلية إنّما هي الخلافة، ويقلد أخلافهم أسلافهم، ويقولون: لولا أنَّ الأوائل علموا فضل المتقدمين عليه لما قدموهم، فضلًا عن أنَّهم كانوا يحاربون معه بالحمية وبنخوة العربيَّة، لا بالدين والعقيدة، لذلك قال (علیه السلام): (لِإِسْرَاعِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي)، فوصف أهل الشام وصاحبها بإسراعهم إلى باطلهم في حين غايره بالمقابلة عندما وصف أهل الكوفة بإبطائهم عن (حقه) لا عن (حقهم)؛ لأنَّهم وأهل الشام على حدِّ سواء في الباطل.
ومن المضامين الاجتماعيَّة في النصِّ وصفه هذا التفرق والتشرذم ب (أيادي سبأ)، وهو مثل يضرب للمتفرقين، وأصل هذا المثل مأخوذ من قوله تعالى عن أهل سبأ: وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلّ مُمَزَّق سبأ / 19.
ثم وصف اعوجاجهم عن الحق بظهر القوس المعوج؛ لأنّ (الحنية) في قوله (علیه السلام): (كظهر الحنية) تعني القوس، و (أعضل المقوّم) أعضل داؤه بمعنى: أعيا.
استعمل الإمام تعابير اجتماعيَّة تتلاءم مع نمط السلوك الاجتماعيّ تُجاه المجتمع الكوفيّ وهذه التعابير مؤلفة من ألفاظ وتراكيب وتشبيهات تعطي معنى التوبيخ والسخريَّة والزجر وسوء الحال مع هذا المجتمع.
إنَّ التغيِّر والتَّحول الذي حصل في الأنماط السلوكيَّة للإمام تُجاه مجتمع الكوفة، وظهر على لغته نابع من عدة أسباب، تختصُّ بالمجتمع الكوفيّ، وهي:
ص: 107
1. دخول الشبهة على عددٍ كبيرٍ منهم عند رفع المصاحف في معركة صفين، فغلب على ظنّهم أنَّ أهل الشام لم يفعلوا ذلك خدعة وحيلة، بل حقًا ودعاءً إلى الدين، فرأوا أنَّ الاستسلام للحجة أولى من الإصرار على الحرب.
2. منهم من سَئِم الحرب، وآثر السلم، فلما رأى شبهةً ما يسوغ التعلق بها في رفض المحاربة وحب العافية، أخلد إليها.
3. منهم من كان يبغض عليًا (علیه السلام) بباطنه، ويطيعه بظاهره، فلما رأوا طريقًا لخذلانه، وترك نصرته، أسرعوا نحوه.
والجدير بالملاحظة أنَّ الإمام (علیه السلام) استعمل أسلوب (الفصل والتفصيل) في ذكر خمس خصال مُني بها المجتمع الكوفيّ، فقال مخاطباً إياهم: " يا أهل الكوفة مُنيت بثلاث واثنتين ..." ولم يقل خمسًا، لأنَّ الثلاث إيجابيَّة، أما الاثنتان فسلبيَّة، فأحب أن يفرق بين الإثبات والنفي. وعبارة: (تربت ايديكم) كلمة يدعى بها على الإنسان، أي لا أصبتم خيراً، وأصل (ترب) من التراب، أي أصاب التراب، فكأنه يدعو عليهم بأن يفتقروا حتى يلتصقوا بالتراب.
وعبارة: (انفراج المرأة عن قبلها) أي وقت الولادة، وكان الإمام (علیه السلام) كثيرًا ما يشبه أهل العراق ولا سيما الكوفة بالمرأة الحامل لتقاعسهم عن الجهاد، ومن ذلك قوله (علیه السلام): "أَمَّا بَعْدُ، يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ، فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ وَ مَاتَ قَيِّمُهَا وَ طَالَ تَأَيُّمُهَا وَ وَرِثَهَا أَبْعَدُهَا" (1)، ويصف أهل البصرة ب (جند المرأة)، وذلك بقوله (علیه السلام): " كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَ أَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ، رَغَا فَأَجَبْتُمْ وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ" (2).
أملصت الحامل: ألقت ولدها سقاطًا، وهذه العبارة من العبارات السِّياقيَّة التي قيمتها قيمة المثل، التي أخذت قيمتها الدلاليَّة الثابتة على العصور بحكم التوافق الاجتماعي، وقيمها بعلها، وتأيمها خلوها من الأزواج، وهو (علیه السلام) بهذه التعابير 3.
ص: 108
1- نهج البلاغة، خطبة / 71 / 101.
2- نهج البلاغة، خطبة / 56/13.
الاجتماعيَّة يصف نكوص أهل العراق حينما شارفوا استئصال أهل الشام وظهور أمارات الظفر ودلائل الفتح، فجنحوا إلى السلم والإجابة عن التحكيم عند رفع المصاحف، فكان حالهم حال المرأة، التي ألقت حملها إلقاءً غير طبيعيٍ، فتلقته هالكاً، ومعلوم أنَّ الحامل تمر بظروف صعبة جدًا تجاهد فيها وتتحمل المشاق والصعاب فتكفُّ عمّا هو إلى نفسها أقرب، وتمتنع عن كلِّ ما هي إليه أشوق، ممّا يضرها ويضر جنينها، ففي حركتها مشقة وفي جلوسها مشقة وفي نومها مشقة، حتى في صلاتها مشقة، كلُّ ذلك يُعطلُ من قدرات الحاملو هي غير حامل، فإذا بها بعد وضع حملها تضيع جهادها السابق هباءً منثورًا، وكأن شيئًا لم يكن، حتى أضحى ما شقيت لأحله، وتحملت العناء بسببه هملًا لم يكن شيئًا مذكورًا، وعبارات: (ومات بعلها، وطال تأيمها، وورثها أبعدها) دلائل واضحات على سوء حالها، إذ لم يكن لها ولد، وهو أقرب المخالفين إلى الميت ولم يكن لها بعل فورثها الأباعد عنها، كالسالفين من بني عم وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من يجري مجراه، ولا نسب بينها وبينه.
وهذا التشبيه يبيّن بوضوح موت الإرادة عند المجتمع الكوفيّ، فالضمير الجماعيّ لهؤلاء اتسم بموت الإرادة، وهو مجموع المعتقدات والمشاعر المشتركة لمجمل أعضاء المجتمع (1)، الذي لم يرَ أمامه سوء الانتصار أو الاستسلام، وبالفعل انقلب على نفسه، وساعد على قتل إمامه (علیه السلام)، نتيجة التآمر والتخاذل.
والجدير ذكره أنَّ الإمام لم يكن راغبًا في الخروج من المدينة إلى الكوفة، وإنّما اضطرته أحوال البصرة إلى ذلك، وقد بيّنه الإمام (علیه السلام) نفسه ذلك، حين قال: " أَمَا وَ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكُمُ اخْتِيَاراً وَ لَكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً. وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ! قَاتَلَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ؟ أَعَلَى اللَّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، أَمْ عَلَى نَبِيِّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ. كَلَّا وَ اللَّهِ لَكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا" (2).1.
ص: 109
1- ينظر: مدخل إلى علم اجتماع الأدب / 84.
2- نهج البلاغة، خطبة/ 101/71.
على الرغم من أنّ أهل الكوفة قد أخفقوا في تحقيق أهداف الإمام (علیه السلام) بنحوٍ عامٍ، إلّا أنَّ هناك شخصيات مثل: كُميل بن زياد، ورشيد الهجريّ، وعمار بن ياسر، وعمر بن الحمق، ومالك الأشتر وعدد قليل من أصحابه (علیه السلام) قد جسدوا خطبه وأقواله " وَ جَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ وَ الشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ؛ فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ، وَ دُعِيتُمْ فَأَجَبْتُم " (1).
4 - المجتمع الشاميّ:
يتصف المجتمع الشامي آنذاك بالتعمية المقصودة والولاء المطلق لبني أمية، يصفهم الإمام (علیه السلام) بعدة أوصاف يجمعها الجهل والجفاء والقسوة، إذ يقول عنهم (علیه السلام): " جُفَاةٌ طَغَامٌ وَ عَبِيدٌ أَقْزَامٌ، جُمِعُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ وَ تُلُقِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ، مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهَ وَ يُؤَدَّبَ وَ يُعَلَّمَ وَ يُدَرَّبَ وَ يُوَلَّى عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهِ؛ لَيْسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لَا مِنَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ " (2).
لفظة (جُفاة): جمع جافٍ، أي هم أعراب أجلاف و (الطغام): أوغاد الناس، والواحد والجمع فيه سواء، ويقال للأشرار واللئام (عبيد) وإن كانوا أحرارًا.
ووردت لفظة (أقزام) ليوازن بها قوله (طغام)، وهذه الثنائيَّة أثرت في التوازي التركيبيّ في داخل النصِّ، لما لها من أبعاد اجتماعيَّة مأخوذة من الواقع، هذه الموازنة ليست لفظية فحسب، بل معنوية أيضًا، ف (القزم) الذي يتعذر عليه بلوغ ما هو عالٍ ممّا يبلغه غيره من ذوي القامة المتوسطة والطويلة، فكأن الإمام (علیه السلام) أراد هنا: (أنكم تعرفون الحق وتستطيعون اتباعه والتزام أصوله وتعاليمه؛ لأنكم قادرون على ذلك، وفيكم القدرة إليه، ولكنكم قصرتم عن الاخذ به؛ بسبب دمغة الباطل والشيطان على رؤوسكم ونواصيكم التي رغبتم أنتم بها، فنكصت رؤوسكم، وجعلتكم مهطعين لا ترقون إلى الحق ونيله أبدًا، فأنتم عبيد أقزام)
ص: 110
1- نهج البلاغة، كتاب / 2/ 365.
2- نفسه، خطبة / 232 / 358.
والمسموع (قزم) يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والإفراد؛ لأنَّهُ في معنى المصدر، وفي ذلك دلالة على الشمول والعموم.
وروي في بعض المواقف الكلاميَّة (قِزام) بالكسر، وهي لغة جديدة نطقت بها
العرب، قال الشاعر:
أحصنوا أُمهم مِنْ عبَدهِم *** تلك أفعال القِزام الوكعة (1)
وقوله (علیه السلام): " وجمعوا من كلّ أوب وتلقطوا من كلّ شوب " أي جمعوا من كلّ ناحيةٍ ومن فرقٍ مختلطةٍ، إشارة إلى عدم أنتمائهم إلى أرضهم وبلادهم، فهم دخلاء على أرض الشام، لا يرعوون بقداسة الأنتماء الجغرافيّ، فكيف يُنتظر من الغريب على البلد خيرٌ، على ذلك البلد أو ما يحيط به. وكأنهم كالسبي الذي ورد إلى هذة الأرض لا يعلم شيئًا عن طرائق النشأة والعيش فيها، فهم يحتاجون إلى تفقيه وتدريب وتعليم وتولية مَن يهديهم إلى الحقّ وسبله وآدابه.
ولشدّة جهلهم يصف الإمام حالهم بأن يحجر عليهم كما يحجر على الصبي والسفيه لعدم رشده، وقوله (علیه السلام): (ويولى عليه) أي: يمنع من التصرف، وقوله (علیه السلام): (ولا الذين تبؤوا الدار والإيمان) أي سكنوها، وإنْ كان الإيمان لا يسكن كما تسكن المنازل، ولكنهم لما ثبتوا عليه، واطمأنّوا سمّاهُ منزلًا لهم، وهو من باب المجاز والتشبيه.
إنَّ النمط السلوكيّ عند الإمام تُجاه مجتمع الشام قد اتسم من لغة النصِّ المُتقدم والنصوص الأُخرى (2) بالتقارب المعنويّ في المفردات والتعابير التي تدلُّ على الاستواء والشمول والعموم بين الذكر والأنثى، والإفراد والجمع إشارة إلى الجهل المطبق الذي يخيم على أفراد المجتمع الشاميّ، فهم لا يميزون الحق من الباطل، وقد وصفهم.
ص: 111
1- الوكعة: ركوب الإبهام على السبابة من الرحل (ينظر لسان العرب مادة (وكع) لم تذكر المصادر قائله.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة: 6 / 245، 7 / 33، 56/7.
زعيمهم معاوية بأنَّهم جماعات لا يميزون الناقة من الجمل، وخير شاهد على ذلك استغرابهم وتعجبهم من استشهاد الإمام (علیه السلام) في محراب الصلاة، فهم لا يعلمون أ مصلٍ كان الإمام علي (علیه السلام) أم غير مصلٍ؟
5 - المجتمع البصريّ:
أبرز ما يميز المجتمع البصريّ في عهد خلافة الإمام (علیه السلام) الخيانة والغدر والتمرد واتباع الفتنة، يقول الإمام (علیه السلام) في ذلك: "وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ وَمَغْرِسُ الْفِتَنِ " (1)، والقول هنا كناية عن كثرة ما يحدث فيها من فتن وضلال، وأنّها ملجأ لمن يفسد في الأرض، ويخرج عن النظام، وفيها حدثت أوّل فتنة كبرى في الإسلام، إذ استقبلت الجمل وأصحابه، وحاربت تحت لوائه، وجرّت أهل الشام إلى شق العصا (2).
وحينما أرسل معاوية إلى أهل البصرة يحرضهم على الفتنة تارةً، ونقض العهد تارةً أُخرى، أرسل إليهم الإمام كتاباً يذكرهم بما كان منه يوم الجمل، إذ قال (علیه السلام): " وَ قَدْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَ شِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ؛ فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ؛ فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِي وَ خِلَافِي فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي وَ رَحَلْتُ رِكَابِي، وَ لَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لَا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلَعْقَةِ لَاعِقٍ، مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ وَ لِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ، غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً إِلَى بَرِيٍّ وَ لَا نَاكِثاً إِلَى وَفِيٍّ. " (3).
إِنَّ غرض الإمام (علیه السلام) من التهديد والوعيد مجرد التخويف والوقاية، كي يكفوا عن الفتنة والفساد، الذي هو ديدنهم آنذاك.
ص: 112
1- نهج البلاغة، رسالة / 18/ 376.
2- ينظر: في ظلال نهج البلاغة / 3/ 429
3- نهج البلاغة، رسالة / 29/ 390.
ثم نجد الإمام يصف حال طلحة والزبير بلغةٍ اتصفت بالثنائيات المتقابلة شبيهةً بالثنائيَّة التي تحدثنا عنها في المجتمع الشاميّ.
ويبدو للباحث التمازج العقيديّ بين هذين المجتمعين، ولاسيما عدائهما الدائم للإمام (علیه السلام) وهذه الثنائيات إشارة لحالهما من جهة وحال أهل البصرة وأهل الشام من. جهة أُخرى، ما بين ناکثٍ وضالٍ، قال: " كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ وَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ، لَا يَمُتَّانِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلٍ وَ لَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِهِ وَ عَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ. وَ اللَّهِ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا وَ لَيَأْتِيَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا. قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، فَأَيْنَ الْمُحْتَسِبُونَ؟ فَقَدْ سُنَّتْ لَهُمُ السُّنَنُ وَ قُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ. وَ لِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةٌ " (1).
نلحظ في النصِّ المُتقدم استعمال الإمام لضمير التثنية، دلالةً على طلحة والزبير، وكذلك جاءت الألفاظ والتعابير الثنائيَّة في تقابل اجتماعيّ مثل: (يمتان، ويمدان) وكذلك: (يرجو الأمر له، ويعطفه عليه) وكذلك: (وَلِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَلِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةٌ) وكذلك: (لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا) و (وَلَيَأْتِيَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا)
ثم أنَّ الأفعال في النصِّ جاءت في ثنائيِّة الإثبات والنفي: (يرجو، ويعطفه) في الإثبات، و (لا يمتان، ولا يمدان) في النفي.
ثم استعمل التكرار الثنائيّ في التعبير: (كلُّ واحد منهما)، ثم ختم النصَّ باستعمال (لكلِّ) مرتين في عبارة: (وَ لِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ وَ لِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةٌ)، وهما تفصيل (لكلِّ) التي ابتدأ بها النصُّ، لتشكل كلٌّ منهما طرفًا من الثنائيَّة.
وربما جاءت الثنائيَّة في النصِّ لبيان حال طلحة والزبير، وربما جاءت لبيان حال
أهل البصرة المغرر بهم، ما بين ناکث وضال. 8.
ص: 113
1- نهج البلاغة، خطبة / 207/148.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ قوله:(علیه السلام): (لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا) إشارة إلى أنَّ الرئاسة لا يمكن أن يديرها اثنان معًا، فلو صحَّ لهما ما أراداه، لوثب أحدهما على الآخر ليقتله.
وقد ذكر ابن أبي الحديد أنَّ أرباب السيرة قد ذكروا أنَّ الرجلين اختلفا قبل وقوع الحرب، فإنَّهما اختلفا حتى في الصلاة، فأقامت عائشة محمد بن طلحة، وعبد الله بن الزبير، يصلي هذا يوماً، وهذا يومًا، إلى أن تنقضي الحرب (1)، وهذا يدلُّ على تأسيس إزدواجية الحاكم لإضعاف الأمة في تلك الحقبة.
6 - مجتمع الزنج:
وهو من المجتمعات الصغيرة التي سكنت البصرة ذكرها الإمام قبل تشكيل هذا المجتمع، قبل قيام ما يعرف (بثورة الزنج)، فقد اتسم نمط السلوك عند الإمام في ضوءِ مفردات النصّ ومضامينه بالتشبيه والتهويل والمبالغة، وهي من أخبار الغيبيات والصلات بالمستقبل، يقول الإمام (علیه السلام): " ييَا أَحْنَفُ، كَأَنِّي بِهِ وَ قَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ غُبَارٌ وَ لَا لَجَبٌ وَ لَا قَعْقَعَةُ لُجُمٍ وَ لَا حَمْحَمَةُ خَيْلٍ، يُثِيرُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ. وَيْلٌ لِسِكَكِكُمُ الْعَامِرَةِ وَ الدُّورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّتِي لَهَا أَجْنِحَةٌ كَأَجْنِحَةِ النُّسُورِ وَ خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الْفِيَلَةِ، مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُنْدَبُ قَتِيلُهُمْ وَ لَا يُفْقَدُ غَائِبُهُمْ " (2).
إنَّ مجيء الألفاظ (لجم، لجب) و (قعقعة، حمحمة) و (الخيل، النعام) في النصِّ يدلُّ دلالة قاطعةً على وحشية هذا الجيش، فاللجب هنا بمعنى الصوت، فهذا الجيش ليس له غبار ولا صوت دلالة على أنّه جيش من الداخل إشارة إلى الزنج الذين كانوا عبيدا في البصرة، وقوله (علیه السلام): (كأني به وقد سار بالجيش) إشارة إلى صاحب الزنج وزعيم حركتهم، وهو علي بن محمد بن عبد الرحيم، وقيل للطالبين، وقيل لعبد قيس،
ص: 114
1- ينظر: شرح نهج البلاغة، 78/9.
2- نهج البلاغة، خطبة / 128 / 186 - 187
قاد ثورة الزنج سنة خمس وخمسين ومئتين، أما أتباعه فهم الزنج الذين يكسحون السباخ (1) في البصرة.
ويستمر الإمام في وصف حركة الجيش الزنجيّ الدالة على أنَّهُ جيش من الداخل وليس من الخارج بقوله (علیه السلام): (ولا قعقعة لجم، ولا حمحمة خيل، يثيرون الأرض بأقدامهم كأنهم أقدام النعام).
أما قوله (علیه السلام): (لا يندب قتيلهم) فالمقصود أنَّ القتيل منهم لا يندبه أحد، كما هي عادة العرب عند فَقدِ عزيز لهم، وذلك لأنّهم كانوا عبيد دهاقين البصرة وبناتها، ولم يكونوا ذوي زوجات وأولاد، بل كانوا عزابًا، فلا نادبة لهم.
وقوله (علیه السلام): (ولا يفقد غائبهم) إشارة إلى كثرتهم، وأنَّهم كلما قتل منهم قتيل، سد مسده غير، فلا يظهر أثر فقده (2). وفي ذلك دلالة على تفككهم وغربتهم، ولو أنَّ أحدهم استنصر الآخر في محنة الحرب لما وجد مَن ينصرهُ من أقرانه؛ لعدم أواصر الدم والنسب والحمية المقبولة فهم الأضعف في النزال، وهم إلى الهلكة أقرب منهم إلى الظفر في كلِّ واقعة.
وهناك مجتمعات أُخرى ذكرها الإمام (علیه السلام) في نهج البلاغة، مبينًا تأثره بها في ضوءِ تنوع سلوكياته (علیه السلام)، واختلاف وظائفه اللغويَّة والاجتماعيَّة تبعاً لاختلاف ثقافات تلك المجتمعات، نكتفي بالإشارة إليها، لكيلا يطول بنا المقام (3).
وصفوة القول أنَّ الإمام اتخذ عدة أنماط من السلوك الاجتماعيّ في حياته الشريفة، فاتسمت نصوص نهج البلاغة بالتَّنوّع والاختلاف في الألفاظ والتراكيب تبعًا لاختلاف المضامين وتنوعها، كلٌّ بحسب المرحلة التي قيلت فيها إجمالًا، بشخصية ا.
ص: 115
1- استعارة لتنقية البئر والنهر وغيرهما، شرح نهج البلاغة 301/8.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 297/8.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة: 7/ 33، 287 (مجتمع الخوارج)، 6/ 479 (مجتمع الملائكة)، 7/25 (مجتمع الانبار) 8 / 81 (مجتمع الجاهلية) 79/17 (مجتمع المشركين) ... وسواها.
الإمام (علیه السلام) من جانب وثقافات تلك المجتمعات وأحوالها من جانب آخر، فللغة " واقعان أساسيان هما: (أ) إنّها تتغير دائمًا في كلِّ مجالات البنى اللغويَّة (الأصوات، والتراكيب، والأسلوب الخطابيّ، والدلالة، والمعجم).
(ب) إنّها تتغير بطرائق متباينة مختلف الأماكن والأوقات " (1)، وهذه المراحل، هي:
المرحلة الأولى: بداية خلافته، ويمكن أن نسمّيها (مرحلة التنظير) على وفق مشروعه الإصلاحيّ، إذ اتسمت خطبه وكتبه (علیه السلام) بمضامين البيعة و وصفها، وموقفة (علیه السلام) منها، والعهد والمكانة وأمور الحكم العادل، ومن ذلك قوله (علیه السلام): " فَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ. وَ قَدْ قَلَّبْتُ هَذَا الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمَ، فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه وآله). فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ وَ مَوْتَاتُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مَوْتَاتِ الْآخِرَة. " (2)
إنَّ الدلالة النّصّيَّة تصور لنا حال المبايعين وحال الإمام أعظم تصوير، ولاسيما أنَّ هذا التصوير جاء مُرصّعاً بأجمل تشبيهٍ، يلائم الموقف السِّياقيّ، فشبههم بتزاحم الإبل العطاش يوم شربها الماء حينما تخلع عنها الحبال، حتى ظنّ أنّ القتل يقع عليه أو يقع من بعضهم على بعضٍ، لشَّدة زحامهم وإقبالهم نحو الإمام (علیه السلام).
من الصعب جدًا أن يستطيع الفرد في مثل موقف كهذا أن يُحكِّم عقله فيما يتأمل، بل لا يمكن للفرد منَّا مجرد التأمل في مثل موقف كهذا، لكن أصحاب النفوس الكبيرة والعقول الراجحة شواذٌ عن هذه القاعدة، فوقف الإمام (علیه السلام) موقف المتأمل، محكمًا.
ص: 116
1- دليل السوسيو اللسانيات، فلوریان كولماس / 173، ترجمة: د. خالد الاشهب وماجدولين النهيبيّ، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط 1، بيروت، 2009 م.
2- نهج البلاغة، خطبة / 54 / 91.
عقله، ومختارًا أولى الأحكام الشرعيَّة في الموقف السِّياقيّ، وما يترتب عليه من مواقف مستقبلًا، فاختار قبول البيعة مع مقاتلة الناكثين والقاسطين والمارقين، على أن لا يكون هو في حكم الجاحد أو المخالف العاصي؛ لأنَّ جهاد البغاةِ واجب على الإمام (علیه السلام) إذا وجد أنصارًا، فإذا أخلَّ بواجب استحق العذاب.
المرحلة الثانية: وهي المرحلة الوسطى من خلافته ويمكننا أن نسمِّيها (مرحلة التنفيذ)، واتسمت بحرب الناكثين والقاسطين والمارقين، ووصفِ تلك المجتمعات التي عاش فيها أو التي وقعت تحت وطأته، وحال الولاة، وتصنيف الطبقات، وتأسيس أدبيات الحرب وتطبيق الشريعة الإسلامية ... وسواها، ومن ذلك قوله (علیه السلام) مخاطباً أهل البصرة بعد معركة الجمل: " وَ قَدْ كَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَ شِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ؛ فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ؛ فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ وَ سَفَهُ الْآرَاءِ الْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِي وَ خِلَافِي فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي وَ رَحَلْتُ رِكَابِي، وَ لَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لَا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلَعْقَةِ لَاعِقٍ، مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ وَ لِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ، غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً إِلَى بَرِيٍّ وَ لَا نَاكِثاً إِلَى وَفِيٍّ. " (1).
استعمل الإمام هنا أسلوب التحذير والوعيد تُجاه الغافل والمتغافل من أهل البصرة، مذكرهم بيوم الجمل ومحذرهم من يومٍ أشدّ منه، ولا يكون يوم الجمل إلّا يومًا حقيرًا بالقياس إليه، لذا وصفه الإمام بقوله (علیه السلام): (إلّا كلعقةِ لاعقٍ)، وهو مثل للشيء الحقير التافه، ويروى بضم اللام، وهو ما تأخذه الملعقة، ثم مازج الإمام (علیه السلام) بين الشدِّة واللين، حينما قال (علیه السلام): (مع أنّي عارف فضل ذي الطاعة منكم ...)، وهذا مضمون قرآنيّ: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) سورة الانعام / 164.
المرحلة الثالثة: هي المرحلة الأخيرة من حياته الشريفة، آخر مدة خلافته ويمكن تسميتها (مرحلة الاعتبار)، التي اتسمت بالزهد والوعظ والإرشاد والوصية، لأنَّ.
ص: 117
1- نهج البلاغة، كتاب / 29/ 390.
التقدم في السِّنِّ هو مركز التجربة البشريَّة، هو انجاز القدرات والمهارات الفيزيائيَّة والاجتماعيَّة، وهو النمو المستمر لإسهام الأفراد في العالم، وتكوين التاريخ الشخصيّ والتنقل عبر تاريخ المجتمع (1).
ففي وصيته لابنه الحسن (علیه السلام) التي كتبها إليه بحاضرين حين انصرافه من صفين: " مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ، الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ، الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى وَ الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً، إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا يُدْرِكُ، السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَ رَهِينَةِ الْأَيَّامِ وَ رَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّنْيَا وَ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِيمِ الْمَنَايَا وَ أَسِيرِ الْمَوْتِ وَ حَلِيفِ الْهُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَحْزَانِ وَ نُصُبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ" (2).
هذا المقطع جزءٌ من النصِّ الكامل لوصية (علیه السلام) بعد أن تجاوز الستين عامًا، هو مقدمة من نصٍّ طويل جداً، لكنه موفٍ بالغرض، فالزهد والإرشاد والموعظة والوصية واضحة فيه، لا سيما أنَّهُ استعمل فيه التراكيب القصيرة المكوّنة من كلمتين أو ثلاث والدالة على التوقف المستمر على فقراتها، والتأمل العميق في عبارتها، وفيها إشارة دلاليَّة واضحة إلى أنَّ الإمام كان يتحدث بلسان الأب المرشد الذي خبر الدنيا وفقه ماهيتها طوال عمره الشريف "فإذا كان التقدم في السّنِّ تقدمًا عبر الزمن، فالسّنُّ هو موقع الشخص في زمن مُعيّن في علاقته بالمرتبة الاجتماعيَّة: مرحلة، ووضع، وموقع في التاريخ " (3)، فقوله (علیه السلام): (مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ) حذفت الياء من كلمة (الفان) ها هنا للازدواج بين نهاية الفقرتين (الفان) و (الزمان)؛ لأنَّهُ وقف، وفي الوقف على المنقوص يجوز حذف الياء مع اللام وإثباتها، والإثبات هو الوجه، ومع عدم اللام يجوز الأمران، وإسقاط الياء هو الوجه..
ص: 118
1- ينظر: دليل السوسيو لسانيات / 317.
2- نهج البلاغة، كتاب/ 392/31.
3- دليل السوسيو لسانيات/ 317.
والحذف هنا دلالة على الموعظة بقصر العمر، ولا سيّما أنّ الحذف أسلوب بلاغي يستعمله المخاطب حينما يدرك أن المحذوف معلوم في ذهنية المتلقي، وهو أسلوب اجتماعي يستعمل بين الفرد - غالبا - والفرد الآخر أو الجماعة، حينما تكون البنية الذهنية واحدة عند الجماعة، سواء في لغة التخاطب أو في لغة المراسلة. وربما جاءت كلمة (الفانِ) مكتفيةً، ويراد بها الإيحاء بسرعة الفناء، ولأنه (وال - د)
فهو (مولود) أي هو كغيره (مخلوق) وأنت (مخلوق) والمخلوق فان مهما بلغ عمره أما عبارة: (المقر للزمان كأنه (ال) جعل نفسه فيما مضى خصمًا للزمان، وها هو ذا يقر له بالغلبة والقهر، دلالة على العجز وعدم الدوام فيما يخص المخلوقات جميعا، كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ الرحمن / 27.
و (المدبر العمر) عبارة قالها الإمام؛ لأنَّه تجاوز الستين ولم يبق إلّا إدبار العمر، وعبارة: (المستسلم للدهر) أشدُّ تأكيدًا من عبارة: (المقر للزمان)، لأنَّه قد يقر الإنسان لخصمه، لكنه لا يستسلم.
أما قوله (الساكن مساكن الموتى والظاعن عنها غدًا) فهو لا يريد الغد بعينه بل استعار منه قرب الرحيل والظعن.
وهكذا تنصب دراسة السّنِّ في علاقته في اللغة - في ضوء اللسانيات الحديثة - ولا سيّما تنوع السوسيولسانيّ على نقطة تقاطع بين الحياة والتاريخ، ويمثل المتكلم الفرديّ أو جماعة عمريَّة من المتكلمين في أي لحظة موقعًا في التاريخ ومرحلة من الحياة في الوقت نفسه (1).
ثم يقابل الإمام (علیه السلام) تلك العبارات الخاصة به بعبارات دلاليَّة بالإمام الحسن (علیه السلام)، فقوله إلى (المولود) هذه لفظة بإزاء (الوالد) وأردف قوله ب (المؤمل ما لا يدرك)، وفيه وجهان دلالیان:.
ص: 119
1- ينظر: دليل السوسيو لسانيات/ 319.
الأول: أَنَّهُ كنَّى الإمام (الحسن) (ا) بذلك، على أنَّهُ لا ينال الخلافة بعد موته وإنْ كان مُؤملًا لها.
ويكون السِّياق المُتقدم من المُحرَّم اللغويّ على وفق طريقة الإمام من إخباره عن المغيبات وصلاته بالمستقبل.
والآخر: أنَّ الإمام أراد جنس البشر لا خصوص الإمام الحسن (علیه السلام)، وكذلك في بقية الألفاظ والعبارات التالية هذه العبارة.
فيكون الظاهر للإمام الحسن (علیه السلام) ولكن الحقيقة الباطنيَّة تكون للناس جميعًا، ويؤكد هذا الرأي أمران:
أ - قوله (علیه السلام) بعدها: (السالك سبيل من قد هلك) فإنَّ كلَّ واحد من الناس يؤمل أمورًا لا يدركها، وكلُّ واحد من الناس سالك سبيل من هلك قبله فيكون مجيء السِّياق هنا بهذا النحو بالخصوص الدال على العموم.
ب - الشموليَّة في خطاب الإمام (علیه السلام)؛ لأنَّ الإمام الحسن (علیه السلام) لم يكن الوحيد من الأئمة المعصومين الذي أُملَّ ولم يُدرك أمله، فكذلك الإمام الحسين (علیه السلام).
ولا يمنع أن يكون الغرض من كلام الإمام الخصوص والعموم معاً، ولا سيّما كلامه (علیه السلام) في نهج البلاغة سالك مسالك الوعظ والحكم للمُتدبر والمُقِّر (1)، فضلًا عن اتصاف كلامه بالشموليَّة كما أسلفنا.
والنكتة في هذا النصِّ أنَّ الإمام ذكر سبع صفات لنفسه، وذكر في قُبالتها أربع عشرة صفة في ولده (علیه السلام)، فجعل بإزاء كلِّ واحدة ممّا له اثنتين لابنه (علیه السلام).
ص: 120
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 16/ 236.
ويبدو للباحث من تمعنه في معاني العبارات أنَّ الصفات السبع الأولى خصَّت من أيقن بقرب أجله، فجاءت قليلة نسبيَّة؛ دلالةً على الفناء السريع لما كان يحس به (علیه السلام).
أما الأربع عشرة صفة الأُخرى فجاءت لمن ما زال يؤمل من الدنيا حظًا واسعًا، وهو ما طابق حياة الإمام الحسن (علیه السلام) الذي عاصر خلافة أبيه والخلفاء من قبله وحتى في حياة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، وعاش في خلافة معاوية بعد وفاة أبيه الإمام علي (علیه السلام) زمنًا.
ص: 121
نهج البلاغة
فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ
الفصلُ الثَّاني
اللُّغةُ والبِنْيَةُ الاجتماعيَّةُ
ص: 123
الفصلُ الثَّاني
اللُّغةُ والبِنْيَةُ الاجتماعيَّةُ
مدخل
تُعرّف البنية بأنَّها " جملة من العلاقات بين الموجودات أو المكوّنات (1) فبنية أي مجتمع بدائيّ، بشكله الأبسط ليست صورة بسيطة ومتشابهة العناصر، وإنَّما هي تركيبة معقدة من العلاقات بين أفراده، الذين يؤلفون مجتمعاً من هذا النوع، فهم مصنفون ومنتظمون في عدد من الأنساق المترافقة، وكلُّ نسقٍ من هذه الأنساق يؤدي وظيفته الخاصة في علاقة الفرد بالثقافة التي ينتمي إليها.
وحينما ننتقل من الحياة العضويَّة إلى الحياة الاجتماعيَّة، نتفحص مجموعة بشريَّة قبيلة أو قرية أو مدينة أو دولة، نستطيع ملاحظة عدد من الأنظمة المترابطة فيما بينها تمثل بجملتها (البنية الاجتماعيَّة)، التي يمثل الأفراد فيها الوحدات الأساسيَّة، تربطهم جملة من العلاقات الاجتماعية في (كلِّ) متكاملٍ. وكما أنَّ حياة الفرد في الحياة العضويَّة، تمثل أساس استمرارها مع تغير مستمر في الخلايا، كذلك أنَّ البنية الاجتماعيَّة لا تتأثر بتغيير أعضاء الجماعة أو رحيلهم، بل تستمر مادامت الحياة الاجتماعيَّة مستمرة، لذلك تُعرَّف الحياة الاجتماعيَّة بأنَّها: تأديةٌ لوظيفة البنية الاجتماعيّة، وهذه الوظيفة تتمثل بالأثر الذي يؤديه النشاط في الحياة الاجتماعيَّة ككلِّ، أو ذلك الإسهام الذي يقوم به النشاط في المحافظة على الاستمراريَّة البنيويَّة (2).
والرّاجح أنَّ مفهوم البنية أقدم من التّخصيص الذي عُرِفَتْ به في العلوم الاجتماعيّة، ويبدو أنَّ أوّل مجال تطبيقيّ له كان في القرن الثّامن عشر، في إطار ترتيب (الأجزاء) ضمن (الكلِّ)، أي بمعنى التّنظيم العضويّ (3)، ثم انعطف هذا المعنى في القرن العشرين على يد.
ص: 125
1- مدخل إلى علم اجتماع الأدب/ 165.
2- ينظر: النسا والقطيع وليد حمارنة مجلة الفكر العربيّ، من ص 85 وما بعدها، العدد / 19، السنة الثالثة، 1981 م.
3- أدخل هذا المعنى إلى علم الاجتماع كل من: (سبنسر) و (اوغست كونت)، يعني أن الأولية للكليّ على الجزئيّ، أي أن أية ظاهرة اجتماعية لا يمكن تغييرها من دون نسبتها إلى الكل، الذي تشكل الجزء منه. ينظر: مدخل إلى علم اجتماع الأدب/ 91.
الفيزيولوجيا وعلم النّفس، فأصبح مرادفاً ل (صيغة) أو (شكل)، ضمّنه عناصر بينها شبكة من العلاقات، ينجم عنها تولد أدوار جديدة للدلالات (1).
وفي هذا القرن ظهر (علم اللّغة) ليدرس تفاصيلها وأصواتها، ويعطي تحديداً جديداً لمفهوم (البنية)، يبتعد به من معنى (الترتيب والتنظيم)، ويقترب به من معنی (الائتلاف) و(المنظومة)، يقول (شتراوس): " إنَّ ما يريد علم الأصوات دراسته ليس الأصوات (Les sons) بحدّ ذاتها، وإنّما الأصوات الكلاميَّة (Les phonemes) المؤلفة للدلالة اللغويَّة، فالصوت الكلاميّ (قيمة لغوية) ولا يمكن تعريفه إلّا في علاقاته بالأصوات الكلاميَّة الأُخرى في النسق الصوتيّ الواحد ... وتعريف الصوت الكلاميّ يعني تحديد مكانه في النسق، وهذا لا يتأتى إلّا إذا أخذ في الحسبان بناء هذا النسق" (2).
إنَّ الطريقة اللغويَّة تعتمد على التحليل البنائيّ للبنيات، فالكلمة مثلاً تتألف من مجموعة عناصر متماسكة (الحروف والأصوات) إذا تغيّر أحدها تغيرت الكلمة وكذلك الجملة فإنَّها تتكون من كلمات مؤتلفة تتغيّر بتغيّر مواقع الكلمات، وقد تنبّه الجرجانيّ في (نظرية النَّظْم) على هذه الحقيقة، فجعل البلاغة والفصاحة يختلفان باختلاف نَظْم الكلمات في الجمل، والذوق الأدبيّ الرابط فيما بينها.
ويبدو للباحث - والله العالم - أنّ (نظرية النَّظْم) التي جاء بها الجرجانيّ ما هي إلّا مقاربة للبنية الاجتماعيّة التي جاء بها الإمام علي (علیه السلام) في تصنيفه الطبيعيّ للمجتمع والترابط الوثيق بين طبقاته، والنظام العام الذي يحكم هذه الطبقات، فضلًا عن النظام الخاص بكلِّ طبقة اجتماعيَّة، ووظيفة الكلمة في نظرية النظم تقترب من وظيفة الطبقة في التصنيف الاجتماعيّ.
ويمكن دراسة البنية الاجتماعيَّة عند الإمام (علیه السلام) في ضوءِ ثلاثة مباحث، هي:.
ص: 126
1- ينظر: تاريخ العلم وعلم النفس الاجتماعيّ، بوشنيف / 31 مجلة المعرفة، العدد / 252، شباط / 1983.
2- Les Grands Tex tes de La Sociolegie Modem p. 261.
المبحثُ الأوَّل / النظامان: (الإداريّ والاقتصاديّ)
النظام الإداريّ:
تُعدُّ عملية إدارة الدولة وتنظيم شؤونها مرتكزاً لحلقة مُحوريَّة هي القوة (Power)، إذتدور عملية التنظيم في فلكها، وكلما كانت تلك العملية قريبة منها كانت أكثر امتلاكاً لها (1).
وتتطلب هذه العملية فرض الضوابط والتشريعات لتكون مشروعة، لذلك يستمد الفكر الإداريّ في الإسلام رصانته الفلسفيَّة والعقائديَّة من الله تبارك وتعالى، متجسداً ذلك في القرآن الكريم، مرتكزاً فكريًّا وعقائديًّا للدين الإسلاميّ الحنيف وتؤطّر السُّنَّةُ النبويَّة الشريفة ذلك البناء العقائديّ عمليّاً وتطبيقيًّا وتحليليًا وتفصيليًا، من طريق الممارسات السلوكيَّة التي أرسى دعائمها الرسول الكريم محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).
ويشكل (نهج البلاغة) تتويجاً هادفاً لذلك الفكر على الصعيد التطبيقيّ ميدانيًّا في أثناء خلافة الإمام (علیه السلام)، وشكَّلت أكثر معطيات البناء الفكريّ والعقائديّ أثراً في حياة المجتمع الإسلاميّ آنذاك (2)، لذا تُعدُّ الإدارة بمعناها العام ذلك الجهاز الذي يسير شؤون الدولة والمجتمع، وهي نظام ضروري لا يقوم مجتمع ولا دولة بغيرها، ولا سيما المتطوّرة، من حيث الخدمات والالتزامات (3).
ولما كانت الأخلاق هي الدعامة الأولى في المجتمع الإسلاميّ، فإنَّ ترتيبها البنائيّ في الصدارة؛ لأنَّ كلَّ الأنماط البنائيَّة الأُخرى إنما تصدر عنها، فكلُّ ما هو صالح
ص: 127
1- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ، ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية، د. متعب مناف جاسم/ 12
2- ينظر: السياسة الإدارية في فكر الإمام علي بن أبي طالب بين الأصالة والمعاصرة، د. خضير كاظم حمود / 7، مؤسسة الباقر، بيروت.
3- ينظر الاتجاهات الفكرية عند الإمام علي (علیه السلام) / 142.
للفرد بالضرورة صالح للجماعة؛ لأنَّ تلك الأخلاق تحقق الأمن على مستوى الفرد ومستوى الجماع من طريق دعامات بنائيَّة، تتمثل داخل المجتمع الإسلاميّ على نحو روابط وعلاقات اجتماعيَّة، أو على نحو قيم ومبادئ كالصدق والتقوى والإيثار والتعاون وسواها، لذا تُعدُّ التقوى الوظيفة الأولى والأساسيَّة (Function Basis) التي ينبغي للفرد أو المجتمع أنْ يلتزم بها سلوكيًّا، ويعتمد عليها التعامل مع الآخرين على وفق سياقات هادفة في دعم البناءات القيميَّة للمجتمع.
ويتلخص علم الإدارة (Management science) بأنَّهُ علمٌ وفنٌ (science and art) علمٌ يستمد من النظريات الفلسفيَّة والفكريَّة وظيفته في مضمار إدارة المجتمع ومنظماته الإنسانيَّة المختلفة وفنٌ يعتمد على (صيغ) ذلك التعامل مع البشر، لأنَّ الإنسان (الفرد) حصيلة متفاعلة من المتغيرات الموروثة والمكتسبة، التي تؤدي البيئة على مختلف جوانبها وظيفتها في التأثير والتأثر في ذلك الفرد أو الجماعة أو المجتمع (1).
والمقصود بالصيغ هنا المضامين التعبيريَّة التي تؤديها اللغة الإداريَّة (ألفاظًا وتراكيب) وحدود تلك الصيغ فمثلًا ما جاء في نهج البلاغة " هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا " (2)، فالصيغ الإدارية المتمثلة بالتراكيب: (جباية الخراج، وجهاد العدو، واستصلاح الأهل، وعمارة البلاد) تشكِّل مرتكزات الحكومات قديمًا وحديثًا، وبنحوٍ أكثر دقة وشموليَّة إنَّها تستند إلى قاعدة (نطاق الإشراف) (ControlSpan of)، الذي كلما كان صغيرًا حقق أبعادًا أكثر للسيطرة والمراقبة وتحقيق الأهداف العامة. 8.
ص: 128
1- ينظر: الاتجاهات الفكرية عند الإمام علي (علیه السلام) / 8.
2- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 428.
ويعني نطاق الإشراف تحديد عدد المرؤوسين، الذين يستطيع الرئيس السيطرة عليهم، وقد أشار (شاشتر برناد) (Chaster barnard) إلى أنَّ المستوى المعقول لنطاق الأشراف يتراوح بين (3 - 9) أفراد (1)، وفي النصِّ المُتقدم إشارة الإمام عبر الصيغ التعبيريَّة المذكورة آنفًا إلى أربعة أفراد، إذ تمثل في أطار الحكومات المعاصرة أربع وزارات أساسيَّة أو أكثر هي:
1 - وزارة الماليَّة (جباية الخراج) وما يرتبط بها من المديريات العاملة في تحصيل الأموال (الإيرادات) من الضرائب والرسوم ... وسواها.
2 - وزارتا الدفاع والداخليَّة (جهاد العدو) و ما يرتبط بهما من قوى الأمن الداخليّ وأجهزة الشرطة والأمن ... وسواها.
3 - الوزارت (الشؤون الاجتماعيَّة، والصناعة والتجارة والزراعة والري) (استصلاح الأهل) وما يرتبط بهنَّ من مديريات تعمل على استصلاح شؤون المجتمع اجتماعيّاً واقتصاديًّا وثقافيًّا ... وسواها.
4 - وزارة الإسكان والتعمير (عمارة البلاد) وما يرتبط بهِنَّ من المديريات العاملة في عمارة البلاد، وتحسين المرتكزات الماديَّة وتطوير البنية الاقتصاديَّة الوطنيَّة والقوميَّة، كالطرق والمواصلات والخدمات العامة.
إنَّ نطاق الإشراف ذو بُعدٍ أساسيِّ في تمكين الوالي أو الحاكم من إدارة شؤون البلاد، وبنحوٍ قادرٍ على استشراف أبعاد العمل الهادف في البناء والتطوير وعمارة البلاد، وتحقيق أهدافها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والحضاريَّة، وفي الهيكل والتنظيم الإسلاميّ يحتل الحاكم أو الخليفة مرتبة ما قبل الصدارة، بعد الله سبحانه وتعالى، ومن بعدهِ أصحاب المناصب الدنيا، فالمسؤول بنحوٍ عام يرتبط بعلاقة دنيوية بالآخرين، يستمد فيها صلاحياته من البناء التنظيميّ، وبعلاقة أخروية بخشية الله وتقواه، وهذه العلاقة أكثر تأثيراً في الفرد والمجتمع لما تؤديه من أثرِ فعالِ في ترصين الأمن والاستقرار،.
ص: 129
1- ينظر: السياسة الإدارية في فكر الإمام علي / 10.
وبذلك فقد سبق الإمام (علیه السلام) كتَّاب أوربا ومفكريها الإداريين الذين ظهرت بواكير علم الإدارة الحديث على أيديهم وفي كتاباتهم في تشريع الوزارات في ضوء فكرة (نطاق الإشراف)، ولعل باكورة ذلك ظهرت بعد الثورة الصناعيَّة في أوربا (1).
بدأ الإمام بطائفة من تشكيلات الدولة والكيان الاجتماعيّ، صنّفها (علیه السلام) في طبقة رؤساء الهياكل الرئيسة لإدارة البلاد، وقد أطلق عليهم اسم (العمال) وهم بمنزلة المحافظين ورؤساء الدوائر العامة في البلاد والمشرفين في البلاد والمشرفين على الأعمال الإداريَّة والقريبين من الحاكم في إدارة البلاد بتنوِّعاتهم كافة، وبحسب عرف التسميات التي سادت عصرنا الحاليّ فهم طبقة واسعة من المجتمع لهم نفوذ سياسيّ وإداريّ واجتماعيّ، وصفهم الإمام (علیه السلام) وحدد طرائق اختيارهم بقوله: " ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِکَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَيَاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالْقَدَمِ فِي الاِْسْلاَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمْ أَکْرَمُ أَخْلاَقاً وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً، وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُْمُورِ نَظَراً" (2).
تمثل عبارات النصّ المُتقدم توجيهًا إداريًا أو ما نعبر عنه بقرارِ إداريّ، تضمن شروط تعيين رؤساء الوحدات الإداريَّة وذلك بتشخيص من له الأهليَّة في تسنم هذه المناصب، أو القائمين عليها.
وهذه الضوابط هي:
1 - أنّ يكون من أهل التجربة والمقدرة.
2 - أنّ يكون من أهل الحياء من الأصول الأُسريَّة المعروفة بأخلاقها الطيبة.
3 - أنّ يكون من أهل السبق والقدم في الإسلام. 5.
ص: 130
1- ينظر: السياسة الإدارية في فكر الإمام علي / 8.
2- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 435.
إنَّ تجاوز هذه الضوابط في تعيين العمال يسلط على الناس منتُخشى غائلته، ولا يحسن أداء عمله، ولا يؤتمن على مالٍ ولا نفسٍ، ومن ثم تجر الويلات والآفات التي تغزو المجتمع وتهدمه، فيصبح خاويًّا لا يستطيع الوقوف على قدميه، والشواهد التاريخية كثيرة في تولية الأقارب والأصحاب من غير كفاية إداريَّة، وما سبب مقتل الخليفة عثمان بن عفان إلّا توليته مروان والوليد وأمثالهما من أبناء عمومته.
وعلى أساس ذلك عبر الإمام (علیه السلام) بقوله: (جُماع من شعب الجور الخيانة)، فانطلق الإمام من معتقدٍ جديدٍ، ونظرية أتى بها أنموذجًا مثالًا للإصلاح والبناء الاجتماعيّ، هي نظرية (العدل الاجتماعيّ) التي مثلت ثورة على القيم والأفكار السابقة المنبثقة عن التنظيم السياسيّ السابق، تمثل هذا المُعتقد الجديد برمته بمستويين رئيسين:
المستوى الأوّل: - عزلُ كلّ عمالِ الخليفة السابق وولاته على الأقاليم عدا أبي موسى الأشعريّ، وهذا التنظيم الجديد ومشروعه التغييريّ العادل واجه تحديات جسيمة، تمثلت في امتناع والي الشام عن تنفيذ القرار، وتحالف الولاة المعزولين معه لإحداث حلف سياسيّ مُضاد للمُعتقد الجديد، وهو أمر استدعى من الإمام استعمال (القوة الشرعيَّة) لإمضاء المشيئة السياسيَّة التنظيميَّة الجديدة، تمثلت في حروب داخليَّة خاضها الإمام لتثبيت التنظيم الاجتماعي الجديد (1).
المستوى الآخر: - أحدث الإمام تغييرات جذريَّة وشاملة في هذا الجانب، فقد كان هناك أرض جعلها الخليفة الثاني عمر ملكًا خالصًا لبيت المال، ثم جاء الخليفة الثالث عثمان فاقتطعها لأوليائه وأعوانه وولاته وأهل بيته وبشأنها كان موقف الإمام علي (علیه السلام) حازما وحاسمًا (2)، وقد تجسد ذلك بقوله: " وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَعُودَ.
ص: 131
1- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ فكر الإمام علي (علیه السلام) نموذجاً، نضال عيسی نايف/ 92، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2008 م.
2- ينظر: الإمام علي بن أبي طالب، نظرة عصرية جديدة، محمد عمارة وآخرون / 27، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1974م.
أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا " (1).
ثم جعل الإمام خصالاً أربعًا يتصف بها أفراد هذهِ الطبقة تحقق العدالة والراحة والطمأنينة للمجتمع، وتكون سببًا لوضع هذه الشروط: (أَکْرَمُ أَخْلاَقاً وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً، وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُمُورِ نَظَراً) فاستعمل صيغة (أفعل) التفضيل لبيان أهمية خصال الشخص الذي تنطبق عليه الضوابط والشروط، وهذه الخصال لم تأتِ بنحوِ اعتباطيّ، ولم تكن معاني ملتصقة على الوجوه حتى يتطبعوا عليها، ويسيروا على هُداها، إنَّما لها أصول وجذور عميقة أنتجت تلك المزايا الأخلاقيَّة فمن لا أصل له لا فرع له (2).
أثر الكتَّاب في إدارةِ الدولةِ:
إنَّ لكتَّاب الدولة وظائفَ مؤثرةً تترك آثارها في مسيرة المجتمع، واستقرار البلاد، ومن المعلوم أنَّ الكاتب الذي يشير إليه أمير المؤمنين (علیه السلام) هو الذي يسمى بالاصطلاح العرقيّ وزيرًا، لأنّهُ صاحب تدبير حضرة الأمير، والنائب عنه في أمور ... وهو في الحقيقة كاتب الكتَّاب، ولهذا يسمّونُه الكاتب المطلق، وكان يقال للكاتب على الملك ثلاث: رفع الحجاب عنه، واتهام الوشاة عليه، وإفشاء السرِ إليه. وكان يقال: صاحبُ السلطانِ نصفُهُ، وكاتبُهُ كلُّه (3).
وما زالت بعض دول المغرب العربيّ تسمي رئيس الوزراء بالكاتب الأول، أما في حكومة الإمام علي (علیه السلام) فهم أفراد الجهاز الإداريّ للدولة، وكان (علیه السلام) يريد أن ينشئ جهازاً إداريًّا جديدًا للدولة، ولاسيما في مصر بدل الجهاز الذي أنشأهُ الخليفة
ص: 132
1- نهج البلاغة، خطبة/16/ 58.
2- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام (علیه السلام)، عبد الرضا الزيديّ / 239، ط 1، 1998م، منشورات ذوي القربي. 3 - ينظر: شرح نهج البلاغة 79/17.
الثاني عمر، فقد اضطر إلى قبول النظم الإداريَّة القائمة في البلاد، حين دوّن له الدواوين عقيل بن أبي طالب، وهي نُظُمٌ أنشأها الرومان والفرس والمصريون القدماء، وكانت لغات البلاد المفتوحة تمثل اللغات الرسميَّة في الدواوين، وهي تخلو من اللغة العربيَّة (1)، وبذلك استعمل الإمام (علیه السلام) سياسة لغويَّة جعلت اللغة العربيّة اللغة الرسميَّة في البلد، وبها تكتب الوثائق الإداريَّة وبها تدوّن الدواوين، ولهذا التخطيط الإداريّ الجديد أثر في المحيط اللغويّ والاجتماعيّ، بل في المُحيط الإقليميّ، إذ يؤثر هذا التخطيط في وزن اللغات الدخيلة (الأعجمية) وحضورها الرمزيّ وتتطابق اللغة الوطنيَّة (الشعبيَّة) مع اللغة الرسميَّة، وتنتهي التبعيَّة الإداريَّة لتلك اللغات، إذ إنَّ الذين يستطيعون قراءة هذه اللغات هم وحدهم القادرون على فكّ رموزها (2).
جاء في نهج البلاغة: " ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ کُتَّابِکَ فَوَلِّ عَلَى أُمُورِکَ خَيْرَهُمْ، وَاخْصُصْ رَسَائِلَکَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَکَايِدَکَ وَأَسْرَارَکَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الاَْخْلاَقِ، مِمَّنْ لاَ تُبْطِرُهُ الْکَرَامَةُ، فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْکَ فِي خِلاَف لَکَ بِحَضْرَةِ مَلاَ، وَلاَ تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُکَاتَبَاتِ عُمِّالِکَ عَلَيْکَ، وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْکَ، فِيمَا يَأْخُذُ لَکَ وَيُعْطِي مِنْکَ، وَلاَ يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَکَ، وَلاَ يَعْجِزُ عَنْ إِطْلاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْکَ، وَلاَ يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الاُْمُورِ، فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَکُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ. " (3).
فالكتّاب في نظر الإمام علي (علیه السلام) هم أركان الجهاز الإداريّ للدولة، ومنهم تتوزع بقية السلطات، ويعدّون رأس العنقود فيمن يخصُّ الإدارة، وهم الأيدي المتحركة للحاكم في إدارة البلاد، ويمثلون أعمدة السلطة والحاشية الأولى، وهي الموقع الأخطر في حياة المجتمع، لأنَّها قد تأخذ بالوالي إلى طريق الخراب والبعد من مصالح.
ص: 133
1- ينظر: علي إمام المتقين، عبد الرحمن الشرقاويّ 284/1، بيروت، 1985م.
2- ينظر: السياسات اللغويَّة، لويس جان كالفي / 64، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 1، الجزائر العاصمة (1430ه - 2009م).
3- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 438.
المجتمع، لذا يحذر الإمام (علیه السلام) من الجوانب السلبيَّة في اختيار هذه الفئة من الناس فيقول: " ثُمَّ لاَ يَکُنِ اخْتِيَارُکَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِکَ وَاسْتِنَامَتِکَ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنْکَ، فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلاَةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وَحُسْنِ خِدْمَتِهِمْ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِکَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالاَْمَانَةِ شَيْءٌ" (1).
والتفرس والاستنامة هنا يعنيان الثقة والسكون، لذا ينبغي له أن يكون اختيارهم على وفق التجربة والخبرة، أي: يتم الاختيار بعد الاختبار، فأن رآهم أكفاء ولّاهم، فالمحاباة والأثرة - وهي الاختيار عن هوى - مفسدة للرعية، ومضيعة للعدل، ومجلبة للبغض.
وفي النصِّ المُتقدم إشارة إلى ظاهرة اجتماعيَّة لا يكاد يخلو منها مجتمع ما، وهي وجود المُتملقين والمُتزلفين للسلطان؛ لغرض التقرب والحصول على المكانة عنده، و جلب نظره من أجل تسلم جانب من إدارة الدولة، وهؤلاء أشبه ما يكونون بالعناصر الإنتفاعيَّة ذات الأهداف المحددة التي تسعى إليها، وإنْ كان ذلك على حساب المصلحة العامة وللمجتمع.
لكن المقياس الحقيقيّ الذي يخلق أثرًا حسنًا في الأمّة لا يأتي إلّا من التعامل الصادق والصريح معهم، لذا قال الإمام (علیه السلام): "وَلَکِنِ اخْتَبِرْهُمْ بِمَا وُلُّوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَکَ، فَاعْمِدْ لاَِحْسَنِهِمْ کَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَراً، وَأَعْرَفِهِمْ بِالاَْمَانَةِ وَجْهاً، فَإِنَّ ذَلِکَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِکَ لِلَّهِ وَلِمَنْ وُلِّيتَ أَمْرَهُ." (2).
إذًا جميع المواصفات المطلوبة في إدارة الأعمال مهمة، وأكثرها أهمية هو اختيار أحسنهم وأفضلهم وأقربهم من قلوب العامة من الناس، فمن ترك أثرًا طيبًا وذكرًا 3
ص: 134
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 438.
2- نهج البلاغة، كتاب / 438/53
محمودًا، وحمل قلبًا ينبض بالإحساس بالناس وحلَّ مشكلاتهم، وعمل بالعدل والحق. وحسن التعامل الإنساني في الرعيَّة، فيدفع إليه الأمر، فهو أهل لذلك (1).
ولأجل التحصين الاجتماعيّ، ومنع انزلاق الكتّاب والعمال إلى الأمراض الاجتماعيَّة من قبيل الفساد الإداريّ والماليّ، قال (علیه السلام): " وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ - نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ، وَيَزَعَهَا عِنْدَ الْجُمَحَاتِ. فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ الله" (2).
وبذلك تشكل القيم الإداريَّة منطلقًا هادفًا في ترصين الإدارة الواعيَّة لبناء المنظومة الإنسانيَّة العاملة، وتحقيق آمالٍ شاملة في تطوير البنية الاجتماعيَّة، وخلق التماسك المنظوميّ السديد، ولا سيّما تأكيد الإمام (علیه السلام) ترويض النفس وجهادها، بإزاء الشهوات الدنيويَّة الزائلة، ومنازعتها أمام المآرب والشهوات. وبذلك شرَّع الإمام (علیه السلام) أخلاقيات مهنيَّة إداريَّة، شملت الولاة أيضاً، جاء في نهج البلاغة: " وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ" (3).
في النصِّ قيمٌ إداريَّةٌ قلما نجد مثلها في أرقى المنظومات الإداريَّة العالميَّة، إذ تتجسد حيثياتها بوضوح في تلك المقولة، إذ إنَّ الإمام (علیه السلام) يؤكد هنا أبعادًا واضحة المعالم، تتجلى في أهمية شعور الوالي أو المسؤول بالرحمة في الرعيَّة والمودة لهم ... وسواها من الأبعاد الإنسانيَّة، التي فاقت ما ظهر حديثاً في نظرية ((اليابانية theory Z) (4)،.
ص: 135
1- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي (علیه السلام)، ص / 252.
2- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 428
3- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 428.
4- ينظر: السياسة الإدارية في فكر الإمام علي (علیه السلام) / 18 - 19.
التي شكَّلت مثلئًا ذا أبعاد ثلاثة هي: (المودة، والثقة، والمهارة) والشكل الآتي يوضح ذلك:
الصورة
إنّ نظرية (Z) أظهرت طبيعة العلائق الإداريَّة السائدة في المجتمع اليابانيّ، و جعلت منه مجتمعاً أكثر تماسكًا وتطوّرًا، إذ إنَّهُ يضع نصب عينه الأبعاد الإنسانيَّة في التعامل مع العاملين والمنظمات السائدة في إطارها، لكنها نظرية تعجز عن بلوغ الأبعاد الإنسانيَّة في نظرية الإمام (علیه السلام) (في التعامل مع الجنس البشريّ) ولا سيّما أنّها أوضحت التعامل مع الجنس البشريّ على وفق إطارين شاملين للأبعاد الإنسانيَّة كافة، وهي " إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ" (1)، إذ ليس بوسع أكثر النظريات التنظيميَّة عمقًا وتحسبًا أن تعطى البُعد الإنسانيّ عمقًا في التعامل أكثر شموليَّة ممّا أورده الإمام (علیه السلام)، بل ذهبت مجموعة من النظريات الاجتماعيّة التابعة للنظريات السياسيّة إلى إثبات التمايز الطبقيّ في ضوء اللون والخلقة والمعتقد والمهنة.
إنَّ معاملة الرعيَّة في الإسلام تنطلق من بُعدٍ إنسانيّ عميق، تحسسه الإمام (علیه السلام) في ضوء الأُخوة في الدين أو في ضوء الخلق والتكوين الجسديّ، تلك الصفة الشاملة التي لا تتعداها سعة في شمولها، إذ إنَّها تضم النوع الإنسانيّ أجمعه، وهكذا تعطي هذه 8
ص: 136
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 428
المعاملة بُعدًا أكثر تأثيرًا في إعطاء الفرد والجماعة والمجتمع وظائفهم الرصينة في العلاقات، فخشية الله وتقواهُ تدعو والي الأمر أو المسؤول في الإسلام أن يكون أكثر اتزانًا في قراراته الإداريَّة والتنظيميَّة؛ لأنَّ الناس مستخلفون في الأرض إدارةً وعمارةً وليسوا مالكين حقيقيين لها، إذ إنَّهم بمنزلة الموظفين لاستثمار تلك الأموال والموارد المتاحة.
وبذلك بيّن الإمام (علیه السلام) نظرة الإسلام في الجمع بين رابطتي الدين والإنسانيّة في حكومة العدل الإلهيّ، التي أخطأ (اودييه odea) تفسيرها في كتابه (علم اجتماع الدين)، إذ يرى أنَّ الدين " أحد اللّبِنَات النظاميَّة المهمة في أي مجتمع، وأنَّ الدين يختلف عن الحكومة التي تهتم بالسلطة والقوة، ويختلف عن النظام الاقتصاديّ الذي يهتم بالعمل والإنتاج والتسويق، ويختلف عن نظام الأُسرة المسؤول عن تنظيم العلاقات بين الجنسين وبين الأجيال، وأنّ الاهتمام بالدين يبدو كأنه اهتمام بشيء غامض ليس من اليسير إدراك حقيقته الأمبريقية " (1).
وهذه النظرة تمثل نظرة (الوظيفيَّة المعاصرة) (2) للدين وكأن الدين يهتم أصلًا باتجاهات الإنسان نحو ما هو فوقيّ حصرًا، بما فيها التنظيمات العمليَّة، لما هو فوق الحياة البشريَّة، بلا نظر إلى مشاركات الدين في بناء المجتمعات البشريَّة.
الضمان الاجتماعيّ:
وفيه حفظ ماء وجه الطبقة المسحوقة، وذلك باستمرار أقواتها بلا من ولا أذىّ لا فرقَ بين جنسٍ ولا لونٍ ولا عقيدةٍ، انطلاقًا من مبدأ: (الناس صنفان: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخلْقِ).
ص: 137
1- مفهوم إسلاميّ جديد لعلم الاجتماع، د. محمد علوان، الجزء الأول (الجماعة) / 58، دار ومكتبة الهلال - بيروت - دار الشرق جدة للنشر والتوزيع والطباعة، 2008 م - 1429 ه.
2- وهي مجموعة من المذاهب الماديَّة الوظيفيَّة الحديثة التي لا ترى للدين أثرًا في بناء المجتمعات، ينظر: المصدر السابق، نفسه / 47 - 59.
سعى العالم المتحضر اليوم إلى سنِّ قوانين الضمان الاجتماعيّ، وأخذ يتبجح بها، في حين أنَّ الإسلام قد وضع أسس ذلك قبل أربعة عشر قرناً تقريباً، وجعل في حكومته الأولى (في طيبة الطاهرة) الأساس الأوّل للضمان الاجتماعيّ، وهو " التكافل العام الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كافة كفالة بعضهم لبعض، ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكانياته، يجب عليه أن يؤديها على أي حال كما يؤدي سائر فرائضه والضمان الاجتماعيّ الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام بين المسلمين يعبر في حقيقته عن دور الدولة من إلزام رعاياها بامتثال ما يكفلون به شرعاً، ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام أنفسهم " (1).
إنَّ مسؤولية الضمان الاجتماعيّ لا تفرض على الدولة ضمان حاجات الفرد الحياتيَّة، وإنَّما تفرض عليها أن تضمن إعالته، وذلك بالقيام بمعيشته وإمداده كفايتهِ.
والكفاية من المفاهيم المرنة، التي تتسع وتضيق، فكلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الإسلاميّ يسرًا ورخاءً، اشبعت الدولة في الإسلام الحاجات الأساسيَّة للفرد من غذاء ومسكن ولباس، وأن يكون إشباعها لهذه الحاجات من الناحية النوعيَّة والكميَّة في مستوى الكفاية (2).
فخصص الإمام (علیه السلام) في حكومته جزءاً من بيت المال وجزءاً من صوافي الإسلام ليخفف العبء الشديد الذي قد يتعرض له هؤلاء "وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِکِ، وَقِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الاِْسْلاَمِ فِي کُلِّ بَلَد، فَإِنَّ لِلاَْقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلاَْدْنَى، وَکُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ " (3). 3.
ص: 138
1- اقتصادنا، محمد باقر الصدر 2 / 698.
2- ينظر: نفسه / 701.
3- نهج البلاغة، كتاب 439/53.
ويقصد ب (صَوَافِي الْإِسْلَامِ) الأراضي والغنائم، وعبارة (في كُلِّ بَلَدٍ) يعني: الارض التي لم يقف عليها بخيلٍ ولا ركابٍ وكانت صافية لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، فلما قُبض، صارت لفقراء المسلمين، ولما يراه الإمام من مصالح الإسلام (1).
ولما كان الناس على صنفين، تجمعها الأُخوة في الدين، أو المماثلة في الخلق والتكوين، نجد المسلم لا ينام وجاره جائع يتضور من الجوع " أَوْ أَبِيتَ مِبْطَانًا وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى وَأَكْبَادٌ حَرَّى" (2)، هذا الشعور بالمسؤوليَّة من الحاكم حثَّ المسلمين على دفع المال للمعوزين والمحتاجين وإعانة الفقراء من الناس في أروع عملية تكافلية اجتماعيَّة، يدخل فيها الأجر والثواب، كما يدخل فيها عامل الإيمان، قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) البقرة / 261 - 262.
وقد سمّى الإمام (علیه السلام) فقراء الأمّة في عملية التكافل الاجتماعيّ بقوله " وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ، مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ وَلاَ يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذَلِکَ عَلَى الْوُلاَةِ ثَقِيلٌ، وَالْحَقُّ کُلُّهُ ثَقِيلٌ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللهُ عَلَى أَقْوَام طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ، فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لَهُمْ " (3) فتعهد الدولة للأيتام هو تكفلهم من النواحي كافة، إقامةً وبذلًا حتى ينشؤوا وينموا، بلا إضاعة حقوقهم ولا إهمالهم ولا تركهم "اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ " (4)، أما قصده ب (ذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ، مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ وَلاَ يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ)، فهم كبار السّنَّ والعاجزون عن العمل من الذين ليس لديهم سوى الاستراحة من تلك السنين، التي.
ص: 139
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 86/17.
2- نهج البلاغة، كتاب / 45/ 419.
3- نهج البلاغة، كتاب / 440/53.
4- نفسه، كتاب / 422/47.
حفرت أخاديد على وجوههم من الجهد والتعب الذي بذلوه، وطول العمر الذي قضوهُ والذي أضعفهم وقلل طاقاتهم، شملهم التعهد الأوّل؛ لأنَّه عائد بالعطف على تعهد الأيتام المُتقدم (وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل) إشارة إلى قوله تعالى: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) الزلزلة / 7. وقوله تعالى: (فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) القارعة / 6 - 7
والعجيب أنْ نرى مفكرًا بشريًّا ك (ماركس) يطبق ما موجود في الغابة على خليفة الله على الأرض، حينما أخذ نظرية (الصراع والمنافسة) بين الكائنات الحيوانيَّة فحط الإنسانيَّة إلى تلك الدرجة الحيوانيَّة، وحاول أن يطبقها عليها، فالصراع بين طبقة البروليتاريا وطبقة أصحاب وسائل الإنتاج، ولهذا لا بُدَّ - في نظره - أن تنقض طبقة البروليتاريا على الطبقة الأُخرى وتجعلها فريسة لها، وتقيم حكمها الخاص بعد أن تلتهمها (1).
فهل هناك أفحش وأسوأ من هذا؟ والأعجب أن يتبنى أفكاره معظم مثقفي العالم الإسلاميّ - بوعي أو بغير وعي _ ويأخذ الصراع منطلقًا لكي يفسر به بناء المجتمعات المتحضرة، بل يفسر به أبناء المجتمعات المتحضرة، بل يفسر به كلَّ شيءٍ في ميدان العمليات الجماعيَّة (2)، وهذا نقيض الرؤية القرآنيَّة (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) البقرة / 251. ذلك الدفع الشريف بين الإنسان وأخيه، وبين النظام والنظام، هدفه التَّقدم والثَّراء، لا الالتهام والافتراس.
الكوارث الطبيعيَّة ومسؤوليَّة الدولة:
أشار الإمام (علیه السلام) إلى الكوارث الطبيعيَّة ومسؤوليَّة الدولة قائلًا: "فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّة، أَوْ إِحَالَةَ أَرْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ" (3).
ص: 140
1- ينظر ذلك في مجمل كتاب (البيان الشيوعيّ).
2- مفهوم إسلاميّ جديد في علم الاجتماع / 55.
3- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 437.
فالأرض معرضة إلى جفافٍ قد يحدث أو إعصارٍ مُدمرٍ، أو صقيعٍ قاتلٍ للزرعِ أو أمطارٍ في غير موعدها، أو زلازلَ أرضيَّةٍ وما شابه ذلك، ففي مثل هذه الحالات يؤكد الإمام مهمة الدولة في رعاية الناس أصحاب هذه المهنة ومساعدتهم على تخفيف العبء الثقيل الواقع عليهم حتى يصلح أمرهم، فإذا أحسَّ الفرد بالرعاية الأبويَّة للدولة والاهتمام به، بوصفه إنسانًا وعضواً في المجتمع إلى جانب مساعدته الماديَّة والمعنويَّة، فإنَّ ذلك يعطيه زخمًا قويًا للعمل الجاد على إعادة التعمير والبناء وتعويض ما خُسر بالجهد الإضافيّ المبذول، وبزيادة الإنتاج سوف يستخرج ما وقع عليه من خراج طواعيَّة وبإرادة ذاتيَّة، يدفعه إلى ذلك حبه للدولة والوالي، لمساعدته إياه في وقت الشدّة، فلا خسارة أبدًا فيما أنفقت الدولة من بيت المال على مساعدة المتضررين، وإن يحصل نقص فيه، فإنَّ العائد الرابح في المستقبل هو أكثر وسيعوض ما خسرته الدولة سلفًا (1)، وهذا هو مفهوم نظام التأمين حاليًا.
النظامُ الاقتصاديّ:
برزت مكة مركزًا تجاريًا رئيسًا ومهمًا في المجتمع الإنسانيّ قبل الإسلام، فقد كان لتصدع سدِّ مآرب أثر بارز في إحداث تحول في الظروف الاجتماعيَّة في الجزيرة العربيَّة، أدى ذلك إلى فقدان أرضٍ شاسعةٍ خصوبتُها، فأصبحت غير صالحة للزراعة، واقتطعتها القبائل البدويَّة من المجتمع الحضريّ المستقر، شارك ذلك في انتقال مركزيَّة إدارة التجارة وتبادلها من اليمن إلى عرب الحجاز، فاستطاعت مكة أن تستحوذ على ما بقي من تجارة اليمن، فضلًا عن الحروب الطويلة بين فارس وبيزنطة، وهو أمر أدى إلى إضعاف اقتصاد البلدين، وجعلت الحرب التجارة من الخليج والبحر الأحمر غير مأمونة (2).
ص: 141
1- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام (علیه السلام) / 298.
2- ينظر: علم الاجتماع والإسلام، بواين تيرنر / 50 - 58، دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ترجمة د. أبو بكر قادر، دار القلم بيروت، ط 1، 1987م.
ولم تكن مكة مركزًا تجاريًا عالميًا فحسب، بل كانت مركزًا ماليًا أيضًا، إذ " إِنَّ عمليات ماليَّة على درجة لا بأس بها من التعقيد، كانت تتم في مكة وكان زعماء مكة في زمن النبي محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) رجالَ مالٍ قبلَ كلِّ شيءٍ، مهرة في إدارة شؤون المال ذوي دهاء، وكانوا مهتمين بأيِّ مجال لاستثمار مربح لأموالهم من عدن إلى غزة أو دمشق، ولم يكن أهل مكة وحدهم الذين وقعوا في الشبكة الماليَّة التي نسجوها، ولكن أيضًا كثيرًا من كبار رجال القبائل العربيَّة المحيطة بها " (1)، وفي خضم ذلك بلغت اللغة العربيَّة ذروتها في الرقي والتَّطوّر، وبدأ تأثير اللغة الأدبيَّة واضحًا لا يجحده أحد في النفوس سلبًا ولا إيجابًا، فأصبح " لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، وما نعلم أحداً يحيط بجميعها غير نبي، ولكنها لا يذهب منها شيءٌ على عامتها لكيلا يكون موجودًا فيها " (2).
لم تعدّ الوحدات الوظيفيَّة الحقيقيَّة في المجتمع المكيّ هي القبيليَّة، بل ظهرت جماعات التجار الأثرياء وأسرهم ومن يعتمدون عليهم، أدى ذلك إلى حدوث اختلافات في المراكز الاجتماعيَّة، تزايد كذلك تقسيم العمل والاهتمام بالانجاز وتدهور الأخلاق التقليديَّة، ونمو الفرديَّة، كلُّ هذا أدى إلى خلق أوضاع اجتماعيَّة غير مستقرة، مهدت إلى ظهور مشكلات فقدان المعايير (Anomie) في مكة (3).
وفي خضم تلك الظروف ظهر الإسلام لا بوصفه علاجًا لظاهرة فقدان المعايير بل بوصفه نظامًا اجتماعيًّا متكاملَا، يحوي بنظمه وتشريعاته وتنظيماته سائر شؤون الحياة الإنسانيَّة، التي جاء الاقتصاد الإسلاميِّ ليعبر عن شبكة من الصلات والاقترانات مع سائر عناصر الإسلام الأُخر وخصائصها (4).1.
ص: 142
1- محمد في مكة، مونتجري وات / 52، ترجمة د. عبد الرحمن الشيخ وآخرون، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، 2002م.
2- مقدمة تهذيب اللغة، الأزهريّ (ت 370 ه)، تحقيق لجنة من المحققين، الدار المصريّة للتأليف والنشر، مطابع سجل العرب (د.ت).
3- ينظر: علم الاجتماع والإسلام/ 52.
4- ينظر: اقتصادنا / 296 - 301.
برزت معالم جديدة في الاقتصاد الإسلاميّ فرضت نفسها داخل النسيج الاجتماعيّ الإنسانيّ آنذاك، مثلت حجر الزاوية لأغلب الموارد الاقتصاديَّة فيها بعد نشوئها، وفي الوقت نفسه مثلت أصلًا من أصول الرؤية الإسلاميَّة للمجتمع الأنموذجيّ، ومن الطبيعيّ أن تتأثر هذه المفاهيم أو المعالم الجديدة بالمعطيات الاقتصاديَّة السائدة في المجتمع قبل ظهور الدعوة، أو للأقاليم قبيل فتحها، ولكنها تعدُّ جديدة في نظرنا؛ لأنَّها أصبحت تمثل أساسًا راسخًا من أسس نظرة شموليَّة متكاملة (1).
تلك المفاهيم الجديدة ممثلة في الغنيمة، والزكاة والصدقة، والخمس، والعشر والفيء، والجزية، والخراج، مثلت موارد (بيت المال)، أو بعبارة أُخرى: (خزانة الدولة)، وقد وضع الرسول محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) عمالًا تابعين لهذا البيت يمارسون أعمالًا مقسمةً عليهم، وإن كانت على نحو بسيط جدًا، حتى وصل الأمر إلى وضع عامل مراقب للأسواق لضبط عمليات البيع والشراء، وهو ما يعرف بنظام (الحسبة في الإسلام) (2).
ثم حدثت نقلة اقتصاديَّة واجتماعيَّة كبرى في حياة المسلمين، بلغت ذروتها إبان عصر الخلافة الإسلاميَّة، ولاسيما زمن الخليفة الثالث عثمان وما رافق ذلك من تحولات اقتصاديَّة خطرة، قوضت الكثير من البنى الماديَّة والمعنويَّة التي أسسها الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، تمثلت في قضية ممارسي الأنشطة الاقتصاديَّة الرئيسة، إذ فُتِح الباب على مصراعيه في عهد الخليفة عثمان أمام التجار القرشيين، لتسلم مناصب سياسية حساسة بجانب أنشطتها الاقتصادية، وهو أمر حمل الإمام عليّا (علیه السلام) في زمن خلافته أن ينحو منحى المواجهة لأنماط التنظيم الاقتصاديّ المنحرف، وإعادة إدارة الأنشطة الاقتصادية، وتنظيمها على وفق ما شرع الإسلام وما سنّه النبي الكريم م.
ص: 143
1- ينظر: المجتمع العربي الإسلاميّ، الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، د. الحبيب الجناحيّ / 17، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد ستمبر (319) - 2005م.
2- ينظر: الإدارة في الإسلام، المنهجيَّة والتطبيق والقواعد، د. فهمي خليفة الفهداويَّ / 99 - 100، دار المسيرة للنشر والطبع والتوزيع، عمان - الأردن، ط 2، 2001 م.
(صلی الله علیه و آله و سلم) فضلا عمّا يستجد من تنظيمات اقتصاديَّة تحاكي وتنسجم مع الأزمنة التي حكم فيها الإمام علي (علیه السلام).
لما كانت الثروة أحد المصادر الجاذبة والأكثر أهمية للأفراد والجماعات، بما توفره من حاجة اجتماعيَّة زيادة على الحاجات والغرائز التي لا تنتهي لدى الفرد، فقد نظر الإمام علي (علیه السلام) بمنهجيَّة عادلة، تحافظ على الثروة من استيلاء ذوي النفوس الضعيفة عليها، هذا من جانب، ومن جانب آخر إيجاد سُبل حقيقيَّة لإنشاء مجتمع تتوافر فيه العدالة التي تمنع نشوء إمبراطوريات صغيرة، تتحكم بمقدرات الغالبيَّة العظمى من الأفراد، فكان لا بُدَّ من صياغة خطاب اقتصاديّ يتولى تنظيم السياسة الاقتصاديَّة التي سبقت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حاول الإمام علي (علیه السلام) جاهداً وضع قواعد تنظيميَّة جديدة، تعتمد عليها التنظيمات الاقتصاديَّة كافة لسائر الأقاليم والولايات آنذاك (قاعدة بيت المال)، فكان بيت المال الركيزة الاقتصاديَّة والماليَّة التي انطلق منها (علیه السلام) في سياسته الاقتصاديَّة، فجعل وظيفة (بيت المال) جمع الأموال لتوزيعها لا لخزنها، وتولى مسؤولية الإشراف عليها بنفسه، يشاركه في الإشراف ولاة أو عمال الأمصار آنذاك، يقول الإمام (علیه السلام) مخاطبًا عامله عبد الله بن عباس: " ... فَارْبَعْ أَبَا الْعَبَّاسِ رَحِمَكَ اللَّهُ فِيمَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ وَ يَدِكَ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ، فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ؛ وَ كُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ، وَ لَا يَفِيلَنَّ رَأْيِي فِيكَ ... " (1).
لقد كانت السياسة الاقتصاديَّة للإمام (علیه السلام) تقوم على ضرورة إحداث تعدديَّة في مصادر الثروة، وعدم حصرها بأيدي بعض الناس، فوضع لذلك أنظمة وتعليمات أصدرها لولاته وعماله، لكي ينعم الناس - بغض النظر عن أيِّ شيءٍ بالحياة الكريمة.
إنَّ تعدديَّة مصادر الثروة تمثل إدراكًا واعيًا لضرورة ذلك في حياة المجتمع، وإنَّ أوّل ما سعى إليه الإمام (علیه السلام) عنايته بالزراعة والصناعة والتجارة، وأن لا يسعى الولاة إلى جمع الخراج من دون العناية بالثروة وتنميتها لكي يكون ذلك في خدمة 8.
ص: 144
1- نهج البلاغة، كتاب / 377/18.
المجتمع "وَلْيَکُنْ نَظَرُکَ فِي عِمَارَةِ الاَْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاَِنَّ ذَلِکَ لاَ يُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَکَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً ... " (1)، تأكيد أهمية صلاح الخراج، فإنَّه (علیه السلام) يوصي بمراعاة الأرض وعمارتها، ويعطي الأمر أولويَّة على جمع الضرائب (الموارد)، وهي مقاربة اقتصاديَّة لقاعدة عُرفت عند علماء أصول علم المال في عصرنا بقاعدة: (ليس للخراج أن يعرقل الإنتاج) وبقاعدة: (الإنفاق العام منوط بالمصلحة العامة)، أمّا القاعدة الأولى فمعناها ألّا يجدر بالحكومة أن تضع ضريبة تحول دون السعي والإنتاج، وتنقص ثمرات المساعي بتخريب الأرض الزراعيَّة وإهمالها، وأمّا القاعدة الثانية فتعني أَنَّهُ لا يصح أن ينفق المال من الدولة في غير المصالح العامة ذات المنافع المشتركة، ويتفرع عنه امتناع العطاء من غير عملٍ مقابلٍ داخل في الخدمة العموميَّة أو الإنفاق لمنفعة قومٍ دون آخرین (2).
أما عبارة: (وَمَنْ طَلَبَ الْحَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ، أَخْرَبَ الْبِلَادَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا) فيرى الفكيكيّ أنَّها تضم قاعدة ماليَّة اقتصاديَّة وإداريَّة مهمة تتقارب إنْ لم تنطبق على القاعدة الماليَّة الحديثة القائلة: (الحكومة ليست تاجرًا)، ومعنى ذلك أنَّ الحكومة لا تشتغل بالمشروعات بقصد الربح، بل لتوطيد منفعة عامة (3). بل إنَّ الفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ يذهب إلى أبعد من ذلك، حينما يوجب على الحكومة تخفيف الخراج في حالة نقص أو ضعف يعتري أرض المالكين، فالإمام (علیه السلام) لا ينظر إلى الدولة الإسلاميَّة على أنَّها مؤسسة جباية فحسب، وإنّما بوصفها مسؤولة عن عمارة البلاد وإصلاح العباد، لذلك يقول: " فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّة، أَوْ إِحَالَةَ أَرْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا.
ص: 145
1- نهج البلاغة، كتاب / 437/53.
2- ينظر: الراعي والرعية، توفيق الفكيكيّ / 181، المعرفة للنشر - والتوزيع المحدودة، ط3، بغداد، 1990م.
3- ينظر: نفسه / 182.
تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ؛ وَلاَ يَثْقُلَنَّ عَلَيْکَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْکَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِکَ وَتَزْيِينِ وِلاَيَتِکَ " (1).
وبذلك احتلت طبقة الزرّاع مكانةً مهمةً في الفكر الاجتماعيّ للإمام علي (علیه السلام)؛ لأنَّها تمثل أبرز مصادر الثروة في بيت المال، لأنَّ المرتبطين بالأرض يمثلون الأغلبيَّة العدديَّة للسكان (2).
شملت الموازنة بين الموارد والحاجات جميع طبقات المجتمع " فَمِنْهَا جُنُودُ اللهِ، وَمِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ، وَمِنْهَا عُمَّالُ الاِْنْصَافِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ، وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْکَنَةِ؛ وَکُلٌّ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي کِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً" (3).
إنَّ طبقات الحاجات تعتاش اقتصاديًّا على طبقات الموارد، على حدِّ قوله (علیه السلام): " فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَ زَيْنُ الْوُلاَةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الاَْمْنِ وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِهِمْ. ثُمَّ لاَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلاَّ بِمَا يُخْرِجُ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَيَکُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ. ثُمَّ لاَ قِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلاَّ بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْکُتَّابِ، لِمَا يُحْکِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الاُْمُورِ وَعَوَامِّهَا. وَلاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَيَکْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ. ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْکَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ. " (4).3.
ص: 146
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 437.
2- ينظر: الإمام علي بن أبي طالب، نظرة عصرية جديدة، محمد عمارة وآخرون / 37، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1974 م.
3- نهج البلاغة، كتاب / 35/ 432 - 433
4- نهج البلاغة، كتاب/ 53/ 433.
وللتجارة والصناعة نصيب في الفكر الاقتصاديّ العلويّ؛ لما تمثلان من رافد مؤثر في حركة المجتمع الاقتصاديَّة؛ لأنَّها تسدُّ الحاجات، وتهيئة المستلزمات الضروريَّة للبلدان الأُخرى والأماكن التي يرتادها هؤلاء التُّجَّار، يقول (علیه السلام) في ذلك: " ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَ يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِکَ. " (1)، نجد التجلي الواضح للأهمية الاقتصاديَّة للتجّار وذوي الصناعات، إذ جمعهما بخطابٍ واحدٍ، محددًا أصنافهم، ثم مبيّنًا علة الاستوصاء بهم خيرًا (ثم استوصي بالتُّجار وذوي الصناعات خيراً، المقيم منهم والمضطرب بماله، والمترفق بدنه)، فقد قسم (علیه السلام) الموصى بهم على ثلاثة أقسام: اثنان للتجّار وهما: المقيم والمضطرب (يعني المسافر)، وواحد لأرباب الصناعات وهو (المرتفق ببدنه) وعلة هذا الاستوصاء أنّهم (مواد المنافع ... من تلك الأمكنة) (2).
ظاهرةُ الاحتكارِ:
في الوقت الذي يوصي فيه خليفة المسلمين بهؤلاء خيراً فإِنَّهُ ينبَّه على ضرورة ألّا يحتكروا السلع والمنافع؛ لأنَّ ذلك مضر بالمصالح العليا للمجتمع، وهذا يمثل عيباً على الولاة في حالة عدم متابعتهم، لذلك وضع الحدَّ الذي يمنع من الاحتكار فيقول (علیه السلام): " وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ، أَنَّ فِي کَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَکُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ؛ فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْيِکَ إِيَّاهُ فَنَکِّلْ
ص: 147
1- نهج البلاغة / 439.
2- نفسه.
بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف. (1)، والاحتكار هو أن يقوم بعض التُّجَّار بتخزين السلع وإخفائها عن الناس إلى أيام محسوبة، تنقص فيها الأشياء ويزداد الطلب على البضائع، فيضطر المحتاج إلى دفع أثمان عالية لأجل الحصول عليها، ويؤدي إلى فساد العامة في تعاملهم. لذلك تطرَّق الإمام (علیه السلام) للاحتكار بيّن أضراره ونتائجه، وهو عمل غير أخلاقيّ، تنبذه المجتمعات، فالاحتكار يخلق بلبلة في صفوف المجتمع، ويؤدي إلى فساد العامة في تعاملهم: " وممّا اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أنّ احتكار الزرع التّحيُن أوقات الغلاء مشؤومٌ، وأنَّهُ يعودُ إلى فائدتِهِ بالتَّلف والخسران وسيبُهُ - والله أعلم - أنَّ الناس لحاجتهم إلى الأقوات - مُضطرُّون إلى ما يبذلُونه لها من المال اضطرارًا، فتبقى النفوسُ متعلقةً به، وفي تعلُّق النفوس بمالها سرٌّ كبيرٌ، فيه وباله على مَنْ يأخذُهُ مجانًا، ولعلهُ الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا وإنْ لم يكن مجانًا، فالنفوس متعلقة به لإعطائهِ ضرورة من غيرِ سعةٍ في العُذر، فهو كالمكره وما عدا الأقوات والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للناس إليها " (2).
إنَّ رعاية المجتمع وأفراده وعدم الإضرار بهم من مهام الحكومة في الإسلام، قال (علیه السلام): "وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ؛ فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَنَعَ مِنْهُ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف" (3).
فالإمام حينما يمنع الاحتكار لا يعني أن يدعو إلى مذهبٍ اشتراكيٍّ، ولا هدفه القضاء على أصحاب البيع والإنتاج وجعل السُّوق المحليَّة حكرًا على الدولة، يرى أنَّ حرية التّجارة والصّناعة في النظام الإسلاميّ ينظمها أصل وقيدان، فالأصل حرية التّجارة والصّناعة، والقيدان هما: (الحلُّ الشرعيّ، وعدم الإضرار بالجماعة) (4).7.
ص: 148
1- نهج البلاغة، كتاب/ 53/ 433.
2- مقدمة ابن خلدون 397/1.
3- نهج البلاغة، كتاب / 439/53.
4- النظام السياسيّ الإسلاميّ مقارناً بالدولة القانونيَّة، د. منير حميد البياتيّ / 137.
النظرةُ العامةُ للحرفِ والصناعاتِ:
كانت الصناعات والحرف في ذلك الزمان يدويَّة الصنع، بدائيَّة التركيب، تطوّرت نتيجة تطوّر الحضارة في المدن ورقيها، فاتسقت دائرة الطلبات على المواد المصنوعة والمنسوجة، فانتشرت دكاكين الصُّنَّاع، وأصبحت حاجة المجتمع لها ضروريَّة لتلبية،الحاجات فهم إذًا صنف من المجتمع مُتحرِّك ومُحرِّك، يتعلق بحياة المجتمع المدنيّ بالدرجة الأولى.
ثم هناك عدد من الحِرْف يحتقر الإنسان التعامل بها، وليس لها منزلة بين المجتمع، بحيث استمرت هذه النظرة وانتقلت إلى مجتمعاتنا، وأصبحت أعرافاً اجتماعيَّةً لم تنقرض إلّا قبل أربعة عقود تقريباً في بعض المجتمعات الإسلاميَّة، إنْ لم يكن بعضها مازال متداولًا في بعض المناطق القبيليَّة.
فالاحتقار الاجتماعيّ صفةٌ ذميمةٌ وبعيدةٌ كلُّ البُعدِ عن أصلِ الشريعةِ الإسلاميَّة، وهي مُتأتيَّة إما من عادات وأعراف قديمة، أو ممّا رُوِّجَ لها من رفض المساواة بين البشر، وربما كانت لتأثيرات الحضارة اليونانيَّة القديمة دور في ذلك، إذ كانوا في أثينا يعدّون أنواع المهن دنيئة (1)، وهكذا نجد في التاريخ القديم أنّ العرب قبل الإسلام احتقروا الصُّنَّاع أيضًا، ونظروا إليهم نظرة استخفاف واستهجان وكانت " الحرف أي العمل باليد من الأمور المستهجنة عند الأعراب، وعند أكثر العرب أيضًا، فلا يليق بالعربيّ الشريف الحرِّ أن يكون صانعًا، لأنَّ الصُّنعة من حرف العبيد والخدم والأعاجم والمستضعفين من الناس" (2)، وهو أمرٌ مستهجن مايزال عندنا اليوم أيضًا.
والفارق واضح بين مجتمع اليونان في أثينا والمجتمع العربيّ الجاهليّ في نظرةِ كلِّ منهما للحرف والصناعات، فاليونان احتقروا الصُّنَّاع والتُّجَّار وأصحاب المصارف في
ص: 149
1- ينظر: قصة الحضارة، ديورانت - ول وايريل م 4 / 62، ترجمة: محمد بدران، 1988م، بيروت.
2- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي 26/7، دار العلم للملايين، بيروت - 1971م.
آن واحد، ولم يُسمح لهم بالانتخاب، أما العرب قبل الإسلام فكانت تزدري الصُّنَّاع وأصحاب الحرف، أما التُّجَّار فكانت تنظر لهم نظرة سمو وعلو وتقدير، بل يمارس أغلبهم العمل فيها (1).
وربما كانت الظروف الطبيعيَّة في مكة سبباً في تفضيل التّجارة على غيرها من أنواع العمل؛ لأنَّها كانت بلداً تجاريَّاً، ولاسيما في المواسم الدينيَّة الكبرى، إذ تهرع الناس من كلِّ القبائل العربيَّة ومن كلَّ صوبٍ وحدبٍ؛ لأداء المراسيم الدينيَّة في الأشهر المعيَّنة من السنة، وهذا الأمر يتطلب بضائع جاهزة للبيع والشراء حتى لا يتأخر البدويّ في عودته إلى محله كان ذلك حافزًا للعمل في التجارة، ودافعًا لانتشار التجارة في المجتمع العربيّ.
وهناك من الحرف والصناعات ما زالت في مجتمعاتنا مُحتقرة، منها (الحائك) الذي لا يحظى بمنزلة اجتماعيَّة مقبولة، وربما سبب ذلك أمران، هما:
1 - عمله المستمر لساعاتٍ طويلةٍ مع النساءِ، وهذا يتطلب جلوسه في مجلسهن وبالهيأة نفسها، فيتطبع بطباعهُن، ويتكلم بكلامهُن.
2 - الكذب وعدم الالتزام بالموعد، وهذه صفة لا تكاد تنفك من أصحاب حرفة الحِياكة. لذا نسبوا قول أمير المؤمنين (علیه السلام) للأشعث بن قيس: (حائك ابن حائك) إلى هذا المعنى؛ لأنَّهُ من اليمن، والحِياكة هي مهنة أهل اليمن الرئيسة وهي مُحتقرة في نظر أهل مكة وشعابها. ويرى الباحث استحالة أن يكون مراد الإمام هنا هو احتقار مهنة الحياكة، والراجح أنَّهُ أراد بالحائك الذي يحوك المكائد والحيل، وهي صفة ورثها عن أبيه، إذ كيف للإمام أن ينهض بالمجتمع أخلاقيًا وهو يتكلم بلسان العامة، ويمارس ما يمارسونه.(2) 6.
ص: 150
1- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي (علیه السلام) / 262 - 263.
2- ينظر: بقية الآراء في المبحث الثاني من الفصل الثالث / 185 - 186.
وربما هناك سبب آخر لاحتقار العربيّ قبل الإسلام الحرف والصناعات، وهو استغناؤهُ عن الأعمال والحاجات التي تحتاج إلى فنٍ وممارسةٍ وخبرةٍ، فكلُّ ما يحتاج إليه يجده جاهزًا، فكان لا يرغب في تعلم المهن والصناعات التي تقيد حركته وتنقله في البوادي.
إنَّ احتقار العربيّ انذاك تلك الحرف انتجت تأخر الامة في الصناعات، فأصبحنا نعتمد على الشرق والغرب في الصناعة.
ولانتقال الحرف والصناعات من العراق وفارس والروم إلى الجزيرة العربيَّة، و عدم قبول العربيّ الأصيل تعلم هذه الحرف والمهن جعل أصحاب هذه الحرف والمهن يستخدمون العبيد والضعفاء والهاربين من بلدانهم، أما العرب فكانوا يعتزون بقبائلهم وأصولهم وأنسابهم التي تمتد إلى عدة اظهر من الأجداد، ومن ثم كان لتلك الأنساب أثرٌ في احتقار المهن والحرف، لاحتقارهم من لا أصل له ولا قبيلة تحميه، إذ كانت العصبيَّة القبيليَّة في أوجّها، ولأنَّ هؤلاء الصُّنَّاع كانوا من العبيد والمقطوعي الأصل، سرى ذلك الاحتقار إلى مهنهم أيضًا، فزداد ذلك الاستهجان، وتعمق في نفوسهم، فصار احتقار الحرف والمهن عرفًا اجتماعيًّا سائداً بين المجتمع (1).
ولما جاء الإسلام بمفاهيمه الإنسانيَّة، جعل من تلك الأفكار والظواهر المختلفة موضعًا للسخريَّة والرفض، وأعطت المفاهيم الجديدة للحياة الاجتماعيَّة ما رفع شأن العامل والصانع، فجعلت من العربيّ الذي يفضل قبيلته على كلِّ شيءٍ، إنسانًا يعتز بأسلافه وانتسابه إليه لا إلى غيره، فجاء قول الإمام (علیه السلام): " مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ" (2)، وذكر عن أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّهُ قال: " إني لأرى الرجل، فيعجبني، فأقول هل له حرفة؟ فإن قالوا: لا سقط من عيني" (3)، وهو في كلامه هذا (علیه السلام) قد قلب الموازين الطبقية، وأعطى الصُّنَّاع دفعًا معنويًّا وأصحاب الحرف، ثم جعلهم من 5.
ص: 151
1- ينظر: نهج البلاغة / 265.
2- نهج البلاغة، حكمة / 23/ 473.
3- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7 / 505.
ضمن اهتماماته في عهده لمالك الأشتر، فصنفهم من ضمن طبقات المجتمع، بيَّنَ صفاتهم وعلاقتهم بالسلطة، إذ قال: " فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِکَ" (1).
ثم تحوّل قسم من أبناء أصحاب الحرف والمهن إلى دراسة العلوم العقليَّة والنَّقليَّة واللغويَّة، وشاركوا مشاركة جادة في تطوير هذه العلوم، وأحسنوا العمل بها، فحازوا الحظوة عن الولاة والرضا من الناس، وكلُّ ذلك زاد من اهتمام المجتمع الجديد بالمهن والحرف.
وصفوة القول أَنَّهُ " لم يكن للعرب على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فنون وصناعات، وإنَّما اقتبسوا فنون ما بين النهرين ومصر - وسورية وبلاد فارس ونجد أنّ الخلفاء الأمويين كانوا يطلبون أساتذة الفن من جميع الولايات المفتوحة، ويستفيدون منهم في بناء المدن والقصور والمساجد، فكانوا يطلبون الأساتذة البيزنطيين في صناعة القاشانيّ والفسيفساء المعّرف لتجميل مساجد دمشق، وكانوا يجعلون عليهم أساتذة إيرانيين، وكانوا يستعملون لأبنية مكة صُنَّاعًا من مصر والقدس ودمشق، وكان ذلك مستمرًا حتى عهد العباسيين أيضًا " (2).
إذاً: فالتِّجَّارة والصِّنَّاعة صنوان لا يفترقان في تقدم العمران والمدنيَّة وإدارة البلاد اقتصاديًّا وسبباً رئيسًا في تطوِّر البلدان وتقدمها.
الزِّرَاعةُ والأَرضُ والزُّرَّاعُ:
لا تختلف الزِّرَّاعة عن الحرف والمهن الصِّنَّاعية عند عرب الجاهليَّة، الذين كانوا لا يهتمون بهذه المهن وإنتاجها، بل تكاد تبدو غريبة على بعضهم إلّا ما غُرِسَ من نخيلٍ وأشجارِ مثمرةٍ حول الواحات والينابيع، التي كان بعضها ينمو تلقائيّاً.
ومن العرب من كانوا يستخفُّون بتلك المهن ويعدّون السخرية بها من صفات الأصالة والسمو " وقد استقل الحواضر - وهم قلة - ما أنف منه أهل البادية – وهم
ص: 152
1- نهج البلاغة، كتاب / 439/53.
2- الإسلام وإيران، الشيخ مرتضى مطهريّ 17/3، ترجمة: هادي الغروي، 1985 م.
الأكثريَّة - في الجزيرة العربيَّة، فكان منهم الزُّرَّاع كأهل المدينة، والتُّجَّار كأهل مكة، غير أَنَّهُ بمعنى أشمل ظلّت كثير من المهن والحرف مزدراة يُعير بها أصحابها، فالتميميونكانوا يعيِّرون الازديين بأنَّهم بحَّارة؛ لأنَّ أبناء عمومتهم في عمان يشتغلون بالملاحة، والقرشيون كانوا يحتقرون أهل المدينة؛ لأنَّهم زرّاع ... وحين قُتِلَ أبو جهل في غزوة بدر، لم يأسف على مقتله بقدر ما أسف على انتهاء حياته بيد المسلم الأكار (الفلاح)، إذ يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: (فلو غير أكار قتلني) أراد احتقاره وانتقاصه " (1).
فلما جاء الإسلام بمبادئه الساميَّة أعطى الزراعة أهمية قصوى، ودعا إلى الاهتمام بالأراضي؛ لأنَّها مصدر الخير والبركة، وقوله (علیه السلام)خير دليل على ذلك: "مَنْ كانت له أرضٌ فليزرعها، فإنْ لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤجره إياها " (2).
لذلك وجه الإمام علي (علیه السلام) أنظار ولاته وعماله إلى مسألة عمارة الأرض والاهتمام بالفلاحين، بوصفهم فئة لها أثرٌ مباشر في حياة الدولة والمجتمع، لما يقدمونه من أموال خراجيَّة؛ ولأنّهم يؤمّنون الغذاء للأفراد، وعدَّ عمران البلاد وزراعتها مصدر قوَّتها فيها تحصل عليه من خراج هذه الأرضي.
قال الإمام (علیه السلام) لمالك الاشتر في هذا الشأن: " وَلْيَکُنْ نَظَرُکَ فِي عِمَارَةِ الاَْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِي اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاَِنَّ ذَلِکَ لاَ يُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَکَ الْعِبَادَ " (3).
أراد الإمام (علیه السلام) معالجة مشكلات المزارعين بتقديم الحلِّ الأنجعِ لعمارةِ الأراضي، ففي قوله لقرظة بن كعب الأنصاريّ في رسالة أرسلها إليه: " أما بعدُ فإنَّ رجالًا من أهل الذَّمَّةِ من عَمِلك ذَكروا أن نهرًا في أرضهم قَدْ عَفَا وأُدفن، وفيه لهم عمارةٌ 3.
ص: 153
1- في السياسة الشرعيَّة، د. عبد الله النفيس / 49، الكويت - 1984 م.
2- النظم الإسلاميَّة، نشأتها وتطورها، د. صبحي الصالح / 379، ط 6 - بيروت.
3- نهج البلاغة، كتاب 437/53.
على المسلمين، فانظُر أنتَ وهُمْ، ثم أعمُرْ وأصلح النهر، فلعمري لئنْ يَعمرُوا أَحَبُّ إلينا من أنْ يُخرجوا وأن يعجزوا أو يقصروا في واجب من صلاح البلاد والسلام " (1).
وهو هنا يُحيي أرضًا بإحياء نهر قد دفن ومحي أثره بفعل طمى أو غرين تجمع فيه، وعدّها الإمام أهم الواجبات لصلاح البلاد وعمرانها.
ويمكننا القول إنَّ الإمام (علیه السلام) تركّز اهتمامه الاقتصاديّ بمفهومين، هما:
احدهما: الحث على العمل، فقد جاء عنه: " ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم" (2) فالكسل عنده يؤدي إلى الفقر، لهذا يقول (علیه السلام): " إنَّ الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز، فتتبع بينها الفقر" (3)، وبالفقر لا يمكن بناء دولة مزدهرة اقتصاديًّا.
والأخر: عمارة البلاد، وجعلها إحدى الركائز الأربع المهمة في بناء اقتصاد سليم (4)، إذ " كانت من توصيات الإمام (علیه السلام) لمالك الأشتر أن نبههإلى العلاقة الماسة بين عمارة الأرض وجباية الخراج، وأنَّ عمارة الأرض أهم من جباية الخراج؛ لأنَّ الأرض إذا لم تكن عامرة فإنها لا تعطي خراجًا.
ومن هذا المنطلق أوصاه إذا حصل قحط أو ذائقة أن يسامح الزرّاع من دفع الخراج لذلك العام، حتى يظل معهم شيءٌ من المال يستطيعون به عمارة الأرض وزراعتها لتعطي الغلال التي يكون منها الخراج، وهذه نظرية عبقرية سبق بها الإمام (علیه السلام) جميع من سبقه ومَن جاء بعده في علم الاقتصاد" (5).8.
ص: 154
1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، م / 4 - 5 /29.
2- دعائم الإسلام، النعمان بن محمد التميميّ المغربيّ (ت 363 ه) 2 / 15، تحقيق: أصف بن علي، مصر - 1963 م.
3- أصول الكافيّ، الكلينيّ محمد بن يعقوب (ت 329 ه) 86/5، تحقيق: علي أكبر غفاريّ، ط 8، طهران، 1388 ه.
4- ينظر: عهده لمالك الاشتر في نهج البلاغة.
5- الاعجاز العلمي عند الإمام علي (علیه السلام)، د. لبيب بيضون/ 68.
المبحثُ الثاني / النظامان: (السِّياسيّ والقضائيّ)
النظامُ السِّياسيُّ:
تستندُ مسألة الحكم أو النظام السِّياسيّ إلى ما أقرّهُ الشَّرع الإسلاميّ ونظمه، إذ إنَّ للدين أهميةً كبرى في البنية الاجتماعيَّة، نظراً لما يقوم به من وضع القواعد والقوانين التي تنظم علاقة الأفراد بالمجتمع، التي من دونها لا يقوم تضامن كامل أو معاملة فاصلة بين الأفراد (1). ويعبر عن النظام السِّياسيّ في لغة الأدب بالخطاب السِّياسيّ الذي يُعدُّ شكلًا من أشكال التعبير عن الواقع (2)، بمعنى أنَّهُ صورة من صور التعبير عن طبيعة الواقع ووعي السلطة الحاكمة، فضلاً عن وعي الجماهير المحكومة وقناعاتهم بها، ومدى التواصلبين السلطة والجماهير بالخطاب السِّياسيّ، الذي يمثل جزءاً مهماً من الواقع الحي.
مثل الصراع على الحكم مزية واضحة في الدولة العربيَّة الإسلاميَّة، فالصر اعدائم بين الأُسر القرشيّة أو حتى بين الأُسر الهاشميَّة وبين هذه الأسر والأحزاب السياسيَّة كالخوارج، وكانت أحقية هذه الفئة أو تلك موضع جدل طويل تحوّل إلى شبه جدل عقيديّ، وما خطب نهج البلاغة التي تناقلتها الألسُن والمؤلفات إلّا مظهرٌ لغويٌّ رمزيٌّ للصراع، أو أنَّهُ الوجه الآخر للصراع العسكريّ بين تلك الأُسر التي مثلت طرفي الحق والباطل في ذلك الصراع. ثم اجتمع رأي الثائرين مع رأي كثير من الصحابة على تولية الإمام (علیه السلام) الخلافة، فرفض البيعة أوّل الأمر، وفي ذلك يقول ابن أبي الحديد " وسألوه بسط يده، فقبضها، فتداكوا عليه تداك الإبل الهيم على
ص: 155
1- ينظر: علم الاجتماع الدينيّ، د. أحمد الخشاب / 177، مكتبة القاهرة الحديثة، ط3، 1970م.
2- ينظر: تحليل الخطاب العربيّ، بحوث مختارة / 187.
وردها، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا، فلما رأى منهم ما رأى، سألهم أن تكون بيعته في المسجد ظاهرة للناس، وقال: إنْ كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر" (1). تُمثل هذه البيعة أوّل إصلاحٍ سياسيٍّ أحدثه الإمام، إذ أجمعت الأمة وفي أشرف مكان وهو المسجد على بيعته. جاء في نهج البلاغة وصف البيعة وحال المبايعين: "وَ بَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا؛ ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ وَ سَقَطَ الرِّدَاءُ وَ وُطِئَ الضَّعِيفُ؛ وَ بَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَ هَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ، وَ حَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكِعَاب. " (2) أي كشفت النساء عن وجوهها متوجهةً إلى البيعة.
إنَّ الخطاب السِّياسيّ الذي نراه في نصوص نهج البلاغة يمثل خطاب الخلافة بحق، لا خطاب (الفرد)؛ لأنَّ مصدره تلك البيعة العارمة التي عبرت عن رغبة الجماهير.
وبهذه البيعة حصل الإمام على السلطة الشرعيَّة، التي مثلت حجر الزاوية في البناء التنظيميّ للمجتمع. ونقصد بالسُّلطة الشرعيَّة وجود ضرب من الشَّرعيَّة (Legitimacy) يمنحها استقرارًا نسبيًّا ويحدد أبعادها، فالجماعة هنا على استعداد للطاعة؛ لأنَّ أعضاءها يؤمنون بأنّ مصدر الضبط مصدر شرعيّ، وهذه من المقاربات الاجتماعيَّة مع (نظرية ويبر - Weber) في التنظيم التي تستند استنادًا أساسيًّا إلى السُّلطة (Authority) التي قصد بها ويبر عمومًا أن تطيع جماعة من الناس الأوامر المحددة التي تصدر عن مصدر معيَّن (3)..
ص: 156
1- شرح نهج البلاغة 1/ 246.
2- نهج البلاغة، خطبة / 229/ 351.
3- ينظر: النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم، د. السيد محمد الحسينيّ / 46 - 47، دار المعارف - مصر، ط5، 1985م.
فالسُّلطة الشَّرعيَّة إذاً: تلك السُّلطة القادرة على فرض قراراتها بوصفها قرارات نافذة ومثبتة، وهي من جهة التفاعل والمسلك السُّلطة التي تكون توجهاتها موضع تأييد واستحسان من جانب أؤلئك الذين تخاطبهم. وفي قُبالة ذلك تعدُّ الطاعة والتأييد المتحمس من عوامل المشاركة في جعل السلطة واجبًا معنويًّا أو حقوقيًّا يربط بين المهيمن والمهيمن عليه، أو بين الحاكم والمحكوم (1).
صنف ويبر أنماط السُّلطة في ضوء التوجه القيميّ العام، الذي يجد تعبيره المثاليّ في إيمان الناس بشرعيَّة السلطة على ثلاثة أنماط هي:
1 - السُّلطة الروحيَّة المستندة إلى الإلهام charismatic، وترتكز على أُسس عظيمة على الولاء للبطولة والقداسة الخاصة أو الاستثنائيَّة أو المثاليَّة لأحد الأفراد أو الأنماط المعياريَّة أو النظام الذي يفرضه أو يرسم معالمه.
2 - السُّلطة التقليديَّة traditional، وتقوم على أسس كلاسيكية تعتمد على اعتقاد قائم في قداسة الأعراف والتقاليد القديمة ومشروعيَّة أولئك الذين يمارسون السُّلطة في ظلّها.
3 - السُّلطة القانونيَّة Legal، وتقوم على أسس معقولة أو رشيدة، تستند إلى الاعتقاد بشرعيَّة القواعد المعياريَّة، وأحقية أولئك الذين ارتقوا إلى مناصب السُّلطة في ظلِّ هذه القواعد ليصدروا الأوامر (2).
لقد تمثلت السُّلطة الملهمة بما حازه الإمام علي (علیه السلام) من سلطة قرابته الدمويَّة والنسبيَّة من الرسول (صلى الله عليه وآله سلم) فضلًا عن قربه الدائم منه، وشجاعته الواضحة في بدايات الدعوة الإسلاميَّة " وتدلُّ أخباره كما تدلُّ صفاته على قوّة جسميَّة.
ص: 157
1- ينظر: المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، د. خليل أحمد خليل / 122، دار الطليعة للنشر - التوزيع، بيروت، د. ت.
2- ينظر: سوسيولوجيا ماكس فيبر، جوليان فروند / 111 - 114، مركز الإنماء القوميّ، بيروت، د.ت.
بالغة في المكانة والصلابة والصبر على العوارض والآفات، فربما رفع الفارس بيده فجلد به الأرض، غير جاهد ولا حافل، ويمسك بذراع الرجل فكأنه يمسك بنفسه فلا يستطيع أن يتنفس، واشتهر عنه أنَّهُ لم يصارع أحداً إلّا صرعه، ولم يبارز أحدًا إلّا قتله، وقد يزحزح الحجر الضخم لا يزحزحه رجال ويحمل الباب الكبيرة يعيا بقلبه الأشداء، يصيح الصيحة فتخلع لها قلوب الشجعان" (1)، وهي انطباق واقعيّ ل (نظرية السمات - traits theory) التي ترى ظهور شخص ما بوصفه قائدًا واستمراره في القيادة على أساس توافر صفات شخصيَّة معينة موجودة فيه، تجعل الآخرين يقبلون أن يقودهم. وهذه الصفات تتعلق بالجوانب النفسيَّة والبدنيَّة والحسيَّة (2).
أما السُّلطة التَّقليديَّة فقد تمثلت عنده بقداسة الموروث الدينيّ عن الرسول محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) عندما أشار إلى أنَّ " الأئمة من قريش" (3).
أما النمط الثالث من الشَّرعيَّة (السُّلطة القانونيَّة) فقد تجسد بعملية (البيعة)، التي تمثل محور السُّلطة العقلانيَّة - القانونيَّة، على أساس حدوث عملية تعاقد اجتماعيّ حقيقيّ بين الحاكم والمحكوم عبر آلية البيعة (4) التي قال فيها: " لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً، وَلَيْسَ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِدًا. إِنِّي أُرِيدُكُمْ للَّهَ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنْفُسِكُمْ..
ص: 158
1- عبقرية الإمام علي (علیه السلام)، عباس محمود العقاد / 12، دار المعارف، مصر، ط 5، 1981م.
2- ينظر: القيادة والتنظيم، د. هوشیار معروف / 51، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط 1، 1992 م.
3- صحيح البخاريّ، كتاب الفرائض، م / 3، ج / 8، ص / 193.
4- ينظر: عملية استدماج أنواع السلطات الثلاث وشرعيتها مع السلطة التي حاز عليها الإمام علي (علیه السلام) وشرعيتها في كتاب: (الدين والسياسة - نظريات الحكم في الفكر السياسيّ الإسلاميّ)، مصطفی جعفر وآخرون 1/ 879، بحث منشور في مجلة المنهاج التابعة لمركز الغدير للدراسات الإسلاميَّة، بيروت، 2003م.
أَيُّهَا النَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ، حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً. " (1).
برز موقف الإمام السياسيّ بوصفه موقفًا (تفاعليًّا - سياسيًّا - اجتماعيًّا) في أحوالٍ حرجة، هي قضية الفتنة التي حدثت في زمن الخليفة الثالث جسد الإمام علي (علیه السلام) موقفه من الثائرين ومن مقتله "لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً، غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. وَ أَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ، اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ، وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ." (2).
هذا الموقف، عمومًا، يرتبط بمدخلين رئيسين، فُسِّرَت في ضوئهما مسألة القيادة هما:
1 - المدخل الموقفيّ: تبعًا ل (نظرية الموقفيًّة - situational their)، إذ يرى أصحاب هذه النظرية أنَّ صفات الشخص (سماته) ليس المحدد الوحيد لظهوره قائدًا، وأنّ الموقف والبيئة والمحيط والظروف الاجتماعيَّة هي الأكثر أهمية، وتشدد هذه النظرية على اختلاف الظروف والأحوال الاجتماعيَّة والتَّنظيميَّة لكلِّ مجموعة بشريَّة، وأنّ أي شخصٍ في جماعةٍ ما يمكن أن يكون قائداً في موقف معين أو حال معين.
2 - المدخل التفاعليّ تبعًا ل (نظرية التَّفاعليَّة - interactional theory) التي تعبر القيادة فيها عن محصلة شخصيَّة الفرد وتفاعلها الحركيّ مع المنظومة الاجتماعيَّة (3)..
ص: 159
1- نهج البلاغة، خطبة / 136/ 195.
2- نهج البلاغة، خطبة / 74/30.
3- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ، فكر الإمام علي ابن أبي طالب (علیه السلام) أنموذجّا / 90.
التخطيط يوضح المراحل التي مرَّ بها الإمام علي (علیه السلام) وصولاً إلى التنظيم الاجتماعيّ (1).
استندت سياسة الإمام علي (علیه السلام) في إعادة تنظيم المجتمع إلى أركان ثلاثة:
الركن الأول: قربه المعنويّ والحسيّ من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) طوال حياته الشريفة، ومن ثم تأثره بكلِّ شيءٍ من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، ومن ضمن ذلك سياسته التَّنظيميَّة وقيادته للمجتمع المسلم، وقد عبر الإمام عن ذلك الأثر بقوله: " وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَ أَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ يَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْ ءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ (صلی الله علیه وآله) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ 1
ص: 160
1- ينظر: نفسه / 81
وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ، وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالاقْتِدَاءِ بِهِ " (1).
الركن الثاني: مذهبة الاجتماعيّ، ويتكون من ثلاثة عناصر هي: (2)
1 - العقيدة: هي القاعدة المركزيَّة في التَّفكير الإسلاميّ، التي تحدد نظرة المسلم الرئيسة إلى الكون بنحوٍ عامٍ.
2 - المفاهيم التي تظهر وجهة نظر الإسلام في تغير الأشياء في ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة.
3 - العواطف والأحاسيس التي تبنَّى الإسلام تنميتها وبثها إلى صف تلك المفاهيم، وتمثل (التقوى) جوهر العناصر المذكورة آنفاً، إذ إنَّها تمثل المبدأ الرئيس في الإسلام من ناحية العبادة والتفاعل الاجتماعيّ على حدٍّ سواء (3) ونجد ذلك جليّاً واضحاً في سلوك الإمام الشخصيّ وفي سلوكه السِّياسيّ بوصفه (خليفة).
الركن الثالث: العلم والمعرفة، واصلهما عند الإمام (علیه السلام) من (القرآن والسنة) فإنَّهما كانا بمنزلة القواعد الأساسيَّة للاشتقاقات والبناءات العلميَّة والمعرفيَّة، على أنَّ تلك القواعد الأساسيَّة واشتقاقاتها كانت هي المسؤولة عن إجادة الإمام (علیه السلام) القضاء وشهرته به (4)، وصياغته للتنظيم القضائيّ المعروف، الذي أبدع فيه وأتقنه.
لقد حوّل الإمام (علیه السلام) علمه ومعرفته إلى واقع عملي، أي علم ومعرفة يعملان معًا، وعلى حدِّ تعبير أحد الباحثين: " كان علي بن أبي طالب يدعو إلى اتحاد العلم9.
ص: 161
1- نهج البلاغة، خطبة / 192/ 301.
2- ينظر: اقتصادنا 1/ 394.
3- ينظر: علم الاجتماع في ضوء المنهج الإسلاميّ، د. محمد البستانيّ / 116 - 118، ط1، 1335 ه - ش.
4- ينظر: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، جورج جرداق 1/ 99.
بالناس، والناس بالعلم سعياً من أجل بناء مجتمع متعلم واعٍ، قادرٍ على إدارة شؤونه بنفسه " (1).
جاء في وصيته (علیه السلام) لأولاده وأصحابه وسائر الناس بعد مطالبته إياهم بالتزام (التقوى) ومن ثم (نظم الأمور): " أُوصِيكُمَا وَجَميعَ وَلدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابي بتَقْوَى اللَّه وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ." (2). نقل الإمام وصيته من الخاص إلى العام حين قال: (ومن بلغه كتابي) ولم يترك المنهج الذي عمل عليه في خلافته، إنَّما كان سعيه دائمًا لكي يكون المجتمع على وفق ما أراده متآلفًا متحابًا، تسوده الطمأنينة والتسامح والتواصل، وإنّ هذا الانفتاح في الخطاب، إنَّما هو شعور من الإمام بضرورة العمل بالوصية في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، لأنَّهُ يشمل كلَّ جماعة، فضلًا عن صيغة الخطاب التي حملت بين طياتها عمقًا أخلاقيًّا يحتاج إليه كلُّ مجتمعٍ.
إنَّ مطالبته (علیه السلام) بالتقوى ونظم الأمور، لإقامة العدل الاجتماعيّ وتطبيقه في شتى مناحي الحياة آنذاك، التي عانت بعض فئاته الفقيرة والمحرومة كثيرًا من غياب العدالة التوزيعيّة disitrire butire justice للثروات والخدمات، بسبب غياب عنصري (التَّقوى والتَّنظيم)، أدى ذلك إلى عدم كفاية السِّياسات التوزيعيَّة وانحيازها لمصلحة فئة دون أُخرى في زمن الخليفة الثالث عثمان.
أوضح الإمام آلة الرئاسة بقوله (علیه السلام): " آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ " (3)، وهو كلام يرتبط ارتباطاً مباشرًا بهذا النصِّ، تمثل بتحويل النصِّ النظريّ الدستوريّ إلى واقع عمليّ: " فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ " (4)، فالرئيس يحتاج إلى الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة، ومنها.
ص: 162
1- علي بن أبي طالب سلطة الحق، عزيز السيد جاسم، مؤسسة الانتشار العربيّ / 204، بيروت، ط1، 1997.
2- نهج البلاغة، كتاب / 422/47.
3- نهج البلاغة، حكمة / 176/ 429.
4- نفسه، كتاب / 53/ 429.
(سعة الصدر) لإدارة شؤون المجتمع والدولة، فإنَّ الصفح عن خطايا الناس هو من الحلم، ويعطي القدرة على تحميل الأشياء التي لا تُلائم أحيانًا هوى النفس.
وقد أثبتت الدراسات الاجتماعيَّة والنَّفسيَّة الحديثة أنَّ تقويم المجتمع لا يكون إلّا على وفق متبنيات عقائديَّة تحمل سمات أخلاقيَّة واجتماعيَّة كمبادئ الإسلام، التي تكون أنجع في بناء المجتمع من العقاب المباشر قبل التوجيه ومراعاة الأحوال، والتجاوز عن السلبيات مع إسداء النصح والإرشاد في الوقت نفسه (1).
الصورة
تخطيط يوضح حقيقة أسس التنظيم السياسيّ وقواعده عند الإمام (علیه السلام) (2).
ص: 163
1- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي (علیه السلام) / 325.
2- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ، فكر الإمام علي ابن أبي طالب (علیه السلام) أنموذجا/ 89.
وإنَّ الإصلاح ينبغي أن يتوافق مع البناء التربويّ والتلويح بحكم القانون، فنلحَظُ الآن علماء النفس والاجتماع يؤكدون أهمية إصلاح الذات الإنسانيَّة وتربيتها، واستمرار العمل معها بمسيرتها، وعدم إطلاق العِنان للشر، لكي يتخذ له مكانًا في النفس الإنسانيَّة.
إنَّ سعة الصدر التي يتمتع بها الوالي أو الحاكم تعطيه مدى من الصبر لا يحتمله غیره، تضیق به صدور أعوانه والنواب عنه، فيتعيّن عليه أن يباشرها بنفسه، إذ قال (علیه السلام): " ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِکَ لاَ بُدَّ لَکَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا، مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِکَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ کُتَّابُکَ، وَمِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْکَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَانِکَ. وَأَمْضِ لِکُلِّ يَوْم عَمَلَهُ، فَإِنَّ لِکُلِّ يَوْم مَا فِيهِ " (1).
إنَّ عبارة: (وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ) التي افتتحها (علیه السلام) بفعلِ الأمرِ (أمضِ) فيها من التدبر والتفكر في عدم ضياع الوقت وتأجيل الأعمال.
ولما كانت البلاد الإسلاميَّة التي امتدت أطرافها إلى بلاد فارس والروم وما بعدهما، تضم في مملكتها قوميات متعددة وأجناسًا مختلفة، فإنَّ إدارة شؤون هؤلاء الخلق ليس بالأمر الهين الذي يمكن أن نجعله صورة كما لو أننا رسمناها في أوراقنا و كتبنا. بل من السَّذاجة العقليَّة تصور بساطة قيادة هذه الأمّة، إذ إنَّ هناك اختلافات سوسيولوجيَّة ونفسيَّة، وهناك العادات والتقاليد والأعراف والمراسيم وسواها وكلُّ تلك صهرها الدين الإسلاميّ في بوتقةٍ واحدة، وأعطى الحرية الكافية لتلك الشعوب بما لا يخالف المبدأ الأصليّ في الشريعة. وهذا الأمر الذي تَطَلَّب من الإمام الإحاطة بثقافات الشعوب الجديدة، ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم، لذا نراه يوجه عامله على مصر بقوله: " أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادِ ... " (2) لذا نرى التَّمازج بين تلك الشعوب ومبادئ الإسلام، التي تمثلت بإهمال الكثير من العادات والتقاليد التي تنافي مبادى 3
ص: 164
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 441.
2- نفسه، خطبة / 428/53
الإنسانيَّة، وحلت محلها روح الإسلام وعظمته، وخلقت منهم روحًا جهادية ثائرة فتحت البلدان الأُخرى.
لذلك أمر (علیه السلام) باللطف والمحبة في التعامل مع أفراد المجتمع " وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّة، وَالمَحَبَّة لهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ " (1).
لو تأملنا الخطاب السِّياسيّ للإمام (علیه السلام) بمجمله لا نجد الحرب هدفًا عنده، إنَّما الاجتماع والتعاون والتعايش السلميّ هو الهدف، والدفاع عن الدين وشرعيته ليست دعوة إلى الحرب وتأجيج نارها، إنَّما هي إصلاح واقع الهيكل الاجتماعيّ وتطبيق الشريعة ورسم الصورة للمسيرة البشريَّة في حياتها، فمن الآداب السّياسيَّة في حكم الإمام (علیه السلام) ما نجده من النصح والوصايا لواليه مالك الاشتر: "وَلاَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَيْهِ عَدُوُّکَ وَلِلَّهِ فِيهِ رِضًى، فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ وَأَمْناً لِبِلاَدِکَ، وَلَکِنِ الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّکَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، فَخُذْ بِالْحَزْمِ وَاتَّهِمْ فِي ذَلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ" (2) فالقبول بالدعوة إلى الصلح والسلم هي نابعة من حبِّ الإمام (علیه السلام) للحق والعدالة" وصاحب هذا التوجه في تاريخ العرب لا بُدَّ له أن يكون محباً للسلم، كارهًا للقتل إلّا إذا كان في القتال ضرورة اجتماعيَّة وإنسانيَّة" (3) خوفًا من غدر العدو، واستعداده، وإعادة تنظيم قواته وتشكيلاته العسكريَّة، والتسلح من جديد ليبادر بالضربة الأولى التي ربما تنهي الأمر، فقد يكون هذا العدو يستخدم صلحه غطاءً لعمل غادر كبير بعد أن يلتف غفلة ويستغل حال التراخي الموجود بفعل السلم، فجاء الخطاب السِّياسيّ بأسلوب التحذير بلفظه الصريح المكرر (الحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ ...) وتوكيد الغدر المحتمل (فإنّ العدو ربما قارب ليغفل).4.
ص: 165
1- نفسه
2- نفسه / 433
3- الإمام علي صوت العدالة الإنسانية 5 / 94.
وجب من هذا الصلح عقد اتفاقيَّة أو معاهدة مع الخصم، لذا وجب المضيّ في وصل منهاجه القويم في الحرب: " وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَکَ وَبَيْنَ عَدُوِّکَ عُقْدَةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّةً، فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَکَ بِالاَْمَانَةِ، وَاجْعَلْ نَفْسَکَ جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَيْتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمُشْرِکُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ؛ فَلاَ تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِکَ، وَلاَ تَخِيسَنَّ بِعَهْدِکَ، وَلاَ تَخْتِلَنَّ عَدُوَّکَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجْتَرِئُ عَلَى اللهِ إِلاَّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، وَحَرِيماً يَسْکُنُونَ إِلَى مَنَعَتِهِ، وَيَسْتَفِيضُونَ إِلَى جِوَارِهِ، فَلاَ إِدْغَالَ وَلاَ مُدَالَسَةَ وَلاَ خِدَاعَ فِيهِ. (1).
وفي علاقة السُلطة بالمجتمع يمثل الحاكمُ في فكر الإمام (علیه السلام) حارسًا والسُّلطةُ أمانةً، أي إنّ تجاوز الحاكم الحقوق يُعدُّ خيانةً للأمةِ: "وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ؛ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ ... " (2) ويشير مضمون النصّ إلياتصاف الوالي بصفة الأمانة من جهة، ويوجب على الحاكم ضرورة عدم استعماله الخونة وتكليفهم بأعمال؛ لأنَّ ذلك خيانة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله سلّم) صاحب الدعوة، وإنْ كان غائباً عن مسرح الحياة، إلَّا أَنَّهُ يعيش برسالته.
لغة المواثيق و الاتفاقيات:
تطرق الإمام (علیه السلام) إلى لغةِ المواثيق السِّياسيَّة والدبلوماسيَّة بعرفنا الحالي ضمن حالة الحرب والسلم والاتفاقات المتعلقة بها، إذ يقول: " وَلاَ تُعَوِّلَنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْل بَعْدَ التَّأْکِيدِ وَالتَّوْثِقَةِ، وَلاَ يَدْعُوَنَّکَ ضِيقُ أَمْر لَزِمَکَ فِيهِ عَهْدُ اللهِ، إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ
ص: 166
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 343 - 444.
2- نهج البلاغة، كتاب / 367/5.
الْحَقِّ؛ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَى ضِيقِ أَمْر تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ، خَيْرٌ مِنْ غَدْر تَخَافُ تَبِعَتَهُ، وَأَنْ تُحِيطَ بِکَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَةٌ، لاَ تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاکَ وَلاَ آخِرَتَکَ. " (1).
والنصُّ يبيَّن فقه (التَّعاهد والتَّعاقد)، فإذا تعلل المتعاقد لك بعلةٍ قد تطرأ على الكلام، وطلب شيئًا لا يوافق ما أكدته المعاهدة، وأخذت عليه المواثيق، فلا تعّول عليه، وكذلك لو رأيت ثقلًا في التزام العهد فلا تركن إلى لحن القول لتتخلص منه، فأخذ بصرح الوجوه لك وعليك (2).
هذه هي مفاهيم الإسلام العظيمة، فالأمانة والعهد والوفاء والصدق مفاهيم أكدها الإمام (علیه السلام) طريقًا لبناء المجتمع الصالح.
لقد أشار النصُّ إلى حقيقة في غاية الأهمية، هي: (التلاعب بمعاني الكلمات)؛ لأنَّ "القانون هو مهنة الكلمات " (3)، فحلُّ النزاعات المدنيَّة ومقاضاة الحالات الجنائيَّة والدفاع عنها تتم برمتها عبر وسيلة اللغة، ليس في تجسيده وتنفيذه بكون القانون مهنة الكلمات فقط، بل يحفظ القانون كذلك بكيفية ظاهرة بالتَّنظيم اللسانيّ للأنواع المختلفة من قبيل ما اللغات التي يمكن أن تكون متكلمة أو مكتوبة؟ وبوصف أي الملابسات؟ وما أنشطة الكلام المحظورة قانونيًا؟ لذلك حذر الإمام من التلاعب بالكلمات حين قال (علیه السلام): "وَلاَ تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّزُ فِيهِ الْعِلَلَ، وَلاَ تُعَوِّلَنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْل بَعْدَ التَّأْکِيدِ وَالتَّوْثِقَةِ" فقد نهى (علیه السلام) عن استخدام لحن القول ملاذًا للهرب من الالتزام بالمواثيق على وفق منهج إلهيّ، لو أنَّ البشريَّة سارت على هداه ومنهجه، لتجنبت السقوط والدمار والخراب العام في الحضارة، ومن ثم خسارة الإنسان لما بناه وبذله من جهد في سبيل الرقي والمدنيَّة بفعل نقض عهد أو تهور سلطان أو اعتداء أثيم، أو غزو في ليلة ظلماء وغير ذلك (4)، فالكلمة لا توضع كيفما اتفق لذا يجب أن تحترم.
ص: 167
1- نفسه، كتاب/ 444/53.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة، محمد عبدة 107/3.
3- دليل سوسيولسانيات / 897.
4- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي (علیه السلام)/ 331.
عبقرية اللغة وأحاسيس الناطقين بها؛ لأنَّ المصطلحات تستلزم معرفة لنظم الإشتقاق والنحت وحصر الجذور، وسواها كما تستلزم من المقننين أن يحسنوا استعمال الألفاظ، ولا سيما المولدة منها التي انتحلوها بفعل الوظيفة والاستعمال؛ لأنَّ قليلا من اللغات تتولى نقل الحادثة أو سن قانون بمفرداتها، في حين أنَّ كثيرًا من اللغات تقتصر على اقتراض هذه المفردات أو توليدها، وهذا هو السبب الرئيس في ظاهرة (التلاعب بمعاني الكلمات).
واليوم نرى الدول تكتب المواثيق بلغاتٍ مختلفة، وتسعى إلى استعمال أذكى السِّياسيين اللغويين في تثبيت النصوص وتدقيقها، فتكتب مثلّا المعاهدة بلسان البلدين وبلغة واضحة، ثم يضيفون لغة ثالثة عالمية يتفقون عليها، تُعدُّ مرجعًا أساسيًا في حال تباين التفسيرات في مواد الإتفاق، ويكتب ذلك في الملاحق القانونية للمعاهدة، ومع ذلك تظهر حالات التحايل والالتفاف والتلاعب بمعاني الكلمات، واستخدام التورية بحيث تحتمل الكلمة عدة معانِ، لغرض التهرب من الالتزامات التي وقعت عليها، ومنذ القدم حاولت الدول وضع القوانين والإفصاح عنها بالاستعمال اللغويّ الحسن كما انتصرت السُّلطة السّياسيِّة عبر الأزمنة لهذه اللغة أو تلك، واختارت تسيير الدولة وقوانينها بلغة بعينها (1).
إذًا الحرب ليست هدفاً بحد ذاتها، إنَّما هي وسيلة للدفاع عن الدين الإسلاميّ والحفاظ على الجماعة المسلمة من التشرذم والتفرق، لذلك يقول (علیه السلام) في تمادي طلحة والزبير في غيهما: " ... إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى سَخْطَةِ إِمَارَتِي، وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى فَيَالَةِ هَذَا الرَّأْيِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ " (2)..
ص: 168
1- ينظر: السياسات اللغوية / 7.
2- نهج البلاغة، خطبة / 245/ 169.
فهذا إمام الحق يدير الحرب والسلم معًا الحرب؛ لأنَّهُ مضطر إليها بعد أن أتم، الحجة فهي للدفاع عن الدين والسلم الذي تمثل بالصبر عليهم ما لم يفرقوا وحدة المسلمين بغيهم.
ثم نراه يوصي مالكًا بأن لا يتخذ البخيل مستشارًا له، بل يتخذ من ذوي الأخلاق الحميدة وأبناء البيوتات الصالحة وأهل العقل والرأي: " ... وَلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِکَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُکَ الْفَقْرَ، وَلاَ جَبَاناً يُضْعِفُکَ عَنِ الاُْمُورِ، وَلاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَکَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ؛ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى، يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ " (1).
كما يوصي أن لا يتخذ الوزراء الذين عملوا للشرار، لأنَّهم قد تلوثوا بالآثم والظلم، يقول (علیه السلام): " إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلاَْشْرَارِ قَبْلَکَ وَزِيراً، وَمَنْ شَرِکَهُمْ فِي الآْثَامِ فَلاَ يَکُونَنَّ لَکَ بِطَانَةً، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الاَْثَمَةِ، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ" (2)، هذا ما نراه سائدا في أغلب البلدان، وعلى مختلف العصور، فالإمام يحذر الحكام والولاة من هؤلاء الخاصة والبطانة الذين يلتفون حوله، ويخوضون في الأمور خوضاً من غير مشروعية لهم، ويؤكد مرة أُخرى شر هؤلاء بقوله (علیه السلام): " ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبِطَانَةً، فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّةُ إِنْصَاف فِي مُعَامَلَة؛ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ الاَْحْوَالِ. وَلاَ تُقْطِعَنَّ لاَِحَد مِنْ حَاشِيَتِکَ وَحَامَّتِکَ قَطِيعَةً، وَلاَ يَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَة، تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ، فِي شِرْب أَوْ عَمَل مُشْتَرَک، يَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَکُونَ مَهْنَأُ ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ، وَعَيْبُهُ عَلَيْکَ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ" (3).
والبطانة التي يقصدها الإمام (علیه السلام) هي الحاشية التي لا تشبع حتى تأكل راعيها وبلاده بأساليبها الملتويَّة والمحّرفة للحقائق وللكلم، والتي لا يسعدها أبدًا أن تصل 2.
ص: 169
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 431.
2- نفسه.
3- نفسه / 442.
حقيقة واحدة إلى الوالي، وتمنع اتصال الناس به، فهي تشكل سياجًا بشريًا حوله وتصُم أذانه بالضوضاء المفتعلة، والكذب والتصوير المعكوس، والتهويل أحيانًا، والتسكين أحيانًا أُخرى، وبما تقتضيه مصالحهم الخاصة، وإذا أمر الوالي يتباطؤون في سيرهم ثم يعكفون بعد أن يبعد نظر الوالي عنهم (1).
لذلك نهى الإمام (علیه السلام) ولاته من الاحتجاب، وأمرهم بأن يخالطوا الناس في مجالسهم ويسألون عن أحوالهم دون وساطة، لمنع البطانة من تزييف الحقائق، فهو ما زال يوصي: " فَلَا تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِك " (2).
يعزز هذا الخطاب السّياسيّ مضموناً سياسيّاً مهماً وهو مكاشفة الأمّة، إذ يقول (علیه السلام): "وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُکَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ، فَفِيمَ احْتِجَابُکَ مِنْ وَاجِبِ حَقّ تُعْطِيهِ، أَوْ فِعْل کَرِيم تُسْدِيهِ! أَوْ مُبْتَلًى بِالْمَنْعِ، فَمَا أَسْرَعَ کَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِکَ إِذَا أَيِسُوا مِنْ بَذْلِکَ! مَعَ أَنَّ أَکْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْکَ مِمَّا لاَ مَئُونَةَ فِيهِ عَلَيْکَ، مِنْ شَکَاةِ مَظْلِمَة، أَوْ طَلَبِ إِنْصَاف فِي مُعَامَلَة" (3).
إنَّ إنصاف الناس وردَّ الظلامة ترسم عدالتك في أذهان الرعيَّة، وإنَّ ذلك أجدى نفعاً وأقوى أثراً وأكثر ثواباً وأجزل عطاءً عند الله، " وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِکَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ، وَاعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ، فَإِنَّ فِي ذَلِکَ رِيَاضَةً مِنْکَ لِنَفْسِکَ، وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِکَ، وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ." (4).
وعلى الحاكم ألّا يكون محتكرًا للسلطة، إنّما عليه أنْ يعبر عن حاجته إلى الاستشارة، ذلك قال (علیه السلام): " ... أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ؛ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ 3.
ص: 170
1- ينظر: في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام علي (علیه السلام) / 308.
2- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 442.
3- نهج البلاغة، كتاب / 442/53.
4- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 443.
كَيْمَا تَعْلَمُوا. وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ ..." (1).
ومن الإصلاحات السِّياسيَّة في نظم الحكم تسويته (علیه السلام) العطاء بين الناس، إذ نراه يقول لمن عاتبه على ذلك: " أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً، [وَ] لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ. [ثُمَّ قَالَ] أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ، فَشَرُّ خَلِيلٍ وَ أَلْأَمُ خَدِين " (2)، إذ كان التوزيع في العطاء بين المهاجرين والأنصار بحسب درجة القرابة من الحاكم والأسبقيَّة في الإسلام، وهو خلاف ما سنَّهُ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، لذا بدأ بالتَّساؤل الإنكاريّ، لأنَّ ذلك يخالف منهج العدالة الذي سار عليه الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، فجاء جواب التساؤل المنفي مؤكدًا بالقسم، ثم يأتي النصُّ بفرضيَّة غير متحققة على صعيد الواقع، إلّا أنّ البنية الكبرى التي تنتج عن هذا التتابع الجمليّ وفي المفهوم العام عن سلوك الشخص القائل، ربما تصبح تلك الفرضيَّة مُمكنة التَّحقق، بناءً على المعطيات الفكريَّة للنصِّ وقائله، لأنَّ البنية الكلية للنصِّ هي موضوع المال وكيفية التصرف به فرديًا أو جماعيًا، شريطة مراعاة الجانب الدينيّ فضلًا عن الجانب الدنيويّ.
وممّا تقدم تبيّن أنَّ النظام السِّياسيّ في فكر الإمام مبنيّ أساسًا على مبدأ ربط السِّياسة بالدين، وتذكر مصادر التاريخ عن الإمام (علیه السلام) كلمات تجسد هذا المفهوم ومنها قوله (علیه السلام): " الملك سياسة، حسن السياسة قوام الرعية آفة الزعماء ضعف السياسة، رأس السياسة استعمال الرفق ... وسواها" (3) وعلى هذا فمن الطبيعيّ أن 7.
ص: 171
1- نهج البلاغة، خطبة / 80/34.
2- شرح نهج البلاغة 88/8.
3- غرر الحكم، الخوانساري 7/7.
نفهم من قول الإمام (علیه السلام) قوله: "من ساس نفسه أدرك السياسة " (1)، أنَّ السِّياسة تبدأ من الذات وتنطلق إلى المجتمع.
إنَّ الغاية من الخلافة عند الإمام (علیه السلام) بلا شك تكوين دولة الحق، وإقامة حكم الله في الأرض، ونشر العدالة والفضيلة، وقد بنى الإمام النظام السِّياسيّ على وفق ثلاثة محاور رئيسة، هي: اللين في حزمٍ، والاستقصاء في عدلٍ والإفضال في قصدٍ (2). ثم تبنى أفضل نماذج الحكم وهو العدل السِّياسيّ (3).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ مفهوم السياسة في الإسلام ليس فيه مبدأ: (الغاية تسوغ الوسيلة)، وإِنَّما خلاف ذلك، وهو مبدأ: (لا يُطاعُ اللهُ من حيث يُعصى) (4)، وهذا مبدأ علي (علیه السلام) في الحكم السِّياسيّ، إذ إنّ المبادئ ثابتة لا تتغير مع تغيّر المصالح.
ونجد الجاحظ قد أسهب في قول الإمام علي (علیه السلام): " وَالله مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي، وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ" (5)، مفيدًا أنَّ الإمام (علیه السلام) لا يستعمل في حربه إلّا ما وافق الكتاب والسُّنَّة، وأنَّ معاوية كان يستعمل خلاف ذلك من مكائد ومحرمات، في حين أنَّ الإمام علياً (علیه السلام) يقول: "لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ، وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِيبُوا مُعْوِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ... " (6)، ويقول الجاحظ: إنَّ عليًا (علیه السلام) كان ملجمًا بالورع عن جميع القول ولا يرضى إلّا ما يرضاه الله (7)..
ص: 172
1- عيون الحكم، الواسطيّ / 431.
2- ينظر: غرر الحكم 13/4/2، 236/7.
3- نفسه 138/7.
4- السَّياسة من واقع الإسلام، صادق الشِّيرازيّ / 23، بيروت، ط 4، 2003 م.
5- نهج البلاغة، خطبة / 200/ 319.
6- نفسه، کتاب / 374/14.
7- ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 10/ 129 - 288، ولم أجدها في مصنفات الجاحظ.
وبهذا فقد وازن الجاحظ بين نوعين من الحكم، هما:
1 - الحكم النَّفعيّ (الأمويّ).
2 - الحكم الإسلاميّ العادل (العلويّ).
فالذين نعتوا علياً (علیه السلام) بأنَّهُ شجاع، ولكنه لا علم له بالحرب والسِّياسة، وقعوا في وهم كبيرٍ، فقد مارس الحرب منذ الصغر ومارسها مع بلوغه الستين (1)، ولهذا يقول: "وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ، وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ ..." (2) ويضيف: ويقود ذلك إلى النار.
وبهذا يمتاز الحكم السِّياسيّ العلويّ بالثبات وعدم التغير، وأنَّهُ بُنيَ على أساس العدل والرحمة، والسماحة، ونشر الأمن، والشدّة مع الظالمين، بعيدًا من المكر والمداهاة والمخاتلة والخداع وهي قواعد عامة وأساسيَّة في الإسلام، جعلت حكومته لا كسرويَّة ولا قيصريَّة، وإنَّما هي إسلاميَّة، ونظام الحكم فيها مبني على الشورى لا على الاستبداد، وهي دستوريَّة لا كما في النظام الدستوريّ الحاليّ (برلمانيّ، أو مجلس تشريعيّ) بل إنَّها تقيد القائمين عليها بشروط القرآن والسُّنَّة وقواعدهما (3).
ولعل الإمام (علیه السلام) في كتابه للاشتر بيَّن دستوريًّا الخطوط الرئيسة للحكومة، لأَنَّهُ ولا هُبلادًا ذات سمات خاصة، وقد أمره بجباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها (4). وكأنه (علیه السلام) قد أجرى دراسة واقعيَّة مستفيضة لمفهوم الحكومة على أرضٍ وطئتها عدة حكومات متعاقبة.
وتمثل تلك الخطوط الرئيسة للحكومة الأصول العامة للحكم، التي لا يمكن أحداً أن يشرع فيها، لأنَّ الحكومة في الإسلام وفي النهج ليست ملكيَّة أو مستباحة، ر.
ص: 173
1- ينظر: شرح محمد عبدة 2/ 180.
2- نهج البلاغة، خطبة / 200/ 319.
3- ينظر: النظام السياسيّ في الإسلام، أحمد يعقوب/ 69.
4- ينظر: نهج البلاغة، عهده للاشتر.
وكذلك ليست ديمقراطيَّة، بمعنى أنَّ الشعب بممثليه المنتخبين يُشرع القوانين، وإنَّما إرادة الشعب في الإسلام مقيدة بحكم الله ورسوله، والشريعة صاحبة السلطان (1).
وهذا لا يعني غياب دور الشعب في تعيين الوالي أو الحاكم (البيعة)، فقد أكد الإمام (علیه السلام) ذلك بقوله: "وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا " (2).
إصلاح النظام السَّياسيّ عند الإمام (علیه السلام):
1 - التساوي في الحقوق، وقد تمثل ذلك في خطاباته لعماله كعمار بن ياسر، وابن التيهان من أنَّ العربيّ والقرشيّ والأنصاريّ والعجميّ وكلَّ من كان في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم سواء (3).
2 - إنَّ الحاكم ليس مشرعًا، وإنَّما هو منفذ لشريعة إلهيَّة، تجسدت بكتاب ثابتٍ النصِّ، وهو القرآن الكريم والأحاديث النّبويَّة الصحيحة المُفسِّرة للنصِّ القرآنيّ. 3 - تنظيم العلاقة بين الحكومة وأفراد المجتمع على أساسين، هما: الأخوة في الدين، والمماثلة في الإنسانية بقوله: " فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ " (4)، وهما صنفا المحكومين (الرَّعيَّة).
ص: 174
1- ينظر: الاتجاهات الفكرية للإمام علي، د. رحیم محمد سالم / 329، مركز الشهيدين الصدريين للدراسات البحوث، ط1، بغداد، 2007.
2- نهج البلاغة، كتاب / 6/ 368.
3- ينظر: الاختصاص، الشيخ المفيد (رض)/ 152.
4- نهج البلاغة، كتاب/ 53 / 428.
النظامُ القضائيّ:
حينما ظهر الإسلام لم تكن هناك مؤسسة قضائيَّة أو نظام قضائيّ، ولم تكن هناك تشريعات قضائيَّة واضحة المعالم متفق عليها عند العرب كافة، ولكن السائد كانتشريعات وأحكامًا قضائيَّة خاصة بالنظام القبليّ، الذي تدار بموجبها الخصومات والنزاعات بين الأفراد، وتستدر حقوقهم وتحدد واجباتهم.
وربما نجد أنَّ " هؤلاء الحكام لم يكونوا يحكمون بقانون مدوَّن، ولا قواعد معروفة، إنَّما يرجعون إلى أعرافهم وتقاليدهم التي كوَّنتها تجاربهم، ولم يكن للقانون الجاهليّ المؤسس على الأعراف والتقاليد جزاء، ولا المتخاصمون ملزمين بالتحاكم إليه والخضوع لحكمه، فإنْ تحاكموا إليه فيها وإلّا فلا ولو صدر الحكم أطاعه إنْ شاء، وإنْ لم يطعه فلا شيء أكثر من أنْ يحلَّ عليه غضب القبيلة " (1).
حينما جاء الإسلام تعرض لتلك التشريعات القبيليَّة، فأقرَّ بعضًا وأنكر بعضًا، إذ عدَّل الإسلام على سبيل المثال عددًا من تشريعات الجاهليَّة البسيطة مثل: الزواج والطلاق والمهر والخلع والايلاء، والغى نظام التبني المعروف، والغى الربا والملامة والمنابذة ... وسواها من التغيرات التي أحدثها في قواعد أو مرجعيات الحكم القضائي (2) تبعًا لما جاء في القرآن الكريم من تشريعات قضائيَّة وحقوقيَّة ولما جاء في السُّنَّة النَّبويَّة من أوامر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) وتقريراته وأقواله وسُننه الحياتيَّة التي وضعها للمجتمع الإسلاميّ.
ويرى أحمد أمين أنَّ أصول الإحكام تشريعات مدنيَّة، جاءت بعد بناء الدولة الإسلاميَّة في المدينة، وأنَّ أصول العقيدة كان من التشريعات المكيَّة، وهي سابقة لأصول الإحكام (3).
ص: 175
1- فجر الإسلام، أحمد أمين / 226، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط 1، 1996م.
2- ينظر: نفسه.
3- ينظر نفسه 228.
وضع الإسلام شروطًا للقاضي، هي (1):
1 - أنْ يكون رجلّا، وهذا الشرط يجمع: أ - البلوغب - الذكورة.
2 - أنْ يكون سليم العقل، ذكيًا يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل.
3 - أنْ يكون حرّا؛ لأنَّ ولاية العبد لا تصح ولمن فيه بقية رق، ويجوز أن يقضي إذا أُعتق.
4 - أنْ يكون سليم السمع والبصر، ليصح بهما إثبات الحقوق.
5 - أن يكون مسلمًا، فلا يجوز لغير المسلم أن يقضي بين المسلمين، وإنّما يقضي بين أهله ودينه.
6 - أنْ يكون عادلًا، صادقًا، أمينًا، عفيفًا عن المحارم، مأمونًا في الرضا.
7 - أنْ يكون عالماً بالأحكام الشرعيَّة، أصولها وفرعها.
وكان النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) يقضي بنفسه بين المسلمين، وكان يحكم بما أنزله الله عليه من الوحي (2)، وكان علي (علیه السلام) أكثر الصحابة قربًا من رسول الله وأكثرهم استيعابًا للرؤية القرآنية ولرؤية الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) لمسائل القضاة ومن ذلك كان الأبرز في هذا المجال، لأنَّهُ أحاط بالرؤى السالفة، فضلًا عن امتلاكه ملكة عقليَّة عاليَّة يجتهد بإحكام عقلية متوازنة كلما كانت القضية جديدة ولا سابق لها.
وأشار النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) والصحابة الأوائل إلى براعة الإمام علي (علیه السلام) ودقته في تولي القضاء، إصدار أحكام هي غايةٌ في الدقة وفي احتواء مسائل معقدة وجديدة، ولا سابق لها في المجال القضائيّ (3)..
ص: 176
1- ينظر: موسوعة الحضارة العربية العصر - الإسلاميّ، د. قصي - الحسينيّ 2/ 454 - 455، دار مكتبة العصر الهلال - بيروت، ط1، 2005م.
2- ينظر: موسوعة التاريخ الإسلاميّ، د. أحمد شبليّ 1/ 383، مكتبة النهضة المصرية، ط 1 1996 م.
3- ينظر: قضاء أمير المؤمنين، محمد باقر جعفر / 60، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1970م.
واتفق الرواة والمؤرخون والفقهاء على إشارة النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) إلى تمكن الإمام (علیه السلام) من القضاء ودرايته به، وجاءت هذهِ الإشارات بألفاظ وتعابير مختلفة منها: (أقضى أمتي علي، واقضاكم علي، واقضاهم علي) (1)، لذا نبع التنظيم القضائيّ في فكرِ الإمام (علیه السلام) من تجربته الشخصيَّة في ممارسة القضاء، تلك الممارسة التي لم يتخلَ عنها حتى بعد توليه أرفع المناصب السياسيَّة آنذاك (الخلافة)، حرصًا منه على رعاية حقوق الناس وإقامة العدل في المجتمع.
كان الإمام (علیه السلام) المستشار الأول والرئيس للقضايا والمسائل كافة،، التي تطرأ زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه (2).
تتجلى الخصائص والسمات القضائيَّة في فكر الإمام (علیه السلام) في كتاب لواليه على مصر، إذ ذكر ما يجب توافره من شروط وسمات في من يتولى القضاء بين الناس، فضلًا عن بيانا لعلاقة وتحديدها بين القضاة بالدولة الإسلاميَّة (الوالي وسائر الأركان الأُخرى)، فنراه يعهد لواليه على مصر - بمجموعة من المقاييس الواجب اتباعها في اختيار (القاضي)، ويمكن توضيحها على النحو الآتي:
1 - يولى القضاء من يجيد التعامل مع المواقف القضائيَّة الحرجة والدقيقة "مِنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ" (3).
2 - يولى القضاء " من لا تمحكه الخصوم" (4) أي تجعله مماحكّا أي تجعله لجوجًا (5)..
ص: 177
1- ينظر: قضايا أمير المؤمنين (علیه السلام)، أبو إسحاق الكوفيّ / 3 مؤسسة أمير المؤمنين، النجف الأشرف، د.ت.
2- ينظر: القضاء في الإسلام، د. عطية مصطفى مشرفة / 105، شركة الشرق الأوسط للطباعة، مصر، ط 1، 1966 م.
3- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 435.
4- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 435.
5- محك الرّجل، أي لجّ. ينظر: شرح نهج البلاغة 42/9.
3 - يولى القضاء من " لا يتمادى في الذلة" (1)، أي أن يتراجع في حال استشعار وجود خلل معيَّن في حكم أصدره أو سيصدره، فضلًا عن طريقة استجواب المتخاصمين التي قد يقع فيها بعض الخطأ أو الزلل. ويؤكد ذلك بعبارة أُخرى: "لا يَحْصَر من الفيء إلى الحق إذا عرفه" (2) والفيء هنا: الرجوع إلى الحق، وتفسير العبارة أي لا يعيا في المنطق.
4 - يولى القضاء من " لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع" (3)، والإشراف على شيءٍ الاطلاع عليه من فوق، فالطمع من سافلات الأمور، مَنْ نظر إليه وهو في أعلى منزلة النزاهة لحقته وصمة النقيصة، فما ظنُّك بمن هبط إليه وتناوله (4) تشير هذه العبارة إلى ظاهرة الرشوة في القضاء.
5 - ويتولى القضاء من " لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ" (5) هذه السمة بمنزلة الدعوة إلى التعمق والتأمل في القضية المطروحة، والدقة والعناية قبل إصدارِ حكمٍ معيَّنٍ، وهي إشارة إلى عدم التسرع بإطلاق الحكم حالما يخطر بباله الحكم القضائيّ للشكل المطروح.
6 - يتولى القضاء من كان " أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ " (6) وهي دعوة إلى التبصر في القضية التي تضم تفاصيل كثيرة ومتنوعة وبعناية شديدة، ولا سيما إذا تعذر الوقوف على وجه الحق فيها من الباطل، فيجب عليه الوقوف على القضاء حتى يرد الحادثة إلى أصل صحيح (7). 4.
ص: 178
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 435.
2- ينظر شرح نهج البلاغة 90/ 43.
3- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 435.
4- ينظر شرح نهج البلاغة 42/90.
5- نهج البلاغة، كتاب / 435/53.
6- نفسه.
7- ينظر: شرح محمد عبده 3/ 94.
7 - يتولى القضاء من يكون " آخَذَهُمْ بِالحُجَجِ " (1) أنْ يأخذ القاضي الحجج والبراهين من كلا الطرفين حتى يبني عليها حكمه العادل.
8 - يتولى القضاء من كان " أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ " (2) والتبرم: الضجر، وهذه الخصلة من محاسن ما شرطه (علیه السلام)، فإنَّ الضجر والتبرم والقلق قبيح، وأقبح ما يكون من القاضي.
في العبارة إشارة إلى سعة الصدر، التي اشرنا إليها آنفًا، والقاضي في المحكمة بمنزلة الرئيس، ويؤكد (علیه السلام) هذا المضمون بقوله التتابعيّ " أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ
الْأُمُورِ " (3).
9 - يتولى القضاء من " لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إغْرَاءُ " (4) أي لا يؤثر فيه المديح والثناء والإطراء والإغراء.
هذه الخصائص والسمات الواجب توافرها في القاضي متصلة ومتداخلة بعضها في بعض، لأنَّها تحدد الصفات النفسية لشخصية القاضي، فضلًا عن أنَّها تمثل بمجموعها تصرفات سلوكية متتابعة، يجب على القاضي إتباعها في أية قضية تطرح أمامه.
ويرى أحد الباحثين أنَّ الخصائص والسمات الواجب توافرها في القاضي والاتصاف بها مقاربة بنحوٍ كبيرٍ لأصول المحاكمات الحقوقيَّة المعاصرة، التي تحتم على القضاة مراعاتها والإلتزام بها في إدارة المحاكمة (5). م.
ص: 179
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 435.
2- نفسه/ 435 - 436.
3- نهج البلاغة، كتاب / 428/53.
4- نفسه / 428.
5- ينظر: الراعي والرعية، توفيق الفكيكيّ / 9 - 11، المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة، ط3، بغداد، 1990 م.
ويبدو من سياق العهد أنَّ الإمام أراد من ذكر صفات القاضي وسماته ليصحح مسار البنية الاجتماعيَّة عمومًا. والبنية القضائية بنحوٍ خاص؛ لأنَّ الشروط الواجب توافرها في القاضيلم تكن كافية في ردِّ المظالم إلى المظلومين، وربما وقع المحذور في القضاء كما وقع في بقية نظم البنية الاجتماعيَّة في عهد الخليفة الثالث.
ويكشف النصُّ المتقدم عن مهارة الإمام علي (علیه السلام) القضائيّة والتشريعيَّة، فهذه السمات بمنزلة الأُسس العامة في (فقه القضاة).
ثم يؤكد الإمام علي (علیه السلام) مسألةً في غاية الأهمية، وهو أنَّ الاجتهاد في القضايا التي لا سابق لها يجب أن يكون في ضوء التشريع الإلهيّ والسُّنَّة النَّبويَّة، لا من رأي القاضي، لذا رفض اختلاف القضاة في الحكم قائلًا: " تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ" (1).
تؤكد بنية النصِّ جانبًا اجتماعيًّا خطيرًا، يؤثر سلبًا في عملية التَّنظيم القضائيّ وفي عملية العدل الاجتماعيّ، إنَّهُ الاختلاف وعدم الوحدة في تتبع أمر القضاء ونصّه، وعدم الرجوع إلى منهله الأساسيّ وهو (القرآن الكريم والسُّنَّة الشريفة)؛ لأنَّهما معين الحكم القضائيّ أيّا كان.
وبأسلوب الاستفهام التعجبيّ يعللُّ الإمام اختلاف القضاة في القضية الواحدة: " أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - دِيناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه وآله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ» وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:.
ص: 180
1- نهج البلاغة، خطبة / 16/18.
وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً النساء / 17 " (1)، وفي النصِّ إشارة واضحة إلى مصدر التشريع القضائيّ في الإسلام والكون عمومًا، وهو الله سبحانه وتعالى.
وهذه التوجيهات والوصايا والأوامر والتعليلات والسمات تمثل بمجموعها ما يصطلح عليه اليوم بالمعايير الاجتماعيَّة - social norms - أو الضوابط الاجتماعيَّة - التّنظيميَّة، التي تنظم المجتمع عمومًا (2)، ومن ثم تحديد القواعد السلوكيَّة، التي تتعلق جميعها سوسيولوجيًّا - Rulesof behavior - بحماية التَّنظيم، ذلك أنُّها تحدد الطرائق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف وبلوغها (3).
على الرغم من ذكر الإمام خصائص القاضيّ وسماته إنَّهُ وضع بعد ذلك ثلاثة أركان أساسيَّة تمثل الأُسس الإداريَّة للتنظيم القضائيّ بين الحاكم السياسيّ (الوالي) والقضاة، وهي من إبداعات حكومة الإمام علي (علیه السلام):
الركن الأوّل: الرقابة:
أكد الإمام (علیه السلام) أهمية متابعة عمل القضاة ومراقبته للكشف عن مكامن الخلل والقصور، أو الفتور في تطبيق أحكام الشريعة، ولاسيما تلك الخاصة المتصلة بشؤون المعاملات اليوميَّة لحياة الناس وما يرتبط بها من سائر الشؤون الأُخرى، إذ قال: " ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ " (4) وتعاهد قضاء القاضي يعني تتبعه بالاستكشاف والتعرف، وهذا التعاهد يشير بنحوٍ عامٍ لمسألة (المراقبة)، التي تمثل أحد أعمدة الإدارة أو أية عملية تنظيميَّة معيَّنة (5).
ص: 181
1- نهج البلاغة، خطبة / 18، ص / 62.
2- ينظر: علم الاجتماع القانونيّ والضبط الاجتماعيّ، د. إبراهيم أبو الغار، ص / 193، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1984 م.
3- ينظر: علم الاجتماع الحضريّ ومشكلات التهجير والتغير والتنمية، د. قباري محمد إسماعيل، ص 256، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985م.
4- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 463.
5- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ/ 160.
فالرقابة إذًا هي عملية قياس لأداء المرؤوسين وتصحيحه للتثبت من أهداف التنظيم الإداريّ - أيّا كان - أنَّها قد نفذت، والالتزام بقواعده ومراسيمه القانونيَّة الموضوعة لمصلحة هذه الأهداف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الرقابة تظهر في الوقت نفسه شكلًا تنظيميًّا، يسعى للوصول إلى قدرته (1).
الركن الثاني: الاحصانة الاقتصادية:
أوصى الإمام (علیه السلام) عامله بأهم ناحية من نواحي إصلاح القضاء وترقيته، وذلك بترقية حال الحاكم (القاضي) وتأمين متطلبات العيش له ويكون ذلك بفرض العطاء الواسع له حتى يكون ما يأخذه كافياً لمعيشته و حفظ منزلته، ويتعفف به عن الرشاوى (2). قال (علیه السلام):" وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ" (3) وذلك لتحقيق توازن نفسيّ من إشباع حاجاته كافة، فضلًا عن درء المخاطر السِّلوكيَّة أو الانزلاقات الأخلاقيَّة التي يمكن أن يقع فيها، فينتج عن ذلك فساد إداريّ خطر، متمثلاً بقبض الرشاوى.
وتتجلى أهمية المكافآت والثوابات في أنَّها تحدث أثرًا واضحًا في السِّلوك التنظيميّ من حيث مشاركتها في تحقيق أداء فعال في العمل، وبذلك يرتفع المستوى الإنجازيّ للأفراد (أصحاب المناصب المختلفة). (4).
الركن الثالث: استقلال القضاء: يُعدُّ الإمام (علیه السلام) الأوّل من فصل بين السُّلطة القضائيَّة والسُّلطة التَّنفيذيَّة، إذ كانت السلطات الثلاث: (القضائيَّة والتَّنفيذيَّة والتَّشريعيَّة) موحدة غير منفصلة في عهد الإمام (علیه السلام)، لذا خطا خطوة مبدئيَّة،
ص: 182
1- ينظر: مبادئ الإدارة، تحليل للوظائف والمهمات الإداريَّة، هارولد كونتز وسيرل أو دويل 2 / 307 - 309، ترجمة: محمد فتحي عمر، مكتبة لندن ط 1، 1982 م.
2- ينظر: الراعي والرعيَّة / 18.
3- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 436.
4- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ / السلطة والثوابت والتواصل - شكلية التنظيم وفاعليَّة الاتصال، د. متعب مناف، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه في قسم الاجتماع - كلية الآداب، بغداد، 2004، 2005 م.
لإكساب القضاة حصانة، وتأمينهم من عقاب السُّلطة (1). إذ قال (علیه السلام): " وَأَعْطِهِ مِنَ المُنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ، لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ. فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرًا بَلِيغًا (2).
وتأسيسًا على ذلك ذهب الباحث جورج جرداق إلى القول: " وبهذا يكون عليٌ قد قضى على السبب الأوّل من أسباب انحراف القضاة، إذ خطا هذه الخطوة المبدئيَّة نحو فصل القضاة عن السُّلطة التَّنفيذيَّة، كي لا يتأثر القضاة بأصحابها " (3).
وفصل القضاء عن السُّلطة التَّنفيذيَّة هو من قوانين المدنيات الحديثة، لأنَّ فيه سببًا من أسباب التَّسويَّة بين البشر أمام قضاء يتولاه عالم ذو خلق كريم، متمتع بالحصانة.
أما الفكيكيّ، فقد ذهب إلى القول أنَّ: " الغرض المهم من استقلال المحاكم، الذي توخاه الإمام (علیه السلام) في وصيته لعامله هو التوثق من عدالة الأحكام وصيانة الحقوق، لأنَّ المحاكم لا تكون مرجعًا موثوقًا به عند الناس إلّا إذا كانت مصونة من التأثير والنفوذ " (4).
وفصل القضاء عن السُّلطة التَّنفيذيَّة هو عمل سياسيّ، لأنَّهُ عملية لإعادة بناء أسس جديدة للصلات أو التفاعلات التَّنظيميَّة بين السُّلطة والقانون، هذه القواعد والأُسس الجديدة تدور حول نقطة محوريَّة وهي: عزل هيبة السُّلطة السِّياسيَّة عن هيبة القانون والقضاء، كي تبقى همزة الوصل بينهما، تحقيقًا للعدالة الاجتماعيَّة بين أفراد المجتمع كافة، وبالمساواة والإنصاف، إذ لا فرق حينها بين رئيس ومرؤوس(5)..
ص: 183
1- ينظر: الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة 2 / 261.
2- نهج البلاغة، كتاب/ 436/53.
3- الإمام علي صوت العدالة الإنسانيَّة/ 2/ 261.
4- الراعي والرعيَّة / 22 - 23.
5- ينظر: تفصيل ذلك كله: في التَّنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ / 160 - 163.
يُعدُّ القانون من أقوى مظاهر عملية الضبط الاجتماعيّ (1)، غايته صيانة التَّنظيم الاجتماعيّ، والحرص على استقراره، وهو في نظر المجتمع عبارة عن (قاعدة اجباريَّة مفروضة على الإنسان من الخارج)، وهذا يعني أنَّ القوانين لا تعني الأشياء والممتلكات، بل تعني استعمال الناس هذه الأشياء والممتلكات.
وحصر (روس - Ross) (2) عملية الضبط الاجتماعيّ بما يمارسه المجتمع من نظم وعلاقات اجتماعيَّة للحفاظ على نظامه، تلك النظم والعلاقات التي يشير الخروج عليها إلى سخط الجماعة، ذلك السخط الذي يتدرج من مجرد السخرية والاحتقار حتى يصل إلى الجرح أو القتل (3).
ويرى (روس) أنَّ النظام في المجتمع ليس سلوكًا غريزيًّا أو تلقائيًّا، ولكنه ناجم عن عملية الضبط الاجتماعيّ ومتوقف عليها (4).
في حين كان الإمام علي (علیه السلام) حاله حال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يعتمد على الدين الإسلاميّ وتشريعاته في إحداث استقرار اجتماعيّ مرتكز على عملية الضبط الاجتماعيّ، إذ لم يكن سعيه بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على هيبة الدولة التي يديرها بقدر ما كان سعيه إلى الحفاظ على هيبة الشريعة الإسلاميَّة وقدسيتها، التي يخرج عليها الخارجون بشتى التصرفات والأفعال المنافيَّة لحكم الشريعة، وهو بهكذا فعل يقدم الدين وضوابطه على السُّلطة وممارساتها. ليؤسس تاريخ العرب السياسيّ الجديد، ه.
ص: 184
1- عملية الضبط الاجتماعيّ: هي الطريقة التي يتطابق فيها النظام الاجتماعيّ كله، ويحفظ، هيكله ثم كيفية وقوعه بصفة عامة كعامل للموازنة في حالات التغيير. (ينظر: المجتمع، ر.م ماكفير وشارلز بيدج / 2/ 273، ترجمة: علي أحمد عيسى، مكتبة النهضة المصريَّة، ط3، 1974م).
2- كان (روس) أول من استعمل مصطلح الضبط الاجتماعيّ social control ليميزه، بوصفه ميداناً متخصصًا بالدراسات الاجتماعيَّة. (ينظر: علم الاجتماع القانونيّ و الضبط الاجتماعيّ / 98)
3- ينظر: المدخل إلى علم الاجتماع، د. غريب أحمد وآخرون / 236، دار المعرفة الجامعيَّة الاسكندريَّة، ط 1، 1996 م.
4- ينظر: نفسه.
المتمثل بتقديم أهمية الشريعة على السُّلطة، وبذلك فقد أكَّد الإمام (علیه السلام) منع أنْ يكون الدين غطاءً أو مظلَّة للسلطة، وقد نوّهُ بهذا الأمر بقوله: " فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالهَوَى، وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنيا " (1)
ويبدو أنَّ هناك فكرة أُخرى تجاوز بها الإمام (علیه السلام) محاولته لإقامة القضاء العادل على وفق الشريعة الإسلاميَّة، إلى محاولة ربط هذا القضاء العادل بالعدل الاجتماعيّ عمومًا، للتخلص من مقومات السُّلوك المنحرف ودوافعه أيّا كان أو محاولة إضعافه.
تلك المقومات والدوافع التي تركّز في مسألة فقدان العدالة السُّياسيَّة، وفقدان التوزيع العادل للثروة، فضلًا عن فقدان الروح الأخلاقيَّة والتَّربويَّة في نفوس الولاة مثلما حصل في زمن الخليفة الثالث، وهذا ما دفع الإمام للقيام بعملية إصلاح اجتماعيّ عام عبر آليات تنظيميَّة متعددة، توخّى منها القضاء على أصول تلك المنابع الفاسدة والغريبة عن أصل الشريعة، فقد أثبتت الأبحاث السُّوسيولوجيَّة الحديثة أنَّ الحقيقة الأساسيَّة للدين ليست بوصفه ضرورة اجتماعية للضبط والتنظيم فحسب، بل في القوة الإلزامية التي يمتلكها الدين يمكن أن يستند إلى ما يعرف ب (الخوف الاجتماعيّ) كالخوف من غضب الإله وانتقامه، فتصبح الضوابط الدينيَّة قوّة إلزاميَّة (2). وهو ما أكده (روس) وبعض الباحثين العرب (3).
وضع الإمام علي (علیه السلام) جملة من القواعد القضائيَّة كي يستند إليها القضاء، وهي مستنبطة من الشريعة الإسلاميَّة، ومنها (4):
1 - على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين..
ص: 185
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 436.
2- ينظر:. 90.George Gurritch Sociology of Law London, 1953p
3- ينظر: دراسة المجتمع، د. مصطفى الخشاب / 232، وينظر: التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ، نضال عیسی رایف/ 168.
4- ينظر: التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ / 169.
2 - اليمين الغموس (الكاذبة) / مرفوضة شرعاً.
3 - شهادة الزور / مرفوضة شرعاً.
4 - كتمان الشهادة / مرفوض شرعًا.
وهذه القواعد الدينيَّة من شأنها أنْ تحقق عملية ضبط واستقرار وأمن اجتماعيّ.
أما فيما يخص الإجراءات القضائيَّة، التي استحدثها الإمام (علیه السلام) في حكومته، وعدّها ثوابت إجرائية لأي قضية كانت، تمثلت في ركنين جديدين:
الركن الأول: فصل الشهود بعضهم عن بعض.
الركن الآخر: تدوّين شهاداتهم على إنفراد.
ويروى أنَّ سبب هذا الفصل بين الشهود هو أنَّ شاباً شكا نفرًا إلى الإمام فقال:
" إنّ هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر، فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك شيئاً! وكان معه مال كثير، فترافعنا إلى شريح القاضي، فاستحلفهم وخلى سبيلهم، فدعا عليٌ بالشَرَطِ (الشرطة) فوكل بكلِّ رجل رجلين وأوصاهم ألّا يمكنوا بعضهم من أنْ يدنوا من بعض، ولا يسمحوا لأحدٍ أن يكلمهم، ودعا كاتبه، أحدهم، فقال: أخبرني عن أبي هذا الفتى، أي يوم خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأيّ علةٍ مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمّن غسله ودفنه؟ ومن تولى الصلاة عليه؟ وأين دفن؟ ونحو ذلك، والكاتب يكتب، ثم دعا الآخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، فسأله كما سأل صاحبه، ثم الآخر، وهكذا حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كلَّ واحد منهم يخبر بغير ما أخبر به صاحبه، فضيق عليهم فأقرّوا بالقصة، فأغرمهم المال، وأفاد منهم القتل " (1).
في النصِّ المتقدم إشارة إلى ركن أساسيّ من أركان العمل القضائيّ هو: مسألة العقوبات أو الجزاء، أو ما يسمى في الشريعة ب (الحدود) 8.
ص: 186
1- القضاء في الإسلام / 107 - 108.
وإقامة الحدود لا تتنافى مع الإخلاص للنظام الاجتماعيّ، والثقة بتحقيق أهدافه، فهو اصطلاح اجتماعيّ نافع يؤدي وظيفة اجتماعية، تعبر عن ظاهرة القهر والإرغام الذي يمارسه المجتمع إزاء العابثين بنظمه، والخارجين على قواعده بفعل القانون.
وعلى وفق ما تقدم تتضح معالم الشدّة والصرامة في تنفيذ العقوبة، التي غالبًا ما يكون الهدف منها تحقيق ضبط اجتماعيّ يسود المجتمع، ولاسيما أنَّ الإمام (علیه السلام) غالبًا ما ينفذ العقوبات بنفسه مع أنَّهُ يمثل أعلى سلطة في المجتمع، خليفة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وهذا ينطبق على دراسة (دور كايم) للضبط الاجتماعيّ الملازم لمجتمع الضبط الميكانيكيّ، إذ تطبق العقوبة فيه من السلطة المركزية وبنحوٍ حازمٍ وصارمٍ، إذ ركزَّ (دوركايم) في دور الدولة المستقلة، بوصفه عاملًا في تطور العقوبات، فشدّة العقوبة وقسوتها تصبح أكثر فاعليَّة وتأثيرًا كلما كانت السُّلطة المركزيَّة في وضع أقوى (1).
ومن القضايا المهمة في النظام القضائيّ عند الإمام (علیه السلام) هو تنفيذ الحدود والديات على المسلم والحرِّ والعبد على وفق الشريعة جاء عن الاصبغ بن نباتة أنَّهُ حضر عمر بن الخطاب خمسة نفر أخذوا في زنا، فأمر أنْ يقام على كلَّ رجل منهم الحدُّ، وكان قد حضر أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال له: ليس هكذا حكمهم، فقال له عمر: " فأقم الحكم عليهم. قال: فقدَّم أمير المؤمنين (علیه السلام) واحداً منهم فساره ثم ضرب عنقه، وقدم الثاني فساره، ثم رجمه، وقدم الثالث فساره، ثم ضربه الحدّ كاملًا، وقدم الرابع فساره ثم ضربه نصف الحدّ، وقدم الخامس فساره، ثم عزره وأطلقه. فعجب الناس لذلك وتحير عمر وقال: يا أبا الحسن في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة أحكام مختلفة؟ فقال (علیه السلام): نعم، أما الأول فذمي، فالحكم فيه بالسيف، والآخر محصن زنى فرجمناه، والآخر غير محصن زني.
ص: 187
1- ينظر: علم الاجتماع القانونيّ والضبط الاجتماعيّ، د. إبراهيم أبو الغار/ 161.
فحددناه، والآخر عبد زنی فضربناه نصف الحدّ، والآخر مجنون مغلوب على عقله عزرناه" (1).
والرواية كاشفة عن القسوة الكامنة في العقوبة، وتناسب العقوبة مع الموقف والمركز الاجتماعيّ للفرد المقبل على الجريمة والانحراف، وكلّ بحسب موقعه وحجم خطئه، فمنهم ذلك الذميّ والمحصن وغير المحصن والعبد والمجنون على أنَّ تلك العقوبات ما هي إلّا حياة للأفراد والمجتمعات، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (2).
ص: 188
1- قضايا أمير المؤمنين، أبو إسحاق الكوفيّ/ 116.
2- البقرة، آية 179.
المبحثُ الثالثُ / التَّصنيفاتُ الاجتماعيِّةُ
أوّلاً: التصنيفُ الطبقيُّ
لا نعرف متى دخلت فكرة الطبقة، بوصفها وحدة اجتماعيَّة كبيرة، وذات مدى رحب، في تركيب المجتمع الإنسانيّ، ففي تاريخ الإنسان المكتوب لا نجد حضارة تألقت ثم أنطفأت إلّا وكانت تعرف فكرة،الطبقات، وكان لهذهِ الفكرة واقع عيانيّ يضرب بجذوره عميقًا في التَّنظيم الاجتماعيّ، وهذا يعني في ظاهر الحال، أنَّهُ لم يمر على البشريَّة وقت طويل لم تعرف فيه فكرة الطبقات. (1)
فالطبقة إذًا ظاهرة اجتماعيَّة عرفتها جميع الشعوب، بدائيَّة كانت أم متحضرة، وأيّا كان الحديث عن مساوئ التَّوزيع الطبقيّ، وعن بعده من العدالة الاجتماعيَّة، التي تطالب بها الديمقراطيات الحديثة، فالطبقة تبقى وتستمر، بل " إِنَّ وضوح حقيقة الطبقات يزداد في حياتنا الجارية، فالمرء يولد في طبقة معيَّنة، ويختلط بأفراد من الطبقة التي ينتمي إليها، ويختار زوجته - عادة - من محيطة وطبقته، وقد يرتفع المرء إلى طبقة أعلى أو يهبط إلى طبقة أدنى، فهناك الواصلون حديثاً (hes parvenus) وهناك من لفظتهم طبقتهم ... ومصير كلِّ فردٍ يرتبط إلى حدِّ كبيرٍ بمصير الطبقة التي ينتمي إليها " (2).
ص: 189
1- ينظر: دراسات في نهج البلاغة / 27.
2- طبقات المجتمع، اندرية جوسان / 15، ترجمة: الدكتور محمد بدوي، دار سعادة - مصر.
وفي التَّقسيم العلميّ للمجتمعات يميز تونيز (1855 - 1936 Tonnie) (1) بين شكلين مهمين، هما: الوحدات الاجتماعيَّة البسيطة (communantes)، والمجتمع المركب (societe).
فالوحدة هي شكل الحياة الجماعيَّة، القائم على الإرادة الطبيعيّة العفويَّة، تظهر نماذجه الأولى في وحدة الدم وعلاقات القرابة ثم وحدة الأرض والتجاور، وتصل أخيرًا إلى وحدة الفكر والعقليَّة أو المذهب والمعتقد. أما المجتمع؛ فهو يقوم على إرادة الاختيار، وهي إرادة مصطنعة، وتنطلق العلاقات فيها من مبدأ: (كلٌّ لنفسِهِ) ونموذجه مجتمع العقد التَّوافقيّ (contractuelle) والمجتمع الصِّناعيّ على الخصوص (2).
ويضيف العالم هانز فرایر (hansfrayer) (3) تفاصيل أُخرى إلى هذا التَّقسيم فالوحدة الاجتماعيَّة هي الشكل البدائيّ للحالة الاجتماعيَّة، إذ كل شيءٍ مشترك من الملكيات غير الماديَّة كالأساطير والعادات والتقاليد والطباع، وكذلك الملكيات الماديَّة من أدوات وتقنيات، كلُّ ذلك مشترك بين أعضاء الجماعة التي تشكل (نحن) غير قابل للتقسيم، هذا ما نجده في الأُسرة والشعب.
أما المجتمع فهو مكون من جماعات غير متشابهة يجمعها رابط الايديولوجيَّة، وهي تمثل حبكة من المصالح، وقد يكون الرابط الأساس بينها مجرد السيطرة من جهة والخضوع من جهة أُخرى..
ص: 190
1- ينظر: مدخل الى علم اجتماع الادب / د. سعد ضاويّ/56.
2- I bld Tome IIIp 670 voir Gavilier Tome I.p 144.
3- ينظر: علم اجتماع الأدب/ 56.
ویری (مارسل موسی 1872 - 1950 marcel mauss) أنَّ هناك تطورًا متدرجًا للتصنيفات الاجتماعيَّة منذ المجتمعات البدائيَّة، وحتى الآن، تتمثل في وقتنا الحاليّ بتعدد الطبقات الاجتماعيَّة وتعقيدها (1).
ويرى (لوسو إي نويز) أنَّ كلَّ مجتمع إنسانيِّ مقسم على طبقات، فالتصنيف ما بين طبقة نبلاء إكليروس وعبيد وعامة موجود في جميع المجتمعات البدائيَّة، أما في المجتمعات المتحضرة، التي شهدت التَّطوّر الواسع، فقد انتهى التَّقسيم على ثلاث طبقات: الطبقة العليا، والطبقة الوسطى، والطبقة الدنيا، وهذه الطبقات موجودة بنحوٍ واقعيٍّ لا يقبل الجدل في العالم الحديث (2).
ويرى أصحاب النظرية الوظيفيَّة أنَّ الطبقات ناجمة من تفاوت في توزيع مردود الحياة الاجتماعيَّة، يلجأ إليه المجتمع لتأمين القيام بجميع وظائفه، وذلك أنَّ الواقع والأدوار ليست جميعها محبوبة ومرغوب فيها، فكيف يستطيع المجتمع إغراء بعض الأفراد بتحمل المسؤوليات الصعبة، وقبول الأدوار المزعجة؟ ولكي تحلّ المشكلة بصورة فضلى، ينبغي لها أنْ تعود المكافآت العالية إلى المراكز المهمة في حياة الجماعة التي تتطلب الكفايات الكبرى (3).
واليوم أصبحت الطبقة مؤسسة اجتماعيَّة ضخمة، تمدها بالغذاء تقاليد عرقيَّة، تقوم على جذور موغلة في أعماق الماضي.
واختلفت آراء العلماء في أسباب التمايز بين الطبقات، وعَزَوها إجمالًا إلى أربعة أسباب هي: (الثروة، والمهنة، ونوع الحياة، والتربية) (4).
ص: 191
1- ينظر: نفسه / 57.
2- ينظر: LULIO MNDIETA YNUNE 2 THEORIEDES GROUES SOCIAUX P. 115
3- ينظر: PAVIS ET MOORE DICT MARA BOUT: SOCIOLOGIE TOME P 617
4- ينظر: طبقات المجتمع، اندرية جوسان / 16.
ويعود سبب ذلك إلى اختلاف النظر في الطبقة بوصفها مؤسسة اجتماعية، فتارةً ينظر إلى الطبقة على أنَّها تقوم بدور معين في العمليات الاجتماعيَّة، وتقدم خدمات معينة إلى المجتمع.
وأُخرى ينظر إليها بوصفها كتلة بشريَّة ذات مستوى (ماديّ) اقتصاديّ واحد، وذات مزاج نفسيّ وعقليّ خاص، يوحد بين مفاهيم أفرادها في مختلف الأذواق والطّباع والعادات.
والضابط الحقيقيّ لأي تقسيم أو تصنيف اجتماعيّ يتأتى من زاوية القيمة العليا للحياة في ذلك المجتمع، ذلك لأنَّ أي حكم تقويميّ إنّما حدث بسبب هذه القيمة العليا، فنرى أنَّهُ كلما قرب المرء من هذه القيمة، وشارك فيها وزاد في تأكيدها، واكتسب خصائصها، ارتفعت قيمته وعلت منزلته وباخلاف نراه كلما بعد عنها ولم يشارك إلّا بقسط ضئيل فيها، أو لم يشارك فيها قط، هبط في المنزلة الاجتماعيَّة (1).
فتارةً تكون القيمة العليا في المجتمع الفضيلة، فيكون الإنسان فاضلًا، رحيمًا بالضعفاء، باذلًا لهم المعونة دون أمل في تلقي الجزاء الدنيويّ ساعيًا في خدمة النوع، مؤثرًا لذلك في مصالحه الخاصة، مدافعًا عن الحق أيّا كان صاحبه محاربًا الباطل في جميع أشكاله وألوانه، شاعرًا بمسؤوليته بوصفه إنسانًا، وحينئذ يرقى إلى القيمة كلُّ من استطاع أن يجعل من نفسه مثلًا أعلى للفضيلة ويحتل المرتبة السفلى من المجتمع أولئك الذين لا فضيلة لهم أو الذين يستمسكون بالفضيلة استمساكًا واهيّا، وما بينهما تتفاوت المراتب الاجتماعيَّة، وهذا المجتمع لا يأخذ صفة الصراع المتمثل في استغلال الطبقات العليا للطبقات السفلى، وإنَّما تنظر الطبقات السفلى إلى العليا نظرة حبِّ ورحمةٍ وإكبارٍ؛ لأنَّها ترى فيهم رسل إصلاح ضحوا بمصالحهم في سبيل مصالح الجميع.
وقد تكون القيمة العليا للحياة هي الاقتصاد (النجاح الماديّ) القائم على اكتناز الأموال وتراكم العقارات، وحينئذ تتحدد المراتب الاجتماعيَّة على هذا الأساس، فيرتفع إلى 9.
ص: 192
1- ينظر: دراسات في نهج البلاغة/ 309.
القمة أولئك الأغنياء الكبار، ملوك المال والأعمال، ويقبع في الحضيض أولئك الذين لا يملكون شيئًا أو يملكون شيئًا قليلًا، ولكن التفاوت الطبقيّ يأخذ صفة الصراع، لأنَّ ما سببّ الانقسام الطبقيّ (الاقتصاد) هو مصدر القيمة العليا في المجتمع، ومن هنا ينشأ عند الطبقات السفلى شعور بالاستغلال، ويواكب هذا الشعور شعور آخر يُولد في أنفسهم مشاعر الحقد والبغضاء، ويدفع بهم أحيانًا إلى الخيانة والإجرام (1).
إنَّنا لا ننكر وجود الطبقات الاجتماعيَّة القائمة على أساس اقتصاديّ أو مهنيّ أو عليهما معًا في المجتمع الإسلاميّ، فلا بُدّ لأيِّ مجتمع أنْ يوجد فيه تصنيف مهنيّ يقوم بسدِّ حاجات المجتمع المتجدد ولا بُدَّ أن يوجد أناس لديهم مال كثير، وآخرون لا يملكون من المال إلّا قليلاً؛ لأنَّ التحكم التام في توزيع الثروات على نحو متساوٍ أمر مستحيل، إذا اختلفت المهن وتفاوتت الثروات اختلف مستوى المعيشة، وتفاوت طراز الحياة الماديّ والنفسيّ، وحينئذ توجد الطبقات (2).
وحديثنا عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام يسوقنا إلى الحديث عن المثل الأعلى للحياة عند الإمام. وما نهج البلاغة إلّا انعكاس الإسلام في نفس الإمام، لذلك لزم الحديث عن أحدهما الحديث عن الأخر، كما تستهدي العين بخيوط الشعاع على مركز الإشراق (3).
إذا تأملنا قليلًا في نهج البلاغة وجدنا أنَّ (التقوى) هي التي تمثل القيمة العليا للحياة، مثلما هي في القرآن الكريم، وقلما نجد خطبة أو رسالة أو حكمة خالية من (التقوى)، كما أنَّنا لا نكادنجد سورة في القرآن الكريمخالية من (التقوى)، فالقرآن الكريم ونهج البلاغة يأمران بالتقوى، وقد وصفها الإمام (علیه السلام) وفصّل فيها، ومدح بها المتقين، إذ قال (علیه السلام): " عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُوجِبَةُ عَلَى اللَّهِ حَقَّكُمْ، وَ أَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللَّهِ وَ تَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ.
ص: 193
1- ينظر: الطبقات الاجتماعية، د. محمد ثابت الافنديّ / 36 - 44.
2- ينظر: دراسات في نهج البلاغة / 36.
3- ينظر: نفسه / 37.
الْحِرْزُ وَ الْجُنَّةُ، وَ فِي غَدٍ الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ، مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ وَ سَالِكُهَا رَابِحٌ وَ مُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ، لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى الْأُمَمِ الْمَاضِينَ مِنْكُمْ وَ الْغَابِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَداً، إِذَا أَعَادَ اللَّهُ مَا أَبْدَى وَ أَخَذَ مَا أَعْطَى وَ سَأَلَ عَمَّا أَسْدَى؛ فَمَا أَقَلَّ مَنْ قَبِلَهَا وَ حَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهَا، أُولَئِكَ الْأَقَلُّونَ عَدَداً وَ هُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ "وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ"؛ فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا وَ أَلِظُّوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا وَ اعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَفٍ خَلَفاً " (1).
وقال)علیه السلام): " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ وَ إِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ وَ بِهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُمْ وَ إِلَيْهِ مُنْتَهَى رَغْبَتِكُمْ وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِكُمْ وَ إِلَيْهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ؛ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ " (2).
وحقيقة التقوى فصلها القرآن الكريم، إذ قال تعالى:)ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿2﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿4﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿5﴾) البقرة/ 2 - 5.
وقال تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة / 177.
ومن النصوص القرآنية الكثيرة يتبيّن أنَّ التقوى تمثل الفضيلة في أرفع معانيها وأجلِّ صورها، ولاسيما أنَّ الإسلام جعلها القطب الذي يدور عليه التفضيل بين الناس، قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/ 13. وأكدها النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) بقوله: ".
ص: 194
1- نهج البلاغة، خطبة / 191/ 285.
2- نفسه / خطبة / 313/198.
ليس العربيٍّ على أعجميٍّ فضلٌ، ولا أبيض على أسود فضلٌ إلّا بالتقوى" (1). وقال
(علیه السلام): " ولا تضعوا مَنْ رفعته التقوى، ولا ترفعوا مَنْ رفعته الدنيا " (2).
إذًا فالقيم الاجتماعيَّة تتفرع عن هذا الأصل، وتنبثق من هذا الينبوع، وقد وعى الإمام (علیه السلام) - بصفته خليفة المسلمين - الواقع المرّ الذي افرزته تراكمات السِّياسات الاقتصاديَّة المخطئة، وعلى هذا الأساس من الوعي جعل الإمام الإصلاح الاقتصاديّ أساساً للإصلاح الاجتماعيّ.
فكان الإمام - بعد النبي الأعظم - أوّل من كشف عن الفقر والغنى مشكلة اجتماعيَّة خطيرة، وفلسفة الفقر تجتمع عنده في هاتين العبارتين: " إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ، وَاللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ " (3) و " ما رأيتُ نعمةً موفورةً إلّا وإلى جانبها حقٌّ مضيعٌ " (4).
ومن هنا أصبحت مشكلة الفقر والغنى من أبرز المشكلات التي حفل بها منهجه الإصلاحيّ، وحين ثارت الطبقة الارستقراطيَّة لسياسة المساواة الماليَّة، التي اتبعها الإمام علي (علیه السلام)، فأشاروا عليه بأنْ يصطنع الرجال بالأموال، فقال: " أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً، لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ. أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ.
ص: 195
1- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقيّ (ت / 458 ه) 9/ 118، الهند، 1352 ه، والعقد الفريد، أحمد بن عبد ربه 2/ 185، مصر، مكتبة الأزهريّ، 1928م. و مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت/ 241 ه) 5 / 411، دار صادر بيروت. و تاريخ اليعقوبي، أحمد بن يعقوب اليعقوبيّ (ت 284 ه) 2/ 91، دار صادر - بيروت.
2- نهج البلاغة / خطبة / 191/ 285.
3- نهج البلاغة، حكمة / 328/ 534.
4- روائع نهج البلاغة / 83 - 233.
الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ" (1).
استعمل الإمام (علیه السلام) المواعظ والخطب في معالجة مشكلة الفقر، بل لم يكتفِ بالكلام، وإنَّما عالج الفقر بحماية أموال الأمة من اللصوص والمستغلين، وصرفهُ في موارده، فكان عينًا لا تنام عن مراقبة ولاته على الأمصار وعن التصرف في أموال الأمّة وطرق جبايتها وتوزيعها، وهو بذلك أوّل من اخترع نظام التفتيش (2).
فكتب إلى أصحاب الخراج: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ [سَائِرٌ] صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ مَا يُحْرِزُهَا؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ وَ أَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ؛ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَغْيِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ يُخَافُ، لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ. فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ" (3) وقد جاءه أخوه عقيل يطلب زيادة على حقه، فردَّهُ مَحَتجا بأنَّ المال ليس له وإنَّما هو مال الأمّة (4)، وجاءه ثانٍ يطلب إليه أن يعطيه مالًا، مُدلّا بما بينهما من رابطة الحب، فردَّهُ قائلًا: " إِنَّ هَذَا المَالَ لَيْسَ لي، وَلَا لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَفَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظَّهِمْ، وَإِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ " (5). 4.
ص: 196
1- نهج البلاغة، خطبة / 126/ 184.
2- ينظر: دراسات في نهج البلاغة / 52.
3- نهج البلاغة، كتاب/ 426/51 - 427.
4- ينظر: خطبة / 224 وقد ذكرناها انفاً.
5- نهج البلاغة، خطبة / 232/ 354.
وهكذا بدأ الضمير اليقظ والقانون الواعي لحاجات الفرد والمجتمع ينمو الإنسان المسلم، ويأخذ سبيله إلى الكمال النسبيّ الذي يتاح للإنسان متحليّا بالتقوى (1).
ينبغي التنويه بأنَّ الإمام استعمل التَّقسيم الطبقيّ على أساس الوظيفة الاجتماعيَّة بالدرجة الأولى، وهناك تقسيم أخر يتم داخل كلِّ طبقةٍ من الطبقات، وهو التَّقسيم على أساس المثل الأعلى، والتَّقسيم الأوّل لا يتتبع حكمًا تقويميّاً على الشخص المنتسب إلى الطبقة، ما يجعله في القمة أو ينحدر به إلى الحضيض.
أما التَّقسيم الآخر فهو الذي يتتبع حكماً تقويمياً، فالإنسان الذي يضع إمكاناته في سبيل المجتمع هو في القمة، أما الإنسان الذي يتخذ هذه الإمكانات سبيلًا إلى الغشِّ والإفساد وإضرار المجتمع، فذلك شخص يحتل مركزه في الطبقات السفلى، لقد جاء في نهج البلاغة عدة تصنيفات للمجتمع، كان من أبرزها في عهد الإمام (علیه السلام) لمالك الأشتر حينها ولاه مصر، إذ قسم الرعيَّة على تسع طبقات هي:
1 - (جنود الله).
2 - (كتّاب العامة والخاصة)، وهم بمنزلة الهيأة الوزاريَّة ومساعديها.
3 - (قضاة العدل)
4 - (عُمال الإنصاف والرفق).
5 - (أهل الجزية من أهل الذمة).
6 - (الخراج من مسلمة الأمّة).
7 - (التّجار).
8 - (أهل الصِّناعات)..
ص: 197
1- ينظر: الخطب رقم / 15 - 62 - 81 - 82 - 112 - 130 - 155 - 159 - 165 - 171 - 180 - 181 - 186 - 189 - 190 (القاصعة) 191 - 192 - 193 - 194 – 196 - 228، والكتب رقم / 12 /27/26/25/ 30 / 31 (وصيته لابنه الحسن) 45 - 47 / 53 (عهده لمالك الاشتر) 46، الحكم رقم / 95 - 203، 10، 242، 344، 388، 410.
9 - (الطبقة السُّفلى).
قال (علیه السلام): " وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض فَمِنْهَا جُنُودُ اللهِ، وَمِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ وَمِنْهَا عُمَّالُ الاِْنْصَافِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْکَنَةِ، وَکُلٌّ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي کِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً " (1).
إنَّ عبارة: (لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ) يمكن أنْ تكون نصًّا لنظرية تقرُّ (التُّعاون المجتمعيّ) إذ إنَّ التفاوت الفكريّ والتفاوت في القدرة ونوعيَّة العمل فضلاً عن الميول والأهداف الوظيفيَّة المتنوِّعة بين الطبقات تؤكد فكرة قيام المجتمعات على فئات تتكامل في الانتاج وتتعاون في العمل الوظيفيّ والتَّطوير الحضاريّ، إذ يأخذ كلّ فرد دوره واختياره الوظيفيّ في التَّخصص المهنيّ أو التَّجاريّ أو الاداريّ ... وسواها، تدلُّ العبارة أيضًا على التَّرابط الاجتماعيّ، إذ لولا الجنود لعَدِم الأمن، وحينئذ تنعدم التِّجارة ويختل نظام الصِّناعة والزِّراعة، ومن ثم يؤدي الإخلال إلى إنهيار الكيان الاجتماعيّ.
ولولا التِّجارة والزِّراعة لما وجدت الضرائب التي تمدُّ الجنود بالمال والسلاح، ولولا التِّجارة لحدثت أزمات اجتماعيَّة، تنشأ من تكدس الإنتاج في غير مكان الحاجة إليه، وعدمه في مكان الحاجة إليه، ولولا العمال (الولاة) و(الكتَّاب) الذين يشرفون على تنظيم هذا النَّشاط؛ لتسيَّب واتجه اتجاهات غير صالحة، ولولا القضاة للجأ الناس إلى تسوية مشكلاتهم بالعنف، وذلك يؤدي إلى بلبلة الاجتماع؛ لذلك جاء سياق الكلام على وفق أسلوب القصر والحصر، الدال على أرتباط كلّ طبقة بالأخرى، وتوقفها عليها في أداء عملها على النحو المطلوب لبناء مجتمع صالح، ولا سيّما أنَّ العطف بين.
ص: 198
1- نهج البلاغة، كتاب/ 53/ 432 - 433.
التبعيضين التقابليين أضفى على السِّياق قوّة ترابطيَّة تلائم تماسك طبقات المجتمع الصالح.
إذاً، فالطبقات الاجتماعيَّة متشابكة ومتداخلة، وليس فيها لأحد على أحدٍ فضلٌ فكلّ فردٍ يؤدي عملًا يستحق قُباله من المجتمع أعمالًا كثيرة، لذلك جاء التَّرابط اللغويّ متناسباً مع التَّرابط العضويّ بين طبقات المجتمع.
وبعد أنْ أجمل الإمام (علیه السلام) ذكر الطبقات الاجتماعيَّة، أخذ يفصل كلَّ طبقة على إنفراد، فبدأ بالطبقة الأولى قائلًا: " فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَ زَيْنُ الْوُلاَةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الاَْمْنِ وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِهِمْ. ثُمَّ لاَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلاَّ بِمَا يُخْرِجُ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَيَکُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ. ثُمَّ لاَ قِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلاَّ بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْکُتَّابِ، لِمَا يُحْکِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الاُْمُورِ وَعَوَامِّهَا. وَلاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَيَکْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ. (1)
يُظهِر النصُّ المتقدم التَّرابط والتَّداخل والتّشابك بين طبقات المجتمع على أنَّ الإمام جعل طبقات (الولاة والقضاة والكتاب) صنفًا واحدًا؛ لما يجمعهم من نمط وظيفيّ واحد تتشابه فيه الإدارة ونوع الحياة والدخل والإنفاق والتصورات الاجتماعيَّة، بل إنَّها واحدة أو متقاربة تقاربًا شديدًا، فهي طبقة قائمة في ثقافتها على العلم والفقه والتشريع والأحكام واللغة والأدب وسوى ذلك من لوازم المعرفة.
فحينما تحدث عن طبقة (جنود الله) جاءت التراكيب مناسبة صفاتهم وأعمالهم من قبيل: (حصون الرعيَّة، وزينُ الولاة، وعزُّ الدين، وسُبلُ الأمن) هذه التعابير الدالة على القوّة والأمن تلائم طبيعة عملهم، ثم جعل قوام الرعيَّة كلِّها بوجودهم..
ص: 199
1- نهج البلاغة، كتاب/ 53 / 433.
ولما ذكر الصنف الثالث (الولاة والقضاة والكتاب) جاءت الألفاظ والتراكيب (يحكمون، والمقاعد، ويجمعون، والمنافع، ويثمنون، خواص العوام وعوامها) ممّا يلائم عمل هذه الفئات، ثم أنَّ هذه الفئات وأمرها موكول إلى الحاكم، وهو ما بينه (علیه السلام) حين قال: "وَفِي اللهِ لِکُلّ سَعَةٌ، وَلِکُلّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ، وَلَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَلْزَمَهُ اللهُ مِنْ ذَلِکَ إِلاَّ بِالاِهْتِمَامِ وَالاِسْتِعَانَةِ بِاللهِ، وَتَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ " (1).
وللأهمية القصوى لهذه الطبقة لما تحمله من خطر على الأمّة، أمر الإمام (علیه السلام) اختيار العسكريين والقائد من بعض الأُسر الكريمة، إذ قال: " ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَالاَْحْسَابِ، وَأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ، ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ، وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ؛ فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْکَرَمِ، وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ" (2).
فهؤلاء يستمدون من وسطهم الأُسريّ تصورات القوة والاستعلاء؛ لما لهم من مركز مرموق في المجتمع ويستمدون من وظائفهم الجديدة ما يعزز هذه التصورات ويمدها بالحرارة والفعاليَّة، لذا جاءت تعابير الفضيلة في وصف هذه الأُسر من قبيل: (ذوي المروءات والاحساب، وأهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة، وأهل النجدة والشجاعة، والسخاء والسماحة، والكرم والعرف).
ثم يبيّن الإمام (علیه السلام) صفات قائد الجنود الذي يختاره الوالي من بين الجنود ويُعدُّ هذا تنقيةً وتهذيباً آخر يمرُّ به قائد الجنود، إذ قال (علیه السلام): " فَوَلِّ مِنْ جُنُودِکَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِکَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَ لاِمَامِکَ، وَأَنْقَاهُمْ جَيْباً، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْماً، مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ، وَيَرْأَفُ بِالضُّعَفَاءِ، وَيَنْبُو عَلَى الاَْقْوِيَاءِ، وَمِمَّنْ لاَ يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، وَلاَ يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ" (3)..
ص: 200
1- نهج البلاغة، كتاب/ 53 / 433.
2- نفسه
3- نهج البلاغة، كتاب/ 53/ 433.
هذه الصفات التي وضعها الإمام (علیه السلام) لاختيار قادة الجنود لو اتبعت في أي جيش لكان الجيش بمنزلة الملائكة، ثم يقول (علیه السلام): " فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَتُحَرِّضُ النَّاکِلَ، إِنْ شَاءَ اللهُ" (1)، هذه العبارة تتضمن مغزى عظيمًا، فبدلًا من أن يوجه اللوم إلى الناكل لنكوله، ممّا يولد في قلبه الضغن والنية السيئة بدلًا من هذا يبعث إلى العمل من طريق المنافسة فحين يسمع الثناء على ذوي البلاء الحسن من آقرانه وحين يرى أنَّ العمل يجد صدىً مستحبًا عند الرئيس يُعبر عنه بالتقدير، يندفع نحو العمل بباعث نفسيّ، فيجد فيه متعةً ولذةً يدفعانه إلى إتقانه، بدلًا من أنْ يزاوله مكرهاً لو دفع إليه من طريق اللوم فلا يجد فيه لذةً، ولا يشعر نحوه بأيِّ شعور نفسيّ يدفعه إلى التجويد والإتقان (2).
أما تفاصيل عمل الجنود وما يخصُّ هذه الطبقة من الآداب، فنجده في نهج البلاغة: " وَلاَ يَدْعُوَنَّکَ شَرَفُ امْرِئ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا کَانَ صَغِيراً، وَلاَ ضَعَةُ امْرِئ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا کَانَ عَظِيماً" (3).
ونجد المزيد من الحديث عن هذه الطبقات في رسائل نهج البلاغة وخطبه ذات المنحى السِّياسيّ (4)
ثانياً: التقسيم النفسيّ
يندر ما نجد عالمًا من العلماء قسم المجتمع في أشكال متعددة ومتنوِّعة، ومنها التَّقسيم النَّفسيّ. ففي خطبة (32) في جور الزمان يصنف الناس على أربعة أصناف الرغبات النَّفسيَّة والاهواء والميول الذاتية: " وَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَ كَلَالَةُ حَدِّهِ وَ نَضِيضُ وَفْرِهِ. وَ مِنْهُمْ
ص: 201
1- نهج البلاغة، كتاب / 435/53
2- ينظر: دراسات في نهج البلاغة / 76.
3- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 435.
4- ينظر: كتاب / 50، 56، 60، 79.
الْمُصْلِتُ لِسَيْفِهِ وَ الْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ وَ الْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ، قَدْ أَشْرَطَ نَفْسَهُ وَ أَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنْتَهِزُهُ أَوْ مِقْنَبٍ يَقُودُهُ أَوْ مِنْبَرٍ يَفْرَعُهُ، وَ لَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَناً وَ مِمَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عِوَضاً. وَ مِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَ لَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ. وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُئُولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ وَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى." (1)
فالأوّل: الذي لا يمنعه من عمل الفساد إلّا وجود ثلاثة نواقص لديه، هي:
1 - فقدانه القوّة الذَّاتيَّة التي تدفعه نحو ارتكاب الجرائم، نتيجة لوجود النَّقص الشُّعوريّ في نفسه، واستصغارها في المواقف كافة، وهو مضمون العبارة: (إِلَّا مَهَانَةُ نَفْسِه)
2 - ضعف سلاحه عند الفتك في الآخرين، وهو مضمون عبارة: (وَكَلَالَةُ حَدِّهِ)، يقال كَلَّ السيف كلالة، إذ لم يقطع، والمراد هنا: إعوازه من السلاح (2)
3 - الضعف الاقتصاديّ الذي يمنعه من السعي، لارتكاب تلك الأعمال القبيحة، وهو مضمون العبارة: (وَنَضِيضُ وَفْرِهِ) وقد عبر (علیه السلام) عن المال بالوفر.
والثاني؛ الشاهر السيفه لقوله (علیه السلام): (ومنهم المصلت لسيفه ... مما لك عند الله عوضا) وهو مختلف تمامًا عن الأوّل، لأنَّه قد شهر سيفه وأعلن الحرب ...
والثالث؛ طالبُ الدنيا بعمل الآخرة، وليس طالب الآخرة بعمل الدنيا، لقوله (علیه السلام): (قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَ قَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ ا.
ص: 202
1- نهج البلاغة، خطبة / 32 / 75 - 76.
2- ينظر: نهج البلاغة، صبحي الصالح، شرح الخطبة نفسها.
لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ) غايته تحقيق مآربه ورغباته، حتى وإنْ كان على حساب إيمانه ودينه وتقواه، وهذا الضعف طالما نجده في المجتمع، وهو الذي يدمر المسيرة الواقعيَّة للمجتمع، ويهدم البناء الإنساني المتماسك في لحظة إشباع رغبة ما في نفسه.
أما الرابع؛ المتزين في لباس أهل الزهد، لقوله (علیه السلام): (وَ مِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُئُولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ وَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى) هذا الصنف درس ذاته، وعرف مدى توثبه قدرته فيما وصلت حالته النفسية إلى نقطة معينة، اقتنع بالوقوف عندما غير متجاوز تلك النقطة لحقارة نفسه، وتقطع الأسباب عنده، فلم يستطع التّطوّر والإندفاع أو الوصول إلى رتبة أعلى في التكامل.
إنَّ هذه الأصناف الأربعة هي في واقعها وحقيقتها تمثل الطرف السلبيّ في المعادلة الاجتماعيَّة، التي تعوق عملية البناء الاجتماعيّ؛ لأنَّها ذوات صفات ذميمة وشاذة، ومخربة لكيان المجتمع.
وهناك طرف المعادلة الاجتماعيَّة الايجابيّ، تمثل بالصنف الخامس، وهم الرجال الذين في قلوبهم ذكر الله، أي أهل الإيمان والتقوى والمعرفة والطاعة، يقول (علیه السلام) فيهم:" وَ بَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وَ أَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ، فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍّ وَ خَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَ سَاكِتٍ مَكْعُومٍ وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ وَ ثَكْلَانَ مُوجَعٍ، قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَّقِيَّةُ وَ شَمِلَتْهُمُ الذِّلَّةُ، فَهُمْ فِي بَحْرٍ أُجَاجٍ أَفْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ، قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَ قُهِرُوا حَتَّى ذَلُّوا وَ قُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا. " (1).
وهذا الصنف الطاهر على خمسة أشكال متفاوتة في طبيعة وجودها في المجتمع مشتركة فيما بينها بصفات إيمانيَّة وأخلاقيَّة واجتماعيَّة واحدة، وهم:
1 - الهارب المنفرد من هذه المجتمعات وطرق معائشها وسلوكياتها، وهو.
ص: 203
1- نهج البلاغة، خطبة 76/32.
مضمون عبارة: (شريد نادٍ).
2 - الخائف المقهور بالظلم " خائف مقموع ".
3 - الساكت المرغم، الذي سدَّ فاهُ ولم يتكلم؛ لكيلا يحدث ما لا يحمد عقباهُ، وهو مضمون عبارة: (وساكت مكعوم).
4 - الداعي إلى الله بإخلاص (وداعٍ مخلص).
5 - الحزين المتألم للوضع الاجتماعيّ السائد، لقوله (علیه السلام): (وثكلان موجع).
وهؤلاء يكونون دائماً مقهورين في مجتمعاتهم الظالمة. وفي الأغلب يقتلون ويصلبون ويسجنون، لذلك نراهم قليلين دائماً.
ثالثا: التَّقسيم العلميً
وفي هذا القسم نرى أنَّ الإمام قد صنف أفراد مجتمعه بحسب المعرفة العلميَّة، وهذا له جوانب مؤثرة في حياة المجتمع ومسيرته، إذ يقول في جانب من كلامه لكميل بن زياد النخعيّ (ت 82 ه): " ... النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ" (1).
إِنَّ كلَّ مجتمع يقسم بحسب المعرفة العلميَّة على الأصناف الثلاثة المذكورة، لكن الأشدَّ خطورة على المجتمع هو الصنف الثالث (الهمج الرعاع)، فهم جهلة الأمّة، الذين تسيرهم الأهواء وتدور بهم الدواليب، ويجرهم القال والقيل ويجمعهم العقل الجمعيّ بين الناس، وقد وصفهم الإمام (علیه السلام) بالهمج، أي الحمقى من الناس الذين يميلون مع كلِّ ريح، دلالة على أنهم بلا أساس قوي يستندون إليه، وبلا عود صلب يتقوون به عند الاضطراب والفتنة فجهلهم من ظلامهم الذي نشأوا فيه.
ص: 204
1- نهج البلاغة، حكمة / 147/ 497.
رابعًا: التَّقسيم الإنسانيّ:
ينتقل الإمام (علیه السلام) بفكره الاجتماعيّ الخاص إلى الفكر الإنسانيّ العام، فيقسم الناس على أساس الإنسانيَّة على صنفين، هما: " إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق " (1).
وهي نظرة إنسانيَّة عظيمة، بل حضارية راقية لا يمكن أن يدرك مدى قيمتها إلّا من يمتلك عقلًا راجحًا وثقافةً واسعةً، وهي تمثل حالة التَّعايش الإنسانيّ الخلّاق.
خامساً: التَّقسيم الإيمانيّ
جاء في نهج البلاغة " شُغِلَ مَنِ الجنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامَهُ سَاعٍ سَرِيعٌ نَجَا، وَطَالِبٌ بَطِيءٌ رَجَا، وَمُقَصِّرٌ فِي النَّارِ هَوَى" (2).
هؤلاء ثلاثة أصناف بهيئات إيمانيَّة مختلفة، تنطبق في واقع الأمر على حقائق إيمان الأفراد وأعمالهم للآخرة، وهذه الصفات تترتب عليها أمور كثيرة في حياة المجتمع وعلاقاته، وطبيعة التعامل فيما بينهم. فالساعي الواقف على حدود الشريعة لا يشغله فرضها عن نفلها، ولا شاقها عن سهلها. والطالب البطيء فعنده قلب تعمره الخشية، لكنه ربما قعد به عن السابقين ميله إلى الراحة، فيكفيه من العمل بفرضه دون نفله وهكذا. أما المُقصِّر فهو الذي حفظ الرسم ولبس الاسم، وقال بلسانه إنَّهُ مؤمن دون قلبه، فهو عبد الهوى وجدير أن يكون في النار هوى (3).
وهكذا نجد تقسيمات وتصنيفات كثيرة في نهج البلاغة، تمثل بمجملها ظاهرة اجتماعيَّة تنظيميَّة، يمكن ملاحظتها بوضوح في مضامين خطب نهج البلاغة وحكمه (4).
ص: 205
1- نهج البلاغة، كتاب / 53/ 428.
2- نهج البلاغة، خطبة / 16 / 59.
3- شرح محمد عبده 1/ 49.
4- ينظر: 1 / 77 - 78 أصناف العرب قبل الإسلام، 1/ 133 - 181، 2/ 433، 7، ص / 58، 128 و 10 / 246 - 363 و 11 / 11 - 27 - 72 و 15 / 107 و 16 / 299 و 3 / 14 - 35 و 18 / 214.
نهج البلاغه
فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ
الفصلُ الثّالثُ
الظّواهِرُ الاجتِماعيّةُ في نَهْجِ البَلاغَةِ
ص: 207
الفصلُ الثّالثُ
الظَّواهِرُ الاجْتِمَاعِيَّةُ فِي نَهْجَ البَلاغَةِ
مدخل:
إِنَّ اجتماع عددٍ من الأفراد، كثيرًا كان أو قليلًا، على نحوٍ ما، يسبغ عليهم بعض الصفات الخاصة، فيصدر عنهم بسبب ذلك ظواهر معينة لا تمت بأيّةِ صلةٍ إلى طبيعتهم الفرديّة.
هذه الظواهر تسمى ب (الظواهر الاجتماعيّة) وهي عبارة عن القوالب والأساليب التي يصبون فيها أعمالهم، والطرائق التي يسيرون عليها في مختلف شؤونهم (1).
ومن هذه القوالب والأساليب ما ينظم الظواهر الفيزيولوجية والبيولوجية فالأكل مثلًا مظهر فيزيولوجيّ، أمّا كيفية الأكل، وأدوات الطعام، وأساليب الطبخ، وترتيب المائدة، وقواعد اللياقة (etiquette) فكلّها معالم الظواهر الاجتماعية، وكذلك العلاقات الجنسيّة بين الذكر والأُنثى، هي ظاهرة فيزيولوجية، أمّا كيفية إشباع الغريزة، وأسلوب إقامة العلاقة، والألفاظ والتراكيب المستعملة في هذه الظاهرة، فكلّها مواضعات اجتماعية، تختلف من جماعة إلى أُخرى.
أما الطرائق التي يسيرون عليها في شؤونهم، فهي الضوابط المختلفة التي تحدد مسيرهم وسلوكهم في أمور معاشهم وعلاقاتهم، وإشباع حاجاتهم النفسيّة والفكريّة والماديّة، وما إلى ذلك من هذه الطرائق أو الضوابط، وتشمل أيضًا القوانين والعادات والتقاليد والمحرمات، وأساليب التصرف في المناسبات،
ص: 209
1- ينظر: علم الإجتماع ومدارسه، مصطفى الخشاب / 58، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1965 م، الكتاب الثانيّ.
والتعبير المُحرَّم كالتعبير عن الحزن والألم، وكأسلوب التعامل مع الموت، وتنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة، أو الرئيس والمرؤوس ... وسواها وما إلى ذلك من القواعد السلوكية والخلقية والمطامح التي تحدد الآمال، وترعى الشؤون الدينيّة أو الاقتصاديّة أو السياسيّة أو عملية التنشئة الاجتماعيّة، كلُّ هذه الظواهر شديدة التنوع، وتختلف من جماعة إلى جماعة (1).
والظواهر الاجتماعيّة نوعان:
1 - ظواهر عالميّة، وتشمل ما يكون له صدى عالميّ، أو ما يكون منتشرًا عالميًا؛ لأَنَّه يهم الإنسان أينما كان، ومن هذه الظواهر مثلًا: حقوق الإنسان والأُسرة والتعليم والمُحرم اللغويّ والنظم الاجتماعيّة ...
2 - ظواهر خاصة، وهي التي تعرفها جماعة، ولا تعرفها سائر الجماعات مثل: لعب الميسر بالقداح عند عرب الجاهلية، والطواف حول الكعبة عندهم التنافس في العطاء والإهداء بين رؤساء القبائل عند هنود آمریکا الحمر، وتعدد الأزواج عند قبائل جزر الماركيز، وتعدد الزوجات في المجتمع الإسلاميّ، وكذلك التصنيفات والتقسيمات الاجتماعية عند المفكرين والفلاسفة في المجتمعات المتحضرة.
وهذه الظواهر قد تكون ثابتة ومستقرة، وقد تكون عرضيّة ومؤقتة، فالظواهر العرضيّة تتأتى عن ظروف طارئة، تمرٌّ بها الجماعة، وتنتهي بزوال هذه الظروف، ومن ذلك: حروب الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين الأوائل والحروب الداخلية فيخلافة الإمام علي (علیه السلام)، وموت الإرادة في المجتمع الكوفيّ، والمكر والدهاء والخديعة في القيادة العسكرية الشاميّة في خلافة الإمام علي (علیه السلام) والغباوة والجهل في الجيش الشاميّ ... وغير ذلك.
ص: 210
1- ينظر: مدخل إلى علم اجتماع الأدب، د. سعدي ضناويّ / 73 - 74.
أما الظواهر الثابتة - والثبات أمرٌ نسبيّ - فكلُّ ما في الحياة من ظواهر يصيبها التطوّر مع الزمن، وهذا التطوّر لا يقلل من ثباتها، كالحياة الأُسرية، وتنظيم العلاقات بين أفرادها، والقيادة والحكم، والدين واللغة ... وغيرها (1).
فالظاهرة الاجتماعيّة كما يُعرِّفها (دوركايم): هي الحدث الذي يجري داخل المجتمع، وتكون له أهمية جماعية، ويعدُّ ظاهرةً اجتماعيةً كلُّ أسلوبٍ في التصرف، ثابت أو عرضيّ، بإمكانه أن يفرض نفسه على الفرد في عملية قسر خارجيّ، ويعدُّ كذلك كلُّ أسلوب في العمل، يكون عامًا في مجال مجتمع معين مع احتفاظه بكيان له مستقل عن الظاهرة الفرديّة (2).
إنَّ الظواهر الاجتماعية شديدة التّنوّع، والظاهرة الواحدة تبدو مختلفة من حضارة إلى أخرى؛ بسبب تدخل الطابع الثقافيّ في الوقائع الاجتماعيّة، فالظاهرة الأُسريّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة أو الدينيّة أو الخلقيّة وما إليها جميعها موجودة في معظم المجتمعات، لكن اختلافها باختلاف المجتمعات أمر شديد الوضوح.
إنّ سلسلة الظواهر مترابطة، ووجود بعضها شرط لوجود بعضها الآخر، تجمعها جميعًا وتنظمها عقليّة الجماعة: فأي نمط لمجتمع محدود، ذي مؤسسات وأشكال سلوك خاصة به، يكون له بالضرورة عقلية خاصة ... وهكذا يكون الاختلاف في المجتمعات اختلافاً في العقلية، يستتبع اختلافًا في المؤسسات وأنماط السلوك؛ لأنَّها ليست في الحقيقة سوى مظهر التصورات الجماعيّة. (3) 5
ص: 211
1- ينظر: مدخل إلى علم اجتماع الأدب / 74 - 75.
2- ينظر: DICTIONNAIRE MARABOUT SOLIOLOGIE TOME IB 18
3- ينظر: lalien leuy brulsl les functions mentales dans les societes primitives ies grdnd texts dela sociologie modeme p. 85
وفي هذا الفصل نتناول عددًا من الظواهر الاجتماعية التي برزت في نهج البلاغة وسنجعلها في ثلاثة مباحث، هي:
ص: 212
المبحثُ الأوّلُ / الظاهرةُ التنظيميّةُ (الأُسرة، والعشيرة، والقبيلة)
للتنظيم مفهوم واسع يظهر عندما يُؤسس نهج واضح، يجري من عليه تنسيق الفعاليات الاجتماعيّة في جماعة معينة لغرض انجاز أهدافها (1). في حين يرى (مالينوفسكي malinovisky) أَنَّهُ الطريقة التي ينظم بها أفراد المجتمع أنفسهم والبيئة الماديّة المحيطة بهم في سبيل إشباع حاجاتهم النفسيّة والحيويّة والاجتماعيّة (2).
ولما كان علم اللغة الاجتماعيّ يفصح عن الأهمية الاجتماعيّة للغة فيما يخصُّ مجموعات من الناس تتراوح بين مجموعات اجتماعيّة ثقافيّة صغيرة كالأُسرة مثلًا، أو من مجموعات كبرى تتكون من بضع مئات من الناس أو بين أُمم مُعيّنة، فإنَّ التنظيمَ الاجتماعيّ لتلك المجموعات جداً في معرفة مضامين التنظيم اللغويّ، الذي يسود تلك الجماعات، ويمثل هذا التنظيم نمطًا مستقرًا من العلاقات الاجتماعيّة والأنشطة المختلفة داخل المجتمع أو الجماعة، ويقوم على تساند الوظائف والمعايير والمفاهيم المشتركة التي ترمي إلى تنظيم الحياة الاجتماعيّة وتحقيق غايات المجتمع (3).
ونهجُ البلاغةِ حافلٌ بالظاهرةِ التنظيميةِ، ويمكننا أن نصفه بأنَّهُ مظهرُ تنظيمٍ متكاملٌ، يبدأ بتنظيم الفرد وينتهي بتنظيم المجتمع، وتُعدُّ الأُسرة من مظاهر التنظيم الاجتماعيّ المهمة في نهج البلاغة، والمؤسسة الصغرى الأكثر أهمية في عملية التنشئة الاجتماعية؛ لأنَّها تشارك بالقدر الأكبر في الإشراف على النّمو الاجتماعي للفرد
ص: 213
1- sills, International Encyclopedia of solial scinces Volume 11, cyowell macmillan, ing, London, 1968, p 297.
2- ينظر: قاموس علم الاجتماع، د. عبد الهادي الجوهريّ / 430 الهيئة المصرية للكتاب، 1979 م.
3- ينظر: نقد الفكر الاجتماعيّ المعاصر، د. معن خليل عمر / 132، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982 م.
وتكوين شخصيته، وتوجيه سلوكه. وعرّفها ميردوك؛ بأنَّها: "جماعة اجتماعية تتميز بمكانِ إقامةٍ مشتركٍ وتعاون اقتصاديّ ووظيفة تكاثرية، ويوجد اثنان من أعضائها علاقة جنسيّة يعترف بها المجتمع " (1).
وللأُسرة مهمة مزدوجة، اجتماعيّة ونفسيّة تؤثر في نمو الفرد اللغويّ؛ لأنَّ الفرد شديد التأثر بالتجارب المؤلمة والخبرات الصارمة التي تحدث في محيطه، لذا نجد الإمام عليًا (علیه السلام) يجعل حفظ التجارب من علامات العقل، فيقول (علیه السلام) في ذلك: " وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ " (2) ويقول أيضاً: " فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ" (3).
الأسرة:
وهي الخلية الاجتماعيّة الأولى في نسيج المجتمع، لذلك كان محور دراسات الفلاسفة منذ القدم، وموضع اهتمام الديانات السماويّة وجميع النظم السياسيّة ودساتيرها، وتُعدُّ بحق أبرز عوامل تقدم المجتمعات وتطورها واستقرارها بفعل العناصر الخيرة والفاضلة والمؤثرة التي ترفدها في المجتمع.
تحدد الأُسرة حركة الفرد في المجتمع، في إطار ظروفها الاجتماعيّة والاقتصاديّة، فضلًا عن الجانب الأكبر من المفردات اللغويّة التي تتكون عند الفرد في سياق الحياة الأُسرية، يقول (جون ديوي john Dewey) (4): " انَّ التعليم المقصود في المدارس قد يصلح من هذه العادات اللغويّة، أو يبدلها، ولكن ما أن يتهيج الأفراد حتى يغيب عنهم
ص: 214
1- الانثربولوجيا الاجتماعية / 81.
2- نهج البلاغة، كتاب / 403/31.
3- نهج البلاغة،حكمة/ 30 / 405.
4- (1859 - 1952) وهو عالم أمريكيّ من أتباع الفلسفة البرغماتية، تأثر فكرياً بدراسات (هيجل) الفلسفية، و (فروبل) النفسية، و (دارون) التطورية، وانمازت عنوان مؤلفاته بالثنائيات، مثل: (المدرسة والمجتمع)، (والديمقراطية والتربية) و (الخبرة والتربية) و (الحرية والثقافة)، وتتلخص منظومة ديوي في التعليم من طريق الفعل، لا تعليم من طريق الإصغاء كما هو الامر في البداغوجيا التقليدية. (ينظر: أعلام التربية والعلوم الانسانية / 79).
في كثير من الأحيان الأساليب الحديثة التي تعلموها عن عمد، ويرتدون إلى لغتهم الأصلية الحقيقية " (1) وإنَّما جاء هذا الإرجاع من التأسى بالأُسرة " لِيَتَأَسَّ صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُمْ، وَ لْيَرْأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ" (2) كما أنَّها تقوم بعملية تنقية لما يتلقاه من خبرات وأفكار من خارجها، إذ تُقوَّم ويحدد الملائم منها: " ... وَإِنَّمَا قَلْبُ الحدَثِ كَالْأَرْضِ الخالِيَةِ ..." (3) فهي بذلك تمثل حلقة الاتصال بين الفرد والمجتمع؛ لأنَّها تنقل التراث الثقافيّ والحضاريّ من المجتمع إلى الفرد، ويظهر ذلك جليًا في احديوصاياه (علیه السلام) لابنه الحسن (علیه السلام) يقول: " أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي وَ إِنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَ فَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فِي آثَارِهِمْ حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ [جَلِيلَهُ] نَخِيلَهُ وَ تَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ وَ صَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ ... " (4).
يعطي النصُّ مفهومَ التراكميّةِ، نتيجةَ الخزين الثقافيّ والاجتماعيّ، الذي حصل عليه الإمام (علیه السلام) من تراكم التجارب التي مرّت بها الأُمم السالفة، فما أعطته تلك التراكمية من قدرة على التنبؤ في الحاضر والمستقبل على وفق المعطيات الثقافيّة والاجتماعيّة في ذلك المجتمع، ومن ثم أصبحت تلك التراكميّة ثقافة سائدة في المجتمع، يتناقلها أفراد المجتمع على نحو تعابير وأمثال وحكم تتردد على الألسن.
وتتمثل مكانة المرأة في نهج البلاغة بما جاء فيه: " ... وَجِهَادُ المَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ " (5) يمثل ذلك حركة المرأة في المجتمع في إطار الجهادين (الأكبر والأصغر)، فالسعي للرزق والعمل في المنزل، وفي المجتمع، وفي الحياة الزوجيّة، وفي تربية الأولاد 5.
ص: 215
1- الديمقراطية والتربية، جون ديوي 20/1.
2- نهج البلاغة خطبة / 2/ 41
3- نفسه / كتاب / 394/31.
4- نفسه.
5- نهج البلاغة / حكمة / 136/ 495.
مع حفظ زوجها واتباع موافقته. ولو عُدنا إلى المصدر التاريخيّ لهذه الحكمة وجدناها خلاصة حدث كلاميّ بين الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) وأسماء بنت يزيد الأنصاريّ الأوسيّة (30 ه - 650 م) أول سفيرة تمثل النساء في الإسلام، حملت مبايعتهُن ومطالبتهُن إلى النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) في السنة الأولى للهجرة وقالت له يا رسول الله: " إنّي وافدة النساء إليك، وأعلم أَنَّهُ ما من امرأة سمعت بمخرجي إلّا وهي على مثل رأيي: إنَّ الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنّا بك وبإلهك الذي أرسلك ... " فطالبته بإنصاف المرأة الممنوعة من الجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله، فأجابها النبي (صلی الله علیه و آله و سلم): " أعلِمي من خلفك من النساء: أنّ حُسنَ تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته بعدل ذلك كلّه) فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارًا" (1)
فاختصر الإمام (علیه السلام) أثر المرأة في المجتمع الإسلاميّ بهذه الحكمة الوجيزة في كلماتها الثرية في مضامينها، لتمثل دستورًا نسائيًا عظيمًا.
وكما أنَّ القرآن الكريم رسم الطريق للمرأة الصالحة، لصيانة زوجها ومنزلها، قال تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ البقرة / 187. جاء في نهج البلاغة " خِيَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ، شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ؛ الزَّهْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَ إِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا، وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا" (2).
وضح الإمام (علیه السلام) الفوارق بين خصال النساء وخصال الرجال، تلبية للإيعازات الطبيعيّة في التكوين، ولتأدية الواجبات في المجتمع، فالعبارات لا تحتاج إلى شرح؛ لأنَّ الألفاظ على أقدار المعاني، وهي مألوفة موحية وإنَّما نقرأ طرفة في المقابلة بين (خيار خصال النساء، وهذه الخصال نفسها شرار خصال الرجال)، هذه المقابلة.
ص: 216
1- الدر المنثور ج/ 2/ 153.
2- نهج البلاغة / حكمة / 234/ 509.
التعاندية تضع القارئ في أجواء مبحث اجتماعيّ شائق، اعتمد على الموازنة الجذَّابة المُفضية إلى التعليل المُقنع.
هذا النوع الكلاميّ الذي برع به الإمام (علیه السلام) شقّ الطريق أمام المباحث العقليّة، التي تربط النتائج بالأسباب، وبفضل هذا التعليل تتبدل المفاهيم الاجتماعيّة حول عناوين اجتماعية، ويصبح (البخلُ) صفةً مقبولةً في المرأة، ويغدو (الجبنُ) خصلة خير في المرأة، ولاسيما أنَّ المجتمع الإسلاميّ جعل عنوان المرأة شرفها، فالجبن منعها من اقتحام المهالك، إذ يتعرض لها اللصوص، ويسلبونها شرفها، وهي عاجزة عن الدفاع لضعفها الجسديّ.
لقد لحَظَ (ونستانلي) (1) في يوتوبياه، خاصية الاغتصاب، عندما شرع الحكم بالموت على الرجل الذي يغتصب المرأة بالقوة، لأنَّ فعلهُ يُعدُّ من قبيل سرقة الحرية الجسديّة للمرأة، ولكن هل يعيدُّ الانتقام من الغاصب كرامة المرأة وشرفها، إنَّ مضمون حكمة الإمام (علیه السلام) حصن حصين يصون المرأة ويحفظها بتربية وقائية، قبل أن تقع فريسة الأشرار (2).
ومن العجيب أنْ نرى عالماً لغوياً كالدكتور إبراهيم السامرائيّ يتعجب من كلام الإمام (علیه السلام) واصفاً إياهُ بِخلوهِ من كلِّ خيرٍ في المرأة؛ مع أنَّ الإمام نظر إلى لمرأة مثلما نظر إليها الإسلام الحنيف، إذ إنَّ أقوال الإمام وآراءَهُ وواقعهُ هي أقوال القرآن وواقعه، لا يفترقان أبدًا، فإنَّ الإمام لم يخلق لنفسه، وإنَّما وجد وخلق ليمثل الإسلام على حقيقته، فإذا فكر أو قال أو فعل، فلا يخرج في جميع ذلك عن دائرة الإسلام، فحذرها.
ص: 217
1- وهو: جيرارد ونستانلي (ت/ 1625 م) عالم ومفكر انكليزيّ، ناقش في كتابه: (يوتوبيا قانون الحرية) روح القوانين الانسانية، واليوتوبيا تعني المجتمع الخياليّ المثاليّ الخالي من الصراع والتنافس، ثم اتخذت الكلمة اليوم دلالة جديدة تشير إلى مشروع النهوض الاجتماعيّ (شبكة الانترنيت).
2- ينظر: نقد الفكر الاجتماعيّ المعاصر، د. معن خليل عمر / 132، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982.
من بعض الصفات التي لا تصلح لها، وإنَّما تصلح للرجل، وأطلقها حكماً توجه المرأة في رحلة الحياة، إن تجنبتها أرضت ربها، وعاشت كريمة في مجتمعها، مثل: المُخادعة والتّبرج والفساد، ... وغير ذلك ممّا جاء في نهج البلاغة: " غَيْرَةُ المَرْأَةِ كُفْرٌ وَغَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ " (1).
تمثلت (الغيرة) هنا بثنائية (الكفر والإيمان)، فالمرأة في غيرتها على زوجها تُحرِّم حلالًا (تعدد الزوجات)، وغيرة الرجل على زوجته تحريم لما حرمه الله، وهو (الزنى).
ثم يقول د. السامرائيّ: " وعجيب ألّا يكون في نهج البلاغة ذكر للزهراء البتول أم الحسن والحسين، على عشرتها الطيبة المباركة، ولا أراه مبتئسًا من أنَّه لم يشرك معها زوجة أُخرى في حياتها على ما قيل في الأخبار، وأنَّهُ همَّ أن يفعل؛ فغضبت الزهراء والتجأت إلى أبيها فرضي عن غضبها، ولم يرضَ لعلي ما كان يزمع أن يفعله، وفي هذا ورد قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) "فاطمة بضعة مني" (2).
ويكتفي الباحث بالردّ على هذا القول من جانبين (3)، هما:
احدها: إنّ (نهج البلاغة) ليس كلُّ كلام الإمام (علیه السلام)، بل هو المختار منه لما صرح بذلك جامعه الشريف الرضيّ (قدس)، وربما كان هنالك كثير في هذا الشأن لم يدوّنه الشريف الرضي في نهج البلاغة، ولا سيما ما يخصُّ الزهراء (علیه السلام) وغيرها من نساء أهل بيته.
والآخر: لقد تناسى أو تغافل السامرائيّ عن خطبة الإمام (علیه السلام) في الزهراء (علیه السلام) حين وافاها الأجل متوجهاً نحو قبر النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) قائلًا: " السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، عَنِّي وَعَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ، وَالسَّرِيعَةِ اللَّحَاقِ بِكَ. قَلَّ يَا رَسُولَ اللهِ.
ص: 218
1- نهج البلاغة، حكمة / 492/124.
2- مع نهج البلاغة دراسة ومعجم، د. إبراهيم السامرائيّ / 19.
3- لدى الباحث عدة إجابات أخرى اكتفى بعرض جانبين، خشية الخروج عن موضوع البحث واقتداءً بقوله (ع): (... لا تقل كل ما تعلم ...).
عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي وَ رَقَ عَنْهَا تَجَلُّدِي، إِلَّا أَنَّ فِي التَّأَسِّي لِي بِعَظِيمِ فُرْقَتِكَ وَ فَادِحِ مُصِيبَتِكَ مَوْضِعَ تَعَزٍّ، فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ وَ فَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَ صَدْرِي نَفْسُكَ، فَ "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ". فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ، إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ. وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ، هَذَا وَ لَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ. وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُوَدِّعٍ، لَا قَالٍ وَ لَا سَئِمٍ، فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ، وَ إِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ" (1)
ثم لم يكتفِ بذاك حتى دسّ السم بالعسل حينما قال: " كأن رأي الإمام علي في (المرأة) ونيله من مكانتها تأتى قبل كلِّ شيءٍ ممّا جرى له في حرب الجمل، وما كان لعائشة من أثرٍ بارزٍ فيها " (2)، وهو يريد بذلك فصل الإمام (علیه السلام) عن أصل الشريعة الإسلامية، وإنقياده خلف عواطفه وانفعالاته مع أنَّهُ القائل (علیه السلام) في المرأة: " ... فَإِنَّ المُرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بقَهْرَمَانَةٍ ..." (3) فشبّه المرأة بالريحانة تدليلًا على التشميم والنّضارة (عناصر الانوثة) والتشبيه يدعو الرجل إلى التعامل الصحيح مع المرأة بالملاطفة والمحبة والعطف ...
وفي تشبيه النفي (وليس بقهرمانة) نفى عنها الحكم والبطش.
ولعل الذي ذهب إليه السامرائيّ من رأي تعوزه الدقة - على أية حال - ربما يكون سببه هو إيراده بعض العبارات المبتورة من نصوصها من قبيل قوله (علیه السلام): " ممَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ " ولم يكمل تعليل القول: " فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ، 1.
ص: 219
1- نهج البلاغة، خطبة / 202 / 320.
2- مع نهج البلاغة - دراسة ومعجم، د. إبراهيم السامرائيّ / 17،، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان، ط1، 1987 م.
3- نهج البلاغة، رسالة / 406/31.
وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ " (1).
وكفى رداً على ما صرح به السامرائيّ تعليل الإمام في النصِّ المذكور، والمقصود من (المرأة شرٌّ كلّها) أنّ المرأة مغريات كلّها، والشر هنا بمعنى الامتحان.
فقد استعمل الإمام المجاز المرسل بعلاقته (المسببية)، وهي أنّ المعنى الأصليّ للفظ المذكور (الشرّ) مسبباً عن المعنى المجازيّ (المغريات)، أي ذكر لفظ المسبب (الشرّ) وأراد به السبب (المغريات)، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا) غافر / 13 أي مطرًا يسبب الرزق، فيكون معنى الحديث: المرأة مغريات كلّها وأغرى ما فيها أَنَّهُ لا بُدّ منها، وهذا نظير قول النبي (صلی الله علیه و آله و سلم): " المرأة كلّها عورة " إنْ نظر الرجل إلى المرأة نظرة ريبة.
ثم كيف ينظر السامرائيّ يا ترى لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) النساء / 34؟ وكيف يفهم قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) المتقدم " المرأة كلّها عورةٌ "؟ كيف وقد جاء عن المسيح (علیه السلام) أنَّه قال: (من أراد أن ينظر إلى امرأة بريبة فليقلع عينه قبل أن ينظر إليها) إذا كانت نظرة تستوجب قلع العين، فلو كان للرجل الآف العيون لاقتلعها منه نظرات النساء، وهذا شيءٌ من الشرِّ الكامن في النساءِ (2).
إنَّ حكمة الإمام (علیه السلام) تفيض نصحًا للمرأة وإشفاقاً عليها. حتى لا تتحول إلى شرّ تتقاسم فيه الذنب مع الرجل، أما المرأة المؤمنة التي لا تتبرج، ولا تسعى إلى إغواء الرجال، ولا تُظهرُ من جسدها إلّا المباح فهي قد حبست مغرياتها (مصدر الشرور) وخرجت إلى المجتمع تحمل الطهر والخير.
تمثل المرأة بيولوجياً العنصر الأضعف، وحالة الضعف هذه قد يستغلها بعضُهم للحطّ من مكانة المرأة وشأنها، لذا قرر (علیه السلام) متجاوزًا هذه الحالة قائلًا " اتقوا الله في 8.
ص: 220
1- نهج البلاغة، خطبة / 80.
2- ينظر: جمهورية الحكمة، ص/ 198.
الضعيفين: اليتيم والنساء " (1)، لأنَّها إنسان، لها مثل الذي عليها، فإنَّ هذا لا يمنع من أن تكون سائرة في فلك الرجال، ولقد وصفها الإسلام من تصرفاتها التي تصدر عن طبيعتها وفطرتها، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) - النساء / 34. ولا ينقص هذا من شخصية المرأة، لأنَّ. حق القوامة مستمد من التفوق الطبيعيّ في استعداد الرجل، وكذلك مستمد من نهوض الرجل بتكاليف الحياة الأُسريّة وأعباء المجتمع.
ولم تختلف نظرة الإمام (علیه السلام) للمرأة عن هذه الصورة التي أوضحها القرآن الكريم، ولم يذكر التاريخ حادثة واحدة أهان بها الإمام (علیه السلام) المرأة أو غمط بعض حقوقها، حتى اللواتي أضمرن له العداء، عملاً بوصية رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، فقال موصياً ولده الحسن (علیه السلام): " الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم أنَّه قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم " (2)، وليس أدلّ على ذلك معاملته لعائشة (أم المؤمنين) التي ألبت عليه الرجال، وحشدت ضده الجيوش، ودخلت معه في حرب ضروس، كانت الأشدّ خطرًا على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك لم يتصرف معها بما يشين كرامتها ويخدش شرفها، بل أذن لها بالرحيل، وجهزها بما تحتاجه من مركب وزاد ومتاع، وخلف معها أخوها محمد بن أبي بكر؛ ليحرسها في الطريق ولتطمئن بوجوده، ثم سار في وداعها (علیه السلام) عدة أميال، وهو يدعو لها بالمغفرة.
تراوحت كلمات الإمام (علیه السلام) في حق المرأة بين الاهتمام بها، وعدم الإساءة إليها أو التعرض لها بأذىّ، والكشف عن طبيعتها، فيقول: "وَ لَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ؛ إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ، وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْفَهْرِ أَوِ الْهِرَاوَةِ فَيُعَيَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِه" (3)، وهذا الضعف ناتج من طبيعتها التكوينية، لذا 4.
ص: 221
1- ألآمالي: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ، ص / 370، دار الثقافة - قم المقدسة، (1414 ه).
2- تحف العقول / 140.
3- نهج البلاغة، كتاب / 374/14.
فهو يحذر منهُن بقوله (علیه السلام): " فاتقوا شرار النساء، وكونوا في خيارهن على حذر، ولا تطيعونهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر " (1).
لقد كانت المرأة أداة للشرّ والفساد، وهي على قدر كبير من الجهل، بحيث تمنعها ضآلة ثقافتها من إبداء الرأي السديد، أما اليوم فقد فتحت أمامها أبواب العلوم المختلفة، ودخلت في أكثر المجالات التي دخل بها الرجل، وأصبحت مشاركتها الايجابية الفعالة في الحياة لا تقل عن قدرة الرجل بل أصبحت تؤدي وظيفة مهمة في صنع الأحداث واتخاذ القرارات، فلا يمكن بعد ذلك عزلها في البيت وقصر - وظيفتها على التربية، إنَّ أقوال الإمام المتقدمة لا يمكن أن تنسحب إلّا على المرأة الجاهلة من قبیل قوله (علیه السلام): " وَ إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ ..." (2) يقول محمد جواد مغنية في ذلك: " أما نهي النبي وعلي عن مشاورة النساء، فيحمل على مشاورة الجاهلة، وكان أكثر النساء آنذاك في معزل عن العلم وتجارب الحياة، ولا ذنب للمرأة إذا قصر الرجل في تربيتها، مع العلم أنَّها من طينة الرجل، وطبيعتها واحدة يشتركان في المسؤولية على قدم المساواة " (3).
لما كان المجتمع العربيّ عمومًا (الجاهلية وصدر الإسلام) مجتمعًا رجوليًا، وجب على المجتمع الإسلاميّ بعد ذلك العصر تثقيف المرأة، وتهذيب غرائزها، وتزويدها بالفضائل الخلقيّة والاجتماعيّة، بحيث يمكن الانتفاع بمواهبها ومؤهلاتها، شرط أن لا يتعارض ذلك مع واجبها المنزليّ، ففي هذه الحالة يكون ضررها أكثر من نفعها، ويكن احتجابها في البيت، وقيامها على راحة زوجها وأولادها أفضل بكثير من اندماجها في المجتمع، وهذا هو جهاد المرأة الحقيقيّ الذي عبر عنه علي (علیه السلام) بقوله: "جِهَادُ الْمرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ " (4).
ص: 222
1- ينظر: شرح نهج البلاغة، 214/15.
2- نهج البلاغة، خطبة / 406/31.
3- في ظلال نهج نهج البلاغة 531/3.
4- نهج البلاغة. البلاغة، حكمة / 136/ 495.
ومن عناصر الأُسرة الناجحة هو اختيار الزوجة الصالحة ذات الحسب والنسب (1) فقد تضمن نهج البلاغة نظرية: (الحفاظ على النسل المتفوق)، حينما قال الإمام (علیه السلام) لأخيه عقيل ابن أبي طالب - وكان عقيلٌ نسابةً: أختر لي امرأة ولدتها الفحول ... فاختار له (فاطمة بنت حزام، جدها صعصعة فارس العرب، وأُمها تمامة تنسب إلى طفيل فارس هوازن وجدتها تنسب إلى كبشة بنت عروة الرجال (2)، فولدت لعلي أربعة أبطال استُشْهِدوا مع أخيهم الحسين (علیه السلام) في كربلاء.
إنَّ تحسين النسل أو الحفاظ على النسل المتفوق في الإسلام يتم بالزواج الشرعيّ؛ إذ جاء في نهج البلاغة: " ... وَتَرْكَ الزِّنَى تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ ..." (3)؛ لأنَّ الزنا فيه إفساد للأنساب، وتدهور للنوع البشريّ، وانحطاط للمجتمعات ... والأعمال تقابل الأنساب " مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " (4)، وكثير من الناس قد اعتمدوا على احسابهم، ولم يعتمدوا على الدين، وإنّما حركتهم الحمية، ونخوة الجاهلية، فأخلدوا إليها وتركوا الدين، وهؤلاء كانوا صنعة الأشرار، الذين جعلوا من بقائهم في السلطة تجهيل الناس وتمسكهم بالاحساب دون الدين، جاء في نهج البلاغة في وصف أهل الشام: " وَ أَرْدَيْتَ جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيراً، خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ وَ أَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ، تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ وَ تَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ؛ فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَ نَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَ تَوَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَ عَوَّلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ، إِلَّا مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ، فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ وَ هَرَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوَازَرَتِكَ، إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَ عَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ؛ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ وَ جَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ.
ص: 223
1- النسب الاصيل والشرف الثابت في الاباء والمهات، اما الحسب فهو الفعال الصالح، ومفاخر الاباء مثل الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء.
2- ينظر: مقاتل الطالبين، أبو الفرج الاصفهانيّ / 82
3- نهج البلاغة، حكمة / 252/ 513.
4- نفسه، حكمة / 23/ 473.
وَ الْآخِرَةَ قَرِيبَةٌ مِنْكَ" (1) فتبرز عندئذ العصبيّة القبليّة المنافية للدين لكن الاحساب التي لا تمزق وحدة المجتمع، والأنساب التي تستلهم شرفيتها من الدين الإسلاميّ تعمل على رصّ صفوف الأُمة، وتحافظ على وحدة المجتمع وخير الاحساب والأنساب ما وصف به (علیه السلام) النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) في نهج البلاغة بقول: " وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلَ وَ حَكَمٌ فَصَلَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَيِّدُ عِبَادِهٌِ؛ كُلَّمَا نَسَخَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرِهِمَا، لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ وَ لَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِر ... " (2).
إنّ ما ذهب إليه الإمام (علیه السلام) في اختيار الأرحام الطاهرة ذات الأنساب والاحساب في التزويج وتكوين الأسرة الصالحة إشارة لأبرز الروابط الأسرية (صلة الرحم)، فما هي إلّا نزعة طبيعية في البشر فرضتها الحمية بين أفراد الرحم الواحد، يقول ابن خلدون في ذلك: " وذلك أنَّ صلة الرحم طبيعيّ في البشر - إلّا في الأقل ومنهم صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم تهلكة، فإنَّ القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه، ويودُّ لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك نزعة طبيعيّة في البشر مذ كانوا " (3)، وهذه النزعة الطبيعيّة في البشر تؤدي إلى الاتحاد والالتحام بين أفراد النسب الواحد، ثم أنَّ اختيار الأرحام الطاهرة ذات الأنساب والاحساب الأصلية ما هو إلّا لتأمين نوعية جيدة من الصالحين، لكيلا تتدهور نوعية الطبقة الصالحة، فقد برَّز أفلاطون تشريعه بأنَّ الناس يعملون دائمًا، لتحسين أنواع كلابهم وطيورهم وخيولهم، وجدير بهم أن يحسنوا نوعية حكامهم حتى لا تتدهور دولتهم.
ومن حسن المعاشرة الزوجية في نهج البلاغة: " ... وَلَا يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَى الخَلْقِ بِكَ ..." (4) والمراد بهذا النهي عن قطيعة الرحم وإقصاء الأهل وحرمانهم، وفي 4.
ص: 224
1- نهج البلاغة، كتاب / 32/ 407.
2- نفسه، خطبة / 214/ 331.
3- مقدمة ابن خلدون/ 128.
4- نهج البلاغة، كتاب / 31/ 404.
الخبر: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام " (1)، وقد جاءت هذه العبارة على نمط المثل المعروف: "شؤم الساحرة أنها أول ما تبدأ بأهلها " (2). بل جعل الإمام أفضلية المؤمنين بعضهم على بعض قائمة على أفضلهم انفاقًا في البر والخير، إذ جاء في نهج البلاغة: " وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ " (3) أي: التقدمة في قوله تعالى: (وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ) البقرة/ 110، وهذه من التضمين القرآنيّ المعنويّ، فأما التقدمة في النفس فإنَّها تقدمة في الجهاد، وأما التقدمة في الأهل فإنَّها تقدمة بالولد والزوجة، وتكليفهما المشاق في طاعة الله.
ومما يتعلق بالأُسرة في نهج البلاغة المحاسبة والتحذير والنهي عن خيانة الأمانة، فقد ورد في نهج البلاغة من كتاب له (علیه السلام) إلى المنذر بن الجارود العبديّ، كان قد استعمله على بعض النواحي، فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله جاء فيه: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ، وَ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ؛ فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً وَ لَا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداً، تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِكَ وَ تَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ. وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً، لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ ..." (4) إنَّ ظنَّ الإمام بصلاح الأبناء تبعاً لحال الآباء أمر معتاد في الغالب، ولكن لكلِّ قاعدة شواذ.
أما قوله (علیه السلام): (وتصل عشيرتك) كأن فيما رقي إليه عنه أنَّهُ يقتطع المال ويفيضه على رهطه وقومه، ويخرج بعضه في لذاته ومآربه.
وعبارة (الجمل اهلك) مثل تضربه العرب في الهوان، قال الشاعر (الوافر) (5):.
ص: 225
1- اخرجه الهيثميّ في (مجمع الزوائد) 8/ 152.
2- شرح نهج البلاغة 16/ 271.
3- نهج البلاغة / كتاب 69/ 460.
4- نهج البلاغة، كتاب / 71/ 262.
5- الابيات الشعريّة للشاعر كثير عزة، ينظر: الامالي، إسماعيل بن القاسم القاليّ (ت / 356 ه) / ااا، تحقيق: إسماعيل يوسف ذياب القاهرة، (1953 - 1954 م). ويروى في ديوان الحماسة 2/ 21 أنَّ الشعر للعباس بن مرداس. ومن معاني الكلمات: الخسف/ الذل، والجير / الحظام، أي: البعير مع عِظَمه يدور به الصبي حيث شاء ويذلهبالزمام فينقاد له. والوليدة / الجارية. والهراوى / جمع هروة وهي العصا. والغِرَ/ جمع غيرة وهي الحمية.
لقد عَظُم البعيرُ بغَيرِ لُبِّ *** ولم يَستغنِ بالعِظَم البعيرُ
يُصرِّفَهُ الصبيُّ بكلِّ وجهٍ *** وَيَحْبِسُه على الخَسفِ الجريرُ
وَتَضربهُ الوليدةُ بالهراوى *** فلا غِيرُ لديه ولا نكيرُ
وأما عبارة (شسع النعل) فضربت مثلا للاستهانة بالأمور؛ لابتذالها ووطئها الأقدام في التراب (1).
وهنا تمثل أثر المراقبة والمحاسبة على الولاة الذين اختيروا على وفق أحسابهم وأُسرهم، على انَّ نهج الابن خالف نهج الأب، وهذا من القليل النادر، حينما يكون العامل الوراثيّ خلافاً للأصل، أو قد يكون العامل الخارجيّ أقوى في التأثير من العامل الداخليّ.
ومن الأخلاق الأُسرية ذم الكبر بين أفراد الأُسرة جاء في نهج البلاغة: " وَ لَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ [الْحَسَبِ] وَ قَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ وَ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ الْكِبْرِ الَّذِي أَعْقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَةَ وَ أَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (2)، والمقصودان قابيل وهابيل ابنا آدم (علیه السلام)، وإنَّما قال (علیه السلام): (ابن أُم) فذكر الأُم دون الأب؛ لأنَّ الأخوين من الأُم بعضها أشدّ حنوًا ومحبةً والتصاقًا على بعضهما من الأخوين من الأب؛ لأنَّ الأم هي ذات الرحم الحضانة والتربية.
وقوله (من غير ما فضل) (ما) هنا زائدة تعطي معنى التوكيد، نهاهم (علیه السلام) أن يتحاسدوا ويبغوا ويفسدوا في الأرض، فإنَّ آدم لمّا أمر ولديه بالقربان، قرب هابيل شرَّ.
ص: 226
1- ينظر: نهج البلاغة، خطبة / 230/17.
2- نهج البلاغة: خطبة / 290/192.
ماله - وكان كافراً - وقرب هابيل خير ماله وكان مؤمناً، فتقبل الله من هابيل ونزل من السماء نارًا فأكلته، قالوا: لأنَّهُ لم يكن في الأرض حينئذ فقير يصل القربان إليه، فحسده قابيل فقتله وأصبح من النادمين لا ندم التوبة بل ندم الحيرة ورقة الطبع البشريّ، لأنَّهُ تعب من حمله لما ورد في التنزيل أنَّهُ لم يفهم ماذا يصنع به حتى بعث الله الغراب (1).
وجاءت عبارة: (ابن أُم) في موضع آخر من نهج البلاغة، حينما شكا الإمام (علیه السلام) لأخيه عقيل حاله من قريش: " فَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَ تَرْكَاضَهُمْ فِي الضَّلَالِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِي الشِّقَاقِ وَ جِمَاحَهُمْ فِي التِّيهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) قَبْلِي؛ فَجَزَتْ قُرَيْشاً عَنِّي الْجَوَازِي، فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ سَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي." (2) تتمثل الشكوى الأُسرية في أعلى مضامينها الاجتماعيّة، ألا وهي الخلافة.
إنَّ عبارة: (فجزت قريشًا عني الجوازي) تجري مجرى المثل، تقول لمن يسيء إليكوتدعو عليه: جزت عني الجوازي؛ (يقال: جزاه الله بما صنع، وجازاه الله بما صنع؛ ومصدر الأول جزاء، والثاني مجازاة، وأصل الكلمة أنَّ الجوازي جمع جازية كالجواري جمع جارية، فكأنه يقول: جزت قريشًا عني بما صنعت ليّ كلّ خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جانحة، أي جعل الله هذه الدواهي كلّها جزاء قريش بما ضعت بيّ (3).
فهذه العبارة المُقتضبة المُوجزة فيها من المضامين الاجتماعيّة ما تكشف ألم الإمام (علیه السلام) ومعاناته من قومه، وله في ذلك أسوة بأخيه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم).
أما عبارة: (وسلبوني سلطان ابن أمي) يعني بهاء الخلافة، و(ابن أُمه) هو رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، ومجيء (ابن أُم) هنا يحتمل أمرين:.
ص: 227
1- ينظر: شرح نهج البلاغة / 40.
2- نهج البلاغة: خطبة / 36 / 410.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة 16/ 302.
احدهما: ما ذكره ابن أبي الحديد من أنّهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم، أم عبد الله وأبي طالب، لذلك لم يقل سلطان ابن أبي؛ لأنَّ غير أبي طالب من الأعمام يشركه في النسب إلى عبد المطلب (1).
والآخر: اقتداءًا بقول هارون لموسى (علیه السلام) في قوله تعالى: (قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي) الأعراف: 150 استرحامًا واستعطافًا، وفي ذلك إشارة دلالية لحديث النبي (صلی الله علیه و آله و سلم): " يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي" (2)، والعلاقة الجامعة بينهما النبوة والخلافة؛ لذلك قال الإمام (وسلبوني سلطان ابن أُمي)؛ للدلالة على موضعه من رسول الله مادام الحديث بهذا المضمون. ويحتمل أن يكون الأمران معًا.
و ممّا يميز خليفة الله في الأرض من غيره من الخلفاء (الحكام والولاة) إنصافه الناس من نفسه وأهله، جاء في نهج البلاغة كلاماً في التبرُؤ من الظلم: " ... وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ، حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً؛ وَ رَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ، غُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ، كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ؛ وَ عَاوَدَنِي مُؤَكِّداً وَ كَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً، فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي، فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي وَ أَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقَتِي. فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَ كَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا؛ فَقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ يَا عَقِيلُ، أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ، وَ تَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ، أَ تَئِنُّ مِنَ الْأَذَى وَ لَا أَئِنُّ مِنْ لَظَى ..." (3).
ص: 228
1- نفسه: 16 / 303.
2- عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق 307/2.
3- نهج البلاغة، خطبة / 224 / 347 - 348.
العشيرة والقبيلة:
إذا كان علم اللغة الاجتماعيّ يختصُّ بدراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع، فمن الطبيعيّ أن تتناول كتب هذا العلم الوحدات الاجتماعيّة الكبيرة مثل: القبائل والأمم والطبقات الاجتماعية، إلّا أنَّ المجتمع يتكون في المقام الأول من الأفراد، وقد اتفق كلُّ من علماء الاجتماع وعلماء (علم اللغة الاجتماعيّ) على ضرورة جعل الفرد مركز الاهتمام الرئيس في هذه الدراسات، حتى لا يغيب الفرد عن بالنا حين نتحدث عن الأحداث والمجريات الواسعة النطاق، فأهمية المتحدث عن الفرد في علم اللغة الاجتماعيّ تعادل أهمية المتحدث عن الخلية في علم الأحياء، فإذا ما عجزنا عن فهم سلوك الفرد، فإِنَّنا سنفشل حتمًا وبالدرجة نفسها في فهم سلوك الجماعات، على أنَّنا نؤمن بعدم إمكان التشابه التّام بين فردين يتحدثان باللغة نفسها، إذ لا يمكن أن يتوفّر لهما القدر نفسه من التجارب والخبرات اللغويّة والاجتماعيّة (1).
عاشت القبائل العربية قبل الإسلام تراثًا ثقافيًا، اشتركت في الكثير من مظاهره، فكلُّ قبيلة كانت تعدُّ نفسها أُمة في قُبالة القبائل الأخرى، التي تنظر إليها بعداوة وكأنها تنتمي إلى أُمة ثانية، ترى نفسها وحدها القائمة على هذا التراث تحميه وتلتزم بقيمه وتتلبّس فضائله، بنحوٍ يجعل سواها من القبائل لا تدانيها بهذا الالتزام.
وكلُّ قبيلة تنسب الفضائل إلى نفسها، وهي عينها التي تدعيها الأُخرى، وإن كانتا متصارعتين، على أنَّ هذه المشاركة في التراث الثقافيّ تجلت في الخصوص في بعض الأفكار والمعتقدات والتصورات والمعارف والنظم، وفي الكثير من العادات والقيم.
أما فيما يتعلق بالماضي ورموزه، بشرية كانت أو مكانية، فلكلِّ قبيلة تراثها الخاص؛ لأنَّ الرموز البشريّة التي تقدسها قبيلة ما هي نفسها رموز العداوة التي تصبُّ عليها قبائل أُخرى كرهها، وتسعى إلى هدمها، وكلُّ معركة تفخر بها قبيلة؛ لأنَّها رمز
ص: 229
1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. هندسن / 32 - 33.
لقوتها وانتصارها، هي المعركة نفسها التي تريد قبيلة أُخرى أن تمحوها من سجل التاريخ، لما ذاقت فيها من الذلِّ والهزيمة.
هكذا يبدو لنا التراث الثقافيّ للقبائل العربية قبل الإسلام طبيعة فريدة، فهو يجمع ويفرّق، ولعل هذه الظاهرة هي التي ترجمت عمليًا صراعًا مستمرًا بين القبائل منعها من أن تؤسس دولة أو تنشئ نظاماً، أو تشكل أُمة (1).
أما (العشيرة والقبيلة) من منظور إسلاميّ، على وفق ما جاء في نهج البلاغة من تفصیلات توضح نظرة الدين الإسلاميّ الحنيف إلى القبائل عموماً والقبائل العربية خصوصًا، تكشف لنا هذه الدراسة ملامح النظام القبليّ العربيّ في مدة خلافة الإمام (علیه السلام)، والتطورات التي حصلت في هذا النظام بفعل المتغيرات الاجتماعيّة كالدين والحروب والمجاورة والوحدة الإسلامية ... وسواها.
وللتفريق بين مفهومي العشيرة والقبيلة، نذهب إلى علم الانثربولوجيا الاجتماعيّة، الذي يفرق بينهما في حدود التعريف، فالعشيرة تعني: (وحدة اجتماعيّة تُعدُّ امتداداً للأسرة، تتميز بتسلسل قرابيّ معين يتفق مع نظام سكنيّ خاص، لذلك هي: (وحدة مكانية) لها خصائص ووظائف خاصة بها، تختلف عن خصائص الأُسرة والقبيلة ووظائفها (2)، وذهب النويريّ إلى أنَّ: " العشائر واحدها عشرة، وهم الذين يتعاقدون إلى أربعةِ أباء، وسُمِّيَتْ بذلك لمعاشرة الرجل إياهم ... وهم يجتمعون في الجد الرابع، فمن هنا جرت السنة بالمعاقلة إلى أربعة أبا (3).
أما القبيلة فهي: وحدة اجتماعية تجمع عدة عشائر أو مجتمعات محلية، تنتشر في المجتمعات البدائية، وتتميز بما يأتي: 5.
ص: 230
1- ينظر: علم اجتماع الأدب / 351 - 352.
2- ينظر: الانثربولوجيا الاجتماعية، د. عاطف وصفيّ / 107 - 112.
3- نهاية الأرب في فنون الأدب، السفر الثانيّ / 285.
1 - وحدة المكان واللغة والثقافة.
2 - يسكنون أرضاً مشتركةً، ويطبقون أنماطاً حضاريةً مشتركةً.
3 - للقبيلة تنظيم سياستيّ ممثل برئيسها، ويحظى باحترام الجميع، ولها مجلس استشاريّ يسمى: (مجلس القبيلة)، يتكون في الغالب من رؤساء العشائر.
4 - تنظم القبيلة وسائل الدفاع والحرب (1).
و على وفق ما تقدم تُعدُّ (القبيلة) الجماعة الكلامية (speech communities)، وتدلُّ على جماعة تُعرف على أساس اللغة، تسمى في علم اللغة الحديث بمصطلح: (الجماعة اللغويّة Linguistic communities) وتعطي المعنى نفسه، أو إحدى مصاديقها (2).
ويُعدُّ تعريف جون ليونز (gohn lynos) (3) للجماعة الكلامية أبسط أنواع التعريفات، وتعني الجماعة الكلامية هي كلُّ الناس الذين يستخدمون لغة أو لهجة بعينها (4)، ويمكن على هذا الأساس أنْ تتراكب الجماعات الكلامية أو تتشابك، وعندئذ يكون هناك أفراد مزدوجو اللغات، دونما حاجة إلى أن تتميز الجماعة الكلاميّة بالوحدة الاجتماعيّة أو الثقافيّة فاللغة إذًا هي الرابط الحقيقيّ بين أفراد القبيلة، وعلى أساسها تُميز كلّ قبيلة من غيرها، لذلك يقال لغة الحجاز ولغة تميم ولغة طيء ...وهكذا، جاء في نهج البلاغة حينما سُئل الإمام (علیه السلام) فأجاب " أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ، [تُحِبُ] نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ وَ النِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ؛ وَ أَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْياً وَ أَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا؛ وَ أَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا وَ أَسْمَحُ عِنْدَ 2.
ص: 231
1- ينظر: نفسه / 113 - 115.
2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د هندسن / 51.
3- عالم لغويّ انكليزيّ معاصر، له عدة مؤلفات، منها: (علم اللغة التركيبيّ 1963 م) و (أفاق جديدة في علم اللغة 1970م) و (علم الدلالة 1977 م) و (علم اللغة النظريّ 1980 م) و (اللغة وعلم اللغة 1980 م) وللأخير عدة طبعات. (ينظر: معجم أعلام التربية والعلوم الإنسانية / 61).
4- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د هندسن / 52.
الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، وَ هُمْ أَكْثَرُ وَ أَمْكَرُ وَ أَنْكَرُ، وَ نَحْنُ أَفْصَحُ وَ أَنْصَحُ وَ أَصْبَحُ " (1) أبرز ما تتميز بها القبيلة هي الصفات الاجتماعيّة واللغة.
وممّا هو خليق بالذَّكر أنَّ البناء الاجتماعيّ في العصر الجاهليّ مُؤلف من ثلاث طبقات: أبناء القبيلة الذين يؤلف بينهم رابط الدم، وهم عمادها، والعبيد أي رقيقها، المجلوب من البلاد الأجنبية المجاورة، والموالي وهم عتاقها، وهؤلاء يدخل فيهم الخلعاء المنفيون من لدن قبائلهم بسبب جناياتهم، وينتمون إلى القبائل الجديدة كأبناء لها.
وفي هذا الاتجاه سار الإمام علي (علیه السلام) بوصفه فرداً من أفراد ذلك المجتمع؛ إذ تؤكد الإشارات أنّ الإمام (علیه السلام) كان يعرف اللغات، ومنها (لغة الزط)، هم جنس من (السودان والهند) (2)، وعندما وصل إلى النهروان اجتمع له أُناس من أهل (بادوريا)، وهي قرية بالقرب من واسط، فأجابهم بالنبطية (3)، وكان (علیه السلام) يعرف الفارسية، وذلك عندما أجاب بنت الملك (يزد جرد)، فقد سألها عن اسمها بالفارسية؛ فقالت (يزد جها نيه (سيد العالم) فقال (علیه السلام): شهر بانويه (سيدة المدينة) (4).
بل إنَّ الإمام كان يعرف لغة قيس وتميم والحجاز وكنعان ... وسواها، ونهج البلاغة حافل بهذه اللغات التي سوف نتطرق لها في مباحث قادمة (5).
ولما كانت خلافة الإمام في الكوفة، استقبلت هذه المدينة عدة قبائل (جند الكوفة) في أثناء خلافته (علیه السلام)، ومن ثم استقبلت ألفاظ الأعراب من مختلف القبائل.
ص: 232
1- نهج البلاغة، حكمة / 120 / 490 - 491.
2- ينظر: أصول الكافيّ، الكلينيّ 7 / 259، وينظر: من لا يحضر - الفقيه، الشيخ الصدوق 3 / 150، تحقيق علي اكبر غفاريّ، ط 4، قم، 1404
3- مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب محمد بن علي (ت / 588 ه) 1/ 332، المطبعة الحيدرية، النجف،1376 ه - 1956 م).
4- ينظر: الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفيّ الكوفيّ (ت/ 283 ه) 2 / 826، تحقيق: جلال الدين المحدث، ط2، قم.
5- ينظر: المبحث الثاني من الفصل الرابع (الأزدواج اللهجيّ).
العربية التي اجتمعت للإمام، فأخذ يخطب فيهم بألفاظ تلك القبائل التي يبدو قسم من مفرداتها غريباً عن القبائل الأخرى، ولكن الغلبة في مفردات نهج البلاغة للهجة (تميم) الحروبهم الكثيرة، فمنهم من كان مع الإمام، ومنهم من كان مع خصومه من الأمويين، على أنَّ اللهجة التميمية كانت حاضرة في جنوبي العراق ووسطه، فضلًا عن أنَّ الإمام كان يكن الاحترام لقبيلة تميم، ومنه قوله (علیه السلام) إلى عبد الله بن عباس، عامله على البصرة: " وَ قَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي تَمِيمٍ وَ غِلْظَتُك عَلَيْهِمْ، وَ إِنَّ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ إِلَّا طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ وَ إِنَّهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا بِوَغْمٍ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لَا إِسْلَامٍ، وَ إِنَّ لَهُمْ بِنَا رَحِماً مَاسَّةً وَ قَرَابَةً خَاصَّةً، نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا وَ مَأْزُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا" (1)، وقد بلغت الألفاظ (تنمرك) و (الوغم) و (مأزورون) منحى اجتماعيًا عظيمًا، فالتنمر للقوم الغلظة عليهم، والمعاملة لهم بأخلاق التنمر من الجرأة والوثوب، لأنّهم أو الكثير منهم كانوا الركن الركين للجمل وهو دجه.
أما الوغم؛ فمعناه: ما تساقط من الطعام وهو القَهْر والذَّحْلُ والتَّرة، والاوغام، أي لا يُهدد لهم ذم في جاهلية ولا إسلام، وهو يصفهم (علیه السلام) بالشجاعة والحمية، ومن مآثرهم (ما ملأت السهل والجبل) (2).
و (مأزرون) كان أصلها (موزورون)، ولكن جاء بالألف ليحاذي به ألف (مأجورون) على طريقة بني تميم في (النبر)، وهو نصُّ قول النبي (صلی الله علیه و آله و سلم): "ارجعن مأزورات غير مأجورات " (3).
أما عبارة (وإن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع لهم أخر) تدلّ على القيادة الرائدة والسائدة العظيمة لهذه القبيلة، التي ما مات منها سيد إلّا قام سيد مكانه.).
ص: 233
1- نهج البلاغة، كتاب / 376/18.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة، 15 / 85.
3- اخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ماجاء في اتباع النساء بالجنائز (1578).
وأشار الإمام علي (علیه السلام) إلى التقاء نسبه بنسب بني تميم بقوله: (وَإِنَّ لهُمْ بِنَا رَحِمًا مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَّةً)، إذ يلتقيان في إلياس بن مضر (1).
أما (القرابة الخاصة) فيقصد بها الإمام (علیه السلام) تلك الخصال الحميدة التي كان يتصف بها بنو تميم على الرغم من إتباعهم طلحة والزبير في معركة الجمل، ولكن هذا لا يمنع من الإحسان لمن أساء، كما جاء عنه (علیه السلام): " عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ " (2).
ويدلُّ النصُّ المتقدم عموماً على اهتمام الخليفة بالقبائل العظيمة، لذا يصف مالك الأشر ب (أخي مذْحج) بقوله مخاطبًا أهل مصر " أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ، وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ " (3).
وجاء في نهج البلاغة " ... وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ وَ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنبَارَ ... " (4) و (أخو غامد) هو سفيان بن عوف بن المفضل الغامديّ، وغامد قبيلة من اليمن، وهي من الأزد، أزد شنوءة، وأسم غامد عمر بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، وسُمِّيَ غامدًا؛ لأنَّهُ كان بين قومه شرٌ، فأصلحه، وتغمدهم بذلك (5).
ومن اهتمام الإمام (علیه السلام) بالعشيرة ما جاء في نهج البلاغة على نمط الوصية لجميع أفراد المجتمع، متأثرًا بما ورد عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أنَّه قال: " لا صدقة وذو رحم محتاج "، سالكاً في ذلك سبيلًا غير النصِّ، كالاستحسان لينفق الأغنياء على أقاربهم الفقراء، كترغيب الفتى الباذل في الذكر الجميل التي أشار إليه (علیه السلام) بقوله "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ عَنْ عِتْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَلْسِنَتِهِمْ، وَ هُمْ أَعْظَمُ.
ص: 234
1- ينظر: في ظلال نهج البلاغة 430/3.
2- نهج البلاغة، حكمة / 501/158.
3- نفسه، كتاب / 412/38.
4- نفسه، خطبة / 70/27.
5- ينظر: شرح نهج البلاغة 2/ 286.
النَّاسِ حَيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ وَ أَلَمُّهُمْ لِشَعَثِهِ وَ أَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِذَا [إِنْ] نَزَلَتْ بِهِ، وَ لِسَانُ الصِّدْقِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ [يُوَرِّثُهُ غَيْرَهُ] يَرِثُهُ غَيْرُهُ ...
أَلَا لَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَ لَا يَنْقُصُهُ إِنْ أَهْلَكَهُ، وَ مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ وَ تُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ، وَ مَنْ تَلِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ." (1).
وعلق الرضيّ (رحمه الله) على هذا النصّ بقوله: " ما أحسن قول الإمام (علیه السلام) من يقبض يده عن عشيرته ... "، فإنَّ الممسك خيره عن عشيرته، إنَّما يمسك نفع يدٍ واحدة، فإذا احتاج إلى نصرتهم واضطر إلى مرافدتهم قعدوا عن نصره، وتثاقلوا عن صوته فتمانع ترافد الأيدي الكثيرة، وتناهض الأقدام الجمة " (2)، نلحظ في النصِّ الأمرَ بالاعتضادِ بالعشيرة، والتكثر بالقبيلة، فإنَّ الإنسان لا يستغني عنهم وإنْ كان ذا مال.
ولعل ما يقف وراء تصنيفات علماء الإنسان لانواع التجمعات بناءً على حجمها، وهي القيمة المفرطة التي يوليها العرب لأهمية العدد، إذ كلما اتسعت قبيلة ما، ضمّت محاربين أكثر، فكان لها نفوذ ومجد،كبيران قال الشاعر (3):
تُعَيَّرُنَا إِنَّا قَلِيْلٌ عَدِيدُنَا *** فَقُلتُ لَهَا إِنَّ الكرامَ قلِيلُ
وفي نهج البلاغة نجد بعض الأوصاف أُطلقت على (العشيرة) وأُخرى على القبيلة، ففي قوله (علیه السلام): " ... رَايَةُ ضَلَالٍ قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا وَتَفَرَّقَتْ بِشُعَبِهَا ... " (4) يصف القبيلة العظيمة، وليس التّفرق للرأية نفسها، بل لأصحابها،.
ص: 235
1- نهج البلاغة، خطبة / 66/23.
2- شرح نهج البلاغة 1/ 204.
3- البيت الشعريّ للشاعر عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثيّ. (ينظر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقيّ، القسم الأول / 111).
4- نهج البلاغة، الخطبة 108/ 157.
فحذف المضاف، ومعنى تفّرقهم، أنَّهُ يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة في بلاد متفرقة، أي تفرق ذلك الجمع العظيم في الأقطار (1)
أما وصفه (للعشيرة) بالزوافر ما نجد في قوله (علیه السلام) في ذم أصحابه في التحكيم: " ما أَنتُمْ بِوَثِيقَةٍ يُعْلَقُ بِهَا وَلَا زَوَافِرِ عِزٍّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا لَبِئْسَ حُشَّاشُ نَارِ الحَرْبِ أَنْتُمْ" (2).
ومن مواطن الإعتضاد بالعشيرة ما جاء في نهج البلاغة " ...وَ أَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَ أَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ" (3)
إنَّ استعمال أسلوبي الأمر والتعليل في النصِّ؛ لتأكيد الإعتضاد بالعشيرة؛ لأنَّ قوة الفرد في مجتمعه من قوة عشيرته.
لقد بيّن الإمام (علیه السلام) أنَّ الفرد باستطاعته أن يكون عشيرة، إذا تخلق بأخلاق الله عزّ وجلّ، ومن ذلك قوله (علیه السلام): " الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ" (4)، وقد جاء هذا المضمون في النبي إبراهيم (علیه السلام)، إذ جاء في التنزيل قوله تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) النحل / 120.
ومن هذه الأخلاق التي تجعل الفرد المؤمن بمنزلة الجماعة قوله: " وَلاَ يَدْعُوَنَّکَ شَرَفُ امْرِئ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا کَانَ صَغِيراً، وَلاَ ضَعَةُ امْرِئ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا کَانَ عَظِيماً" (5).
وتدلُّ هذه الحكمة على النهي الموسوم بالوصية، وبإتباع الأمور على واقعها من غير النظر في شرف الرجل ووضعه في التعظيم والتحقير، لذا لم يترك الإمام (علیه السلام) عشيرته من وصيته حينما ضربه ابن ملجم، إذ قال: " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا.
ص: 236
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 7/ 131.
2- نهج البلاغة، خطبة / 184/125.
3- نهج البلاغة، خطبة/ 406/31.
4- نفسه، حكمة / 418/ 551.
5- نهج البلاغة، كتاب / 53 / 435.
أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً، تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي، انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ؛ وَ لَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُور" (1).
فنجد في النصِّ توكيد القول: (قُتل أمير المؤمنين)، هذا التوكيد يصور لنا حال أهل المقتول حينما يطالبون بالثار من قاتله، وهي صورة اجتماعيّة مألوفة في جميع المجتمعات، تمثل حديث النفس المتكرر لعظم المصيبة والفاجعة.
إنَّ الإمام (علیه السلام) قابل هذا التأكيد بتأكيد آخر يقي القوم من الوقوع في المعصية، وهو طريق إرشاديّ لجميع الناس، وذلك حينما قال (علیه السلام): (انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ) توكيد أنّ سبب الموت هو عمق الضربة وشدّتها، لا سبب آخر، لأجل أن يعظ جميع الناس من القتل الخطأ، وهو توكيد للمضمون القرآنيّ قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) الإسراء/ 15. وقد سبق هذا التوكيد قوله (علیه السلام): (أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي) وهو تؤكيد آخر لمضمون الآية المذكورة آنفاً، ثم جاءت العدالة الاجتماعيّة في أعظم صورها حينما قال (علیه السلام): (فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ) توكيدًا لفظيًا ليحدد لهم العدالة المطلوبة في القصاص.
ولا يخلو مجتمع من ظاهرة الفخر والاعتزاز بالحسب والنسب ويقرن ذلك بالشجاعة وقوة البأس، إذ جاء في نهج البلاغة قوله (علیه السلام) في جواب له عن كتاب المعاوية: " وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ؛ مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ وَ بِالسَّيْفِ مُخَوَّفِينَ؟ "فَلَبِّثْ قَلِيلًا يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ"؛ فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ وَ يَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ؛ وَ أَنَا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ، أَحَبُّ اللِّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ؛ وَ قَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
ص: 237
1- نفسه، کتاب / 47/ 423.
بَدْرِيَّةٌ وَ سُيُوفٌ هَاشِمِيَّةٌ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وَ خَالِكَ وَ جَدِّكَ وَ أَهْلِكَ، "وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ". هود / 83 " (1).
ومن صور التقابل إعتماد الحسب وترك العمل بحجة المكانة الاجتماعيّة: " مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " (2).
ومن السنن الإلهيّة الدائمة التي تضمّنتها حكم نهج البلاغة: "مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَد" (3)؛ إذ إنَّ الإنسان قد ينصره من لا يرجو نصره وإنْ أهمله أقاربه وخذلوه، فقد تقوم به الأباعد من الناس، وقد وجدنا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ضيعه أهله ورهطه من قريش وخذلوه، واجتمعوا عليه فقام بنصره الأوس والخزرج، وهم أبعد الناس نسبًا منه، لأنَّهُ من عدنان وهم من قحطان وكلّ واحد من الفريقين لا يحب الآخر حتى تحب الأرض الدم.
وقامت ربيعة بنصرة الإمام علي (علیه السلام) في صفين وهم أعداء مضر، الذين هم أهله، ورهطه وقامت اليمن بنصرة معاوية في صفين، وهم أعداء مضر ولو تأملنا السِّير لوجدنا هذا كثيرًا شائعا (4).
لقد حذر الإسلام من التعصب للعشيرة أو القبيلة وصرح الإمام (علیه السلام) في خطبته (القاصعة) بأنَّ المجتمع الإنسانيّ الحق لا يمكن أن يجتمع مع النزعة القبيليّة، لأنَّ هذه النزعة ما هي إلّا أرث شيطانيّ يزينه الشيطان لأوليائه، ويؤكد الإمام أنَّ الشيطان أحق بالمحاربة من هولاء الضعفاء الذين يقع عليهم الظلم، ويلحق بهم الحيف بسبب النزعة القبيليّة، جاء في نهج البلاغة " فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ وَ أَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنِدَائِهِ وَ أَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ؛ فَلَعَمْرِي لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ.
ص: 238
1- نهج البلاغة، كتاب / 28/ 389 - 390.
2- نفسه، حكمة / 23 / 473.
3- نفسه، حكمة / 14 / 472.
4- ينظر: شرح نهج البلاغة 18 / 269.
وَ أَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، فَقَالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَذْفاً بِغَيْبٍ بَعِيدٍ وَ رَجْماً بِظَنٍّ غَيْرِ مُصِيبٍ صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ وَ إِخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ وَ فُرْسَانُ الْكِبْرِ وَ الْجَاهِلِيَّةِ (1).
ثم جاء الإمام (علیه السلام) بالشواهد القديمة، مستعملًا الوظيفة التاريخيّة، بوصفه وسيلة إقناع تداولية في تبصير المستمعين؛ كي يعتبروا، فالواقع الاجتماعيّ المزري جرَّ أُممًا قبلهم إلى الانهيار، وجدير بهم أن يعتبروا بمن قبلهم ممّن غفلوا عن عدوهم الكامن في أعماقهم، وصرفوا - بإغوائه وإحائه - عدوانهم إلى إخوانهم في الدين والإنسانية، قال (علیه السلام): " فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ مَثُلَاتِهِ، وَ اتَّعِظُوا بِمَثَاوِي خُدُودِهِمْ وَ مَصَارِعِ جُنُوبِهِمْ، وَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ كَمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ " (2).
وفي الخطبة نفسها يذكر الإمام (علیه السلام) حال العرب قبل الإسلام كيف كانوا ثم كيف اتحدوا، فأصبحوا يُطاعون في بلاد كانوا فيه أذلة ضعفاء، ثم ذكر أنّ أعظم ما أمتن الله به على العرب أن جمعهم، وألف بين قلوبهم وجعلهم أخوانًا، قال (علیه السلام): " فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِ امْتَنَ عَلَى جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأُلْفَةِ الَّتِي [يَتَقَلَّبُونَ] يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا وَ يَأْوُونَ إِلَى كَنَفِهَا بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيمَةً لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ وَ أَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ(3).
إذا كانت الأُلفة والأخوة الإيمانية هي أساس البناء الاجتماعيّ الإسلاميّ، فإنَّ المجتمع الجاهليّ قد سادته الانشطارات والانصهارات القبيليّة، والأخوة المتحولة إلى عداوة زمن الصراع، وهذا ما يمكن أن نستشفه أو نلمس ما يشابههُ من الصراعات.
ص: 239
1- نهج البلاغة، خطبة/ 288/192.
2- نفسه، خطبة / 192/ 291.
3- نفسه / خطبة 192/ 299.
الحربية القبيليّة في ذلك العصر، ولاسيما الحروب بين القبائل ذات الأصل الواحد، كالحروب بين عبس وذبيان والأوس والخزرج، وبكر وتغلب.
وهكذا تحولت الرابطة القبيليّة (الدم والنسب) في المجتمع الجاهليّ إلى رابطة (الأخوة الإيمانية) في المجتمع الإسلاميّ.
وفي الغالب يكون رؤساء القبائل هم أصحاب المصلحة في استشراء العصبية القبيليّة، والتفكك الاجتماعيّ، والطبقة الفارقة، فلو وعى هؤلاء الناس الحياة الاجتماعيّة الصحيحة، وراعوا المصلحة العامة وحدها لما بقيت لهؤلاء الرؤساء قيمة لأنَّ وجودهم منوط بهذه العصبية، وقد عرف الإمام (علیه السلام) ذلك، فوجه إليه صفعة مدوية حين صرخ بالناس محذرًا:
"أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَ كُبَرَائِكُمْ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ وَ أَلْقَوُا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ جَاحَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِآلَائِهِ، فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ وَ دَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ وَ سُيُوفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً وَ لَا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً، وَ لَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ وَ خَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ وَ أَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ، وَ هُمْ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ أَحْلَاسُ الْعُقُوقِ، اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ وَ جُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اسْتِرَاقاً لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ وَ نَفْثاً فِي أَسْمَاعِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ وَ مَأْخَذَ يَدِهِ." (1).
كان الإمام (علیه السلام) بوصفه قائد الجماعة وزعيم المجتمع المسلم يشعر بواجبه الشرعيّ في توجيه الجماعة الحاضرة، وبيان مصداقية خطابه عبر سلسلة من الحوارات الخطابية، فكان لا بُدّ لمثل ذلك أن ينتج عنه احتمالان: الامتثال أو التّمرد، وترشح الاحتمال الثاني في سلوكيات أفراد المجتمع في الغالب منذ اللحظات الأولى لتوليه الخلافة؛ لأنَّ الصراع الذي واجه الإمام (علیه السلام) ليس صراعاً عسكريًا أو سياسيًا أو.
ص: 240
1- نهج البلاغة/ 290 - 291.
اقتصاديًا، وإنّما كان صراعًا فكريًا في الدرجة الأولى، فإنَّ التأسيس لثقافة تنسجم مع روح الإسلام ودعوته لا يمكن أن تنجح وسط مجتمع يعيش عقوداً في حروب متواصلة، بثقافة مبتورة انتقائيّة طغت على المجتمع لعقودٍ من الزمن، وهنالك جيل من الولاة والأمراء الشباب الطامعين إلى المجد والسلطة والشهرة فضلًا عن الولاءات القبلية التي باتت تهدد الولاء الدينيّ، لذلك استعمل الإمام (علیه السلام) التوكيد اللفظيّ في عبارة: (ألا فالحذر الحذر)، إذ إنَّ المجتمع قد سلك طريقاً مختلفاً تماماً عن الطريق الذي سلكه الإمام (علیه السلام).
وعلى هذا النسق العاليّ من البيان الشامخ يمضي بنا الإمام (علیه السلام) في بيان أمراض المجتمع ولا سيما العصبية القبيليّة، ويكشف عن أسبابها النفسيّة، ويبرهن بذلك عن وعي خارق للعمليات الاجتماعيّة، وأسباب انحرافها، وطرق إصلاحها (1).
وبذلك نجد في نهج البلاغة صوراً لنظرة الإسلام المُبدِعة وعمقها في العشيرة والقبيلة، وما يحكم كلَّ واحدةٍ منها من أنظمة و آواصر تمثل التجربة الفذة، التي استوحاها مُبدِعهُ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، فإنَّ الفرد ليس مجرد (آلة تصوير اجتماعية) يعكس صورة دقيقة وحقيقية لماضيه في إنموذجه التصويريّ، أي بالأسلوب نفسه الذي يستطيع به جهاز التسجيل تسجيل الماضي القريب، وإنَّما يدّون تجاربه بعد تنقيتها بوساطة مرشح يمثل مجموعة تجاربه الحديثة وإنموذجه الحاليّ (2) لذلك نجد رؤية الإمام (علیه السلام) في نهج البلاغة قد امتلكت حساسية في الكشف عن عالم رحب متناقض حتى أصبحت هذه الرؤية ذاتاً مُؤرّخة بالأحداث الاجتماعيّة، أعطتنا محاور مهمة عن شخوص، ورموز، وزمان ومكان، ووقائع مخيفة، مرَّ بها التاريخ فكشفت هذه الرؤية عمق التجربة الشخصيّة لقائد تاريخيّ حملت وراءَهُ مسائل العصر ... ونجد وعيه (علیه السلام) بلور الرؤية ليس بوعي مجرد، وإنَّما هو وعي مقترن بمفاهيم.
ص: 241
1- ينظر: دراسات في نهج البلاغة، الشيخ محمد مهدي شمس الدين / 163.
2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. هدسن / 34.
إنسانية (أخلاقيّة، واجتماعيّة) (1)، إذ من الكشف الحاصل في حقيقة خطاب نهج البلاغة يمكننا تصور البنية التي يقوم عليها هذا الخطاب، فتنظيم العلاقة بين الفرد وأُسرته وعشيرته وقبيلته لا تكون على أساس الفوقيّة الانتمائيّة التي تجبر الآخرين على الإتباع والانقياد للسلطة، وإنَّما تكون على أساس الخصال الحميدة التي تسود المجتمع المسلم بعيداً عن التزلفات القبيليّة التي قد تسبب انهياراً للقيم الدينية، والعودة بالمجتمع الحديث التدين إلى منزلقات التقوقع، وهذا ما أشار إليه الإمام (علیه السلام) في كثيرٍ من مواقفه الخطابيّة، وسرده لأحداث التاريخ، وبيان أنَّ عدم إتباع الرسل على النحو الأمثل المطلوب، وتطبيق تعاليمهم، إنَّما سيؤدي إلى الانحدار أو الانهيار..
ص: 242
1- ينظر: سلسلة قراءات في انطباعية نهج البلاغة، علي حسين الخباز / 18، العتبة العباسيّة المقدسة - قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة - شعبة الإعلام، ط 1 / 2000م.
المبحث الثاني / الظاهرةُ الثّقافيّةُ (الأعراف والعادات والتقاليد)
يصعب تحديد معنى الثقافة بدقة؛ لأنَّ علماء الاجتماع وعلماء الانثروبولوجيا استعملوها بمعان متنوعة، وقد أُحصيت ب (مئة وستين) تعريفًا (1). إذا تتبعنا مراحل تطور هذه الكلمة وجدناها عبّرت في الأصل عن وضع اجتماعي أصاب نوعًا من التقدم، وأصبحت عند ذلك المجتمع مكتسبات يرثها جيل عن جيل.
ويُعدُّ تعريف (تايلور) للثقافة: (الاكتساب والتوارث) أكثر شمولًا، فهي في نظره ذاك الكلّ المُعقد الذي يضمُّ معاً العلوم والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والأعراف وجميع الاستعدادات والعادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه فرداً في المجتمع (2)، وأبرز ما يميز الثقافة أنَّها ترتبط بالحياة (من إعتقادٍ ودينٍ وأدبٍ وأعرافٍ ... وسواها) (3) قُبالة الحضارة التي تختصُّ بالتقنيات والتنظيمات الاجتماعيّة.
ويرى (لالو ونيلس) أنَّ الثقافة ترتبط بكلِّ جهد يوجهه الإنسان نحو ذاته، ليدفعها في طريق الكمال، في حين ترتبط الحضارة بأفعال الإنسان الموجهة نحو إحداث التعديلات في العالم التي تتجسد في أعماله (4).
ولما كانت اللغة تستمد أهميتها في الدلالة على ثقافةٍ معينة من أُمها، موازية لوجود تلك الثقافة، تتبادل وإياها الوظائف في موضوعات التعبير، وتعيرها رموزها لتجسيد هذه الموضوعات فنتج عن ذلك التلازم الذي يولد التآخي والتشابه، حتى غدت الثقافة محدودة بحدود اللغة، مع أنَّ اللغة جزءٌ من الثقافة، وهذا يعني بمجملهِ
ص: 243
1- ينظر: علم اجتماع الأدب / 197.
2- ينظر: La sociologies Duct, Maraa bout Tom p: 71.
3- ينظر: نفسه: 50: p.
4- ينظر: نفسه.
أنَّ اللغة تسيطر على التفسير الثقافيّ، وقد أثار العالم النفسيّ الأمريكيّ (دونلاب) فكرة إمكان اكتشاف شيء جديد من حياة المجتمع بوساطة تحليل لغته، فعندما ندرس البنية اللغويّة لشعب من الشعوب، فنحن ندرس أساليب تفكيره، وعندما ندرس مفرداتها نتعرف أنماط التمييز عنده، ولا نبعد عن الحقيقة إذا وصفنا اللغة بأنَّها تبلور لتفكير الشعب (1)، أو كما عبر عنها ابن جني: " أصوات يعبر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم " والأغراض دليل تفكير الشعوب وسلوكه.
ومن وجوه الاستعمال الرمزيّ للتعبير اللغويّ الأمثال السائرة، التي هي خلاصة تجربة إنسانيّة أو اجتماعيّة غدت أنموذجَا لنمط من التعرف أو السلوك في حادثة أو موقف أو قصة.
فالرمز في العبارة المثليّة قد لا يؤدي معناها الظاهر أي دلالة واضحة، إِنَّهُ يُلخصُّ التجربة التي تحمل عظةً، وتذهب مثلًا. وهذه التعابير الرمزيّة هي أصعب أنواع الرموز فهمًا، إذ لا يكون بين الدال والمدلول عليه أي صلة معروفة، فلا يمكن إدراك معناها الحقيقيّ إلّا بمعرفة القصة أو الحادثة، وهذا يقصر فهمها على أبناء الجماعة الذين يتناقلون تجاربها، ويظلّون على اطلاع على معجم مصطلحاتها (2).
وفي نهج البلاغة نجد أنَّ التراث الثقافيّ العربيّ قد تجلى بوضوح ضمن أُطر اجتماعيّة الفرد (الإمام (علیه السلام))، إذ إنَّ شدّة الحافظة التي اشتهر بها (علیه السلام) أمكنته من استظهار التراث الثقافيّ العربيّ، وقد أخبرنا (علیه السلام) عن شدّة تلك الحافظة بقوله (علیه السلام): " إنّ ربي قد وهب لي قلبًا عقولاً " (3) ومن مظاهر ثقافته العامة أحكامه على الشعر، جاء في نهج البلاغة: عندما سئل: من أشعر الناس. فقال (علیه السلام) "إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي.
ص: 244
1- ينظر: Les texts De La sociologie mode p: 99.
2- ينظر: علم اجتماع الأدب / 234.
3- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهانيّ 67/1، مصر - الخانجيّ.
حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَالملِكُ الضِّلِّيلُ " (1) ويقصد به امرأ القيس.
وظاهرة العادات والأعراف والتقاليد علامة تحكي لون حضارة كلّ أمة، وتعبّر عن مدى ارتباطها بالمعاني الإنسانية الموروثة، وتصف مضامين هذه المعاني وما تنطوي عليها من قيم وأهداف على نحو أمثال تتداول بين المجتمعات من جيل إلى آخر.
إنَّ العبارات التي جرت بين الناس أمثالاً تُذكر ويُستشهد بها، إنَّما هي خلاصة تجارب أجيال من الناس، صاغوها وبلوروها ممّا عرض لهم من حوادث الزمان ووقائع الأيام.
لقد أشار أحد الباحثين (2) إلى دلالة عبارة المثل على القصة أو الحادثة التي قيل فيها المثل، وهي على ما يبدو دلالة ضمنيّة، تنطوي تحت دلالته على عموم المماثلة، فالنسبة بين موقف سابق وموقف لاحق كالشبة بين شيئين متقابلين، وفي ذلك قال الزمخشريّ: " ثم سُمِّيَتْ هذه الجملة من القول، المُقتضَبة من أصلها، أو المُرسلة بذاتها، المُتسمة بالقبول المُشتهرة بالتداول، مَثَلًا، لأنَّ المحاضر بها يجعل موردها مثلاً ونظيراً لضربها" (3)؛ وهذا يدلُّ على أنُّ الأمثال عموماً تمثّل مغزىّ اجتماعيًّا، انتُزع من موقف إنسانيّ أو قصة تظهر مجموعة مواقف، وهذه المواقف تمثّل وقائع (قصة) حدثت في ظروف معينة.
وهذه الوقائع مثلت فيما بعد عرفًا أو تقليدًا اجتماعيًّا، جمع شتات تلك القصة في عبارة مُوجزة في اللفظ مُكثفة في الصورة، تمثل حصيلة ما يؤديه المغزى العام لتلك القصة..
ص: 245
1- نهج البلاغة، حكمة / 455.
2- ينظر: على سبيل المثال، الأمثال في القرآن الكريم، محمد جابر الفياض / 137، دار الشؤون الثقافيّة العامة، بغداد، 1988 م.
3- المستقصى في أمثال العرب جار الله الزمخشريّ، المقدمة، عنى به محمد عبد الرحمن خان لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة العثمانيّة، دائرة المعارف حيدر آباد الدكن، الهند، 1962م.
فالعبارات المثلية على وفق ما تقدم تمثل نظرة أُمة إلى الحياة ورأيها في تفصيلات الاجتماع ومظاهر الأخلاق، مُعبّرة عن ذلك كلّه بأدوات لغويّة مُوصولة بوسائل حياة الناس، وبأساليب عيشهم.
وكان للعرب النصيب الأوفر من الأمثال الدالة على أعراف المجتمع وتقاليده وهي تنطق بحكمة الحياة، صاغوها في إطار المناخ العربيّ الجاهليّ أو الإسلاميّ - من تجارب الحياة اليومية - عبر مجتمعات متصلة بصلات ثقافيّة وتاريخيّة ولغويّة، تمثل في مجموعها الصلات الاجتماعيّة جاء في نهج البلاغة: " وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ " (1).
فالأمثال تمثل عقليّة قائلها، أو قلْ عقليّة المجتمع؛ لأنَّ الأمثال إِنَّما جاءت نتيجة تجارب اجتماعيّة متعددة، تجسدت من طريقها حقيقة اجتماعيّة، صاغها قائلها بقوالب لغويّة، انمازت بالدقة والتركيز والإيجاز؛ فعقلها المجتمع، لما تخفيه في طياتها من مضامين اجتماعيّة قصصًا تمثلت بأعراف وتقاليد وعادات.
لذا أخذ المتكلمون هذا المعنى، وقالوا: العقل نوعان غريزيّ ومُكتسب فالغريزيّ، يتمثل بالعلوم البديهيّة، والمُكتسب، يتمثل بما أفادته التجربة وحفظته النفس (2).
ومن الألفاظ الصحراويّة التي باتت غريبة وظلّت كذلك، منذ أن أظهرها الإمام علي (علیه السلام) في نهج البلاغة إلى القرن الثاني الهجريّ، حينما سجّلها أبو عبيد القاسم بن سلّام (ت / 224 ه) في كتابه (غريب الحديث) (3) لفظة (اللَّدم). جاءت هذه اللفظة في كلام الإمام علي (علیه السلام) لما أُشير عليه بألّا يتبع طلحة والزبير ولا يقاتلهما، فقال (علیه السلام): ه.
ص: 246
1- نهج البلاغة، كتاب / 403/31.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 269/16.
3- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ (ت / 224 ه) 3 / 436، الهند - 1976 ه.
"وَاللَّهُ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ، حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا، وَيَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا ..." (1).
و اللدّم صوت الحجر أو العصا أو غيرهما، تضرب به الأرض ضرباً ليس بشديد (2) ومعنى النصِّ هو: لا أقعد عن الحرب والانتصار لنفسيّ وسلطانيّ، فيكون حالي مع القوم المشار إليهم، حال الضبع مع صائدها، والعرب تقول في رموزها وأمثالها: "أحمقُ مِنَ الضَّبُعِ" (3).
ويأتي حُمق الضَّبُعَ - كما تزعم العرب (4) - من أنَّهم إذا رموا في جحرها بحجر، أو ضربوا بأيديهم باب الحجر، فتحسبه شيئاً تصيده، فتخرج لتأخذه، فتُصاد عند ذلك، ويبلغ من حُمقها أنَّ الصائد يدخل عليها وجَارَها، فيقول لها: أُطرقي أمّ طُرِّيق، خامري أمَّ عامر، أي طأطئي رأسك، فقالوا: فتلجأ إلى أقصى مغارها، فيقول: أمُّ عامر ليست في وجرها، أمُّ عامر نائمة، فتمدُّ يديها وتستلقي، فيدخل عليها الصائد، فيوثقها، فيقول الصائد أبشري أمَّ عامر، فتَشدُّ عراقيبها، فلا تتحرّك، ولو شاءت أن تقتله لأمكنها، ومن هذا المعنى قول الكميت (5):
فعْلُ المَعَرَّة للمقا *** لة خامري يا أمَّ عامر.
ص: 247
1- نهج البلاغة، خطبة / 6/ 54
2- ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجواهريّ (ت / 393 ه) - (ل.د.م.) 5 / 2029، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة، 1956م.
3- جمهرة الأمثال أبو هلال العسكريّ، الحسن بن عبد الله (ت/ بعد 395 ه - ) 1/ 276، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، وعبد الحميد قطامش، 1384 ه.
4- ينظر: شرح نهج البلاغة 1/ 148.
5- شعر الكميت بن زيد الأسديّ (ثلاثة أقسام في جزأين) جمع داود سلوم (ت/ 2010م)، النجف الأشرف 1969م.
وقال الشَنْفَرى (1):
لا تقبروني إِنَّ قبريَ مُحرَّمٌ *** عليكم ولكن خامري يا أمَّ عامر
وقد توسع ابن سيده في معنى لفظة (اللَّدم) فقال: " لدمتْ المرأة صدرها؛ ضربته، ولدمتُ خبز الملة، ضربته" (2)، وزاد ابن منظور على السابقين في دلالة (اللَّدم) المعنوية بقوله: " ... وإنَّ اللّدم بمعنى اللطم والضرب بشيءٍ ثقيل يُسمع وقعُه " (3). ولفظة (اللّدم) من الألفاظ الغريبة، واختلاف دلالاتها في المعجمات إنَّما يدلُّ على غرابتها، ويؤكد هذه الغرابة أمران:
الأول: عدم توسع المعجم الحديث في دلالتها، بل أورد الدلالات السابقة القديمة؛ وذلك يدلُّ على عدم استعمالها حديثاً في دلالة جديدة.
والآخر أنَّها من الألفاظ الصّحراويّة التي انتقلت إلى الحضر عند ارتحال الأعراب من البدو. الذي يقصد إليه الإمام علي (علیه السلام) هنا معنی دقیق، بعيد عن الضرب، لأنَّهُ مستعار، وكأنه يقول: لن أقعد عن طلب الحق على الرغم من المكائد والدسائس، وكثرة الحروب، وقد كنى باللّدم عند الخديعة، كما يَخْدَع الضَّبُعَ صائدوها، فعلّق الإمام (علیه السلام) هذا المعنى الجديد (الخديعة) للّدم، وحده في أذهان المجتمع، وتحول إليه مدلول هذه الكلمة، وأصبحت دلالة صريحة فيهما، وانقرض معناها القديم في الاستعمال، وبقي مدوّناً في متون المعجمات فقط.
وجاء في موضوع آخر من نهج البلاغة: " وَالله لَا أَكُونُ كَمُسْتَمِع اللَّدْمِ؛ يَسْمَعُ النَّاعِيَ، وَيَحْضُرُ الْبَاكِيَ، ثُمَّ لَا يَعْتَبِرُ " (4) والنصُّ أيضاً خاص بطلحة والزبير، وعبارة: 8.
ص: 248
1- ديوان الشنفرى (ضمن مجموعة الطرائف الأدبية) / 36 لجنة التأليف والترجمة والنشر - مصر - / 1937 م.
2- المحكم ابن سيده علي بن إسماعيل (ت / 458 ه)، تحقيق: جماعة، القاهرة (1958 - 1972) 470/6 مادة (ل.د.م).
3- لسان العرب، ابن منظور محمد بن مکرم (ت/ 711 ه) 12/ 539، بيروت، 1374 ه.
4- نهج البلاغة، خطبة / 207/148.
«مستمع الدم» كناية عن الضَّبُع، تسمع وقع الحجر باب جحرها من يد الصائد، فتخذل وتكفّ جوارحها إليها، حتى يدخل عليها فيربطها، وكأنّه يقول: لا أكون مقراً بالضيم أسمع الناعي المخبر عن قتل عسكر الجملِ الحكيمَ بن جبلة وأتباعه، فلا يكون عندي من التعيير والإنكار لذلك، إلّا أن أسمع وأحضر الباكين على قتلاهم (1)، فأصاب لفظة (اللّدم) تطورًا دلاليًا وانتقاليًا من البيئة الصحراوية إلى البيئة الحضرية، ويعدّ التطور الدلاليّ من أسباب تطور اللغة، وما يعتري ألفاظها من مدلولات مجازيّة (2) في نطاقها سعةً أو ضيقاً.
والجدير بالذكر أنَّ الإمام (علیه السلام) كان كثير التمثيل بالضَّبُع وسلوكياته وصفاته، ففي قوله: " ... فما راعني إلّا والناس إلى كعُرْفِ الضَّبُعِ، ينثالون عليه من كلّ جانب ... " (3) يصف حال المبايعين له بالخلافة ب «عُرْفِ الضَّبُعِ»؛ لثخنهِ، وكثافته.
و (عُرْفُ الضَّبُعِ) ما كَثُرَ على عنقها من الشعر، وهو ثخين، يضرب به المثل في الكثرة والازدحام.
إنَّ استعمال الإمام (علیه السلام) هذا اللفظ بهذا التوظيف يوحي بمعرفته (علیه السلام) حياة الحيوان وطرائق عيشه وتعامله مع محيطه، وتأثره بالبشر وطرائق تعاملهم مع الحيوان فضلًا عن معرفته بصفات الحيوانات وتفاصيل تشريح أعضاء أجسامها، وما يضرب بها مثلًا للشجاعة والقوة والصبر والتحايل، وما يضرب بها مثلا للضعف والجبن والتسليم للأقوى وضعف الحيلة وحسن التخلص من المواقف العسيرة.
وهكذا أصبحت هذه العبارات أمثالاً يتداولها الناس، إذ حملة اللغة - شعراً ونثراً - ذخيرة واسعة من العبارات، منها ما تختصُّ بالضَّبُعِ وصفاته وسلوكياته عبر القرون، ونالت حظاً من التداول الاجتماعيّ في البيئات العلميّة وغير العلميّة، كلٌّ بمقتضى ثقافته، ونوع همومه، ومنحى أهدافه. 3.
ص: 249
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 78/9.
2- ينظر: اللغة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي / 65 دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة (1971).
3- نهج البلاغة، خطبة / 50/3.
إنَّ هذا التداول المثليّ والعرقيّ يشير إلى الارتباط الواضح بين الحاضر والموروث، ويعني انتماءً إلى المنظومة القيميّة المعرفيّة والأخلاقيّة للحضارة عبر مراحل من التّدّرج تدلُّ على عقليّة مَن صاغها من جهة، وعلى عقليّة مَن أجاد استعمالها على وفق دلالاتها المعنويّة، فحياة الأُمم والشعوب فيها تنوّع واختلاف وسلائق خاصة بكلِّ منها؛ لأنَّ لكلِّ مجتمع بشريّ طبائع وأعرافًا متداولة وقيمًا تميزه من غيره ولا بُدّ لنجاح دراسة أي مجتمع أن تعتمد على دراسة التراث المتراكم الذي ما زال بعضه حيًا حتى الآن، تتداوله الشعوب والمجتمعات جيلًا بعد جيل.
وعلى الرغم من أنّ المثل يمتاز بالإيجاز والتركيز، والوضوح والبيان، والدقة والاختزال، وبما يحمل من خبرة حياتية تمسُّ الجوهر الإنسانيّ في الصميم هناك عدد من الأمثال الدالة على عُرْفٍ أو عادةٍ أو تقليد لمجتمعٍ ما لم تتخذ شهرة المثل السائر، إلاّ أنَّها انتقلت من ذلك المجتمع إلى المجتمع الجديد، وبتلك الصياغة الحكيمة للمثل، فأضفى عليها حياةً جديدةً، نتيجةَ استعماله للعبارة في دلالتها الجديدة، ومطابقة مقتضى الحال لما شُبّهَ به من مضمون اجتماعيّ اختزلته تلك العبارة المُوجزة، وما دلالة لفظة (اللّدم) الجديدة إلّا دليل صادق على ذلك. واجتمعت فيما بعد بمنزلة الأمثال والحكم الدائرة في المجتمعات لسهولة تداولها بين الناس، ولاسيما الأدباء والشعراء منهم ممّا يجعلها يسيرة الحفظ والتذكّر والاستشهاد والتأثير.
ولم يخرج كلام الإمام علي (علیه السلام) في نهج البلاغة عن عادة العرب في نسبة كثيرٍ من الأمور إلى الدهر على المجاز، وإنَّما الحقيقة هو انتساب هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ومنها: " ... عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ، لَا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ وَ لَا يَبْقَى سَرْمَداً مَا فِيهِ، آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلِهِ، مُتَشَابِهَةٌ أُمُورُهُ، مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلَامُهُ ... " (1)، وكأنّ الدهر يرفع ويضع، ويُغني ويُفقر، يوُجد ويُعدم، وعبارة: (متظاهرة أعلامه) أي إنَّ دلالته على سجيته التي عامل الناس بها قديمًا وحديثًا،.
ص: 250
1- نهج البلاغة، خطبة/ 157/ 222.
و (متظاهرة)، يعني يقوي بعضها بعضًا، وهذا كلام كلّه جارٍ منه (علیه السلام) على عادة العرب في ذكر الدهر.
ومن عادة العرب أنَّها تقول للكرام من الناس قليلي المأكل والمشرب، رافضي اللباس الرفيع ذوي الأجسام النحيفة «مِراضٌ من غير مرضٍ»، ويقولون أيضًا للمرأة ذات الغضيض الفاتر، وذات الكسل: «مريضة من غير مرض». جاء على عادة العرب في نهج البلاغة قوله (علیه السلام) في وصف المتقين: " ... فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْرَارٌ أَنْقِيَاءُ، قَدْ بَرَاهُمُ الخوْفُ بَريَ الْقِدَاحِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ ... " (1).
لقد أحدث الإمام (علیه السلام) تغييرًا في عبارة المثل، وهذا أمرٌ طبيعيّ، فقد يصیب المثلَ تغييرٌ في عبارته، وهذا التغيير الذي يطرأ على عبارة المثل يكون على ضربين، حذف أو إضافة كلُّ بحسب سياقه في الكلام، فالأعراف والتقاليد والعادات فضلًا عن التطورات الحضاريّة المختلفة تلقي بظلالها على حركة المجتمع وتطوره وتقدمه، فالحركة الاجتماعيّة لا تقوم بها طبقة من المجتمع دون الأُخرى، فالجميع يضع طابعه على تاريخ البلد، وتبعاً لاختلاف الطبقات التي تتلقى الموروث الثقافيّ من عادات وتقاليد وأعراف، يحدث تطور في لغة العرف أو التقليد، وذلك بتغير صيغة أو تقديم وتأخير أو حذف أو إضافة مع بقاء المعنى واحدًا بين الحدث الأصليّ والحدث المطابق.
وعلى هذا النسق جاء كثير من الأمثال على غير صيغها، فقولهم في المثل: " إنَّ الحديث لذو شجون " (2) أورده الصّبي هكذا في كتابه: (أمثال العرب)، في حين نجد الميدانيّ يورده: «الحديث ذو شجون» (3) وغير ذلك..
ص: 251
1- نهج البلاغة، خطبة 305/193.
2- أمثال العرب المفضل بن محمد الضّبيّ (ت / 168 ه) / 47، القسطنطينية، 1979م.
3- مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانيّ النيسابوريّ (ت / 518 ه) 1 / 156. تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، ب. ت.
ومن عادات العرب أن تطلق عبارة: (ابن اللبونِ) معرفًا، أو (ابن لبونِ) منكرًا، على ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا يقال للأنثى (ابنة اللبون)، وذلك لأنَّ أُمها في الأغلب ترضع غيرهما، فتكون ذات لبن، واللبون من الإبل والشاة: ذات اللبن، غزيرة كانت أم بكيئة (قلَّ لبنها)، فإذا أرادوا الغزيرة قالوا: لبِنَة (1). وعلى سياق الكلام المتقدم جاء في نهج البلاغة: " كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَلَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ " (2).
ولما كان (ابنُ اللَّبُونِ) ولدَ الناقة الذي دخل في سنته الثالثة؛ فإنَّ أُمّه تكون قد وضعت غيره، فلها لَبن، لذلك يحمل كلامه (علیه السلام) على دلالتين:
الدلالة الأولى: أن يكون المراد من ذلك: كنْ في الفتنة بحيث لا مطمع فيك لأحدٍ من طريق القوة ومن طريق المال، يعني لا تُهيِّج الفتنة بنفسِك ومالك، فعبّر عن القوة بلا ظهر، وعن المال باللبنِ.
الدلالة الأخرى: أي لا تكن في الفتنة منقاداً لصاحب الفتنة بحيث يركَبُكَ، أي يُحمِّلُكَ وِزْرَهُ، ويستمد منك كما يستمد الحالب من اللبن.
والمراد بالقولين: لا تكن سَلسَ القيادِ في الفتنة والشرِّ (3).
وعلى عادة العرب واعتقادهم أنَّ الشمس منزلها ومقرها تحت الأرض، جاء السياق اللغويّ في نهج البلاغة: " فَسَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ شَمَّرَ هَارِباً وَ نَكَصَ نَادِماً، فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَ قَدْ طَفَّلَتِ الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ" (4)، فقوله (علیه السلام) للإياب، يعني للرجوع، أي ما كانت عليه في الليلة التي قبلها، يعني غيبوبتها تحت الأرض. 0.
ص: 252
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 246/18.
2- نهج البلاغة، حكمة / 469/1.
3- ينظر: معارج نهج البلاغة 2 / 788.
4- نهج البلاغة، كتاب/ 36 / 410.
وهذا الخطاب إنَّما هو على قدر أَفهام العرب، إذ كانوا يعتقدون أنَّ الشمس مقرّها ومنزلها تحت الأرض، وأنَّها تخرج كلَّ يوم فتسير على العالم، ثم تعود إلى منزلها، فتأوي إليه كما يأوي الناس ليلًا إلى منازلهم (1). ويحتمل أن يكون الاستعمال هنا مجازيًا.
ومن عادات العرب أنهم يجعلون الخَمْل إلى الجسد، وتُظهِر الجلد، فجاء السياق اللغويّ تبعاً لهذه العادة في قوله (علیه السلام): " ... ولُبِسَ الإسلام لُبْسَ الفرو مقلوبًا ..." (2): أي انعكاس الأحكام الإسلاميّة في ذلك الزمان.
ومن العادات العربية في الجاهليّة (العادات الفلكيّة) الإيمان والتعلق بالسماء والنجوم والكواكب، والظواهر كالليل والنهار والدهر والزمان ... وغيرها، فجاء السياق اللغويّ على وفق عادات العرب في قوله: «أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً " (3).
فعبارة: (ما سمر سمير) تعني الدهر، وتعني ما أقام الدهر وما بقي، والأشهر في المثل: «ما سمر ابنا سمير». فقالوا: السمير الدهر، وابناه: الليل والنهار؛ لأنَّهُ يُسمَر فيهما.
ويقولون: «لا أفعله السَّمَر والقمر»، أي مادام الناس يسمرون في ليلة قمراء و «لا أفعله سمير الليالي»، أي أبداً، قال الشَّفَرى (4) الأزديّ:
هُنالِكَ لا أرجو حياةً تسُرُّني *** سَمير اللَّيالي مُبسلاً بالجَرائِرِ
وعبارة: «ما أمَّ نجمٌ في السماء نجماً» أي قصد وتقدم لأنَّ العرب ترى أنَّ النجوم يتبع بعضها بعضًا، فلا بُدّ من تقدم وتأخر، فلا يزال النجم والكوكب وأمّ نجم نجمًا هو أصناف الاتصالات من: (المقارنة، والمقابلة، والتسديس، والتثليث، والاتصال.
ص: 253
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 301/16.
2- نهج البلاغة، خطبة 107/ 158 - 159.
3- نفسه، خطبة/ 126/ 184.
4- ينظر: شرح نهج البلاغة 8 / 286.
المطالعيّ، والجبر، والإقبال، والإدبار، والانصراف، والنقل، والجمع، وردِّ النور، والمنع، ودفع الطبيعة، ودفع القوة ... وغيرها) (1).
والأدب العربيّ - شعرًا ونثرًا - يمثل (ديوان العرب)، فهو يضمُّ طائفة من الصياغات المثليّة، التي طالما رددتها الألسنة على طول التاريخ، وربّما أخذ بعض الناس هذه الأمثال، وصاغها في شعر أو نثر صياغةً جديدة، فغيّر بعض الألفاظ أو قدّم أو أخّر وهكذا، كما رأينا في المثال المذكور آنفاً: «ما سمر سمير ...».
وربما نجد أمثالًا صاغها قائلوها من معنى قرآنيّ أو تركيب قرآنيّ مع الإبقاء على الظلّال المعنويّة الرابطة بين الصياغتين شكلّا ومضمونًا. جاء في نهج البلاغة « ... قذفًا بغيبٍ بعيدٍ ...» (2)، أي قال إبليس هذا القول: قذفًا بغيبٍ بعيدٍ، والقذف في الأصل: رَمي الحجر وأشباهه، والغيب: الأمر الغائب (3).
وهذه العبارة مقتبسة من الألفاظ القرآنيّة، قال تعالى في كفار قريش: (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكانٍ بَعيد) (4)، أي يقولون: هذا سحرٌ، أو هذا من تعليم أهل الكتاب، أو هذه كهانة أو غير ذلك ممّا كانوا يرمون به (علیه السلام).
وجاء في نهج البلاغة على هذا النسق: « ... من بناتٍ مَوؤُودةٍ ...» (5).
قيل: كان سبب قتل البنات في الجاهليّة أَنَّهُ لمّا مُنِعَت تميم الإتاوة، وجه إليهم النعمان بن المنذر كتائب، فاستاق البهائم وسبى الذراري، فأتاه القوم، وسألوه النساءَ، فقال النعمان: كلُّ امرأة اختارت أباها أو أخاها أو زوجها، رُدَّت إليه، ومَنْ اختارت صاحبَها السّابي تُرِكَتْ عليه فكلُّهُنَّ اخترنَ آباءهنّ إلّا ابنة لقيس بن عاصم، فإنَّها.
ص: 254
1- ينظر: معارج نهج البلاغة 1/ 485.
2- نهج البلاغة، خطبة/ 288/192.
3- معجم الفاظ نهج البلاغة، مادة قذف / 446.
4- سورة سبأ، آية: 53.
5- نهج البلاغة، خطبة / 290/192.
اختارت صاحبها عمر بن المشمرج. فنذر قيسٌ أنَّهُ لا تولد له بنتٌ إِلّا وَأَدَها أَنفَةً. و اقتدی به جماعة من العرب، وقالوا: لا نقتلهُنّ عجزًا عن الإنفاق عليهنّ، ولكن مخافة أن يتزوّجنَ غيرَ الأكفاءِ) (1).
ويُروى لصعصعة بن ناجية ناقتان عُشَراوان، فقال صعصعةُ: ركبتُ جملًا في طلبهما، فرُفع لي بيت من الحرير، فقصدتُه، فإذا شيخٌ بفناءِ الدارِ، فسألته عن الناقتين، فقال: ما مِيسَمُهما؟ فقلت: مِيسَمُ بني دارم فقال: هما عندي وقد أحيا الله بهما قوماً من أهلك من مضر. فانتظرتُ لتَخرجا إليّ. فإذا عجوزٌ قد خرجت من كسرِ بيتٍ فقال لها الشيخ ما وضعت؟ إنْ كان سَقْباً شاركنا في أموالنا وإنْ كان حائلاً وأدناها، فقالت العجوز: ولدت أنثى، فقال الشيخ: إِديها، فقلتُ: أتبيعُنيها؟ فقال: هل تبيع العرب أولادَها؟! فقلتُ: إِنَّما أشتري حياتها لا رِقَّها. قال: فبكم؟ قلتُ: احتكِمْ. فقال الشيخ: بالناقتين والجمل، فقلت ذاك لك.
فقال صعصعة الرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آمنتُ بك، وقد صارت لي سنّةٌ في العرب أن أشتري كلَّ موؤودَةٍ بناقتين وجمل، فلي إلى هذه الغاية مئة وثمانون موؤودة، وقد أنقذتُها من القتل، هل أنتفع بذاك وأؤجر عليه؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لا يَنْفَعُكَ، لأَنَّك لم تبتغِ بهذاك وجه الله تعالى. وإن تعمل في إسلامك عملًا صالحًا - وإن كان قليلا - نَفَعَكَ (2).
وقد نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قتل الموؤودة بقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) الإسراء/ 31، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) - التكوير / 8 - 9. 8.
ص: 255
1- ينظر: معارج نهج البلاغة 724/2.
2- ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي علي بن أبي بكر (ت/ 807 ه) 1/ 94،95 - باب فيمن عمل خيراً ثم أسلم، تحرير: العراقيّ وابن حجر، القاهرة - 1353 ه،، والمعجم الكبير للطبرانيّ سليمان بن حمد (ت / 360 ه) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيّ، بغداد - 1397 ه،8 / 91 - 92، 12 / 74، والدرّ المنثور ذيل الآية: (وإِذا الموْؤُدَةُ سُئِلَتْ) - التكوير / 8.
وقد يحصل تطور في صيغة المثل، نتيجة التغيير الذي يجري على المثل في البيئة التي أوجدته، فالعربيّ مثلًا يقول: «كمستبضع التمر إلى هجر»؛ وذلك أنَّ (هجر) (1) معدن التمر مدينة في البحرين كثيرة التمر، وسبب ذلك أنَّ رجلًا أحمق من أهل هَجَر قدم البصرة ومعه مالٌ كثيرٌ ليشتري به شيئًا للربح، ويحمله إلى هَجَر، فلم يجد شيئًا أكسد من التمر، فاشترى بماله التمر، وحمله إلى هَجَر، وتَلِفَ ماله وفسد التمرُ في بيوته، فضُرِب به المثل (2).
جاء في نهج البلاغة: «كناقل التمر إلى هجر» (3)، وأصل المثل «كمستبضع تمرٍ إلى هَجَر» (4). والتطور في الصيغة من (مستبضع) إلى (ناقل)، وأحدث حسان بن ثابت تطورًا آخر حينما ضمن قصيدته التي قالها في أول إسلامه، يردُّ بها على ضرار بن الخطاب بقوله:
فإنَّا ومَنْ يُهدي القصائد نحونا *** كمسبتضع تمراً إلى أهل خيبر (5)
وقال الشاعر:
فإِنّك واستبضاعَكَ الشِّعرَ نَحْوَنَا *** كَمُستَبضِعٍ تمراً إلى أَهْلِ خَيْبَر (6)
ويلُ حَظُ أنّ التشبيه الذي رافق المثل في رحلته الطويلة قد بثّ الحياة في عبارة المثل، وبعثها على البقاء وأكسبها جمالًا ورونقًا، ومنحها القدرة على الإيحاء بما يزيد المثل بيانًا، ويجعل أكثر دقة وتحديدًا، أو يجعله أشدَّ تأثيرًا وأكثر جمالًا..
ص: 256
1- وهي اسم بلد مذكّر مصروف، والنسبة إليه هاجري على غير القياس.
2- ينظر: معارج نهج البلاغة، ج / 2، ص / 501.
3- نهج البلاغة، كتاب/ 28، ص / 386.
4- ينظر مجمع الأمثال الميدانيّ 3 / 39 برقم (3080)، وجمهرة الأمثال، أبو هلال العسكريّ (ت/ 395 ه)، الحسن بن عبد الله بن سهل، 25/ 141 تحقيق: محمود أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطاش، دار الفكر، ط 2، 1988 م.
5- شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاريّ / 87، ضبطه وصححه: عبد الرحمن البرقوقيّ، مطبعة الرحمانية، مصر، 1929 م.
6- نسبه في لسان العرب 8 / 5 (بضع) إلى خارجة بن ضرار.
ولما كانت الأمثال تمثل معنىً من معاني الاستعارة، التي تعني " أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه" (1)، جاء في نهج البلاغة: " ... ولو يطاع لقصيرٍ أمرٌ ... " (2) هذا مثل عربيّ قديم جاء به الإمام على سبيل التشبيه الاستعاريّ بين الموقف السابق والموقف اللاحق، وأصل المثل: هو أنّ جذيمة الأبرش ملك العرب خَطَبَ (الزَّبَاء) وهي ملكة الجزيرة، فأمرته الزَّباء بالقدوم عليها، فزيّن نصحاء جذيمة له ذلك، وتابعوه، فخرج جذيمة بألف فارس، وخلف سائر جنوده مع ابن أخته عمرو بن عدي، وكان الجذيمة مولىّ يقال له قصير بن سعد اللّخميّ، وكان مخالفًا لرأي جذيمة في الإقدام على الزَّباء، فلما وصل جذيمة إلى منزلٍ قريب إلى الجزيرة، استقبلته جنود الزَّباء مع الأسلحة والعُدَّة، وما ترجَّلوا لجذيمة وما عظَّموهُ، فقال قصيرٌ لجذيمة: انصرف فإنّها امرأة، ومن عادة النساء الغدر والمكر، فما قبل جذيمة قوله، فقال قصير: «لا يُطاعُ لقصيرٍ أمرٌ» فصار مثلًا بعدما أخذت الزَّباء جذيمة وقتلته (3).
وهذا المثل يضرب لمن كان رأيه صائبًا ولكن لا يقبل جاء به الإمام (علیه السلام) حينما وجد أمره غير مطاعٍ.
ثم إنَّ الإمام (علیه السلام) استعمل هذا المضمون بمثلٍ جديدٍ وهو: " لا رأيَ لَمَنْ لا يُطاع" (4).
تأثر الإمام علي (علیه السلام) بأساليب الأدباء العرب قبل الإسلام شعرًا ونثرًا، فاقتبس مفردات ومصطلحات، وانتفع بأفكار قائليها، وإنتاج مجتمعاتهم الأدبية والعلمية، ولا يخفى ما لهذا كلَّه من أثر بليغ في نهضة لغة نهج البلاغة وتهذيبها واتساع نطاقها وزيادة ثروتها. 7.
ص: 257
1- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانيّ (ت: 471 ه) / 106، تعليق وشرح: محمد عبد المنعم خفاجة، مطبعة الفجال الجديد، القاهرة، 1969م.
2- نهج البلاغة، خطبة / 81/35.
3- ينظر: معارج نهج البلاغة، 1/ 313.
4- نهج البلاغة، خطبة / 72/27.
والأمثلة على ذلك كثيرة، منها تأثره بمضامين الشعر الجاهليّ الاجتماعيّة، فكان يختار الأبيات ذات المضامين المثليّة والعرضيّة الدالة على حوادث ووقائع مشهورة تشابه حالة مجتمعه - أفرادا وجماعات - جاء في نهج البلاغة: " فكنتُ أنا وإياكم كما قال أخو هوازن:
أمرتكم أمري بمُنْعَرَجِ اللِّوى *** فلم تَسْتَبينُوا النُّصحَ إِلّا ضُحى الغَدِ"
نجد الإمام (علیه السلام) وقد تأثر بعبارة دريد بن الصّمَّة: (بمنعرج اللّوى) الدالة على حادثة تاريخيّة من واقع المجتمع الجاهليّ، تمثلت على نحوِ عرفٍ أو مثلٍ لمن لا يُطاعُ أمره، وعاقبة مَن عصاه.
وجمال التمثيل هنا هو إتيانه المعنى في موضعه، لا يبرح إلى معنى آخر، ممّا يرينا مقدرة متفوقة للإمام (علیه السلام) في الإفادة من مخزونهِ الثقافيّ، إذ تنازع أصحابه بعد نتائج التحكيم، فندم بعضهم، وتذمر قسم، وضبع آخرون، فأنبهم الإمام على فعلتهم بقبول التحكيم، وقد نصحهم برفضه، وكشف لهم عن نتائجه المخزية، وأتت النتيجة كما توقع (وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ) ص / 3.
غزا عبد الله بن الصِّمَّة - أخو دريد - من بكر بن هوازن غطفان، فلم يصدهُ عن وجهه شيءٌ، حتى غنم وساق الإبل. فلما كان بمنعرج اللّوَى أقام وقال: لا والله لا أرجع حتى أنتقع وأُجيل السِّهام، فقال له دريد أخوه وكان معه: لا تفعل فإنَّ القوم في طلبك.
فأبى ولجَّ وأقام، ونحر النقيعة، وقد أقعد له رجلًا ربيئًا، فقال عبد الله لربيئه: انظر ما ترى.
قال: أرى خيلًا عليها رجال كأنهم،صبيان، رماحهم بين آذان خيولهم.
فقال: هذهٍ فزارة، فالتقى القوم، وكان دريد نهاهُ أن يقيم، وقال: إنّ القوم سيطلبونك ويتبعونك ولن تفوتك النقيعة، فطُعِنَ عبد الله بن الصِّمَّة، فاستغاث بأخيه، فأقبل عليه أخوه دريد، فنهنه عنه القوم حتى طُعِنَ دريد، وصُرِعَ وقُتِلَ عبد الله، وإذا كان آخر النهار مرَّ بدريد الزهدمان العبسيان، فعرفه أحدهم، فطعنه قال دريد: وقد أصابتني جراحة فاحتقن الدَّم، فلما طعنني زهدم خرج الدَّم واسترحت، فإذا جَنَّ الليل مشيتُ وأنا ضعيف قد نزفني الدَّم، فوقعتُ بين عرقوبي جمل الظعينة، فنغر الجمل
ص: 258
فعرفتني الظعينة، وأعلمت الحيَّ بمكاني، فغُسل عني الدَّم، وزودت سقاءً وزادًا، فنجوتُ، وكانت الظعينة في سيّارة من هوازن.
فقال دريد في ذلك (1):
أمَرْتُهُمُ أمْري بمُنْعَرَجِ اللّوَى *** فَلَمْ يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إِلّا ضُحَى الغَدِ
فَلَمَّا عَصَوْنِي كُنْتُ منهم وقد أرَى *** غوايَتهُمْ وَإِنَّني غيْرُ مُهتَدي
وهل أنا إلّا مِن غَزِيَّةٍ إِنْ غَوَتْ *** غَوَيْتُ وإِنْ تَرْشَدَ غَزْيَّةُ أَرْشَدِ
فإن يكُ عَبْدُ الله خَلّى مَكانه *** فَما كانَ وَقَافاً ولا طائشَ اليَد
حتى قيل في المثل: «أعصى من أبي ذفافة» وهو عبد الله بن الصِّمَّة، لأنّه عصا أخاه دُريد بن الصِّمَّة.
أما عبارة: (أخو هوازن)؛ لأنّ دريد بن الصِّمَّة من بني جشم بن معاوية بن بكر بنهَوازن (2).
ومن العبارات الدالة على حادثة جرت مجرى المثل، ما جاء في نهج البلاغة " ... بعد اللتيا والتي ... " (3)؛ إذ يروى" أنَّ رجلًا من جديس تزوج امرأة قصيرة، فقاسي منها الشدائد وكان يعبّر عنها بالتصغير، فتزوج أمرأة طويلة، فقاسي منها ضعف ما قاسى من القصيرة، فطلّقها، فقال: بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبدًا " (4). فجرى هذان اللفظان مجرى المثل على الدواهي والشدائد.
وقيل: إنَّ العرب تصغّر الشيء العظيم كالدُّهيم واللُّهيم، فأشار إلى الداهية العظيمة باللتيا، وإلى الداهية التي دونها بالتي، وذلك منهم رمز، قال الراجز من حديش:.
ص: 259
1- الخبر والشعر في الأغاني لأبي فرج الأصفهاني علي بن الحسن (ت / 356 ه) 10 / 5 - 9، مصر (1323 ه) وفي شرح نهج البلاغة 2/ 368، وفي معارج نهج البلاغة 1 / 314 - 315.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 2/ 369.
3- نهج البلاغة، خطبة/ 5/ 53.
4- مجمع الأمثال 92/1.
بعد اللُّتَيْا والَّتي
طلَّقْتُ جَهْلاً طلّتي (1)
ومن العبارات التي جاء بها الإمام (علیه السلام) في نهج البلاغة ذات المضامين الاجتماعية قوله: " ... وانفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس ... " (2).
ذهب ابن دريد في أمثاله إلى أنَّ الرأس إذا انفرج عن البدن، لا يعود إليه وصار البدن جيفة، لا يتهيأ لأمرٍ ما، ولا يكون بين الرأس والبدن بعد ذلك اتصال، ويعني: انفرجتم عني انفراجاً لا اتصال بعده.
وذهب المفضل إلى أنَّ معناه أنّ الرأس اسم لرجل تُنسب إليه قرية من قرى الشام، يقال لها: بين الرأس، وفيها تُباع الخمور. قال حسان (3):
كأنّ سبيئة من بيت رأسٍ *** يَكُونُ مِزاجَها عَسَلٌ وماءٌ
ومن حديث هذا الرجل أنَّهُ انفرج عن قومه ومكانه فلم يَعُدْ وخلّى قومه.
وقيل: إنَّ الرأس: القوم الأعزّاء، والرجل العزيز، قال عمرو بن كلثوم بِرأس مِنْ بَنِي جُشَمِ ابنِ بَكْرٍ.
ويحتمل أن يكون مراد الإمام (علیه السلام): انفرجتم عنّي انفراج الأعِزّاء، الذين لا يبالون بمفارقة أحد.
وأوّل مَنْ قال هذا القول هو أكثم بن صيفي في وصية له: يا بَنيّ لا تتفرجوا عند الشدائد انفراج الرأس، فإنكم بعد ذلك لا تجتمعون على عزِّ (4).
والحقيقة أنَّ الإمام استعمل اللغة الرمزية في غير الواقع، إذ إنّ انفراج الرأس عن الجسد على سبيل التمثيل، إشارة إلى التمسك بالوحدة وعدم التفرق، ويبدو أن وظيفة اللغة.
ص: 260
1- ينظر: معارج نهج البلاغة 242/1.
2- نهج البلاغة، خطبة / 79/34.
3- ديوانه 17/1.
4- ينظر: معارج نهج البلاغة 1 / 311 - 312.
هنا تجاوزت الحواس إلى التخيلات، فقدرة اللغة هنا لا تضاهى؛ لأنّها لا تشمل الموجودات التي تقع تحت الحواس فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى أوهام الخيال وأطياف الأحلام وخفقات الجوانح والحياة النفسية والفكرية، فهي تحيط بكلِّ شيء، حتى عدّها بعض الباحثين الأداة الوحيدة التي تمثل العالم الماورائي، وهذا التمثيل اللغوي من خصوصية الانسان لأنَّهُ الوحيد القادر على التعامل مع عالم الرموز ومن هنا يصف أرنست کاسیریر (Ernest cassirer) الإنسان بأنَّهُ: (حيوان الرموز)، لأنَّ الإنسان إذا كان عاقلاً اكتسب قدرة على تمثيل الأشياء بنحوٍ رمزيّ من طريق الكلمات والمعاني المجردة، وعلى تحريك الحقائق بطريقة رمزية، إنَّ هذه القدرة هيأت للإنسان أن يزيد بنحوٍ لا متناهٍ، قدرته على الاختراع، وقدرته في السيطرة على سائر العالم، على الرغم من ضعف قوته الجسديّة التي لا تناسب مع حجم العالم وكبره وذلك بسبب قدرته على صنع الرموز (1).
تنبع الأمثال والأعراف والعادات التي وجدت في الآداب القديمة من صميم الحياة الإنسانيّة والتجارة العمليّة للمجتمعات التي أنتجتها، لذا تُظهر نظرتهم إلى الحياة والموت، وإلى ما هو غيبيّ، وإلى القدر الذي تحتله المعتقدات التي يؤمنون بها، جاء في نهج البلاغة في وصف الموت وملازمته لابن آدم: " ... وأنتم طرداء الموت إنْ أقمتم له أخذكم، وإنْ فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظِلِّكم ... " (2) وهذا من الأمثال المشهورة في ذكر الموت؛ لأنّ الظلِّ لا يصح مفارقته لذي الظلِّ مادام في الشمس (3).
ولم تكن الأمثال في نهج البلاغة ممّا يختصُّ بالإنسان فحسب؛ بل شملت الحيوان أيضاً، وقد مثلنا آنفاً بالضبع وصفاته وسلوكياته، وكذلك جاءت العبارات المثلية لتشمل الطاووس، حينما وصفه الإمام (علیه السلام) بقوله: " يمشي مشي المرح المختال ويتصفح ذنبه وجناحه، فيقهقه ضاحكاً لجمال سِرباله، وأصابيغ وشاحه، فإذا رمى.
ص: 261
1- ينظر: علم اجتماع الأدب، د. سعد ضاويّ / 237.
2- نهج البلاغة، كتاب / 28، عهده لمحمد بن أبي بكر / 385.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة، 15/ 111.
ببصره إلى قوائمه زقاً معُولاً بصوتٍ يكاد يبيّن عن استغاثته، ويشهد بصادق توجعه، لأنّ قوائمه حُمْشٌ كقوائم الديكة الخلاسية " (1).
فعبارة: «قوائمه حُمْشٌ» أي دقاقٌ، وهو أحمش الساقين، وحُمْش الساقين بالتسكين، وقد حَمِشت قوائمه، وضرب المثل في قوائمه الحُمْش بالديكة الخلاسيّة؛ لأنَّها متولدة من الدجاج الهنديّ والفارسيّ، فتكون قوائمها حُمشاً.
وكأنه (علیه السلام) يقول: إنَّ الطاووس يُزهى بنفسه، ويتيه إذا نظر في أعطافه، ورأى ألوانه المختلفة، فإذا نظر إلى ساقيه وَجَم لذلك وانكسر نشاطه وزهوه، فصاح صياح العويل لحزنه، وذلك لدقة ساقيه ونتوء عُرقوبيه. وحُمْش جمع أحمش بمعنى: دقيقٌ (2) وقد تمتزج الأمثال القصصيّة في سياق النصِّ امتزاجًا متسقّا، يجعل للنصّ دلالة كلية على تلك الأمثال، لتؤدّي غرضًا واحدًا.
ومن كلام له (علیه السلام) قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك، فخفض إليه بصره (علیه السلام) ثم قال: " مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي، عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ، حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ، مُنَافِقٌ ابْنُ كَافِرٍ؛ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً وَ الْإِسْلَامُ أُخْرَى، فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَ لَا حَسَبُكَ، وَ إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ وَ سَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَتْفَ لَحَرِيٌّ أَنْ يَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ " (3).
فعبارات النصَّ «حَائِكٌ ابْنُ حَائِكِ» و «فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلَا حَسَبُكَ» و «وَإِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الحَتْفَ» و «حَرِيٌّ أَنْ يَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَلَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ» كلّها تدلُّ على أمثال قيلت في مواقف مختلفة في شخص واحد وهو الأشعث بن قيس، فامتزجت لتؤدي غرض التوبيخ والاستهانة والضعة. 3.
ص: 262
1- نهج البلاغة، خطبة / 238/165.
2- نفسه، / 189.
3- نهج البلاغة، خطبة / 62/19 - 63.
فعبارة: «حائكٌ ابنُ حائكٍ» مَثَلُ يضرب به لأهل اليمن؛ لأنَّهم يعيّرون بالحياكة، وليس هذا ممّا يختصّ به الأشعث، هذا ما ذهب إليه ابن أبي الحديد، مستشهداً بقوله لخالج بن صفوان: " ما أقول في قوم ليس فيهم إلّا حائك بُرْد، أو دابغ جِلْد، أو سائس: قرد ملكتهم امرأة، وأغرقتهم فأرة، ودلّ عليهم هُدهُد! " (1).
وقيل: حاكَ يَحِيكُ حِياكاً وحَيْكاً وحِياكة، حرّك منكبيه وفحج بين رجليه في المشي يقال منه: رجل حائك وامرأة حائكة، والحيّاك: المتبختر، والحيّاكة: المتبخترة، قال الشاعر:
جاريةٌ مِنْ شَعْبِ ذِي رُعَيْنِ *** حَيّاكةٌ تَمشِي بِعُلْطَتَيْنِ (2)
وكان الأشعث من أبناء ملوك كندة، ولم يكن حائكاً، بمعنى ناسج الثوب، وإنَّما وصف أمير المؤمنين (علیه السلام) بهذا المشي والهيئة، وهذا مشي المخانيث، ويدلُّ على حسبه ووجاهته في قومه قول أمير المؤمنين: «فما فداك في واحدة منها مالك ولا حسبُك»، وأمير المؤمنين إنَّما عيَّرهُ بالتخنيث، فعبَّر عن هذا الفعل الشنيع باستعارة مليحة دالة: على هيئة التخنيث (3).
وممّا يرجح القول الأول ما روي عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) من أَنَّهُ دفع غزلًا إلى حائك من بني النجار لينسج له ثوبًا، وكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يطلبه ويأتيه متقاضيًا، ويقف على بابه ويقول: ردّوا علينا ثوبنا حتى نتجمّل به في الناس والحائك يكذب وَيَعِدُهُ «مواعيد عرقوب»، حتى توفّي رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ولم يتم له هذا النسج (4).
وأما قوله: «وإنّ امرءًا دلَّ على قومه السيف، وساق إليهم الحتف، لحريٌّ أن يمقته الأقربُ، ولا يأمنه الأبعدُ» فهو إشارة إلى فعل الأشعث بن قيس، حينما كان ملكًا لحضرموت، وقت منع أهل حضرموت الصدقات، فأتاهم مهاجر بن أبي أميّة، وحارب.
ص: 263
1- شرح نهج البلاغة، 1/ 195.
2- البيت في الصحاح / 1144، مادة (علط)، والعلطتين: قلادتين. وفي معراج نهج البلاغة 1 / 275، والشاعر هو جُبَيْنَة بن طريف العُكْلِي، الذي راجز ليلى الأخيلية وفضحها، وفي المؤتلف والمختلف: 135 (حنينة) بالنون.
3- ينظر: معارج نهج البلاغة 1 / 275.
4- نفسه 276/1.
الأشعث، حين أظهر الأشعث الارتداد، فطردَ مهاجر الأشعث وبني كندة من حضرموت، فالتجؤوا إلى حصن حصين في البادية، فقصد مهاجر بن أبي أميّة وعكرمة بن أبي الحكم الأشعثَ، وقتلا مَن وجدا من قومه، فطلب الأشعث الأمان في نفرٍ من قومه وكتب أساميهم، وما كتب اسمه، وآمنه المهاجر، فخرج الأشعث من الحصن وسلّم قومه إلى مهاجر، حتى قتلهم جميعًا، وما أبقى منهم نافع خِرام ولا قائد زمام، وقال مهاجر للأشعث: هاتِ كتاب الأمان، فعرض عليه الأشعث الكتاب، فقال مهاجر: ليس فيه اسمك، وإنَّك مقتول، فتكلم في حقِّهِ عكرمة حتى حمله مهاجر مقيداً إلى المدينة.
فهذا معنى قوله (علیه السلام): «دلّ على قومه السيف» فإِنَّهُ سلّم قومه إلى مهاجر، وما طلب الأمان إلّا لثلة من قومه (1).
إنَّ الأعراف والتقاليد والعادات التي تمثلت بالعبارات المثليّة في نهج البلاغة، هي من مخترعات المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يدلُّ على توظيف لغة نهج البلاغة تلك المواقف والأحداث، حتى أصبح نهج البلاغة سجلًا صادقًا لتاريخ القبائل العربية قبل الإسلام وعصر الرسالة والخلافة الراشدة، بل مثّل نهج البلاغة سجلاً لحضارات أُمم خلت قبل ظهور المجتمع العربيّ، على أنَّ العادات والتقاليد والأعراف والأمثال ظواهر إنسانيّة لا يمكن أن تحدد أو تحصر بأُمةٍ دون أخرى، فهي ظواهر ذات طبيعة حكمية عامة، تظهر عند كل الناس، وتخرج على كلِّ لسان، لذلك قيل: من الصعب إرجاع الأمثال الإنسانيّة العامة إلى جماعة معينة (2).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ نهج البلاغة حفظ لنا تراث ثرءًا من أساطير المجتمع وعاداته وآدابه وأمثاله وظواهر من طريق اللغة المكتوبة المنقولة بالطريقة الشفويّة؛ لأنَّ نقل التراث شفويَّا من جيل إلى جيلٍ لاحقٍ معرّضٌ للضياع أو التحريف والتغيير؛ لأسباب تتعلق بالحفظ والذاكرة، فإنَّ الوسيلة الوحيدة لحفظ ذلك كلّه هو تسجيله كتابةً. والواقع أنَّ الأُمة التي لم تستعمل الكتابة قط، هي أُمة قد فقدت معظم تاريخها وتراثها الثقافيّ..
ص: 264
1- ينظر: معارج نهج البلاغة 1 / 277.
2- ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 8 / 363، دار العلم للملايين، بيروت (1971 م).
المبحثُ الثالثِ / الظاهرةُ السّياقيّةُ (المُحَرَّمَ اللُغَويّ (تابو Taboo))
لم يعرف مصطلح (المُحَرَّم) بلفظه العربيّ في البحث اللغويّ، بل شاع بلفظه الأعجميّ (تابو)، وهو معرب المصطلح الإنكليزيّ (Taboo) والفرنسيّ (Tabou)، وأصله بولينيزيّ (Polynesian)، يتضمّن دلالتين متضادتين: دلالة الشيء المُقدّس في قُبالة دلالة الشيء المُدنس، المُقلق، الخطر، المُحظور (1). وهو مصطلح شائع منذ القدم في الأُمم القديمة، فالرومان (اللاتين) عرفوا كلمتين ترادفان المصطلح البولينيزيّ - كان كلُّ معنى استقل بلفظة على حدة – الأولى ساكر (Sacer)، والأخرى أوغسطس (Augustus)، وتدلُّ الأولى على الشيء الذي قطع من الإنسان وأدخر بالآلهة، وتدلُّ الأخرى على قوة الخلق (2)، واستعمل اليونان لفظة أغيوس (Agios)، في حين استعمل العبرانيون كلمة كادوش (Qadosb)، وكلُّ هذه الألفاظ تعطي معنى (تابو).
وفي قُبالة (تاب) استعملت لفظة (نوا) (Noa)، لتعطي معنى نقيضًا لمعنى (تابو)، أي الشيء العادي المتاح للجميع والمتداول غير المحظور، وفي ضوء هذا يمكن القول إنَّ (تابو) وبكلمة مُوجزة: هو ما يَجب ويُهاب، ما يُقدس ويُدنس ما تُحظر منه وتحب الظفر به ... مجموعات من التناقضات لا تنفصم عراها إلّا عند انتهاكها واستباحة حرمتها، وبين الخوف والرغبة في التصريح يقول فرويد (Freud): " وهكذا وقفت هذه الأقوام أزاء حظرها موقفًا ازدواجياً؛ فقد كانت يطيب للاشعورها أن ينتهك هذه المحظورات، ولكنها كانت تخشى أن تفعل ذلك، وهي تخشاه؛ لأنَّها تودُّ لو تفعله، والخوف أقوى من الرغبة " (3).
ص: 265
1- ينظر: المحرم اللغويّ، د. محمد كشاش / 10، المكتبة العصريّة، صيدا - بيروت، ط 1، (1426 ه - 2005 م).
2- ينظر: نفسه.
3- الطوطم والحرام، سیمموند فروید/ 47.
وهناك من الظواهر ما يكتنفها الغموض، ويعتريها الإيهام، ولا يجد الإنسان تفسيرًا لها، فيقف بإزاءها متحيرًا، فلا يجد مغرمًا إلّا بردّها إلى قوة غيبيّة خارقة يسندها إليها، كالقول بالجان والخوارق وما شابهها، وهو ما خلص إليه (فونت) بقوله: " ... الحرام هو تعبير عن اعتقاد الأقوام البدائيّة بالقوى الجنية ونتيجة له ... " (1) بل يرى (فونت) أنَّ المُحرم أقدم من الآلهة، وأنّهُ يعود في أصله إلى زمن سابق كل دين (2).
وهذا هو الراجح؛ إذ إنَّ (تابو) لا يردُّ في تحفيزاته أثر إلهي؛ لسبقه الأديان، ولا يشكِّل منظومة مكتوبة تنتقل وتتداول – كما هو حال الشرائع السماوية - بل يفرض نفسه من تلقائها (3).
ولما كان (تابو) ظاهرة تفصح عن الخوف بإزاء الأشياء، بالاتصال مع الأفعال المرتبطة بهذه الأشياء، يمكننا تصنيف المحظورات اللغويّة في نهج البلاغة أربعةَ أصناف، هي:
1 - ما يختصُّ بالموت ومقدماته وأسبابه وعلاماته ومتعلقاته:
وردت في نهج البلاغة ألفاظٌ وتراكيب تدلُّ على (الموت) تجنبًا لصريح اسمه، ابتعادًا عمّا يجلبه من القشعريرة. جاء في كلام للإمام علي (علیه السلام) حينما خوف من الغيلة، فقال: " وَإِنّ عَلَيَّمِنَ اللَّهَ جُنَّةً حَصِينَةً، فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلَمَتْنِي ... " (4). والغيلة هنا بمعنى القتل على غير علم ولا شعور، والجُنَّة: الدرع وما يجن به أي يستتر من ترس وغيره، وهنا يعني بالجنة الأجل، وعلى هذا المعنى الشعر المنسوب (5) إليه (علیه السلام):
مِن أيِّ يوميّ مِنَ الموتِ أفرّ *** أيومَ لم يُقدَر أم يوم قُدِر
ص: 266
1- نفسه / 39.
2- نفسه / 32.
3- ينظر: المحرم اللغويّ / 19.
4- نهج البلاغة، خطبة / 95/62.
5- البيتان في اللسان 6 / 383، وانساب الأشراف 1 / 13، زالخصائص 3/ 221، شرح نهج البلاغة، 91/5.
فيوم لا يقدَر لا أرهَبُهُ *** ويوم قد قُدِّر لا يغني الحذَرَ
والأصل في كلِّ ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا) آل عمران 145. وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) الأعراف/ 34. وقوله تعالى: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ الأنعام / 61.
وفي ذكر الموت أيضاً قوله (علیه السلام) في خطبته الغرّاء: " عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً وَ [مُضَمِّنُونَ] مُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَ كَائِنُونَ رُفَاتاً " (1)، الاحتضار هنا بمعنى حضور الملائكة عند الميت، وهو حينئذ مُحتضر، وكانت العرب تقول: لبنٌ مُحتضرٌ: أي فاسد ذو آفة، يعنون أنَّ الجن حضرته، يقال: (اللبنٌ مُحتضرٌ فغطِ إناءك)، والأجداث: جمع جدث، وهو القبر كما ورد عنه (علیه السلام) أَنَّهُ قال: " قد شخصوا من مستقر الأجداث" (2). ومستقر الأجداث: مكان استقرارهم بالقبور. والرفات: الحطام.
وجاء في بعض الروايات (مقبوضون اختصارًا) بالخاء العجمية، وهو موت الشاب غضًا أخضر، أي مات شابًا، وكان فتيان يقولون لشيخ: أجززت يا أبا فلان، فيقول: أي بني، وتختضرون، ومنه أجز الحشيش: أن يجز، ومنه قيل للشيخ كاد يموت: قد أجز.
ويذهب ابن أبي الحديد المعتزليّ (3) إلى تحسين الرواية الأولى؛ لأنَّها أعمُّ. وقد قيل: (كتبت له سعادة المحتضر، وأفضت به إلى الأمر المنتظر) كناية عن الدعاء له بالسعادة الأخروية، وهو أمر منتظر، لا ينجو من بين يديه أحد من البشر (4).
ومن المُحرم اللغويّ لفظة الموت قوله (علیه السلام): " ... وَالسِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ، فَ - «کُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ»: سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا، وَ شَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا 8
ص: 267
1- نهج البلاغة، خطبة / 110/83
2- نهج البلاغة، خطبة / 156/ 220.
3- شرح نهج البلاغة، 6/ 356.
4- ينظر: المحرم اللغويّ / 28
بِعَمَلِهَا. " (1). فعبارة (السياقة إلى الورد المورود) تعني الموت، وعبارة: (سائق وشهيد) قد فسر (علیه السلام) ذلك وقال: (سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا) وقد قال بعض المفسرين في تفسير آية: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ) ق / 21. إِنَّ الآية لا تقتضي كونهما اثنين، بل من الجائز أن يكون ملكًا واحدًا جامعًا بين الأمرين، وكلام الإمام (علیه السلام) يحتمل ذلك أيضًا، لأنَّه لم يقل أحدهما، لكن الأظهر في الأخبار والآثار أنَّهما ملكان (2).
ومن التعبير عن الموت قوله: " وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ، أَلَا وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ" (3). ويروى: (إلّا حشاشة نفس) بالأفراد، وهو بقية الروح في بدن المحتضر.
وكذلك في وصيته لابنه الحسن (علیه السلام) يقول في أخبار الأمم الغابرة: " ... وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا، وَعَمَّا انْتَقَلُوا، وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ، وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ ... " (4).
وكُني عن الموت بالسير، جاء في نهج البلاغة: " ... وَحُثِثْتُمْ عَلَى المُسِيرِ فَإِنَّما أَنْتُمْ كَرَكْبٍ وُقُوفٍ لَا يَدْرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالسَّيْرِ ..." (5)
فالسير هنا بمعنى الخروج من الدنيا إلى الآخرة بالموت، فجعل الناس في الدنيا كركب وقوف لا يدرون متى يقال لهم: سيروا فيسيروا؛ لأنَّ الناس لا يعلمون الوقت الذي يموتون فيه. وقد سُمِّيَ الموت والمفارقة سيرًا، لأنَّ الأرواح يعرج بها إما إلى عالمها، وهم السعداء، أو تهوى إلى أسفل السافلين، وهم الأشقياء، وهذا هو السير.
ص: 268
1- نهج البلاغة خطبة / 85/ 117
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 4216.
3- نهج البلاغة، كتاب/ 375/17.
4- نهج البلاغة، وصية/ 394/31.
5- نهج البلاغة خطبة / 157/ 222 - 223.
الحقيقيّ، لأنَّ حركة الرجل بالمشي، ومن أثبت الأنفس المجردة، قال: سيرها خلوصها من العالم الحسّيّ واتصالها المعنويّ لا الأبديّ ببارئها، فهو سير في المعنى لا في الصورة.
ومن لم يقل بهذا ولا بهذا قال: إنَّ الأبدان بعد الموت تأخذ في التحلل والتزايل فيعود كلُّ شيءٍ منها الى عنصره، فذاك هو السير (1).
ومن التعبير عن الموت قوله (علیه السلام): " ... لَزَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا ..." (2)، أي خرجت شوقاً إلى الجنة. فعبارة: (زهقت نفسه) بمعنى: مات.
أما قوله (علیه السلام)حينما أمر الناس بالعمل: "عِبَادَ اللَّهِ، الْآنَ فَاعْلَمُوا [فَاعمَلوا]، وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ وَ الْأَعْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ الْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ وَ الْمَجَالُ عَرِيضٌ، قَبْلَ إِرْهَاقِ الْفَوْتِ" (3).
لقد صوّر الإمام (علیه السلام) في هذا النصِّ حال الحياة، فكنّى عن ذلك ب (الألسن المطلقة)؛ لأنَّ المُحتضر يعتقل لسانه، (والأبدان صحيحة)؛ لأنَّ المُحتضر يكون سقيم البدن، (والأعضاء لدنة) أي ليّنة قبل الشيخوخة والهرم ويبس الأعضاء والأعصاب، أما قوله (علیه السلام) (قبل أرهاق الفوت) أي قبل أن يجعلكم الفوت مرهقين والمرهق: الذي أدرك ليقتل، قال الكميت (4):
تَندَى أَكُفُّهمُ وَفِي أَبْيَاتِهِم *** ثِقَةُ المُجاورِ والمضافِ المُرهَقِ
هذا من جانب، ومن جانب آخر صوّر لنا الموت بقوله (علیه السلام) حينما أدرك رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الأجل: " ... وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي،.
ص: 269
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 9 / 143.
2- نهج البلاغة، خطبة / 165/ 240.
3- نفسه، خطبة / 196 / 311.
4- ينظر: شعر الكميت بن زيد الأسديّ، (ثلاثة أقسام في جزأين) / 69 جمع داود سلوم (ت/ 2010م)، النجف الأشرف 1969م.
وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي، فَأَمْرَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي ... " (1)، و في موضع أخر يقول: " ... وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ ..." (2) أراد بذلك آخر الأنفاس التي يخرجها الميت ولا يستطيع إدخال الهواء إلى الرئة عوضاً عنها، ولا بُدَّ لكلِّ ميت من نفخة تكون آخر حركاته. ويقول قوم: إنّها الروح، وعبر عنها الإمام (علیه السلام) بالنفس، لما كانت العرب لا ترى بين الروح والنفس فرقًا (3).
وعبر عن القبر بالرمس، جاء نهج البلاغة " ... وَقَبْلَ بُلُوعِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ الأَرْمَاسِ ..." (4).
وكنّى عن الموت بهادم اللذات: " ... وأكثر ذكر هادم اللذات ... " (5)، و هادم اللذات: بناؤها قائم على أنَّ الموت يقضي على لذات الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ) الحديد / 20. والنفس مجبولة على حبّ اللهو واللذة والسعادة. قال أبو العتاهية ذاكرًا هادم اللذات بدلًا من التصريح به: [ من الطويل ]:
أيَا هَادِمَ اللذَّاتِ ما مِنكَ مهربٌ *** تُحاذِرُ نَفْسِي مِنكَ ما سيصيبُها (6)
وما بعد الموت: يعني العقاب والثواب في القبر وفي الآخرة.
وكنَّى عن الموت بالمنون: " ... وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا ... (7) وفيها وصية شريفة جدًا، إذ جعل طالب الدنيا المعرض عن الله تبارك.
ص: 270
1- نهج البلاغة، خطبة / 197 / 312.
2- نفسه، خطبة / 202/ 321.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة 5 / 409.
4- نهج البلاغة، خطبة / 190 / 282.
5- أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت (2307)، والنسائي، كتاب الجنائز، باب: كثرة ذكر الموت (1824)، وأحمد في مسنده (7865).
6- ديوان أبي العتاهية / 60.
7- نهج البلاغة، كتاب / 69/ 461.
وتعالى عند موته كالعبد الآبق يقدم به على مولاه أسيرًا مكتوفًا ناكس الرأس، فما ظنُّك به حينئذ (1).
وكنَّى عن الموت بالرحيل: "تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ ..." (2).
وكنَّى عن الموت بوصفه (خطراً ما أفظعه)، قاله بعد تلاوته قوله تعالى: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) التكاثر / 1 - 2. قال (علیه السلام): " ... يَا لَهُ مَرَامًا مَا أَبْعَدَهُ وَزَوْرًا مَا أَغْفَلَهُ وَخَطَراً مَا أَفْطَعَهُ ..." (3).
قال القوم: إنَّكم قطعتم أيام عمركم في التكاثر بالأموال والأولاد، حتى أتاكم الموت، فكنَّى عن حلول الموت بهم بزيارة المقابر.
وقال قوم: بل كانوا يتفاخرون بأنفسهم، وتعدى ذلك إلى أن يتفاخروا بأسلافهم الأموات فقالوا: منّا فلان وفلان - لقوم كانوا وانقرضوا ويؤكد هذا التفسير قول الإمام (علیه السلام): (يا له مرامًا ما أبعده)، أي: لا فخر في ذلك، وإنّما الفخر بتقوى الله وطاعته، (وزورًا ما أغفله!) والزور: اسم للواحد والجمع كالخصم والضيف فجعلهم بتذكر الأموات السالفين كالزائرين لقبورهم.
وقوله (علیه السلام): (وخطرًا ما أفظعه) إشارة إلى الموت، أي: ما أشدَّهُ! فضع الشيء بالضم، فهو فظيع أي شديد شنيع مجاوز للمقدار، وكنَّى عن الموت بعبارة: (سقوا كأسًا) جاء في نهج البلاغة: " ... وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَمِيَتْ أَخْبَارُهُمْ وَ صَمَّتْ دِيَارُهُمْ، وَ لَكِنَّهُمْ سُقُوا كَأْساً بَدَّلَتْهُمْ بِالنُّطْقِ خَرَساً وَ بِالسَّمْعِ صَمَماً وَ بِالْحَرَكَاتِ سُكُوناً، فَكَأَنَّهُمْ فِي ارْتِجَالِ الصِّفَةِ صَرْعَى سُبَاتٍ ..." (4) أي لم تنقطع.
ص: 271
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 228/18.
2- نهج البلاغة، خطبة / 204 / 322.
3- نهج البلاغة، خطبة / 221/ 339.
4- نهج البلاغة، خطبة / 221/ 339.
أخبارهم عن بعد عهد بهم، ولا عن بعد منزل لهم، وإنَّما سقوا كأس المنون (الموت) التي أخرستهم بعد النطق، وأصمتهم بعد السمع، وأسكنتهم بعد الحركة (1).
وكنَّى عن القبور بالربوع: " وَتَهَكَّمَتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصُّمُوتُ" (2). ويعني بالربوع: الصموت القبور، وجعلها صموتًا؛ لا نطق فيها، كما تقول: ليل قائم ونهار صائم أي يقام ويصام فيهما.
وهذا كلّه على طريق الهز والتحريك وإخراج الكلام في معرض غير المعرض المعهود، جعلهم لو كانوا ناطقين مخيرين عن أنفسهم لأتوا بها وصفه من أحوالهم (3).
وكنَّى عن الموت بالعارض " إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ فَتَحَيَّرَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ، وَيَبِسَتْ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ " (4). والغصة ما يعترض مجرى الأنفاس. وقال: إنَّ كلَّ ميت من الحيوان لا يموت إلّا خنقًا، وذلك لأنَّهُ من النفس يدخل، فلا يخرج عوضه، أو يخرج فلا يدخل عوضه، ويلزم من ذلك الاختناق؛ لأنَّ الرئة لا تبقى حينئذ مروحة للقلب، وإذا لم تروحه اختنق.
وعبارة: (ويبست رطوبة لسانه) تدلُّ على أنَّ الرطوبة اللعابيّة، التي بها يكون الذوق تنشف حينئذ، ويبطل الإحساس باللسان تبعاً لسقوط القوة (5).
وكنَّى عن الموت بتصويح النبت: " فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيح نَبْتِهِ (6) أي أمرهم أن يأخذوا العلم من أهله، يعني نفسه (علیه السلام) - قبل أن يموت، فيذهب العلم، فكنَّى عن ذلك بتصويح النبت (7)..
ص: 272
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 11/ 107.
2- نهج البلاغة، خطبة / 221/ 341.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة 11 / 12.
4- نهج البلاغة، خطبة / 121 / 342.
5- ينظر: شرح نهج البلاغة 116/11.
6- نهج البلاغة، خطبة / 105/ 153.
7- ينظر: شرح نهج البلاغة / 119.
وكنَّى عن النعش ب (أعواد المنايا): " ... مَحْمُولًا عَلَى أَعْوَادِ المَنَايَا، يَتَعَاطَى بِهِ الرَّجَالُ الرِّجَالَ حَمْلًا عَلَى المَنَاكِبِ، وَإِمْسَاكًا بِالْأَنَامِلِ" (1).
هذه جملة من الألفاظ والأساليب المستعارة للموت في نهج البلاغة (2)، تكنَّي عنه، وتبعد ظلاله، بعد هجر لفظه الصريح، والتورية بعيدة من الإفصاح.
2 - ما يختصُّ بالأمراض والأوبئة:
يقرن اللسان العبارة بالترجي والدعاء، بما ينجي من البلاء، وتأتي في رأس المُسمّيات - موضع التحريم - أسماء الأوبئة والأمراض، فمثلًا يقولون أصابه بعيد عنك - كذا، وهو مريض - بعيد الشرّ عنك ...
ويتحاشى اللسان عن التلفظ بالاسم. يقولون: (مرضه لا يتسمى) أو (معه مرض خبيث) وربما قالوا: (مرض ما له دواء) ... في كلِّ ذلك يقصدون: (مرضًا مستعصيًا) كالسرطان، فيحاولون اسداله الخفاء عليه، بذكره بلفظه الأعجميّ أو بوصف أعراضه، وكان ذلك حجابًا ساترًا للفظة الفضيحة (3).
وقد عرف السلوك اللغويّ طريقة في التعبير عن الأمراض والعاهات والأوبئة، فالتجأ الناس إلى استعمال مفردات أُخرى، تربطها باللفظة الأصليّة رابطة دلاليّة وسبب هذا الاستعمال هو المُحرم اللغويّ وما يلقيه من ظلال مكروهة.
ونحن هنا سوف نتعقب عبارات الأمراض في نهج البلاغة، لنقف على جملة منها: كنَّى عن مرض (البرص) بالسوء: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُصْبِحْ بِي مَيِّتاً وَ لَا سَقِيماً وَ لَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوءٍ ..." (4) والسقم هنا بمعنى المريض، والسوء كناية عن
ص: 273
1- نهج البلاغة، خطبة / 132/ 191.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة، 6 / 362،7 / 118، 8 / 214 - 379، 9 / 69 - 99 - 143 - 191، 10 / 347، 59/11، 214 - 84 - 8 - 7/13، 15 / 96 ... وغيرها.
3- ينظر: المحرم اللغويّ / 9.
4- نهج البلاغة، خطبة / 215/ 333.
البرص، أي: ولا أبرص والعرب تكني عن البرص بالسوء، ومن أمثلتهم: ما أنكرك من سوء، أي ليس إنكاري لك عن برص حاصل بك فغير صورتك، وأراد بعروقه أعضاءه (1).
وجاء في التنزيل قوله تعالى: ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ) طه / 22. والبرص مرض من الأمراض المنتشرة في ذلك المجتمع.
وكنَّى عن مرض نقص البصر وضعفه ب (أبصار العشوة): " لَقَدْ نَظَرُوا إِلَيْهِمْ بِأَبْصَارِ الْعَشْوَةِ ... " (2) أي نظروا النظر المُفضي إلى الرؤية، لأنَّ أبصارهم ذات عشوة وهو مرض في العين ينقص به الإبصار، وفي عين فلان عشاء وعشوة، بمعنى ومنه قيل لكلِّ أمر ملتبس يركبه الراكب على غير بيان أمر عشوة، ومنه أوطأتني عشوة، ويجوز بالضم والفتح (عُشوة، وعَشوة) (3).
وكنَّى (علیه السلام) عن سوء علاقته بأصحابه من قريش بالوباء، إذ جاء في نهج البلاغة: "وَجَدَحُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ شِرْبًا وَبِيئًا " (4)، والوبيء: ذو الوباء والمرض، وهذه استعارة، كأنه جعل الحال التي كانت بينه وبينهم قد أفسدها القوم، وجعلوها مظنة الوباء والسقم، كالشرب الذي يخلط بالسم فيفسد ويوبي (5).
وكنَّى (علیه السلام) عن الأمراض بالفترات، جاء في نهج البلاغة: " وَتَوَلَّدَتْ فِيهِ فَتَرَاتُ عِلَلٍ، أَنَسَ مَا كَانَ بِصِحَّتِهِ، فَفَزِعَ إِلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ الْأَطِبَّاءُ مِنْ تَسْكِينِ الْحَارِّ 9.
ص: 274
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 11/ 60.
2- نهج البلاغة، خطبة / 221/ 339.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة 11 / 102.
4- نهج البلاغة، خطبة / 233/162.
5- ينظر: شرح نهج البلاغة 172/9.
بالْقَارِّ" (1) فالفترات هنا بمعنى: أوائل المرض، وقد ورد قول أحدهم: (عرضت له فترة أصابت عوده) (2).
وكنَّى (علیه السلام) عن شدّة المرض المؤدي للموت بجملة من العبارات صورت حال المريض وحوله أهله وأصحابه: " حَتَّى فَتَرَ مُعَلِّلُهُ وَ ذَهَلَ مُمَرِّضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ وَ خَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلينَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خَبَرٍ يَكْتُمُونَهُ. فَقَائِلٌ يَقُولُ هُوَ لِمَا بِهِ وَ مُمَنٍّ لَهُمْ إِيَابَ عَافِيَتِهِ وَ مُصَبِّرٌ لَهُمْ عَلَى فَقْدِهِ يُذَكِّرُهُمْ أُسَى الْمَاضِينَ مِنْ قَبْلِهِ" (3).
إنَّ النفس الإنسانيّة لم يتغير موقفها تُجاه الظاهرتين المذكورتين آنفًا (الموت والمرض)، خافت الموت، ورهبت اسمه وفزعت من المرض، وتجنبت لفظه، وبقي منهج العربيّ اللغويّ معناً قائماً حتى اليوم، يستعمل العبارات والأسماء كناية عن المُحظور اللغويّ (الموت) و (المرض)، ومازالت اللغة العربية تتلون مع كل بيئة وزمان ومجتمع ومكان ... محتفظة بالدافع الواحد القائم على تجنب اللفظ الصريح؛ لما يمثله من (مُحرّم) يخشى ويحظر، وهذا ما تتسم به اللغات جميعًا.
3 - ما يختصُّ بدنس الفاحش من الألفاظ:
لم تكن قضايا الجنس وأسماء الأعضاء التناسليّة، أقل شأن من حيث التعبير بها عن ألفاظ الموضوع السابق، لذا أيدتها العرب بألفاظ أُخرى أقلُّ تصريحًا.
وقضية ترك التصريح مشكلة اجتماعيّة وحضاريّة وإنسانيّة ولغويّة ونفسيّة تشابكت فيها خيوط نسيجها؛ ممّا يرفعها إلى مرتبة الظاهرة التي تستحق بذل الجهد والغوص والتعب والكدِّ، بغية رفع الإبهام عنها، والإفصاح عن مضامينها.
ص: 275
1- نهج البلاغة، خطبة / 242/221
2- ينظر: المحرم اللغويّ / 32.
3- نهج البلاغة، خطبة / 216. وينظر: المحرم اللغويّ في 159/1، 9/ 150، 10/ 342، 408 ... وسواها.
فقد يضطر المتكلم حيناً إلى ولوج معجم الفاحش من الألفاظ، يجبرهُ على ذلك موقف تعبيريّ اجتماعيّ، وقد ينفعل حيناً - كما هو الحاصل في البيئات الشعبية - فيلجأ إلى الشّتم والسُّباب تنفيساً عن كربة وتخلصًا من مصيبة، وفي حين آخر تنزل به نائبة من فعل إنسان يومئ إلى غضبه بلسانه، فيقذف من سخيف القول، وفاحش الكلام ما يندى منه جبين الإنسان (1).
وحينما يركب الفرد منّا مركب الفاحش من الألفاظ عند التعبير عن عضو من أعضاء عورته، أو ما شاكله في تسميته، يضطر بسبب فقرهُ اللغويّ إلى الإفصاح والتلفظ بما حقه الستر وعدم البوح.
لقد حث العلماء والأدباء ومن قبلهم القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية على لزوم الحياء، وترك القبح من القول، قال تعالى: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا) النساء: 148. أنشد محمد بن عبد الله البغداديّ [ من الطويل]:
إِذَا قَلَّ مَاءُ الوَجهِ قَلّ حَيَاؤُهُ *** فَلَا خَيْرَ فِي وَجهٍ إِذَا قَلَّ مَاؤُهُ
حَيَاءَكَ فَاحفظهُ عليكَ، فَإِنَّماي دُلُّ على وَجهِ الكرِيم حَيَاؤُهُ (2)
ونهى صالح بن عبد القدوس عن ركوب مسلك الفاحش، لما فيه من مجافاة الصواب، وفقد ناطقه السجايا والآداب، قال: [ من البسيط ]
إنطِق مُصِيبًا بِخَيرٍ لا تَكُن هَذِرًا *** عَيَّابَةً نَاطِقاً بالفُحشِ والرِّيب
وَكُن رَزِينًا طَوِيلَ الصَّمْتِ ذَا فِكَرِ *** فَإِن نَطَقتَ فَلَا تُكثِر مِنَ الْخُطِبِ (3).
ص: 276
1- ينظر: المحرم اللغويّ / 98.
2- ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، أو حاتم محمد أبن حبان البستيّ / 56 - 57، شرح وتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد القفيّ، دار الكتب العلمية بيروت، ب. ت.
3- ينظر: لباب الآداب، أسامة بن منقذ / 276، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الجيل، بيروت، ط 1 (1411 ه – 1991م).
ومن يعود إلى مصادر التراث العربيّ، شعرهُ ونثرهُ، يجد سلوكين متباينين تُجاه قضية الفاحش والسخيف من القول، الأوّل يعمد إلى التصريع باللفظ القبيح، ويتبناهُ ابن قتيبة في كتابه: (عيون الأخبار)، والحصريّ في كتابه: (جمع الجواهر في الملح والنوادر)، والثاني يلجأ متفكراً في أساليب العفّة والحشمة، وعليه معظم العلماء والأدباء فضلًا عن القرآن والحديث وأقوال الأئمة والصحابة والتابعين. ومنهم أمير المؤمنين علي (علیه السلام)، ونهج البلاغة خير دليل على ذلك، إذ جاء فيه: " كَلَّا وَاللَّهُ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ ... " (1).
فكنَّى (أرحام النساء) بكناية لطيفة، وهي: (قرارات النساء)، فلما وجدت الناس قد تواضعوا على استهجان لفظة (أرحام النساء) كنَّى عنها بتعبير لطيف: (قرارات النساء) وجاء في التنزيل العزيز قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) النساء / 43 ويعني الجُمَاع وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ) فصلت/ 20. و(الجلود) هنا كناية عن (اسم موضع الفروج)، وعبارة: (قرار مكين)، جاء في نهج البلاغة: " بُدِثْتَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، وَوُضِعْتَ فِي قَرارٍ مَكينٍ، إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ" (2) فكنَّى عن (الرّحم) بعبارة: (قرار مكين) أي أنَّ الرحم متمكنة في موضعها برباطاتها؛ لأنَّها لو كانت مُتحركة لتعذر العلوق، لكن الجنين هو الذي يتحرك داخل هذا القرار، لذلك أردف قول (علیه السلام) بعبارة: (تمور بطن أمك) أي تتحرك في داخل رحمها، ولا تحير، أي لا ترجع جوابًا (3).
وكُنِّيَ عن ماء الرجل وهو يختلط بماء المرأة ودمها بلفظة: (الأمشاج)، وهي جمع مشيج، كيتيم وأيتام جاء في نهج البلاغة في نهج البلاغة: " ... وَمَحَطِّ الْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْأَصْلَابِ" (4) أيضاً من ألفاظ المُحرّم اللغوي، وتعني المواضع التي يتسرب منها مَني الرجل من صلبه أي يسيل..
ص: 277
1- نهج البلاغة، خطبة/ 94/60.
2- نهج البلاغة، خطبة / 234/163.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة 179/9.
4- نهج البلاغة، خطبة / 91/ 135.
ومن ذلك قول النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) للمرأة التي استفتته في الذي استخلف له ولم يستطع جماعها: " لا حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك " (1) و (ذوق العُسيلة) تركيب منقولبجسر المشابهة من العسل المشهور بلذة طعمه؛ فجعل بذلك للجماع لذ، وجمعت بين الاستعمال الحقيقيّ وما نقل له. وهذه المرأة هي زوج دفاعة القرظيّ (2).
وكُنّيَ عن العفة والشرف ب (ستر العورة)، جاء في نهج البلاغة "وَقَدْ تَوَكَّلَ اللهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بإِعْزَازِ الْحَوْزَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ " (3).
و من الأحاديث النبويّة بهذا المجال: " من كشف قناع امرأة، وجب عليه مهرها " (4). فكنَّى عن الدخول بها بكشف القناع، لأنَّهُ يكشف في تلك الحالة غالبًا، والعرب تقول في الكناية عن العفّة: ما وضعت مومسة عنده ننده قناع.
ومن حديث عائشة (أم المؤمنين): " كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) يصيب من رؤوس نسائه وهو صائم" (5). فكنَّتْ بذلك عن القبلة.
وقد كنَّتْ العرب عن المرأة بالريحانة، وبالسرجة، قال الرقيات:
لا أشم الريحان إلّا بعيني *** كَرَمًا إنما تَشَمُّ الكِلَابُ (6)
أي: أقنع من النساء بالنظر، ولا أرتكبُ منهُنَّ مُحرَّمًا.
والسرحة: الشجرة..
ص: 278
1- أخرجه البخاريّ (2639) ومسلم (1433) والترمذيّ (1118) والنسائيّ (3283).
2- ينظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الاثير 3 / 237.
3- نهج البلاغة، خطبة / 193/134.
4- أخرجه البخاريّ ح (2639) ومسلم (1433) والترمذيّ (1118) والنسائيّ (3283).
5- ينظر: شرح نهج البلاغة 16/5.
6- دیوانه / 85.
و من الأخبار النبويّة قوله (علیه السلام): " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسيقين ماءه زرع غيره) (1). وأراد النهي عن نكاح الحُبالى؛ لأنَّهُ من وطئها فقد سقى ماؤهُ زرعَ غيرِ هِبمائِهِ.
وقال (صلی الله علیه و آله و سلم) الخوات بن جبير (2): (ما فعل جملك يا خوات)؟ يمازحه، فقال: قيدهُ الإسلام يا رسول الله؛ لأنَّ خواتاً في الجاهليّة كان يغشى البيوت ويقول: شرد جمليّ وأنا أطلبهُ، وإنَّما يطلب النساءَ والخلوةَ بهُن (3).
وقد نهى القرآن عن الزنى وكنَّى عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) الممتحنة / 12. لأنَّ الرجل يكون في تلك الحالة بين يدي المرأة ورجليها.
وجاء في نهج البلاغة من المُحرّم اللغويّ في جماع الحيوانات ألفاظًا وتعابير استخدمها الإنسان في التعبير عن دنس الفاحش من القول في حياته، ومنها ما يختصُّ بالطاوس والغراب، إذ ورد: " وَ مِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي [أَحْسَنِ] أَحْكَمِ تَعْدِيلٍ وَ نَضَّدَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِيدٍ بِجَنَاحٍ أَشْرَجَ قَصَبَهُ وَ ذَنَبٍ أَطَالَ مَسْحَبَهُ، إِذَا دَرَجَ إِلَى الْأُنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَيِّهِ وَ سَمَا بِهِ مُطِلًّا عَلَى رَأْسِهِ، كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنَجَهُ نُوتِيُّهُ، يَخْتَالُ بِأَلْوَانِهِ وَ يَمِيسُ بِزَيَفَانِهِ، يُفْضِي كَإِفْضَاءِ الدِّيَكَةِ وَ يَؤُرُّ بِمَلَاقِحِهِ أَرَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضِّرَابِ" (4).
ففي النصّ المُتقدم صورة واضحة لحالة الجماع عن الطاووس، ومن الألفاظ البديلة للفظ المحرّم (يُفضي) بمعنى يُسفد، ويؤر أيضًا بمعنى يُسفد، وهذه من أفضل الكنايات عمّا يجري بين الرجل والمرأة من التماس اللذة، قال تعالى: (وَقَدْ أَفْضَى 5.
ص: 279
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 5/ 17.
2- وهو خوات بن جبير بن النعمان بن أمية النصاريّ صحابيّ، وأحد فرسان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) توفي سنة 40 ه.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة 17/5.
4- نهج البلاغة، خطبة / 237/165.
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) - النساء / 21. إنَّ كثيرًا من صفات الحيوان وأفعاله أو ممّا يصاحب الفعل من حركة أو صوت انتقلت إلى الإنسان بفعل المحرّم اللغويّ، لتكون بديلًا لفظيًا للفظ الأصليّ لما يستقبح ذكره، ومنها: الإفضاء والاسفاد و الإدراج ... وسواها (1).
أما (الأرَّ) فهو الجماع، ورجل أرٌّ كثير الجماع، و (ملاقحه) أدوات اللقاح وأعضاؤه، وهي آلات التناسل. وقوله (علیه السلام): (أَرَّ الفحول) أي: أرًّا مثل أرَّ الفحول ذات الغلمة والشبق.
وذكر ابن أبي الحديد أنَّ قومًا زعموا أنَّ الذكر تدمع عينه فتقف الدمعة بين إجفانه، فتأتي الأنثى فتطعمها، فتلقح من تلك الدمعة وأمير المؤمنين (علیه السلام) لم يحل ذلك، ولكنه قال: (ليس بأعجب من مطامعه الغراب)، والعرب تزعم أنَّ الغراب لا يُسفد، ومن أمثالهم: (أخفى من سفاد الغراب) فيزعمون أنَّ اللقاح من مطاعمة الذكر والأنثى منهما، وانتقال جزء من الماء الذي في قانصته إليها من منقاره (2).
وقال الشريف الرضيّ في عبارة: (يؤر بملاحقه): " الأَرُّ: كناية عن النّكاح يقال: أَرَّ الرجل المرأة يُورها، إذ نكحها " (3).
إنَّ مشكلة التلفظ بالفاحش قضية (اجتماعية - لغوية)؛ وهي تدلُّ دلالة قاطعة على حياة الإنسان، ومقدار التحضر ومدى التماس أسباب التقدم والتطور يوم كان الناس يعيشون في حياة شغف ويعانون القساوة ... تلفظوا بالوحشيّ والخشن والفاحش، ولا يخشون فيه لومة لائم، لأنَّهُ صدى معيشتهم ومرآة واقعهم، ومع ارتقاء حياتهم سمت ألفاظهم وتطورت أساليبهم، وهو أمر طبيعيّ، فالوحشيّ من اللفظ يناظر الوحشيّ من الناس والفاحش يظهر الفاحش.2.
ص: 280
1- ينظر: فقه اللغة واسرار العربية، أبو المنصور الثعالبيّ (429 ه) / 114 - 115، تحقيق ومراجعة عبد الرزاق المهديّ، دار أحياء التراث العربيّ، بيروت، لبنان، ط1، (1422 ه - 2002 م).
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 9 / 186 - 187.
3- ينظر: نفسه 9/ 192.
وقد دعت ضرورات اجتماعيّة وعلميّة وحضاريّة وأخلاقيّة إلى هجر الفاحش من اللفظ، وقد قطعنا أشواطًا من الحضارة والمدنيّة؛ ليكون لساننا منسجمًا مع حياتنا، ولا يكون الحلُّ إلّا بتوخي اللفظ الراقي الذي ترتضيه الطباع ولا تنفر منه الإسماع، لأنَّ ذلك ضرورة لغويّة وحاجة اجتماعيّة ومظهر من مظاهر حيويّة العربيّة، ومرونتها في مسايرة المدنيّة، ودلالة على اتساعها وقدرتها على الاستجابة لكلِّ جديدٍ مبتدعٍ، وكلُّ معنى من لفظه الحقيقيّ المنتزع (1). فما أجمل أن يُكنَّى عن (غشيان النساء) بعبارة:
(أطوف عليهن) (2). ويُكنَّى عن الطلاقبعبارة: (إِلَيْكِ عَنِّي) (3)، أو عبارة: (فَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ) (4). أي: أبعدي أو اذهبي حيث شئتِ، لأنَّ الناقة إذا ألقي حبلها على غاربها، فقد فسح لها أن ترعى حيث شاءت، وتذهب أينما شاءت، لأَنَّهُ إِنَّما يردها زمامها، فإذا ألقي حبلها على غاربها، فقد أهملت (5)، جاء في نهج البلاغة: " ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَ تَهْزِيعَ الْأَخْلَاقِ وَ تَصْرِيفَهَا، وَ اجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً وَ لْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ، وَ اللَّهِ مَا أَرَى عَبْداً يَتَّقِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى يَخْزُنَ لِسَانَهُ، وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَيْراً أَبْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً وَارَاهُ؛ وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ، لَا يَدْرِي مَا ذَا لَهُ وَ مَا ذَا عَلَيْهِ؛ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ.
ص: 281
1- ينظر: المحرم اللغويّ / 114 - 116.
2- نهج البلاغة، كتاب/ 24/ 381.
3- نفسه، کتاب/ 420/45.
4- نفسه.
5- ينظر / شرح نهج البلاغة 15 / 399، 1 / 122 - 125، 10/ 245، 9 / 182، 5 / 41 - 51 ... وسواها.
تَعَالَى وَ هُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْوَالِهِمْ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ، فَلْيَفْعَلْ" (1).
4 - ما يختصُّ بألفاظِ السياسةِ وعلاقتها:
السياسة مصطلح يدلُّ على " نشاط يرتبط بالعلاقات بين طبقات الشعوب وغيرها من الفئات الاجتماعيّة، ويتمحور حول مسألة الاستيلاء على السلطة الحكومية والاحتفاظ بها واستخدامها " (2). وتشتمل على الهيئات والأفكار والحروب والفتن والسلطة وغير ذلك من مفاهيم ومصطلحات سياسيّة.
ويتفرع قاموس الخطاب السياسيّ ما بين أسماء الحكام وألقابهم وكناهم، ونظم الحكم التي يمارسونها، والتقسيمات الإداريّة والمناصب ... والأساليب العسكريّة والمصطلحات السياسيّة ... وغيرها وهي تتبدل من حين إلى حين، ومن بيئة إلى بيئة. فيحدث لقوالب التعبير التحول والتغير وعدم الاستقرار، وهو ما عاشته البيئة العربية، إذ شهدت الحياة العربيّة تغيراً في نظام الحكم، ما بين الجاهليّة عاشت فيه مفاهيم جديدة، فكان بحق ثورة (سياسيّة - اجتماعيّة) في الحياة العربيّة (3).
واقتضت تعاليم الإسلام الحنيف وأعراف البيئة العربيّة الجديدة تحضير استعمال مفردات، وتحريم عبارات، تناولت جوانب مختلفة.
وفي نهج البلاغة جملة من تلك المفاهيم المستحدثة والألفاظ الجديدة موازنة بين الإسلام والجاهليّة أو بين عهد الإمام (علیه السلام) ومن سبقه من الخلفاء الراشدين الثلاثة.
ص: 282
1- نهج البلاغة، خطبة 254/176.
2- معجم العلوم الاجتماعيّة، ناتاليا يفر يموفا (Efremova, Natalya) وتوفيق سلوم / 347، دار التقدم، موسكو، ط 1، 1992 م.
3- ينظر: المحرم اللغويّ / 38.
ومنها قوله (علیه السلام): " وَ سَأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ" (1) إشارة إلى (معاوية)، سمَّاهُ شخصًا معكوسًا، وجسمًا مركوسًا، والمراد انعكاس عقيدته، وأنّها ليست عقيدة هدى، بل هي معاكسة للحق والصواب وسمَّاهُ (مركوسًا) من قولهم: أرتكس في الضلال، والركس ردُّ الشيء مقلوبًا، قال تعالى: وَ اللهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ) النساء / 88، أي: قلبهم وردهم الى كفرهم، ولما كان تاركًا للفطرة التي كلّ مولود يولد عليها، كان مرتكسًا في ضلاله، ولما كان من أهل الشقاوة، سُمِّيَ معكوسًا أو مركوسًا رمزًا لهذا المعنى (2).
وجاء في موضع آخر " وَ مَنْ لَجَّ وَ تَمَادَى فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَ صَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَى رَأْسِهِ" (3) وهو يصف حربه مع أهل الشّام بصفين، وفي النصِّ إشارة إلى (معاوية) وكنَّى عنه تارةً بنعت أبائه "وَ مَا لِلطُّلَقَاءِ وَ أَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَ تَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَ تَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ " (4).
وتعني العبارة أنَّ قدر معاوية يصغر أن يدخل نفسه في أي الرجال من المهاجرين الأوليين، ويقصد بالمفاضلة بين (أبي بكر وعمر وعلي)، ولفظة (الطلقاء) أطلقها رسول الله بعد فتح مكة، حينما عفا عن أبي سفيان و مشركي قريش، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقل (علیه السلام) لمعاوية بعد أن أعلن عصيانه في نهاية كتاب أو رسالة (السلام عليكم)، بل وردت عبارة: (والسلام لأهله) (5)، إذ لم يستمر في الدين حتى يقول له: (والسلام عليك)، وهو عنده فاسقٌ لا يجوز إكرامه.
والجدير بالذكر أنّ الإسلام قد تجاوز في إطاره الاجتماعيّ عن ألفاظ التحية الجاهليّة، واضعاً أُخرى أقرب إلى روح الحياة السياسيّة الجديدة، إذ كان تحية الجاهليين 9
ص: 283
1- نهج البلاغة، كتاب / 45/ 450.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 16/ 398.
3- نهج البلاغة، كتاب/ 58/ 449.
4- نفسه، كتاب / 387/28.
5- نهج البلاغة، كتاب / 370/9
في الغدوات: (أنعم صباحًا) وفي العشاءات: (أنعم مساءً)، وقد تحولت إلى (عم)؛ لكثرة الاستعمال (1)، ومنها قول امرئ القيس:
الاَعِمُ صباحًا أَيُّها الطَّلَلُ البَالِي وَهَل يَعِمَن مَن كانَ فِي العصر الحالي (2).
ثم انتقلت بفعل الإسلام إلى (السلام عليكم)، يصدقه قوله تعالى: (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ) يونس / 10.
وكنَّى عن أبي سفيان بعبارة: (يحزب الأحزاب) (3) إشارة إلى أحزاب معركة الخندق، وكنَّى عنه أيضًا بأسد الأحلاف (4)، وكنَّى (علیه السلام) عن الخليفتين أبي بكر وعمر ب (فلان وفلان) (5).
وكنَّى أيضًا عن (طلحة والزبير) بالشيخين: "فارجعا أيها الشيخان عن رأيكها " (6)، وعبارة (الشيخان) هنا إشارة إلى علمهما بالحقِّ ومشاهدتهما الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) وهو يبين لهما ولغيرهما الحقّ وطرقه وأهله، فهما يعلمان بذلك، كما يعلم الشيخ ذو العلم والخبرة والعمر بما يجري في ضوءِ ما جرى.
واستعمل لفظة: (أبي محمد) مع طلحة لما مرَّ عليه وهو صريع في الوغى، كأنه يندبه ويتحسر عليه: (لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان غريباً ...)..
ص: 284
1- ينظر: الأنصاف في مسائل الخلاف، محمد عبد الرحمن ابن الأنباري، 2/ 809، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت (1407 - 1987م).
2- الديون، أمرى القيس / 139، دار صادر، بيروت (1392 - 1972م).
3- نهج البلاغة، خطبة / 28/ 388.
4- نفسه.
5- ينظر: شرح نهج البلاغة، 1/ 99، 12/ 197، 130/16، 17/ 104.
6- نهج البلاغة، كتاب / 447/54.
وكنَّى عن عائشة أم المؤمنين ب (فلانة): " ... وأما فلانة، فأدركها رأي النساء ...) (1). والحمة: " وإنها للفئة الباغية فيها الحماً والحمة ... " (2)، ووصف أهل البصرة ب (جند المرأة) قاصدًا بالمرأة (عائشة أم المؤمنين)؛ لأنَّهم أطاعوها في معركة الجمل وناصروها.
(3) وكنَّى عن الخليفة عثمان ب ابن عفان (3) وعن عمر بن العاص ب (ابن النابغة): " وَأَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجهْلِ بِاللَّه قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ، وَمُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ " (4) و " ... عَجَبًا لِابْنِ النَّابِغَةِ يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِي دُعَابَةً ... " (5)
وقد ذكر الزمخشريّ في كتابه (ربيع الأبرار) أنَّ النابغة أم عمرو بن العاص، وكانت أمة لرجل من عنزة، فسبيت، فاشتراها عبد الله بن جدعان التميميّ بمكة فكانت بغيًا، ثم اعتقها، فوقع عليها أبو لهب وأمية بن خلف وهشام بن المغيرة وأبو سفيان والعاص بن وائل في طهر واحد، فولدت عمرًا، فأدعاه كلهم فحكمت أمه فيه، فقالت: هو من العاص بن وائل، وذلك أنَّ العاص بن وائل كان ينفق عليها كثيرًا، وكان أشبه بأبي سفيان(6).
وكنّى عن الحجاج بن يوسف الثقفيّ ب (غلام ثقيف): " أَمَا وَاللَّه لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ الذَّيَّالُ الميَّالُ يَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ وَيُذِيبُ شَحْمَتكُمْ إِيهِ أَبَا وَذَحَةَ (7)..
ص: 285
1- نفسه، خطبة / 156، ص / 219.
2- نفسه، خطبة / 137، ص / 195.
3- نفسه، خطبة / 174، ص / 250.
4- نفسه، خطبة / 180، ص / 260.
5- نفسه، خطبة / 84، ص / 116.
6- ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات، لأبي القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشريّ (ت 538 ه)، والكامل في اللغة، لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحويّ (ت 285)، نقلاً عن كتاب شرح نهج البلاغة، أبن أبي الحديد 6/ 37.
7- نهج البلاغة، خطبة / 116، ص/ 175.
وهذه من أنباء المغيبات والصلات بالمستقبل، و(الذَّيَّال الميَّال) التائه الظالم، وعبارتا: (يَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ وَيُذِيبُ شَحْمَتكُمْ) تعني: يستأصل أموالكم، وكلتا العبارتين استعارة.
وعبارة: (إِيهِ أَبَا وَذَحَةَ) انتقل فيها الإمام (علیه السلام) وكأنه يخاطب حاضراً بين يديه و (إيه) كلمة يستزاد بها من الفعل، وتقديره: زد وهات أيضًا ما عندك، وضدها (إيها) أي: كف وأمسك و (الوذحة) الخنفساء، ولها عدة احتمالات دلاليّة تبين صلتها بالحجاج (1)، لا سعة لذكرها هنا.
ويبدو للباحث - والله العالم - أنَّ العدول عن الاسم الصريح إلى غيره ما هو إلّا سلوك يمليه المُحرّم في المخوف منه؛ لأنَّ الخوف والهيبة من ذكر الاسم الصريح للميت أو الغائب يؤديان بالمتكلم إلى أن يسلك طرقاً يحتمي بها، لأنَّهُ يعتقد أنَّ مجرد ذكر الموت أو الميت يوقع في النفس القشعريرة والارتجاف واهتزاز البدن؛ وكأن اللفظة وقعت موقع فعلها، وصلت إلى محل مسماها، هذا مع العامة من الناس، أما الإمام (علیه السلام) فلم يذكر المُحرّم اللغويّ بلفظه سيرًا على أدب القرآن اللغويّ الذي ورد فيه الأمر بعبارة مؤدبة لطيفة أسمى من العبارة المتداولة، وكأن القرآن الكريم يقول: الزموا هذهِ الألفاظ وتأدبوا بها وقيسوا عليه واهجروا ما تعارفتم عليه، وهو سبيل انتهجه الإمام (علیه السلام) هنا، فهو مع القرآن والقرآن معه.
وكنَّى عن الخلافة بعدة كنايات: (سلطان ابن أمي) (2) ومنها: (... أشركتك في أمانتي ...) (3) ومنها " ... أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ أَلَا وَإِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ ..." (4).
ص: 286
1- ينظر: شرح نهج البلاغة، ج / 7، ص / 195.
2- نفسه، خطبة / 36/ 410.
3- نفسه،کتاب / 41/ 413.
4- نفسه، کتاب / 176/ 254.
ويعني بالقدر السابق: الخلافة ... وغيرها، ومنها: (لمع لامع، وطلع طالع ولاح لائح) (1)
وكنَّى عن (الحرب) بعدة كنايات، منها: (... لا فرطن لهم حوضاً أنا ماتحه ...) (2) ومنها: (... وتحلب عبيط الدماء ...) (3). ومنها: (... احمر البأس ...) (4). وغيرها.
وكنَّى عن (الهزيمة) ب (الجولة) وعن (الهرب) ب - (الانحياز عن الصفوف)، جاء في نهج البلاغة: " ... وقد رأيت جولتكم، وانحيازكم عن صفوفكم ...) (5). فأحجل في اللفظ، وكنَّى عن اللفظ المنقر، عادلاً عنه إلى لفظ لا تغير فيه، وهذا باب من أبواب البيان لطيف، وهو حسن التوصل بإيراد كلام غير مزعج عوضًا من لفظ يتضمن جبهًا وتقريعًا (6)؛ " وسرّ كلّ تلك التّكنيّة أو التّعميّة هو ما استقر في ذهن الإنسان منذ القدم من الربط بين اللفظ ومدلوله ربطاً وثيقاً، حتى أَنَّهُ يعتقد أنَّ مجرد ذكر الموت يستحضر الموت، وأنَّ النطق بلفظ الحيّة يدعوها من حجرها ... وقد سيطرت تلك العقيدة على عقول كثير من أبناء الأُمم البدائية، حتى أصبحوا لا يفرقون بين الشيء واسمه ... " (7). فضلًا عن ظاهرة التطير التي تلقي بظلالها على لغة الفرد، فيعدل من صيغة إلى أُخرى،.
ص: 287
1- نفسه، خطبة / 152/ 213.
2- نفسه، خطبة / 196/137.
3- نفسه، خطبة / 151/ 202.
4- نهج البلاغة، كتاب/ 369/9
5- نفسه، خطبة / 10/ 156.
6- ينظر: شرح نهج البلاغة، 170/17 كناية عن (الحرب)، 9 / 33 كناية عن (الكنوز)، 84/11 كناية عن (الصبر)، 175/6، كناية عن (النفاق)، 200/7 كناية عن (النار)، 77/9 كناية عن (المدينة المنورة)، 9 / 115 كناية عن)نفسه)، 1 / 1،268/8، 9/ 154، / 404،63/15، 11/ 114 كنايات عن (الدهر،وألفاظه)، 416/8، 11/ 24،17/ 98 كناية عن (الشيطان)، 7/ 180، 8/ 396 كناية عن (الفقر)، 200/7، 107/15 كناية عن (الليل والنهار)، 6/ 256، 9 / 54 كناية عن (البخل) ... وسواها.
7- دلالة الألفاظ / 144.
ومن استعمال مفردة إلى سواها، على هدي المجتمع الذي تولدت فيه؛ لأنَّ اللغة وثيقة الصلة بكلِّ أنماط السلوك الجماعيّ، فيظهر (المُحرّم اللغويّ) كظاهرة اجتماعيّة لا يخلو منها مجتمع أو حضارة.
ص: 288
نهج البلاغه
فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ
الفَصْلُ الرَّابِعُ
البِنْيَةُ اللغويّةُ وأثرُها في اطُتَلقي
ص: 289
الفَصْلُ الرَّابعُ
البِنْيَةُ اللغويّةُ وأتْرُهَا فِي المُتَلقي
مدخل:
إنَّ الأصل في اللغة احتواء القيمة ونقلها، فاللغة وعاء يحوي أسمى ما يمكن أن يتعلق به الفرد من معانٍ، بمعنى أنَّ اللغة قائمة على فقه الكلمة المعبّرة عن القيمة، وهذا يعني أنّ الارتباط متلازم بين اللغة وقيمها، فهي تنشئ متعلميها على اتقان استعمال الكلمات والتراكيب في سياقاتها التعبيريّة والقيميّة على وفق ضوابط و قواعد محددة، ففي فقه اللغة أصول، وفي النحو تراكيب، وفي الأصوات أنغام، وفي المعاني دلالات ... وغير ذلك.
فالبنية اللغويّة تؤثر إيجابًا في المتلقي إذا كانت مشحونة بالقيم، وتنحصر أو تصبح غير فعالة أو أداة محايدة إذا خلت وتم افراغها جزئيًا من هذا المضمون على النحو الذي يُلْحَظُ حديثاً في لغة المحادثة اليومية والاعلام، فاللغة في نظرنا رسالة ووسيلة لنقل القيمة وليستأداة الاتصال فقط، تدرس لذاتها وفي حدِّ ذاتها (1).
وقد حثَّ الخطاب العلويّ في غير موضع على الحيطة والحذر في الكلام، منها قوله (علیه السلام): " قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ " (2)، فأحسن القول ما يوثق الصلة بالخالق تعالی (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فصلت/ 33، وهذا يعني أنَّ الكلمة تكون ذات مضمون دالٍ إذا حملت مخزونًا قيميًّا ثابتًا.
ص: 291
1- ينظر: فقه اللغة وعنف اللسان في المنطقة العربية، بحث منشور في كتاب اللسان العربيّ و اشكالية التلقي، عبد الرحمن العزيّ / 14، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربيّ، رقم / 55، ط 1، بيروت، 2007م.
2- نهج البلاغة، حكمة/ 81/ 482.
وتُعدُّ الكلمة العلامة أو السمة المميزة للانسان " لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ " (1) إذا كانت الكلمة ذات قيمة عليا، أما إذا كانت الكلمة فاقدة للقيمة أو تناقضها فليس لها قرار " وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ " (2)، فالكلمة إما أنْ تكون منتجة، وإما أنْ تكون مستهلكة، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿24﴾ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿25﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿26﴾) إبراهيم / 24 - 26
فالقيمة العليا للكلمة تدلّ على ارتفاع منزلتها، وترفع صاحبها، قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ) فاطر / 10، وقول الإمام (علیه السلام) " لَا تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَبَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ " (3).
مركز الجذب الذي احتلته اللغة الخطابيّة في نهج البلاغة، هو (عنصر الخطيب) بالدرجة الأولى، فهو عمادها، بوصفه منظومة جماليّة إنموذجيّة شاملة للجانبين: اللغويّ والأخلاقيّ، قابلة للتأثير في المناحي النفسية والاجتماعية للمتلقي؛ ذلك أنَّ الفن الخطابيّ يعتمد أساساً على قوة الخطيب البيانيّة والحجاجيّة من جهة، وعلى سيرته الأخلاقيّة التي يسعى إلى تلبسها اجتماعيًا، بوصفه مُمثلاً لقيم مثالية من المفترض احتذاؤها والسير على هَدْيها من جهة أُخرى، لذلك غدا الإمام علي (علیه السلام) رمزًا للفضيلة، ومثالًا لصنعة الخطابة، فتفرقت بنيته اللغويّة في مسالك ومفارق متنوعة ولبست حللًا شتی تراوحت بين العقلانيّة والبرهنة، والجماليّة الأدبيّة والاحتماليّة التعدديّة، وسمته (ع) بسمات الإنسان ذي القيم العليا. 1.
ص: 292
1- نهج البلاغة، حكمة / 477/40.
2- نفسه.
3- نهج البلاغة، حكمة / 548/411.
إنَّ عملية التأثر في المتلقي تتوقف من جانب آخر على موقع المتلقي من هذه العملية، فكيف لنا أن نعتقد أنَّما ينتجه الخطيب من بنى لغويّة ذات أفكار ومضامين مفيدة أو غير مفيدة؟ إنّ الجواب عن هذا السؤال يتطلب البحث عن اقتضاءات مشتركة داخل موقع المستمع (فضاء المستمع)، من شأنها أن تخلق آثارًا جماعية مشتركة بين المتخاطبين.
إنَّ البحث في موقع المستمع داخل المجال التداوليّ يلغي تقريبًا الطرائق المعياريّة، وينتج طرائق متنوعة، تتلاءم مع الوضع التواصليّ المطلوب في عمليات التأثير والإقناع، فضلًا عن الشروط المجالية؛ ذلك أنّ بناء العمليات الحجاجيّة يستوجب منذ البداية عدَّ المستمع والبحث فيه، بعبارة أخرى ينبغي لنا البحث عن الاتفاقات السابقة والمشتركة التي سيقوم عليها الحجاج، وإلّا فإنَّ الحجاج سيكون مصادرة على المطلوب، ولا يؤدي وظيفته الحجاجية الأساسيّة، لذا يُعدُّ المستمع مكونًا أساسيًا في العمليات التخاطبيّة والتواصليّة، وموجهًا ضروريًا بطبيعتها وأهدافها (1).
إنّ إشكالية إنتاج اللغة داخل السياق التواصليّ، تتعلق بقضية الإقناع على نحو رئيس، إذ لا تتحدد قضية الإقناع في ذاتها، إنما هي رهان يؤسس قاعدة الحجاج داخل اقتضاءات مجاليّة متنوعة، يتمتع بها المخاطبون بقسط من الحرية، فإنَّ ما يطرحه ويدافع عنه الخطيب لم يكن سوى قول نظريّ خالص، وفارغ من سلطة الإقناع، فالحرية هنا شرط أساسيّ، ينبغي لنا استحضاره في كلِّ مقاربة خطابيّة (2).
وتثير قضية الإقناع إشكالًا آخر يتعلق بمضمون ما يمكن إيصاله للمتلقي، فقد يكون معنىً أو قضيةً أو فكرةً أو فرضيةً او خبرًا أو اقتراحًا أو اعتقادًا أو موقفًا أو شعورًا ... وسواها من المعلومات القيميّة، ذلك أنَّ العلامات اللغويّة تتجاوز نقل.
ص: 293
1- ينظر: عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، دكتور عبد السلام عشير / 21 افريقيا الشرق 2006 م.
2- ينظر: عندما نتواصل نغير / 22.
المضمون، إلى نقل إيحاءات المعاني وظلالها التي سبق لها أن انطبعت في اذهان المتلقين عبر تجاربهم، فارتبطت بعواطفهم، وتداخلت مع مشاعرهم، وكوّنت تطلعاتهم ورغباتهم، بل شكّلت نظرتهم للعالم وللآخرين (1).
وفي هذا الفصل سوف يتناول الباحث أثر البنية اللغويّة في المتلقي في ضوءِ ثلاثة مباحث، هي:.
ص: 294
1- ينظر:نفسه/ 38.
المبحثُ الأوّلُ / البُعد التُواصليُّ (تحليلُهُ، أنماطُهُ)
تُعدُّ عملية التواصل بين المتكلم والسامع من أولى ركائز مبحث السياق، ويتطرّق الالسنيون المعاصرون، المهتمون بتحليل السياق إلى تفصيلات هذا التواصل وما يفرضه محيط السياق وظروفه على التركيب اللغويّ للنصِّ المنطوق، ذلك أنَّ المتكلم حينما يُفرض عليه نوع من أنواع السياق، يتبنى الخصوصيات البنيويّة والتواصليّة التي يفرضها ذلك النوع، فلا يمرُّ وقت على الإنسان بلا أن يحدث تواصل بينه وبين الآخرين وبينه وما بين العالم من كائنات وظواهر.
غير أنَّ أرقى ضروب التواصل هو التواصل باللسان، فالإنسان هو الكائن الذي يرمز كما يستنشق الهواء أكثر من الكائنات الأُخرى، إذ يرمز للأشياء بأصوات وعلامات وصور، وهي آلية تجعله يختزن ما يدركه في الكون جميعًا، لذلك عُدَّ الكلام أصلًا في كلِّ تواصل بشريّ، حتى إنَّ ما سواه من وسائل الاتصال الأُخرى تجري على قانونه، وتفهم على مقتضاه (1).
وللخطبة خصوصيات تميزها من أشكال التواصل الأُخرى، فهي تختلف عن أشكال التواصل الكتابيّة، ومن شروطها الأساسية أن يخاطب فرد ما جماعة ما أو يخاطب فرد فردًا ما أمام جماعة ما تكون بموقع المنصت ولا يحق لها مبدئيًّا مقاطعة الخطيب والدخول معه في حوار قبل الانتهاء من خطبته (2)، لكننا نجد أحداثًا كلاميّة في خطب نهج البلاغة كان سببها مقاطعة فرد من الجماعة الخطيب (الإمام) قبل الانتهاء من خطبته وانحراف مسار الخطبة عن موضوعها الأصلي، نتيجة لعدم استيعاب بعض المستمعين مفاهيم الخطبة، وهذا ما حصل في الخطبة المعروفة ب
ص: 295
1- اللسان والميزان أو التكوثر العقليّ، طه عبد الرحمن / 213.
2- نفسه / 122.
(الشَّقشقية) التي اشتملت على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح الإمام (علیه السلام) صبره عنها، ثم مبايعة الناس له، إذ يقول فيها: " أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ، يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ يَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى وَ فِي الْحَلْقِ شَجًا، أَرَى تُرَاثِي نَهْباً، حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ. ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى:
شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا *** وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ) (1)
فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا.
فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ، فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ، حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ فَيَا لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ. إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ، فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَ النَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أُخْرَى وَ قَسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» القصص: 83 بَلَى؛ وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَكِنَّهُمْ حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ 7
ص: 296
1- ديوان أمرؤ القيس / 67
وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ. (1)
وحينما بلغ الإمام هذا الموضع قاطعه رجل من أهل السواد وناوله كتابًا، قيل فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها، فاقبل الإمام (علیه السلام) ينظر فيها، فلما فرغ من قراءته، قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو أطرت في خطبتك من حيث أفضيت.
فقال: هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرّت.
ويقترب مفهوم نظرية (المساءلة والبلاغة) لماير (2) من تحليل هذا الخطبة، إذ استطاع ماير - اعتمادًا على منطلقات معرفيّة ومرتكزات فلسفيّة - أن يؤسس منهجًا تسأوليّاً يقوم على مبدأين، هما: المبدأ الافتراضيّ في تحليل الأقوال، ومبدأ الاختلاف الإشكالي داخل الأقوال، إذ تقوم كلّ الأقوال في العمليات التواصلية على مبدأ الافتراض المؤسس على الجواب والسؤال المفترضين انطلاقًا من مجموعة من المقومات التي تحكم العمليات التواصليّة كالسِّياق والمعلومات السالفة والمعلومات الموسوعيّة، والتجربة الذاتيّة، القدرات التفكيريّة والتأويليّة والتخيليّة، إذ يصبح كلُّ قولٍ (خبرًا، إنشاءً، استفهامًا، تعجبًا، نهيًا، أمرًا ...) فتراضًا لشيءٍ ما داخل سياق نصّيٍّ معين، أي جوابًا عن سؤال سالف، وسؤالًا لجواب لاحق، وبهذا يعبر الافتراض عن انتظارات متعددة ومختلفة تقتضيها العلاقات الإنسانية لتحقيق أهدافها ومراميها، أو عن انفعالات ذاتيّة تؤثر في سِّياق الخطبة (3).6.
ص: 297
1- نهج البلاغة، خطبة / 3 / 50 - 51.
2- وهو أحد منظري البلاغة المعاصرة الذي أحدثت دراساته طفرة نوعية في تحليل الخطاب في مجال التواصل والإقناع. (ينظر: عندما نتواصل نغير، د. عبد السلام عشير / 194، أفريقيا الشرقية، 2006 م.
3- ينظر: عندما نتواصل نغير / 196.
وعلى وفق هذه النظرية فإنَّ هذه الخطبة بمنزلة الجواب لسؤالٍ سابق يمكن استنتاجه، وهو: لماذا (نكث طائفة ومرقت أُخرى وقسط آخرون)؟ مع أنَّهم سَمِعوا قول الله تبارك تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) القصص: 83، ثم يجيب (علیه السلام) عن هذا التساؤل بقوله: " بلى والله سمعوها ووعوها ولكنهم حَليت الدنيا في اعينهم وراقتهم زبرجها" (1).
ومن جهة أخرى فإنَّ هذه الخطبة تُعدُّ بمنزلة سؤال الجواب لاحق، وهذا السؤال يمثل الانفعالات والنكبات التي عاناها المشروع الإسلامي بعد ثلاث وعشرين سنة من التربية والتهذيب، ويمكننا تحسس هذا السؤال وهو: لماذا صبر علي (علیه السلام) على تلك الانحرافات؟ وقد عبر ابن عباس عن تأسفه على عدم بلوغ الإمام مبلغ الجواب بقوله: " فَوَاللَّه مَا أَسَفْتُ عَلَى كَلَامٍ قَطُّ كَأَسَفِي لَى هَذَا الْكَلَامِ أَلّا يَكُونَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (علیه السلام) بَلَغَ مِنْهُ حَيْثُ أَرَادَ " (2)، فمجيء القسم المؤكد ب (قط) والتأسف في كلام ابن عباس ما هما إلّا دليل على افتراض وجود جواب لاحقٍ لم يطرد الإمام في كلامه؛ لیبینه.
إنَّ تأثير الإمام في المتلقي (ابن عباس) إنَّما جاء تبعاً لما يسمى بمفهوم (الاصابيّة)، وهي نظرية سيكولوجيّة تعمل على اختيار ما يأخذ بكلام المتخاطبين وما يؤثر فيهم من أقوال وحجج، ومبدأ (الاصابيّة) ليس بقاعدة، لكنه يعمل محرك لعمليات التأويل على مستوى النظام المركزيّ للذهن، وبهذا المعنى تقترب الاصابيّة من (مبدأ التعاون) الذي جاء به غاريس إلّا أنَّ مبدأ التعاون يمكن خرقه، بخلاف (الاصابيّة) التي لا يمكن خرقها؛ لأنَّها لا تتطلب في معرفة سابقة من طرف المتخاطبين من أجل تحقيق التواصل الملائم، بل أنَّها موجودة سابقًا عند الإنسان ولا تعرف الاستثناء (3)..
ص: 298
1- نهج البلاغة، خطبة / 3/ 50.
2- نهج البلاغة، خطبة / 3/ 50.
3- ينظر: عندما نتواصل نغير / 32.
هكذا ف (الاصابيّة) بين الإمام وابن عباس مؤسسة على التصور المعرفيّ والاستدلاليّ فيما بينهما، ومدعومة في الوقت نفسه بأسباب سيكولوجيّة ومنطقيّة، يصعب خرقها، فهي بهذا المعنى قاعدة الفعل التواصليّ بامتياز (1).
أما عن المبدأ الثاني من نظرية (المساءلة والبلاغة) فمبدأ الاختلاف الإشكاليّ الذي يقوم على طرح الاختلافات القائمة بين الأقوال، ويرمي إلى تحقيق مبدأ القول اقناعًا واستمالةً، وهذه الاختلافات هي المزية الحقيقيّة في العمليات التواصليّة، ليس بوصفها تنوعات قوليّة في الشكل والمضمون، بل بوصفها اختلافات تحكمها ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفيات السِّياقيّة والثَّقافيّة التي يتوافر عليها الذهن البشريّ، ويبنين بها تفكيره الخاص، إذ تصبح محوراً للاختلافات الإشكالية التي تجسد اللغة من متكلم إلى آخر (2). لكن المظهر الإشكاليّ للاختلاف الذي يمتاز به تفكير الإمام (علیه السلام) يجسده أقواله في علاقاتها التواصليّة مع الآخرين، وعلى نسق واحد في نصوص نهج البلاغة، نجد الإمام (علیه السلام) وقد تقلصت عنده حدة الاختلاف الإشكاليّ الأوّل مع مرور مراحل حياته الشريفة، وهو ما علله (ماير) بأنَّ الإنسان في تلك الحالة قد لا يتواصل، لأنَّهُ يشعر أنَّ كلَّ شيءٍ محيط به محط اختلاف مع الآخر (3)، وربما أنَّ الايدولوجيّة التي يحملها الإمام (علیه السلام) تساعده على جلاء الشيء وإيضاحه، وإنَّما يتواصل الإمام مع الاختلاف الإشكاليّ الأوّل؛ ليجيب بمقدار الضرورة عن الأشياء الغامضة والإشكالات المتعلقة بالعقيدة والدين، فالاختلافات الإشكالية الأوّليّة التي حصلت بين صفوف ال - الأُمة بعد وفاة النبي حول مسألة الخلافة، استغلتها طوائف متعددة أيام خلافته (علیه السلام)، ففي بدء خلافته نكثت طائفة رفعت شعار (المطالبة بدم الخليفة الثالث) مع أنَّ الإمام (علیه السلام) أوضح موقف دعاتها ومشاركتهم في مقتل الخليفة الثالث، إذ قال الإمام: "وَ إِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ؛ فَلَئِنْ كُنْتُ.
ص: 299
1- ينظر: عندما نتواصل نغير / 34.
2- ينظر: نفسه / 196.
3- ينظر: نفسه / 197.
شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ، وَ [إِنْ] لَئِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ، وَ إِنَّ أَعْظَمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ؛ يَرْتَضِعُونَ أُمّاً قَدْ فَطَمَتْ وَ يُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَتْ. يَا خَيْبَةَ الدَّاعِي، مَنْ دَعَا وَ إِلَامَ أُجِيبَ؟ وَ إِنِّي لَرَاضٍ بِحُجَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ عِلْمِهِ فِيهِمْ. " (1). أما الطائفة المارقة فقد رفعت شعاراً (لا حكم إلّا لله)، وقد أجابهم (علیه السلام) موضحًا أنَّها: " كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ، وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ" (2). ولم يترك لهم حجة إلّا وأسمعهم إياها، فعبارة: (كلمة حق يراد بها باطل) تمثل تقابلًا ثنائيًّا لا يقبله العقل والمنطق، لكنه موجود في الحقيقة وحاصل في الواقع، وبذلك فتح الإمام المجال أمام المستمعين والقرّاء لاستعمال قدراتهم العقلية في فكّ هذا التقابل الرمزيّ، انطلاقًا من تأويلهم الخاص، وهنا تكمن قوة التقابل الحجاجيّ: تقابل لا يقبله منطق العقل ولا يرفضه منطق الواقع.
يقترب ما جاء به (هيجل) من تصادم الأفكار ابتداءً وتلاحمها في النهاية من مبدأ التقابل الثنائيّ المتعارض هنا؛ ذلك لأنَّ التقابل في الطبيعة والإنسان في تماس مستمر، يجعل من كلِّ علاقة واقعيّة علاقة تقابليّة، حتى الإنسان في ذاته وتجاربه وعلاقاته يشتمل على مبدأي السلب والإيجاب (3).
في حين أنَّ الطائفة القاسطة رفعت شعار: الثأر بدم الخليفة الثالث، وهي بذلك ترتبط ايدولوجيا بالطائفة الناكثة، وحقيقتيهما وهو الاستئثار بالسلطة، وقد أعلن الإمام (علیه السلام) براءته من دم الخليفة الثالث قائلًا: " للَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً، غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ.
ص: 300
1- نهج البلاغة، خطبة /22/ 64.
2- نهج البلاغة: خطبة / 40 / 83.
3- ينظر عندما نتواصل نغير / 184 - 185.
خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. وَ أَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ، اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ، وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ " (1).
إنَّ الخطر الاجتماعيّ الذي أحدثته الطوائف الثلاث في حينها تمثل باللغة الإعلامية التي تضمنتها شعاراتهم البراقة، والتي أثرت في حياة المجتمعات حتى يومنا هذا، تلك اللغة التي تميزت بالقدرة على تحويل الإيجاب إلى سلب والسلب إلى إيجاب ودليل ما نراه الآن من قضايا ظاهرة البطلان تجد من يعتقد صدقها، وأُخرى واضحة الصدق تجد من يعتقد كذبها.
فنشأ عن هذا الاختلاف (نزاع داخليّ)، هو حالة عادية، لأنَّ الحرب الداخلية في كلِّ مجتمع حديث لا تتوقف إلّا تحت ضغط الحرب الخارجيّة، فما دامت الحرب في الخارج فالسلم في الداخل، وما دام السلم في الخارج فالحرب في الداخل، هذا هو التبادل والمميِّز للمجتمع (2). ومع كلِّ ذلك نجد الإمام (علیه السلام) قد تواصل مع الأُمة محاولًا إيجاد قواسم مشتركة تفرضها الطبيعة التواصليّة الإنسانيّة، فهناك أزمة اجتماعيّة، سببها التباين الكبير بين الذي يطمح له مبدع النصّ والواقع الحياتيّ المعيش فيه، فنراه (علیه السلام) يحاول جاهدًا بث رؤاهُ بما يبذر الأمل في مجتمعه، محفزًا له للنهوض برؤية تمتلك مقومات متنوعة، منها القوتان الوجدانيّة والإيمانيّة، إذ قال (علیه السلام) في صفة أصحاب النبي (صلی الله علیه و آله و سلم): " لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَ خُدُودِهِمْ وَ يَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ" (3). ملقياً عليه الحجج: " اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائِرَةِ وَ الْمُصْلِحَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا، فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلَّا النُّكُوصَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَ الْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ 7.
ص: 301
1- نهج البلاغة، خطبة / 74/30.
2- ينظر: اللغة والمجتمع، م.م. جاكسون / 233.
3- نهج البلاغة، خطبة / 144/97.
عَلَيْهِ يَا أَكْبَرَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً، وَ نَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَ سمَاوَاتِكَ، ثُمَّ أَنْتَ بَعْدُ الْمُغْنِي عَنْ نَصْرِهِ وَ الْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ " (1). لذلك نجد أنّ هذه رؤية امتلكت حساسيّة في الكشف عن عالم رحب متناقض، حتى أصبحت هذه الرؤية ذاتاً مُؤرَّخةً بالإحداث، أعطتنا محاور مهمة عن شخوص ورموز، وزمان ومكان، ووقائع راعبة مرَّ بها التاريخ، وكشفت هذه الرؤية عن عمق التجربة الشخصية لقائد تاريخيّ حملت رؤاه مسائل العصر، ونجد أنَّ وعيه (علیه السلام) بلورة الرؤية ليس بوعي مجرد، وإنَّما هو وعي مقترن بمفاهيم أخلاقيّة واجتماعيّة (2).
إنَّ اختلاف ابن عباس والرجل من أهل السواد حول إتمام الخطبة أو قطعها يقودنا إلى موضوع (المستمع المقصود)، إذ إنَّ التفاوت في فهم نصِّ الخطبة ربما يعود لاختلاف البنيات الفكريّة والاجتماعيّة لجماعة المستمعين، فإنَّ النصَّ الذي يستدعي تفسيراً حرفيّاً عند مستمعٍ قد يستدعي عند مستمعٍ آخر الاستنتاج والتأويل (3)، ويبقى الخطيب هو المسؤول المباشر عن إنشاء كلامه كوحدة متكاملة الأجزاء، وليس للسامع أن يغير في اتجاه الكلام أو موضوعه، فنصُّ الخطبة بهذا المعنى يقترب من النصِّ المكتوب، فهو لا يخضع بنحو مباشر لإرادة السامع حول مسألة متابع الخطبة أو قطعها، لكن يبقى الفارق بين نصِّ الخطبة والنصِّ المكتوب، هو أنَّ الأخير يحتاج في بعض الأصناف كالرواية مثلًا إلى تصور قارئ وهميّ توجه إليه الكتابة، أما الخطيب فمستمعه حاضر أمامه، وإليه يتوجه في الخطاب.
إنَّ اختلاف التصورات التي فرزتها الخطبة من تنظيرات، اتسمت بأبعادها الزمانيّة ومنطلقاتها المتباينة ومقاصدها الخفيّة، تمركزت في الجانبين (الإمتاعيّ والإقناعيّ)، الإمتاع بوصفه إجراءات أسلوبيّة واستراتيجيات استهوائيّة، تخاطب في.
ص: 302
1- نفسه، خطبة / 212/ 330.
2- ينظر: دراسات في نهج البلاغة، د. علي إبراهيم /6، بحث منشور على شبكة الانترنت.
3- ينظر: قران المخاطبة والاقتباس في الخطاب الوسيط المعاصر، طلال وهبت / 213، بحث منشور في مجلة فصول، العدد /77 - شتاء ربيع 2010 م.
المقام الأوّل أحاسيس الجمهور، وتسعى إلى تحريك عواطفه، متوخية التأثير الفاعل في الدفع إلى تبني مواقف مؤيدة للخطبة المتوجه بها إليها، ومن ثم قبول قضيته عن حماسة لا عن روية، هذا قُبالة الإقناع وجوهره - الأطروحة والأطروحة المضادة – ذات التوجه المبني على مسار استدلاليّ مُنظم، المحتمل للمعقول والمقبول من الرأي المخالف (1).
و في كثير من خطبه (علیه السلام) يتوجه بها إلى جمهور أوسع بكثير من الجماعة الحاضرة، سواء أكان هذا الاتساع كميّاً أم كيفيًّا، فمضامين خطبه حيّة عند السامع المباشر وغير المباشر، فحينما يقول: أيها الناس أو عباد الله، أو يا أخوتاه، ... وغيرها من عبارات الاستهلال التي اعتادها الخطباء عند البدء بخطبهم، فهو يوجه كلماته في الواقع إلى الجماعة الحاضرة، لكنه يدرك أنَّ تلك الكلمات أوسع مدى من الجماعة الحاضرة، فهو يؤثر في سلوكيات الجماعات عبر الأزمنة والأمكنة والمواقف المختلفة.
ولكننا لا ننكر أنَّ الإمام (علیه السلام) في عدد من خطبه كان يوجه الخطاب إلى صنف خاص من أصناف المستمعين وهو: (المستمع المقصود) يعمل على تكوين تصور عن كيفية تلقي هذا الصنف لخطبته، فينشئ الخطبة بما يتلاءم وطرائق التلقي والتفسير عند صنف المستمع المقصود الذي اختاره والمستمع المقصود في الوقت نفسه يكون مطلعًا على الظروف المرتبطة بموضوع الخطبة، ولا ينجح التواصل بين الخطيب ومستمعه المقصود إلّا إذا ابتدأ الخطيب من حيث يستطيع المستمع المقصود مواكبته في خطبته، أي إذا ربط مضمون خطبته بواقع أو عالم معين من الحقائق (2).
وحين ننعم في النظر في الحوارية التي دارت بين الإمام (علیه السلام) و همام بن تغلب ونتأمل في عناصر الحدث الكلاميّ، آخذين في الحسبان سياق الخطبة وأثره في موضوع 4.
ص: 303
1- ينظر: الحجاج وبناء الخطاب في أضواء البلاغة الجديدة، أمينة الدهريّ / 8، شركة النشر و التوزيع المدارس - الدار البيضاء، ط 1،1432 ه - 2011م.
2- ينظر: الحجاج وبناء الخطاب في أضواء البلاغة الجديدة،أمينة الدهريّ / 214.
الخطبة، يصف فيه حال المتقين، أي أنّ مفرداته لا تخرج عن المعجم الدينيّ، إنما جاءت هذا الخطبة على وفق حواريّة تسبب في حدوثها سؤال سالف (مفترض) في ذهن المستمع المقصود لم يستطع إظهاره، فنتج عن هذا السؤال المفترض سؤال ظاهر، توجه به همام إلى الإمام (علیه السلام) قائلًا: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم؟ ويبدو أنَّ السؤال المفترض في ذهن السامع هو ليس السؤال الظاهر الذي طرحه، أي ليس النظر إلى المتقي، وإنَّما معاشرتهم والانتماء إليهم، وانقطاع النفس عن علائقها في المحسوسات تشوقاً إليهم، ولا سيما أنّ همام (المستمع المقصود) من العبّاد الزاهدين، فيكون السؤال المُفترض هو: كيف أجد ضالتي بالقرب من المُتقين؟ وقد قيل في الوجد إِنَّهُ: " حالة تحدث للنفس عند انقطاعها عن المحسوسات بغتةً، إذا ورد عليها وارد مُشوِّق" (1)، أي اتصال النفس بمبادئها المجردة عند سماع ما يقتضي ذلك الاتصال، لأنَّ وصف الإمام (علیه السلام) المُتقين تسبب في موت همام فجأة.
ولما أحسَّ الإمام (علیه السلام) تعلق همام بالمتقين خاف عليه، فأجاب بما يروع من تشوقه المهلك بالتأسي في القرآن الكريم، قائلًا له: يا همام أتقِ الله وأحسن ف (إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ) النحل / 128.
أراد الإمام (علیه السلام) من هذا الاقتباس أن يقيم علاقة بين حدثين خطابيين، الأوّل: حدث الإنتاج الأصليّ للكلام المقتبس، والآخر: حدث الإنتاج المقتبس لكلامه اللاحق، أراد من ذلك الاقتباس أن يعيد تأطير كلامه حول مضمون المقتبس، وزجَّه في انسياق وواقع جديدين على وفق حاجاته التواصليّة، ويطلق دارسو النصِّ على عملية الاقتباس هذه مصطلح (تجديد السِّياق) (2).1
ص: 304
1- شرح نهج البلاغة، 10/ 336 (من أقوال الحكماء).
2- Fair clough Norman (2004) Analy sing Discourse Textual analysis for social research London and New york, Rou tledge p.p 139 – 141
إنَّ الأغراض التعبيريّة الإقناعيّة للخطيب، وبنية نصِّه شكلا معًا عالمًا نصّيّاً يتفاعل معه النصُّ المُقتبس، سواء أكان الكلام المُقتبس بحرفه أم بغير حرفه، وفي كلتا الحالتين تقوم صلة بين الخطيب من جهة، والنصُّ المقتبس وموضوع الخطبة وظروف القول المحيطة به من جهة أُخرى، لأنَّ كلَّ كلام مُقتبس له مُتكلم مُستقل، لديه أهداف وقناعات وتوجهات تزامنت مع كلامه، وهذه المكوّنات تتفاعل مع الإطار الجديد الذي اختاره الخطيب (سيد الموقف)، فهو الذي ينظم العلاقة بين النصِّ المُقتبس ونصِّهِ الجديد، وظروف التواصل التي يعيشها مع مستمعيه.
على الرغم من استشهاد الإمام (علیه السلام) بالنصِّ القرآنيُ لم يكتفِ همام بهذا القول ولم يقنع حتى عزم على الإمام (علیه السلام) أن يفصل في وصف حال المتقين، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ثم قال: " فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ - غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ - لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ - وَ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ - وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ - فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ - مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ" (1).
إنَّ تناقل الإمام (علیه السلام) في الردِّ على المسترشد ربما كان لمصلحة في تأخير الجواب لعله كان قد حضر المجلس من لا يحب أن يجيب وهو حاضر، فلما انصرف أجاب، ولعله رأى أنَّ في تأخير الجواب ما يثير تشوق همام إلى سماعه، وهو أسلوب من أساليب التأثير في المتلقي، فيكون أنجع في موعظته والتأثير فيه، وربما كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وربما كان التثاقل عن الجواب ليتسنى ترتيب المعاني التي خطرت له في قوالب لفظيّة مناسبة، ثم ينطق بها كما يفعل المتروي في إنشاء الخطبة والقريض (2)..
ص: 305
1- نهج البلاغة، خطبة/ 193/ 304.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة، 10/ 317.
هيّأ الإمام (علیه السلام) مستمعه المقصود لمضامين خطبته، والتأثير فيه، فابتدأ خطبته ب (الاستهلال) المعروف عنه (علیه السلام)، وهو الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه وآله، وقد وافق هذا التهليل موضوع الخطبة وسياقها الاجتماعيّ، ثم قال: أما بعدُ، فاستعمل أسلوب التفصيل الذي يدلُّ على انتظار معلومات ترد لاحقًا، توجب على المستمع المقصود سماعها وتأملها، ثم مهد لوصف المتقين بذكر نعم الله على الخلق، وهو غني عن عبادتهم، وفي نهاية الفقرة بدأ بذكر صفات المتقين، وأنّهم من أهل الفضائل. تميزت عبارته بثنائيات متوافقة مع حال المتقين فقال: " منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع "، إذ صور فيها سلوكهم بجملٍ أسميّة للدلالة على الثبوت والدوام، ثم قال: " غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ؛ نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ، كَالَّتِي نُزِّلَتْ فِي الرَّخَاءِ؛ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ [لَهُمْ] عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ" (1). فتغير أسلوب الخطبة من أسلوب الجمل الاسميّة إلى أسلوب الجمل الفعليّة مع متابعة الثنائيات المتوافقة، فابتدأ فيها بالفعل الماضي (غضوا، ووقفوا) للدلالة على تحقق الوصف بهم: " غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ؛ نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ، كَالَّتِي نُزِّلَتْ فِي الرَّخَاءِ"، الماضي هنا في منزلة الحاضر والمُستقبل المُتحقق قطعًا، فالمتقون هم الغاضون أبصارهم والموقفون أسماعهم على العلم النافع لهم في كلِّ زمان ومكان.
وفي عبارة: " وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ [لَهُمْ] عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ". فإنّنا نجد الجملة الشرطيّة جوابًا لسؤال لاحق طرحه أحد الحاضرين، بعدما أتمَّ الإمام (علیه السلام) كلامه، وصعق همام ومات، قال (علیه السلام): " أَهَكَذَا تَصْنَعُ المَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. 4.
ص: 306
1- نهج البلاغة، خ/ 193/ 304.
فَقَالَ (علیه السلام): وَيْحَكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْت لَا يَعْدُوهُ، وَسَبَبًا لَا يَتَجَاوَزُهُ، فَمَهْلًا لَا تَعُدْ لِمثْلِهَا، فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ " (1). فاعتراض القائل في غير موضع الاعتراض لما بيَّنه في أثناء الخطبة، وهذا يدلُّ على الفارق المميّز بين صنفي المستمعين (المقصود وغير المقصود)؛ فلا يلزم من موت العامي عند وعظ العارف أن يموت العارف عند وعظ نفسه؛ لأنَّ انفعال العاميّ ذا الاستعداد التام للموت عند استماع المواعظ البالغة وتدبرها أتمُّ من استعداد العارف عند سماع نفسه أو التفكر في كلام نفسه، لأنَّ نفس العارف قويّة جدًا، والآلة التي يحفر بها الطين قد لا يحفر بها الحجر (2). فضلا عن أنّ الله تعالى ضرب لهم أجالًا ينتهون إليها.
وعبارة: (فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ)، أي تكلم بلسانك، وأصله النفخ بالفم، وهو أقل من النفث (3).
ثم أنَّنا نجد عبارة: (شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ) ما هي إلّا نتيجةً لفقرةِ أُخرى: " عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، فَهُمْ وَالْجنَّةُ كَمَنْ قَدْ رآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ " (4). فلا ريب في أنَّ من شاهد هاتين الحالتين يكون على قدم عظيمة من العبادة والخوف والرجاء، وهذا مقام جليل.
ممّا تقدم نلحظ أنَّ الإمام (علیه السلام) استعمل أسلوب الاستدلال وأسلوب الحجاج والثنائيات التقابليّة للتأثير في المستمع المقصود، فجاءت الثنائيات الخبريّة متتاليّة: "قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ 3
ص: 307
1- نهج البلاغة، خطبة/ 304/193.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة، 10/ 337.
3- ينظر: مختار الصحاح، مادة (ن ف ث) / 671.
4- نهج البلاغة، خطبة/ 304/193
عَفِيفَةٌ " (1)، نتيجة لما رأوه، ف " صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً، أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً، تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ؛ أَرَادَتْهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا، وَ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا " (2).
وهذا القصد الاختباري الذي جاء به (علیه السلام) انطلاقًا من مؤشرات إنسانيّة غير کافٍ، بل أنَّهُ بداية الطريق إلى قصد أخر أعمق من القصد الإخباري، وهو القصد إلى التغيير المعرفيّ للسامع المقصود، وهو السبب الذي جعل التواصل والتفاعل قائمين بين عناصر الحدث الكلاميّ، وهو أمر جعل فهم القصد التّواصليّ للإمام (علیه السلام) غير معتمد على دلالة القول اللسانيّ، بل منطلقًا منها، ومتجاوزًا بتشغيل كلِّ أنواع المقدمات والقرائن السِّياقيّة، بهدف تغيير المحيط المعرفيّ للمستمع المقصود، لذلك استعمل الإمام (علیه السلام) قدراته الاستدلاليّة الاستنتاجيّة في بث معلومات عن وصف حال المُتقين ذات علاقة بالعلامات اللسانيّة والسِّياق الاجتماعيّ لتلك الجماعة، حتى وصل الإمام (علیه السلام) بمستمعه المقصود إلى بيان سلوكهم الحياتيّ: " أَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلًا، يُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ؛ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ، رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً وَ تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ؛ وَ إِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ، أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَ شَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ؛ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أَكُفِّهِمْ وَ رُكَبِهِمْ وَ أَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ.
وَ أَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ وَ لَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي" (3). فعاد الإمام (علیه السلام) بتكرار أسلوب التفصيل لبيان.
ص: 308
1- نهج البلاغة، خطبة / 193/ 305
2- نفسه، خطبة / 193/ 305
3- نهج البلاغة، خطبة / 193/ 305.
حالهم ليلاً ونهارًا، فذكر صفاتهم وسلوكهم في الليل، وهي صفات لم يطلع عليها أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فهي من وظائفهم وعلامة صدقهم مع الله سبحانه وتعالى ثم عرَّج على تكرار أسلوب التفصيل ثالثًا؛ ليصف سلوكهم ووظائفهم في النهار التي يطلع عليها الناظرون جهارًا.
وفي عبارة: " لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهمُ الْقَلِيلَ، وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ. فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ". نجدهم لا يسكثرون في كثير من أعمالهم ولا يرضيهم اجتهادهم، وأنَّهم يتهمون أنفسهم وينسبونها إلى التقصير في العبادة. وهو معنى جليل انتقل إلى الأدب العربيّ فيما بعد، قال المتنبي:
يَسْتَصغَرُ الخَطرَ الكبيرَ لنفسِهِ *** ويظنّ دجلَةَ ليس تكفي شاريًا (1).
ويُعدُّ هذا من الأثر اللغويّ الذي أحدثه الإمام (علیه السلام) في الأدب العربيّ، تداولته الأجيال وحفظته المجتمعات.
أما قوله (علیه السلام) في نهاية الفقرة: " اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ " (2).
فهو كلام مستقل بنفسه منقول عنه (علیه السلام) أنّه قال لقوم مرَّ عليهم وهم مختلفون في أمره، ومعناه: اللهم إن كان ما يشبه الذامون ليّ من الأفعال الموجبة الذمّ حقًا، فلا تؤاخذني بذلك وأغفر ليّ ما لا يعلمون من أفعال، وإن كان ما يقوله المؤرخون حقًا، فأجعلني أفضل ممّا يظنون فيّ.
ربما جاء في هذا الكلام توقع لما سوف يحصل عند المستمعين من شبهات بعد فراغه من كلامه، وبالفعل نجد أنَّ الاختلاف واضح بين ما استقبله المستمع المقصود من مضامين ومعلومات، وما استقبله المستمع غير المقصود، وربما كان شكلاً أُعيد بناؤه.
ص: 309
1- ديوان المتنبي، شرحه وكتب هوامشه: مصطفى اسبيتيّ، 154/1، دار الكتب العلمية،،بيروت، ط4، 2009م.
2- نهج البلاغة، خطبة / 193 / 305.
انطلاقًا من الفرضيات المستخلصة من الذاكرة الموسوعية للإمام (علیه السلام) ومن المعلومات السِّياقيّة للحدث الكلاميّ، فضلًا عن مزاوجة التواصل الصريح مع التواصل الضمنيّ، فالمضمون الصريح ما هو إلّا مجموعة الفرضيات المقصودة، أما المضمون الضمنيّ فهو مجموعة الفرضيات المُستنتجة، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الجانب الصريح يبدو أكثر غنىّ وإثارةً للاستدلال والاستنتاج والتأثير
ثم قال (علیه السلام): " فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ وَ إِيمَاناً فِي يَقِينٍ وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ وَ قَصْداً فِي غِنًى وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْراً فِي شِدَّةٍ وَ طَلَباً فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِي هُدًى وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ يُمْسِي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ يَبِيتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً حَذِراً لِمَا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ فَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَةِ إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَا تُحِبُّ قُرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ وَ زَهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَى يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ تَرَاهُ قَرِيباً أَمَلُهُ قَلِيلًا زَلَ - لُه خَاشِعاً قَلْبُهُ قَانِعَةً نَفْسُهُ مَنْزُوراً أَكْلُهُ سَهْلًا أَمْرُهُ حَرِيزاً دِينُهُ مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ مَكْظُوماً غَيْظُهُ الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَ إِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ،
يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ يُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ وَ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ؛ بَعِيداً فُحْشُهُ لَيِّناً قَوْلُهُ غَائِباً مُنْكَرُهُ حَاضِراً مَعْرُوفُهُ مُقْبِلًا خَيْرُهُ مُدْبِراً شَرُّهُ؛ فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٌ وَ فِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ وَ فِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ؛ لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَ لَا يَأْثَمُ فِيمَنْ يُحِبُّ؛ يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ لَا يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ وَ لَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ وَ لَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ وَ لَا يُضَارُّ بِالْجَارِ وَ لَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ وَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ؛ إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ وَ إِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ؛ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ؛ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ
ص: 310
دُنُوُّهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ وَ لَا دُنُوُّهُ بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ." (1)، إذ استعمل الإمام لفظة (علامة) وهي لفظة سيميائية تعمل بوساطة التشابه الواقعي بين الدال والمدلول على تبني ملاحظة السلوك الدال على صفة المتقين، إذ تحمل العلامة معلومة يوضحها المرسل بنحوٍ رمزي وتكون هذه المعلومة مرتبطة دائمًا بتجربة المتلقي الذي ينبغي له أن يكون قادرًا على الكشف عنه، وإعطائها دلالتها الحقيقية (2)، فليس من الغريب أن يصعق المخاطب (همام) بعد سماعها؛ لأنَّهُ الوحيد الذي استطاع فك الرموز التي تحملها العلامة ومن ثم فهم المعلومة التي تحملها العلامة ولكن عدم استعداده لتحمل مضامينها أدى إلى موته: "هَكَذَا تَصْنَعُ الْمُوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا " (3).
ومن جانب آخر امتازت خطب نهج البلاغة بتعدد المخاطبين من متكلم وسامع ومخاطب، فلكلِّ علاقة تبادليّة كلاميّة نواة تتألف من متكلم ومستمع وكلام، أما المستمع فليس بالضرورة أن يكون مخاطبًا، أي ليس بالضرورة أن يكون مستمعاً مقصودًا. هنا يمكن أن نستخلص الأنماط التواصليّة في خطبة المُتقين، أنموذجًا يمكن تطبيقه على بقية الخطب على مايأتي:
أ. النمط الأول: مخاطبة الإمام (علیه السلام) للمستمع المقصود: " يَا هَمَّامُ اتَّقِ اللهَ وَأَحْسِنُ " (4).
بدأ الإمام كلامه بعبارة موجزة على سبيل الإجمال، مُتضمِّنةً النتيجة النهائيّة لقوله تعالى: (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ) النحل / 128. إذ يدلُّ النداء ومجيء فعل الأمر بصيغة الأفراد (اتق، وأحسن) أنَّ الكلام موجه إلى منادى معين وهو (همام). ويمكن تبينّها في هدي الرسم الآتي: 3.
ص: 311
1- نهج البلاغة، خطبة / 193 / 305.
2- ينظر: التواصل نظريات ومقاربات، جاكسون / 193، ترجمة: عز الدين الخطابيّ وزهورحوتي، ترجمة: عبد الكريم غريب، منشورات عالم التربية، ط 1، 2007.
3- نهج البلاغة، خطبة / 307/193.
4- نهج البلاغة، خطبة / 304/193.
الصورة
ب. النمط الثاني: مخاطبة الإمام (علیه السلام) لله سبحانه وتعالى على سبيل الدعاء والثناء، وهو أسلوب اعتاده الخطباء الإسلاميون في بدء خطبهم، ويمكن تبيّنه في هدي الرسم الآتي:
الصورة
والجدير بالذكر أنَّ الإمام (علیه السلام) حينها أحسّ بتأثر المستمع المقصود، ضمّن كلامه عبارة اعتراضية أوضح فيها تنزيهه عن الشبهات التي قد تحصل عند المستمعين بأسلوب الدعاء المُوّجه إلى الباري سبحانه وتعالى: " اللهم لا تؤاخذني ... ما لا يعلمون " (1).
و قد يكون في هذا النمط أن يتوجه الخطاب من الخطيب باسمه واسم الحاضرين لله تبارك وتعالى، لذلك يكون المستمعون جميعًا مقصودين بنحو غير مباشر.
ج. النمط الثالث: مخاطبة الإمام (علیه السلام) جمهور المستمعين (المقصودين وغير المقصودين)، والخطاب في هذا النمط يتوجه إلى الحاضرين جميعًا، وهذا النمط أبسط الأنماط التي يستعملها غالباً الخطباء وأكثرها تردادًا، يتبيّن ذلك من الرسم الآتي:
الصورة
ص: 312
1- نهج البلاغة، خطبة / 193، ص / 305
د. النمط الرابع: مخاطبة الإمام (علیه السلام) المستمعين الحاضرين بنحوٍ من التفصيل؛ لما أوجز من خطابٍ في جوابه الأوّل، إذ يذكر فيها علامات المُتقين وصفاتهم وسلوكهم على نحو الأخبار الصادق، يتمثل أحيانًا بصيغة الجمع كما في قوله (علیه السلام): " غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ؛ نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ، كَالَّتِي نُزِّلَتْ فِي الرَّخَاءِ؛ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ [لَهُمْ] عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ؛ عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ؛ فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ، وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ" (1). ويتمثل أحياناً بصيغة الإفراد كما في قوله: " إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ، خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ أَنَا أعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي" (2). والرسم الآتي يبيّن عناصر النمط الرابع.
الصورة
ه. النمط الخامس: مخاطبة الإمام (علیه السلام) للمستمع غير المقصود، تمثل ذلك عندما صعُق ومات قال حينها (علیه السلام): " أهَكَذَا تَصْنَعُ المَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا" (3). ويمثل الرسم الآتي عناصر هذا النمط:
الصورة
ص: 313
1- نهج البلاغة، خطبة / 193 / 305.
2- نفسه.
3- نهج البلاغة، خطبة / 193 / 307.
و. النمط السادس: مخاطبة الإمام (علیه السلام) المستمع غير المقصود (المعترض)، وفي هذا النمط توجه الكلام للمستمع غير المقصود الذي حصلت في ذهنه شبه فاعترض على الإمام (علیه السلام) بقوله: وما بالك يا أمير المؤمنين يمثل الرسم الآتي عناصر هذا النمط:
الصورة
قال (علیه السلام): " وَيْحَكَ، إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ وَ سَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ؛ فَمَهْلًا لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا، فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِك" (1). فجاءت ألفاظ (ويحك، لسانك) متصلة بكاف المخاطب، بدلالة توجيه الخطاب بنحوٍ مباشرٍ إلى المستمع المعترض، فضلًا عن مجيء أسلوب التوكيد ب (أنّ، واللام ومهلًا) الدالة على الإنكار، والجدير بالذكر أنَّ المستمع غير المقصود على صنفين الصنف المعترض، وإليه توجّه الخطاب في النمط الخامس، والصنف الآخر المستمع غير المقصود (غير المعترض).
ويمثل النصّ الآتي عناصر التواصل في النمط الثالث قال (علیه السلام): " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَ لَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ وَ وَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ " (2).5.
ص: 314
1- نهج البلاغة، خطبة / 307/193.
2- نفسه / 305.
المبحثُ الثاني / وسائلُ الإقناعِ التّداوليّ
امتاز التراث العربيّ من غيره من تراث الأُمم الأُخرى، بسبب تدوين النصوص الدينيّة والعلميّة والأدبيّة والاجتماعيّة وضبطها لغويًا، وعلى الرغم من أنَّ المكتوب تقيد لبعض جوانب الملفوظ في ضوءِ المقابلات الترميزيّة، لكن بقية الدراسات العربية في تحليل الص لا تعنى بالغرض العام، إلّا من طريق تحليل اللغة الحيّة المتكلمة في ظروفها الوضعيّة، منظورًا في ذلك إلى حال مستعملها وغاياته، والمتلقي، وما يتقاسمه الاثنان من آفاق مشتركة، قد تساعد على عملية التأثير المرجوة، لذلك ظهر مجال جديد يُعنى بكلِّ ذلك، سُمِّيَ بالتداولية، وهي تُعنى بدراسة العملية التواصليّة بمقتضياتها الحقيقيّة والافتراضيّة كافة في الخطاب الأدبيّ بمختلف مظاهره وتجلياته، شعرًا كان أم نثرًا (1).
وتعود كلمة (التداولية) في أصلها الأجنبيّ - e Pragmatig - إلى الكلمة اللاتينية Pragmatic الذي استعملت عام 1440 م، وتتكون من الجذر PRAGMA ومعناه الفعل - Action (2)، ثم دخلت اللغة فاكتسبت اصطلاحًا لسانيًا ذا دلالة جديدة، يعني ذلك الاهتمام المنصب على مستوى لغويٍّ خاص، يهتم بدراسة اللغة في علاقتها بالسياق الاجتماعيّ (المرجعيّ) لعملية التخاطب، وبالأفراد الذين تجري بينهم عملية التواصل (3)، وبعبارة أخرى تركز اهتمامها في مجموعة الضوابط والمبادئ التي تحكم عملية تأويل الرموز والإشارات اللغويّة في إطار جهاز الدلائل
ص: 315
1- ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافيّ العربيّ / 28، الدار البيضاء - ط2 / 2000 م.
2- ينظر: Maxidico, Dictionnaire encyctopedipue de la langue Francoise, edition de la co naissance 1997, p 876.
3- ينظر: نفسه
اللغويّة، لا في حرفيتها (المستوى التركيبيّ والمستوى الدلاليّ). بل إنَّ بعضًا ممّا يعين على التأويل وتوجيه حرفية اللغة إلى غير وجهتها، هو من غير جنسها بالأساس، كمظاهر الضجيج، وتعبيرات الوجه، وأوضاع الجسد، وحركات الأيدي، ومحتويات الوعاء الزمانيّ والمكانيّ، ممّا له الأثر الكبير في الإيحاء والفهم (1). تلك عوامل إذا أُسيء استغلالها وفهمها شوهت المقاصد، وعاقت الوصول إلى لبّ نتاج الدلالة الحق، التي هي وليدة علاقة العلامات بمستعمليها، بوصفهم أحياءً عاقلةً ذوي أبعاد متعددة (2).
ومفهوم التداولية من المفاهيم التي ساد فيها الإبهام أسوةً بكثيرٍ من المفاهيم والمصطلحات اللسانيّة الحديثة، فالتداولية إجمالاً: مجموعة من النظريات اللسانية، التي نشأت متفاوتة من حيث المنطلقات ومتساويّة من حيث اللغة، بوصفها نشاطًا يمارس ضمن سياق متعدد الأبعاد، أو تلك الشروط والقواعد اللازمة للملاءمة بين أفعال القول ومقتضيات الموقف الخاصة به، أي العلاقة بين النصِّ والسياق، ويُلْحَظُ باستمرار تلك العلاقة الوثيقة بين التداوليّة والدلالة من جهة والتداوليّة والنحو من جهة أُخرى، إذ يجمع بينهما مستوى السياق المباشر، ممّا يجعل التداوليّة قاسمًا مشتركًا بين أبنية الاتصال النحويّة والدلاليّة والبلاغيّة (3).
و ممّا تقدم اتضح لنا من وجه أنَّ مفهوم التداوليّة الذي يغطي بطريقة منهجيّة منظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة العربيّة ب (مقتضى الحال)، وقد خرجت من رحمها المقولة الشهيرة: (لكل مقام مقال)..
ص: 316
1- ماهي السيميولوجيا، بارنار توسان / 10، ترجمة: محمد نظيف، افريقيا الشرقية، الدار البيضاء، ط 2، 2000م.
2- ينظر: المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب، المفهوم والمبادئ والحدود، نواري سعودي أبو زید / 122 بحث منشور في مجلة فصول العدد / 77، سنة / 2010.
3- ينظر: تعريف (فيرشورن) في شظايا لسانيّة / 59، وتعريف (فان دايك) في المصدر نفسه وتعريف (فرانسواز ارامنكو) في النصّ والسياق / 275.
وللتمييز بين مدلولي العبارة التداوليّ والحرفيّ، نأخذ مثلاً عبارة (أحسنت)، التي تعني استجادة المتكلم تصرفًا أو موقفًا معينًا من المتلقي، بحكم أنَّ المعنى في التداوليّة ينبثق من علاقة العلامة بالمتكلم من جهة، وبالسياق من جهة ثانية، وبالاستعمال في الجماعة اللغويّة التي ينتمي إليها طرفا العملية التداوليّة من جهة ثالثة، فالعبارة قد تعني الاستحسان الحق إذا صاحبها هشٌّ يظهر على ملامح الوجه أو تصفيق أو صياح أو سواها، ممّا يدلُّ عليها، وقد تدلُّ على السخرية والاستهزاء إذا خوطب بها مصاحباً لإمالة الصوت أو هز الرأس، وقد تحمل العبارة دلالة التوبيخ ممزوجاً بالغضب، إذا كان المخاطب أبًا والسامع ولدًا، فرَّط في أمرٍ كان ينبغي له أن يحسن فيه، فتُلقى العبارة في عكس مدلولها الحرفيّ، من باب التعريض، زيادة على اللوم (1).
ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) الدخان / 49. في موقف الأخذ للكافر زيادة في التنكير والتوبيخ وفي نهج البلاغة: قال (علیه السلام) لمعاوية في هذا المضمون: " وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ" (2).
وقد أشار أمير المؤمنين إلى قضية (قصور اللغة) عن تأدية المعنى، إذ قال: "إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ " (3)، هذه المقولة التداولية تشير إلى قصور قدرة اللغة على نقل الأفكار والأحاسيس والمشاعر بالعدد والماهية أنفسهما، إذ " إنَّ النفس كلما ازدادت علوًا في مراتب الكمال كان ضبطها للقوة المتخيلة أشد فكان الكلام الصادر عنها أقل وجودًا، إذ لا يصدر عنها حينئذ كلمة إلّا عن تروٍّ وتثبت ومراجعة لعقلها في كيفية وضع تلك الكلمة " فلا ترقى تلك القوالب اللفظية لحمل تلك المضامين العظيمة المقصودة. 1.
ص: 317
1- ينظر: المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب، المفهوم والمبادئ والحدود، نواري سعودي أبو زيد/ 123، بحث منشور في مجلة فصول، العدد / 77، سنة / 2010.
2- نهج البلاغة كتاب / 389/28 - 390.
3- نهج البلاغة، حكمة / 481/71.
تمثل هذه المقولة حلاً لإشكالية قصور اللغة فهي وسيلة يطل الفرد بها على العالم، يُفهم عنه ويفهمه، وتنقل من طريقها الأفكار المجردة والعواطف والأحاسيس المضمرة في قالب مسموع بالأصل، ثم مكتوب كإجراءٍ تالٍ افتراضًا وتحقيقًا، فهي الكلام الذي نستعمله، ومنها ننتهي إلى النصِّ الذي نقرؤه، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى أهليّة هذه الوسيلة كي تنقل بأمانة، وهل اللغة قادرة على استيعاب كلّ أحداث الكلام وما يحيط بها؟ ثم كيف ننظر إلى حقيقة مرجعيّة الخطاب الأدبيّ المكتوب، هل هي حقيقة كلّها؟ أو مفترضة كلّها؟ أو تأخذ بحظٍ من هذه وتلك؟ ولا سيما إذا قصدنا عنصر الإيحاء الذي هو ابرز مقومات أدبية الخطاب، فأي دور سيؤديه؟ وهل هو عامل ايجابيّ في التعاطي التداوليّ مع المدوّنة المعينة، أو هل يشكِّل عرقلة في الوصول إلى حقيقة انبثاق الدلالة وآلية الإنتاجيّة فيما بين أطراف الخطاب المتعددة، ومدى تحكم كلُّ طرف من تلك الأطراف في العملية الخطابيّة في بناء الدلالة، التي وصفت بأنَّها إحدى بنات تربة التداوليّة كوظيفة (1).
لهذا نرى أنَّ حكمة الإمام تحمل حلًا لإشكالية (قصور اللغة) إلى حدٍّ ما في تأدية الغرض، ولا أدلُّ على ذلك من أننا أحياناً نريد شيئاً، فنصوغه بعبارات، يفهم السامع منها شيئاً آخر، بحكم أنَّ اللغة قد تخون صاحبها أحيانًا، بل قد تحمل الدلالة عكس القصد، ويزداد الأمر حدّة فيما يتعلق باللغة المتعاليّة عن اللغة النفعيّة، إلّا إذا أشركنا جميع الأبعاد، التي يفترض ألّا تغيب عن الصائغ للخطاب ولا عن المؤول له كشرط مستصحب.
واللافت للنظر أنَّ الدرس التداوليّ درس ممتد على مساحات واسعة ومختلفة، بما يجعله حقلًا يركِّز في مناطق متداخلة من علم الدلالة وعلم اللغة الاجتماعيّ، فالارتباط وثيق بين محاور هذين العلمين، لكننا نجد أنَّ المحور التداوليّ يولي العلاقة بين التراكيب اللغويّة أهميةً كما يُعنى بالمقام مباشرة، أما المحور الدلاليّ فيدرس أولًا الصلات بين.
ص: 318
1- ينظر: المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب/ 126.
الرموز اللغويّة ومسمياتها، وهو فضلًا عن ذلك يلتفت إلى المقام، لكنه لا يُعنى بتفاصيل القول فيه، تاركًا عبء ذلك على التداوليّة (1).
لذا أفردت التداوليّة مجالا واسعًا لدراسة الاعتماد المتبادل بين اللغة والسياق الاجتماعيّ، ممّا لم يكن متوفرًا قبل ظهور التداوليّة منهجًا للتحليل والفحص.
وصفوة القول أنَّ الدرس التداوليّ أقرب إلى أنْ يكون مستوىً جديدًا إضافيًّا في الدرس اللسانيّ، يملأ الفجوات التي تركتها المستويات الأُخرى (2). وهذا ما حدا أحد فلاسفة اللغة المحدثين، وهو (رادولف كارناب) (3)؛ على أنْ يصف التداوليّة بأنَّها قاعدة اللسانيات أو أساس لها (4) أي أنَّها حاضرة في كلّ تحليل لغويّ.
ويرى باحث آخر (5) أنَّ التداولية عتبة المفارقة للدرس اللسانيّ، فمجرد أن ينتهي عمل اللسانيّ في دراسة اللغة تظهر مشاركة التداوليّ في الوقوف على الأبعاد النفسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة للمتكلم والمتلقي والجماعة التي يجري فيها التواصل، وبهذا فهو يرى أنَّ التداوليّة استطالة للسانيا، نحو جانب جديد، أشار إليه (ايمل بنفنست) (6).
ص: 319
1- ينظر: التراكيب الإعلامية في اللغة العربية، د. حنان إسماعيل عمايره / 57، دار وائل للنشر - ، عمان، ط 1، 2006م.
2- ينظر الخطاب القرآنيّ، دراسة في البُعد التداوليّ، د. مؤيد آل صوينت / 3، بيروت - لبنان، مكتبة الحضارات، ط 1 (1431 ه - 2010 م).
3- (1891 - 1970م) هو فيلسوف يهودي الماني من ابرز فلاسفة المدرسة الوضعية المنطقية التجريبية، ومن مؤلفاته: (البناء المنطقيّ للعالم) و (التركيب المنطقيّ للغة) و (المدخل للسيمانتك) و (المعنى والضرورة) ... وسواها. (شبكة الأنترنيت: موقع / اللسانيات العربية)
4- ينظر: Francoise Armengaud: La pragmatique, puf, 4e edition 1999, p3
5- ينظر: المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب، نواري سعودي أبو زيد / 124.
6- (1902 - 1976) هو من ابرز علماء اللسانيات العامة واللسانيات المقارنة واللغات الهندواوربية، ويعد من مؤسسي النظريات التلفظية والتداولية والتفاعلية في اللسانيات الحديثة ولكن تأثيره قد تعدى حدود البحث اللسانيّ إلى كثير من العلوم الانسانية والى الدراسات الادبية ذات المنحى البنيويّ (ينظر: معجم أعلام التربية والعلوم الإنسانية / 23).
واسماه (لسانيات التلفظ)، الذي ينتقل بموجبه الاهتمام من ثنائيّة (اللغة والكلام) إلى ثنائيّة الملفوظ (Le dit) الذي يحمل المضمون أو الدلالة، وفعل التلفظ أو القول في حدِّ ذاته (Laction de dire) (1).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ (شارل موريس) (2) هو أوّل من حاول إدخال نوع من المقابلة المفضية إلى التمييز بين مجالات ثلاثة في دراسة اللغة، وهي: (التداوليّة والدلالة، والنحو) (3). موضحاً العلائق فيما بينها، جاعلًا التداولية حلقة تدور في فلك السيميائيّة، لأنّها - برأيه - تصبّ اهتمامها على معالجة العلامات و مستعمليها، انطلاقًا من قصديّة متعمدة، هي التي حركت عملية التواصل، وأحدث العلاقات داخل اللغة على وفق المناويل النحويّة المختلفة.
لقد حددت البلاغة الجديدة (المعاصرة) المبنيّة على فني (الإقناع و الإمتاع) بأنّها "تقنيات خطابية قادرة على التأثير " (4)، بوصفها " فنًا للإقناع بطريق الخطاب" (5)، وبوصفها "وسائل لفظية مؤثرة، حاملة على اعتقاد وجهة نظر أو تعديلها أو توجيه الآخرين إلى تأملها (6) أو أنّها "مسافة تخاطبيّة تزيد أو تنقص بحسب المقاصد " (7)، أو.
ص: 320
1- ينظر: Francoise Armengaud: La pragmatique. p8.
2- شارل موريس (1839 - 1914 م) عالم فلك امريكيّ صاحب نظرية السيموطيقية، ومؤسس المنهج الفلسفي الحديث (البرغماتية)، أو ما يطلق عليها التداولية (شبكة الأنترنيت، موقع / اللسانيات العربية).
3- ينظر: La communication, p67 - paragmatique pour le dis courslitteraire, p3 - les timescales de la lin quistique, p 44.
4- chaim perelman. Leman rhetorique. vrin, 2002, p28.
5- Olivier Reboul. Introduction a la rhetorique. PUF, 1991, p.4.
6- Ruth Amossy. Largumentation dans la discours. Nathan, 2000, p. 29.
7- Michel Meyer. principia Rhetorica. fayard, 2008, p.21.
أنَّها "صناعة تفيد قوّة الإفهام على ما يريده الإنسان أو يُراد منه بتمكين من إيقاع التصديق به وإذعان النفس له " (1).
ومن وسائل الإقناع التداوليّ الأساليب النحويّة ذات البعد التداوليّ ك (ظاهرة الحذف)، فقد أولت الدراسات التداوليِة الحديثة المخاطب (المتلقي المشارك في عملية التواصل) اهتمامًا خاصًا، انطلاقًا من مبدأ خطابيِ: الخطاب يتوجه (من و إلى) أحد الطرفين، ولم يكن هذا الأمر غائباً عن أنظار النحاة الأوائل، فلا ينقطع حديثهم عن (الحذف) والإشارة إلى العلم بالمحذوف، بعده القطب الذي ترتكز عليه ظاهرة (الحذف)، ويشبه (علم السامع) أن يكون مسوغًاً ثابتاً للحذف، وهو يجري من كتبهم كالأصل الثابت المتواتر، وهم يصرحون به تصريحًا غير ملتبس (2).
والحذف في لغة العرب أسلوب تعبيريّ له معانيه ودلالاته، وهذا الأسلوب بارز في النسيج الخطابيّ العلويّ، فقوله (علیه السلام): " الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ " (3) اختزال لعبارات طويلة بعبارة مكثفة المعاني، وفي كلِّ ذلك يدعو مقتضى الكلام إلى حذف بعض أجزائه لتحقيق غاية ما، إذ يكون الحذف في بعض المواضع الكلامية أبلغ من الذكر في بلوغ المراد، ذلك أَنَّهُ " باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنّك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُبن " (4) فالحذف من سنن العرب، وقد يكون ذا صلة بسياق الحال: " كلما كان معلوماً في القول، جاريًا عند الناس،.
ص: 321
1- التلقي والتأويل مقاربة نسقية، محمد مفتاح / 34، المركز الثقافيّ العربيّ، 1994 م.
2- ينظر: الصورة والصيرورة، نهاد الموسى / 128، دار الشروق للنشر، عمان، ط 1،2003 م.
3- نهج البلاغة، حكمة / 418/ 551.
4- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانيّ / 121.
فحذفه جائز لعلم المخاطب " (1)، وهذا الحذف لا يخل بالفهم عند وجود ما يدلّ على المحذوف من قرينة لفظيّة أو معنويّة (2).
وللحذف التداوليّ في نصوص نهج البلاغة سمة دلاليّة خاصة، وتصوير لفظيّ جماليّ مميّز، في قوله (علیه السلام): " فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ ... فَلْيَنْظُرْ نَاظِرٌ أَسَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعُ) (3) ضرب من الإيجاز وتكثيف العبارة، وهذا " مظهر من مظاهر الكلام العربيّ وإيجازه والتخفيف من ثقله، ومن ثم التخفيف من عبء الحديث " (4) الدال على جملة من المضامين الاجتماعيّة، متمثلة في الالتزام بالفضائل الكبرى والقيم العليا، كالصّدق والتّعقل والتّبصر.
جاء حذف المسند إليه في جملتي الشرط المتجاورتين، جوابًا للاستفهام المتقدم: (فإن كان له مضى فيه، وإن كان عليه وقف فيه) والتقدير في الجملتين هو (فإن كان عمله) فكأن الإيجاز في هذا المقام مودى الحذف، الذي يحيل ذهن السامع على فهم المراد من سياق العبارة السابقة عليه: (فالناظر بالقلب العامل بالبصر، يكون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله عليه أم له) وهي الوقفة مع النفس بالتبصر فيما ينفع، إذ يرتكز هذا النصّ على مفهوم (العلم)؛ لأنّه مقياس خطوات البشريّة في ميادين الحياة جميعها.
لقد أثار النصُّهنا عدة تساؤلات في ذهن السامع، أشبعتها دلالاته المختلفة، وهو أمرٌ عبر عنه ه التداوليون بأكثر من تعبيرٍ، فمنهم من دعاه (كيفيات القول) (5)، ومنهم)
ص: 322
1- المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد 3 / 254، تحقيق: عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب بيروت، ب. ت.
2- ينظر: التراكيب اللغويّة في العربيّة، دراسة وصفيّة تطبيقيّة، د. هادي نهر / 15، مطبعة الرشاد، بغداد / 1987 م.
3- نهج البلاغة، خطبة / 216/154.
4- التراكيب اللغوية في العربية - دراسة وصفية تطبقية، د.هادي نهر / 151 - 152، مطبعة الرشاد، بغداد 1987 م.
5- ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النصّ، د. صلاح فضل / 99، عالم المعرفة، الكويت، ط 1، (1413 ه - 1992 م)
من اسماه (الاستدلال التجسيريّ) (1) الذي يقوم على عمد المتكلم عند صياغة الكلام إلى اختصار العبارات والحلقات التي يقدر أنّ المخاطب قادر على إرجاعها عند التأويل اعتمادًا على المعرفة المختزلة في ذهنه فاللسان العربيّ بطبيعته ينحاز إلى إيجاز العبارة وطي المعارف المشتركة طيّا، اعتمادًا على قدرة المخاطب على تداول ما أضمر من الكلام، وعلى استحضار أدلته التداوليّة متى اقتضت ذلك حاجة الفهم (2).
ونجد الأمر نفسه في قوله (علیه السلام): " فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع " وتقدير المسند إليه المحذوف (أم هو راجع)، الذي جاء في سياق الجملة الاستفهاميّة، لبلوغ مستوى فهم الحكمة الاجتماعية، المتمثلة ب (العامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح)، وهذا الحذف دلَّ عليه سياق النصِّ في عبارة: (أسائر هو) ومؤداه في إمكان تقدير المحذوف، وإنَّما كان الحذف هنا لغرض إظهار جماليّة التعبير، وحسن اتساق النظم، فضلا عن قصد الفعل والتأثير في السامع، وإيقافه على دلالات الحذف التداوليّة (3). فإنَّ " كثيرًا من حالات الحذف تعتمد في وقوعها وتحليلها على المقام، أي واقع الحال، كما تعتمد على سياق المقال، أي الخطاب " (4).
وقد يؤدي السياق إلى العدول عن المعنى الظاهر كما في قوله (علیه السلام): " ... وَ لَا اعْتَدَلَ بِمُمَازِجٍ لِتِلْكَ الطَّبَائِعِ إِلَّا أَمَدَّ مِنْهَا كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ ... " (5) أي استعمل دواءً منفردًا معتدل المزاج أو مركبا كذلك إلّا وأمد كلّ طبيعة منها ذات مرض بمرضٍ زائد على الأول. 2.
ص: 323
1- ينظر: أصول تحليل الخطاب/ 78.
2- ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقليّ، د. طه عبد الرحمن / 112، المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت، ط 1، 1988 م.
3- ينظر: الاستدلال في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية، فاطمة كريم رسن/ 123، أطروحة دكتوراه في كلية التربية للبنات - جامعة بغداد / 1430 ه - 2009 م.
4- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 109.
5- نهج البلاغة، خطبة / 221/ 342.
وينبغي أن يكون قوله (علیه السلام): (ولا اعتدال بممازج) أي ولا رام الاعتدال لممتزج؛ لأنَّهُ لو حصل له الاعتدال لكان قد برئ من مرضه، فسمى محاولة الاعتدال اعتدالاً؛ لأنّه باستدلال المعتدلات قد تهيأ للاعتدال، فكأنه قد اعتدل بالقوة.
والحذف هنا بالفعل (رام) الذي دلَّ عليه سياق القول، وكذلك في النصِّ حذف آخر، وهو حذف المفعول للفعل (أمد) وتقديره (بمرضٍ)، وحذف المفعولات في اللغة كثير واسع (1)، ودلّ على تقدير المفعول (بمرض) سياق الكلام، الذي يدور كلّه حول مرض الموت، وهذا العدول عن الظاهرة والمحذوفات سببه علم المخاطب سعةً وإيجازًا وإظهارًا واستغناءًا، وهي مسالك في القول، يخرج فيها الكلام على غير مقتضى الظاهر، وتصرف في البناء اللغويّ مع بلوغ المعنى المراد اعتمادًا على الملابسات الحافة، قال سيبويه: " وإنَّما اضمروا ما كان يقع مظهراً استخفافًا، ولأنَّ المخاطب يعلم ما يُعنى" (2).
فلولا القرينة اللفظيّة (المرض) لما جاز الإتيان بالإيجاز التركيبيّ بالحذف، كي لا يغمض الأمر على المخاطب، فمن يسمع النصَّ يقفز إلى ذهنه معنى (المرض)، فيعلم أنَّ في النصِّ حذفًا، فالعلاقة بين المرسل والمتلقي والتي حرصت البلاغة على إبرازها قد وجدت طريقها إلى نظرية الاتصال، ومن ثم إلى التداولية، التي عنيت بالسّياقات المختلفة، وأطراف الموقف التواصليّ عناية كبيرة على أساس أنَّ " النصَّ اللغويّ في جملته إنَّما هو نصٌّ في موقف، فكلُّ رسالة لها قصدها وموضعها وظروف تلقيها " (3).
فكثيرًا ما يحذف في اللغة بعض أجزاء الكلام ثقة من المخاطِب بعلم المخاطَب، إذ يقوم الباث بحذفه غالبًا، اعتمادًا على إدراك السامع، ويقدر السامع المحذوف اعتمادًا.
ص: 324
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 11/ 115.
2- الكتاب، سيبويه 224/1.
3- علم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب والبلاغة وعلم اللغة النصيّ، برند شبلنر / 116، ترجمه وعلق عليه: د. محمود جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع،ط 1، 1987م.
على قصد المتكلم الذي يجهد في إدراكه، مستعيناً بالقدرة والكفاءة التداوليّة على المحذوف في مثل تلك المواضع.
وقد يكون للقرائن الخارجيّة أثرٌ كبير في الكشف عن المحذوف وتقديره (1) ومن هذه القرائن على سبيل المثال لا الحصر تعايش الإمام مع القرآن، إذ كانت بينهما علاقة وثيقة كما وصفها هو (علیه السلام) بقوله: " ذَلِكَ الْقُرْآنُ، فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ. أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ" (2) هذه الملازمة التي نجدها في لغة النهج، ما هي إلّا ثقافة تشع من عبارة إلى عبارة، حتى أنَّنا نجد عبارات النهج وقد استضاءت بمعاني القرآن الكريم وأسلوبه، بل إنّنا نجد في بعض المواضع قد أصابها الاختزال والاختصار والتغيير في الشكل دون المضمون، وهو عرف تداوليّ امتازت به نصوص نهج البلاغة، أكسب الخطاب الحركة والتفاعل، ومن ثم أقحم المتلقي في خضم عملية تفسير الخطاب وتأويله، جاء في نهج البلاغة: " وَإِخْدَةِ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ " (3) وهو اختزال لقوله تعالى: (فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) القمر / 42.
وقد يتغير السياق بتغير التراكيب كما في قوله (علیه السلام): " الحَمْدُ اللهَ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلٌ وَغَسَقَ وَالْحمْدُ لله كُلَّمَا لَاحَ نَجْمٌ وَخَفَقَ" (4)، وفيها قبس من قوله تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) الفلق / 3. وربما نجد في بعض المواضع أنَّ الإمام مزج بين تركيبين مختلفين، ليعطي دلالة جديدة للتركيب الجديد، تزخر بالمعاني المكثّفة، جاء في نهج البلاغة قوله (علیه السلام): " وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ (5) وهو جمع لآيتين، هما قوله تعالى: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُود) الواقعة / 30، (وَمَانُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ) هود / 30؛ هذا.
ص: 325
1- ينظر: المعنى وظلال المعنى / 157.
2- نهج البلاغة، خطبة / 158/ 224.
3- نهج البلاغة، خطبة / 115/83.
4- نهج البلاغة، خطبة / 87/48.
5- نهج البلاغة، خطبة / 1/ 40.
التزيين تزخر به نصوص نهج البلاغة، يعتمد فيها المتلقي في فهم المحذوف على القرائن الخارجيّة، التي تتمثل بقدرته التحليليّة وثقافته القرآنيّة على تقدير المحذوف المتداول، ففي طبيعة اللغة أن يسقط من الألفاظ ما يدلُّ عليه غيره، أو ما يرشد إليه سياق الكلام أو دلالة الحال، واصل البلاغة في هذه الوجازة؛ لأنّها تعتمد على ذكاء المتلقي والقارئ
وثقافتهما (1).
إنَّ أنماط الخطاب الذي يمكن تفسير الحذف وتحليله فيه على أساس العودة إلى واقع الحال وثقافة المتلقي، تظهر بوضوح وبنحو مطرد في حالات الحوار أو تبادل الحديث المباشر بين المتكلم والسامع، كمقامات الاستفهام واللقاءات الاجتماعيّة والتهنئة والدعاء والتعليق بالقبول أو الرفض ... وسواها، ولا يقتصر الحذف في هذه الحالات على عنصر معيندون آخر، فقد يكون المحذوف فعلًا أو اسمًا أو جملة أو شبه جملة أو عاملاً لمفعول به أو لمفعول مطلق أو لمفعول لأجله أو للحال ... وغيرها (2).
وممّا تقدم ذكره آنفًا تبيّن للباحث أنَّ ظاهرة الحذف في البنية النحويّة لها القدرة على استيعاب المقام التداوليّ، الذي يمثله أساسًا المتكلم والمخاطب وظروف استعمال القول؛ وذلك لاشتماله على موضع قارٍ للوسم بما يحدد عناصر المقام، ويجعل المعنى الخطابيّ مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بعلم المخاطب، واستعمالات العرب، بحيث لا تكون العلاقة الدلاليّة بين الخطاب وما يحيل عليه سوى مظهر من وضع تداوليّ معقد، يشارك في تحديده كلٌّ من المتكلم والجمل التي يتلفظ بها، وما تحيل عليه، والمخاطب والسّياقين المقاميّ والمقاليّ. 0.
ص: 326
1- ينظر: خصائص التركيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، د. محمود أبو موسى/ 111، دار التضامن، مصر، ط2، 1980 م.
2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد شبر / 109 - 110.
وصفوة القول: إنَّ (ظاهرة الحذف) من أبرز الوسائل الإقناعيّة التي زخرت بها تراكيب نهج البلاغة (1) ظاهرة لغويّة اجتماعيّة من قبيل تغييب العنصر في اللفظ لإمكان استرجاعه، اعتمادًا على القرائن والتداوليّة (2).
ومن الأساليب النحويّة ذات البُعد التداوليّ، التي زينت الخطاب العلويّ في نهج البلاغة (أسلوب النداء)، إنَّهُ باب وما حواهُ من أحكام وقوانين يمثل ضرباً من الخطاب الكلاميّ، الذي لا يكون له أثر في التواصل إلّا بوصفه عنصراً من عناصر مسرح اجتماعيّ، يضم مرسلًا ومستقبلًا أو مخاطبًا ومتلقيًا.
يضم أسلوب النداء في جوهره منادياً ومنادى، ولا يكون النداء في فراغ؛ إذ يقتضي الأمر وجود طرفين بينهما علاقة من نوع ما استلزمت مقاميً توظيف هذا الأسلوب خاصة، وقد أشار النحاة إلى هذا الربط بين الأسلوب الندائيّ والأسلوب المقاميّ، وتنوع الأحكام تبعاً لتنوع ظروف المقام (3). لذا أسلوب النداء أسلوب لغويّ متداول بين العرب، توزعت أدواته على المنادى بحسب المقام، فللمنادى البعيد وشبهه أدوات خاصة، وللمنادى القريب أداة خاصة (الهمزة)، والى ذلك أشار ابن مالك بقوله (4):
وللمنادى الناءِ أو كالناءِ *** يا وأيْ وكذا أيا ثم هيا
ولعل السَّرّ في هذا التصنيف الوظيفيّ لأدوات النداء هو محاولة الربط بين أسلوب الخطاب وواقع الحال، لذا اشتمل أسلوب النداء للبعيد المخاطب على عدة أدوات، امتازت باشتمالها على حروف المدِّ باستثناء (أي)؛ لأنَّ البعيد يحتاج إلى مدِّ الصوت ليسمع المتلقي، حتى يقع التواصل بين طرفي الرسالة..
ص: 327
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 5 / 425، 7 / 138، 11/ 63، 115، 172، 13 / 98، 15 / 111، 115، 130 ... فضلا عن ظاهرة الحذف في حكم نهج البلاغة في الجزئين / 17 - 18.
2- ينظر: أصول تحليل الخطاب 2/ 160.
3- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد شبر / 99.
4- ينظر: شرح ابن عقيل 3/ 255.
أما (أي) فهي للبعيد تجوزًا، وربما جعلها ابن مالك في حكم البعيد المشار إليه في كلامه (أو كالناء) والمقصود به المتوسط في البعد.
ولا يخلو نهج البلاغة من أسلوب النداء، بل تكاد تضم نصوصه كلها هذا الأسلوب، جاء في قوله (علیه السلام): " أَيُّهَا النَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ، حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً " (1)، وقوله (علیه السلام): " أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا" (2) هذا الخطاب الأُمميّ (أيها الناس) الذي لا يعني فريقًا معينًا من الناس، بل يعني الناس جميعهم، وإن كان الخطاب موجهاً إلى الحاضرين منهم، أسلوب تداوله الناس في لغاتهم، ولا سيما العرب، إذ إنَّ حذف (ياء النداء) منه جاءت من أجل ربط المبنى بالمعنى، أي إقامة علاقة ترابطيّة بين مكوّنات الخطاب ومقامه؛ لأنَّ النحاة العرب وجدوا عند تقعيد الأحكام أنّ أداة النداء لا يجوز حذفها مع المنادى البعيد؛ لاحتياجه لمد الصوت المنافي للحذف، وكذلك الحال مع المنادى النكرة المقصودة، كما في قول الإمام (علیه السلام): " يَا قَوْمِ، هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ وَ [دُنُوٌّ] دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ. أَلَا وَ إِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ وَ يَحْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ، لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاً وَ يُعْتِقَ فِيهَا رِقّاً وَ يَصْدَعَ شَعْباً وَ يَشْعَبَ صَدْعاً، فِي سُتْرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ. ثُمَّ لَيُشْحَذَنَّ فِيهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَيْنِ النَّصْلَ تُجْلَى بِالتَّنْزِيلِ أَبْصَارُهُمْ وَ يُرْمَى بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ وَ يُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ " (3) يذكر فيها قوماً من فرق الضلال اخذوا يمينًا وشمالًا، أي ضلوا عن الطريق الوسطى، التي هي منهاج الكتاب والسُّنَّة..
ص: 328
1- نهج البلاغة، خطبة / 136/ 195.
2- نفسه، خطبة/ 281/189.
3- نفسه، خطبة / 209/150.
جاءت لفظة (قوم) نكرة مقصودة وجب إثبات الأداة معها، على وفق ما تداوله العرب؛ لأنَّ في النكرة المقصودة سمة البّعد المتمثلة بالتعيين، وكذلك الحال مع المنادى المستغاث والمندوب فهما معنيان اسلوبيان متفرعان عن النداء في تصور النحاة، ولهذا قال سيبويه: " إنَّ المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه، فإن شئت الحقت في آخر الاسم الالف؛ لأنَّ الندبة كأنهم يترنمون فيها، وأن شئت لم تلحق كما لم تُلحق في النداء" (1)، فالمندوب شبيه بالمنادى، ويختلف عنه في أنه (مُتفجعٌ عليه)، إذ فيه معنىّ زائد على النداء، وهو أنّه مندوب أو مستغاث به، ففي قولنا: (يالزيدٍ لعمرو) و (وازيداه)؛ فإنَّ الحذف هنا ينافي المطلوب من المستغاث والمندوب، ويفوت الدلالة الصوتية المقصودة، ذات السمات المعيّنة، التي ترفدها بالقدرة على التوصيل والتأثير.
جاء في الاستغاثة قوله (علیه السلام): " فَيَا للَّهَ وَلِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ " (2)، فاللام في (يا الله) مفتوحة، واللام في (وللشورى) مكسورة؛ لأنّ الأولى للمدعو، والثانية للمدعو إليه، قال المبرد: " فإذا دعوت شيئاً على جهة الاستغاثة فاللام معه مفتوحة ... فإن دعوت إلى شيءٍ، فاللام معه مكسورة " (3)، ومن الواضح أنَّ الأداة في الندبة والاستغاثة من البنيات الصوتيّة المهمة، وهي المنطلق إلى اكتساب الخطاب خواص صوتية أُخرى تنفرد بها الندبة والاستغاثة، كرفع الصوت وطرائق توزيع النبر وأنماط التنغيم.
أما الأداة مع المنادى القريب فإنّها تحذف كما في قول الإمام (علیه السلام): " فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ " (4) وكذلك نرى الإمام يحذف الأداة عند الدعاء؛ لأنَّ المدعو هو الله وهو قريب جداً كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) البقرة / 186..
ص: 329
1- الكتاب، سيبويه، باب الندبة، 2/ 220.
2- نهج البلاغة، خطبة / 3/ 50.
3- المقتضب 254/4.
4- نهج البلاغة، خطبة / 153 / 215.
ومن مواطن حذف الأداة في الدعاء قوله (علیه السلام): " اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَ سَعِيدِهَا ..." (1)، لذلك حينما يخاطب جنس الإنسان ويقصد به نفسه أولا ومن ثم الآخرين" أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ وَ الْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ ... " (2).
و ممّا تقدم تبيّن لنا عدد من الوسائل الإقناعية التي استعملها الإمام (علیه السلام) في خطبه ورسائله للتأثير في المتلقي، وهناك عدد آخر من هذهِ الوسائل سوف نوضحها في المبحث الثاني من هذا الفصل..
ص: 330
1- نهج البلاغة، خطبة/ 72/ 101.
2- نهج البلاغة، خطبة/ 89 / 232.
المبحثُ الثالثُ / وَسائلُ الاستمالةِ التداوليّةِ
تُعرف الخطبة بأنَّها فن الإقناع والاستمالة، أوهي ذلك التفاعل القائم بين المتكلم والمخاطب في استعمال اللغة. ويمثل هذا المبحث استكمالاً للمبحث الأوّل؛ لأنّ وسائل الإقناع والاستمالة تشترك جميعها في تأدية الخطيب فن الخطبة بنجاح والتأثير في المتلقين.
إنَّ وسائل الاستمالة التي نحن بصددها ما هي إلّا تلك الأبعاد التي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغويّ المستنبطة من السِّياق الاجتماعيّ للخطبة، وهذه الوسائل لها سمة خاصة، إذ إنَّها تتنوع بتنوع المواقف والاحداث والظروف، ففي قوله (علیه السلام) لشريح بن الحارث قاضيه الذي اشترى دارًا بثمانين دينارًا، فبلغ ذلك الإمام علي (علیه السلام)، فاستدعى شريحًا فقال له: " بلغني أنَّك ابتعت دارًا بثمانين ديناراً، وكتبت لها كتابًا، وأشهدت فيها شهودًا "، فقال له شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، فنظر (علیه السلام) نظرة المُغضب، ثم قال له: " يَا شُرَيْحُ أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَ لَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً وَ يُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً. فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ؛ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَ دَارَ الْآخِرَةِ. أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ، فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ" (1).
في هذا النصِّ تبرز التداوليّةُ الاجتماعيّةُ وسيلةَ استمالةٍ وتأثيرٍ بنحوٍ واضح في قوله (علیه السلام) المتقدم (ابتعت دارًا بثمانين دينارًا، وكتبت لها كتابًا، وأشهدت فيها شهودًا) التي ترمز إلى أسلوب العقود المتداول بين الأُمم، ولا سيما أنَّ الصيغة المذكورة، هي صيغة العقود الإسلاميّة، ولم يغادر الإمام (علیه السلام) استعمال الوسيلة الرمزيّة (العلامة
ص: 331
1- نهج البلاغة، كتاب / 3 / 366.
البصريّة) الدالة على الإنكار، حينما نظر إلى شريح نظرة المّغضب، تلك النظرة التي تمثل سمة من سمات الحجاج المؤثر في إنكار الأمر المستهجن، المبني - في عمومه – على طرحٍ يعيد قضية معينة، تستدعي من المحاجج اتخاذ موقف بصددها، بتقديم منظوره الخاص، ومحاولة إحداث التأثير المراد في المخاطب بوصفه (النتيجة) الطبيعيّة للمحاججة، ما لم تنأ عن هذه الوجهة، وما دام ينتظمها مسار استدلاليّ، تبنيه قوانين الانتقال (القياس والمقايسة، والمفارقة ... وسواها)، فقد تكون ذات موجهات شبيهة بالمنطق، تستند إلى صرامة الأدلة ونسبيّة الحجج (1).
وهذه العلامة تدلُّ على بُعد اجتماعيّ، تمثل في الزهد الشديد في الدنيا، واستكثار للقليل منها، ونسبة هذا المشتري إلى الاسراف والخوفٌ من أن يكون قد ابتاعها بمالٍ حرام (2).
ومن وسائل التأثير والاستمالة (الرمزيّة)، أي استعماله (علیه السلام) للعلامات اللغويّة المؤثرة التي لا يتحدد مرجعها إلّا في سياق الخطاب؛ لأنَّها خالية من أي معنى في ذاتها، كأسلوب النداء (يا شريحُ) الدال على المشاركة في الحدث الكلاميّ، واستعماله الإشارات (Deictics)، كاسم الإشارة واسم الموصول وضمائر المخاطبة وظرفي المكان والزمان، وهذه يسميها النحاة العرب ب (المبهمات)، إلّا أنَّها عاملٌ مهم في تكوين بنية الخطاب، لما لها من أثرٍ في الإحالة إلىالمعلومات.
وهذه الإشارات تمثل جانبًا مهمًا من جوانب الخطبة، ومسارًا مؤثرًا من مسارات الدراسات الأدبية الحديثة، فهي تعني " تلك الأشكال الإحاليّة التي ترتبط بسياق المتكلم مع التفريق الأساسيّ بين التعبيرات الإشاريّة القريبة من المتكلم مقابل.
ص: 332
1- ينظر: الحجاج وبناء الخطاب في ضواء البلاغة الجديدة، أمينة الدهريّ / 23 شركة النشر والتوزيع المدارس - الدار البيضاء، ط 1، 1432 ه - 2011م.
2- ينظر: نهج البلاغة 14/ 238.
التعبيرات الإشاريّة البعيدة عنه " (1)، فكلُّ فعلٍ لغويٍّ يكون ناجحًا إذا علم المخاطب قصد العبارة وإحالتها، وإذا كان المتكلم غرضًا، ينبغي بموجبه أن يشكِّل المخاطب هذه المعرفة، فالمتكلم يشكِّل المركز الذي من طريقه يمكن أن نحدد مسألة القرب والبعد الماديّ والإجتماعيّ (2)، لذلك نرى الإمام استعمل (ياء المتكلم) قُبالة (كاف المخاطب)، وهما ضميران إشاريان يرمزان إلى المتكلم والمخاطب، لأنَّ مرجعهما يعتمد اعتمادًا تامًا على السِّياق الذي يستعملان فيه، وبين هذين الرمزين شكٌ ممزوجٌ بالامتعاض في الإحالة من تحقق شرط الصدق، الذي أكده شريح، فتحقق عند الإمام (علیه السلام) مطابقة المرجع (الخبر) للواقع.
وفي مجيء الإشارات الزمانيّة والمكانيّة في النصِّ دلالةٌ واضحةٌ على زمنٍ ماضٍ عن زمن الحدث الكلاميّ، ودليلنا في ذلك قوله (علیه السلام): (بلغني أنك ابتعت دارًا ...) الدال على المضي عن زمن الحدث الكلاميّ، وكذلك جواب شريح: (قد كان ذلك يا أمير المؤمنين) فالفعل (كان) يدلُّ على المضي أيضًا في الزمن البعيد عن زمن التخاطب الذي دلَّ عليه اسم الإشارة (ذلك)، فضلًا عن تحقق وقوع الابتياع البعيد من مركز الإشارة الحدث الكلاميّ والدال عليه بعبارة: (قد كان ذلك).
ثم أنّنا نستنتج بُعدًا اجتماعيًا من الإشارات اللغويّة الرامزة للعلاقة الرسميّة بين المتخاطبين، إذ إنّ التركيب الدال على صيغة التبجيل في قول شريح يا أمير المؤمنين يرمز إلى التفاوت المقاميّ بين الخطيب والمخاطب، مع مراعاة المسافة الاجتماعيّة التي أوجبت على شريح استعمال اللقب أو النعت، قُبالة استعمل الإمام (علیه السلام) النداء بالاسم المجرد، للدلالة على نوع تلك العلاقة من جهة الفوقيّة والتحتيّة، فمسألة تحديد نوع العلاقة الاجتماعيّة بين أطراف الخطاب مسألة نسبيّة تختلف من موقف إلى آخر، من.
ص: 333
1- مقاربة تداولية دراسة لغوية، ليلى آل حمد / 7، المملكة العربية السعودية، بحث منشور على شبكة الأنترنت.
2- ينظر: المقاربة التداولية، ارمینکو فرانسواز / 50، ترجمة: سعيد علوش الرباط مركز الإنماء القوميّ، 1986.
حيث قرب الأطراف أو بعدهم، أو تفاوتهم أو تساويهم في الوظيفة والرتبة، سواء أ كان هذا التفاوت في القرب والبعد والتساوي ماديًّا أم اجتماعيًّا أم نفسيًّا، فأنَّها تدلُّ على التفاوت المقاميّ بين المتخاطبين.
من وسائل الاستمالة المتداولة التي اتسمت بها عبارات هذا النصُّ ما نلحظه من مقاربةٍ بين الرمزيّة الواقعيّة والرمزيّة الوعظيّة، إذ قال (علیه السلام): "هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ، اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ وَ خِطَّةِ الْهَالِكِينَ وَ تَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ، الْحَدُّ الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْآفَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي وَ الْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ. اشْتَرَى هَذَا الْمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ مِنْ هَذَا الْمُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هَذِهِ الدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ وَ الدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الضَّرَاعَةِ؛ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى مُبَلْبِلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ وَ سَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مُزِيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ مِثْلِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ تُبَّعٍ وَ حِمْيَرَ؛ وَ مَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ وَ مَنْ بَنَى وَ شَيَّدَ وَ زَخْرَفَ وَ نَجَّدَ وَ ادَّخَرَ وَ اعْتَقَدَ وَ نَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ، إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَ الْحِسَابِ وَ مَوْضِعِ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ، إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ. شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَى وَ سَلِمَ مِنْ عَلَائِقِ الدُّنْيَا. " (1)، ويكفينا عن التعليق ما قاله ابن أبي الحديد في هذا الموضع: " وموضع الاستحسان في هذا الفصل وإن كان كلّه حسنًا، أَنَّهُ أملى عليه كتاباً زهديًا وعظيًا مماثلًا لكتب الشروط التي تكتب في ابتياع الأملاك، فإنّهم يكتبون: هذا ما اشترى فلان من فلانٍ، أشترى منه دارًا من شارع كذا، وخطة كذا، وتجمع هذه الدار حدودًا أربعة، فحدُّ منها ينتهي لدار فلان، وحدٌّ ينتهي إلى ملك فلان، ومنه شروع باب هذه الدار وطريقها: (أشترى هذا المشتري المذكور من البائع المذكور جميع الدار 6.
ص: 334
1- نهج البلاغة، كتاب/ 3/ 366.
المذكورة بثمن مبلغه كذا وكذا دينارًا أو درهمًا، فما أدرك المشتري المذكور من درك فمرجوع به على من يُجب الشرع الرجوع به عليه).
وهذا يدلُّ على أنَّ الشّروط المكتوبة الآن، قد كانت في زمن الصحابة تكتب مثلها أو نحوها، إلّا أنّا ما سمعنا أحداً منهم أنَّهُ نقل صيغة الشَّرط الفقهيّ إلى معنىّ آخر كما نظمه هو (علیه السلام)، ولا غرو فما زال سبّاقاً إلى العجائب والغرائب! " (1).
ومن المعلوم أنَّ من وسائل الاستمالة التداوليّة ما يسمى بالافتراض السابق (pposition Pres) الذي يعني أنَّ ما يوجهه المتكلم من حديثٍ إلى المخاطب على أساسٍ ممّا يفترض سلفاً أَنَّهُ معلوم عنده (2)، وبحسب التداوليّة الذهنيّة بين المتخاطبين.
ومن هذه الافتراضات التي يعلمها (شريح) مسألة الثواب والعقاب على الأعمال، فمن غير المنطقيّ أن يتحدث الإمام إلى شريح بهذه اللغة الرمزيّة بغير وجود معلومات سابقة في ذهن، وفي هذا الصدد يقرر (فينيمان) أنَّ لأي خطابٍ رصيدًا من الافتراضات السابقة، يضم معلومات مستمدة من المعرفة العامة وسياق الحال والجزء المكتمل من الخطاب نفسه (3)، فعند كلِّ طرفٍ من أطراف الخطاب رصيدٌ من الافتراضات السابقة التي تزداد مع تقدم عملية الخطاب.
وضمن رصيد الافتراضات السابقة المصاحبة لأي خطابٍ، توجد مجموعة من المعلومات الخطابيّة المسلّمة، والمعلومة المسلّمة هي: تلك المعلومة التي يعدّها المتكلم قابلة لأن نحصل عليها، إمّا بالإحالة على ما سبق من النصِّ أو بالعودة إلى المقام (4) 1
ص: 335
1- شرح نهج البلاغة، 14/ 240.
2- ينظر: مقاربة تداولية دراسة لغوية، ليلى آل حمد / 10، المملكة العربية السعودية، بحث منشور على شبكة الأنترنت.
3- ينظر المقاربة التداولية، ارمینکو فرانسواز / 52، ترجمة: سعيد علوش الرباط مركز الإنماء القوميّ، 1986.
4- ينظر: المقاربة التداولية دراسة لغوية، ليلى آل حماد / 11
فمثلًا تشير أداة التعريف إلى ما يسمى بالمعلومات السابقة، في حين تؤدي أداة التنكير وظيفة الإشارة إلى معلومات لاحقة، أي إلى وحدات لغويّة لم يوضحها المتكلم فقوله (علیه السلام): " يَا شُرَيْحُ: أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَ لَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً وَ يُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً" (1)، ويقصد ملك الموت وهو من المسلّمات السابقة المتداولة، وكذلك استعمال (ال التعريف) في اللفظين المتقابلين (الدار والثمن) إشارة إلى ثنائيّة العوضين في عملية البيع، في حين نلحظ أنّ الإمام (علیه السلام) قد استعمل التنكير في قوله: (لأكتب لك كتابًا)، إشارة إلى تأثير التداوليّة الوعظيّة التي لا يعرف (شريح) عنها شيئاً، بل لا يعرف أحدٌ عنها شيئاً قبل الانشاء كما
عبر عن ذلك ابن أبي الحديد بقوله السالف: " ... إلّا أنّا ما سمعنا من أحد منهم أَنَّهُ نقل صيغة الشرط الفقهيّ إلى معنىً آخر قد نظمه هو (علیه السلام) " (2).
فقد التفت النحاة من قبل إلى أثر المخاطب في الاتصال الكلاميّ، وجعلوا تعريف الشيء أو تنكيره محكوماً بالعلاقة المفترضة بين المتكلم والمخاطب، فإذا قدر علمه بالشيء استعمله معرفة، وإذا قدر جهله به استعمله نكرةً، فالمنكر لا يحيلُ إلّا على معلومات مخزونة في ذهن السامع، في حين أنَّ المُعرّف قد يحيل إلى معلومات معجميّة أو لغويّة، وقد يحيل إلى معلومات اصطلاحيّة تداوليّة، وقد يحيل على معلومات تخصُّ أفراداً معينين للسامع، له سابق معرفة بهم (3).
ومن جانب آخر تُعدُّ صيغ ألفاظ البيع من أفعال الكلام، إذ إنَّ الفعل البيعيّ لا يصح إلا بألفاظ خاصة، تواضع عليها أهل اللسان العربيّ في تأدية الفعل الكلاميّ وقد فرق شهاب الدين القرافيّ (ت / 684 ه) بين صيغ البيع وصيغ الشهادة؛ لأنَّ الصيغة الأخيرة لا تصح إلّا بالفعل المضارع " وعكسه في البيع، فلو قال: أُبيعك لم.
ص: 336
1- نهج البلاغة، كتاب / 3 / 366.
2- شرح نهج البلاغة 240/14.
3- ينظر: المقاربة التداولية دراسة لغوية، ليلى آل حماد / 13.
يكن إنشاءًا للبيع، بل إخبار لا ينعقد به بيعٌ، بل وعد بالبيع في المستقبل، ولو قال بعتك، كان إثباتا للبيع.
فالإنشاء في الشهادة بالمضارع وفي العقود (مثل البيع) بالماضي، وفي الطلاق اسم الفاعل، نحو أنت طالق ... ولا يقع الإثبات في البيع باسم الفاعل، ولو قال أنا بائعك بكذا ... لم يكن إنشاءً للبيع " (1).
وذهب الشريف محمد بن علي الجرجانيّ (ت / 816 ه) إلى القول: إنَّ " صيغة ألفاظ العقود (من قبيل: بعت واشتريت و طلقت ...) إنشائية، إذا لم يتم وقوع فعلها في الماضي، فإنَّ العلم بعدم وقوع فعلها في الماضي دلالة على كونها للإنشاء " (2)، فهي من أفعال العقود الدالة على الايقاع، لذا نرى أنّ الألفاظ التي وردت في النصِّ المتقدم كانت بصيغة الماضي الدال على الإيقاع (ابتعت كتبت، شهدت، نقدت، اشتريت)، وهي ألفاظ تداوليّة لم تتمكن اللسانيات الحديثة وفلسفة اللغة من بلورتها إلاّ حديثًا، فدرسوها ضمن نظرية (الأفعال الكلاميّة)، واستنبطوا من الأساليب الخبريّة عبر الجمع بين المنطلقات والمفاهيم النظريّة والنصوص التطبيقيّة من جهة أُخرى أفعالًا،كلامية منها الرواية والشهادة والوعد والوعيد، والدعوى والإقرار والكذب والخلف ... واستنبطوا من الأساليب الإنشائية أفعالاً كلامية أُخرى، منها: الإذن والمنع والندب والإباحة، والتخير والتعجب، وألفاظ العقود والمعاهدات والإيقاعات (3)..
ص: 337
1- أنوار البروق في أنواع الفروق، شهاب الدين أحمد بن أدريس القرافيّ (ت/ 684 ه) 4 / 1189، القاهرة دار أحياء الكتب العربية، 1344 ه.
2- حاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشّمسيّة، الشريف علي بن محمد الجرجانيّ (ت / 816 ه) / 44، القاهرة، مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ، 1948 م.
3- ينظر: التداولية عند علماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الافعال الكلامية في التراث اللسان العربيّ، الدكتور مسعود صحراويّ/ 172، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 2005 م.
ويغلب على خطب نهج البلاغة سمة الأفعال الإنجازية، ولا سيما في هذه الخطبة - التي نحن بصددها - بوصفها وحدة لغويّة فعليّة متكاملة أنتجت فعلًا مؤثرًا في المستمعين، وإلى هذا المعنى ذهب (أوستين) و (سيرل) من اتباع المدرسة الفلسفية التحليلية، ذهبا إلى أنَّ الإنسان المتكلم وهو يستعمل اللغة لا يستعمل الكلمات الدالة على المعنى فحسب، بل يقوم بفعلٍ (1)، وهو ما يسمى ب (الفعل الكلاميّ)، ويعني التصرف أو العمل الاجتماعيّ الذي ينجزه الإنسان بالكلام، ويُراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة. وهذا يعني أنّ المعاني والمقاصد التواصلية التي مرَّ ذكرها آنفًا أفعالٌ كلاميّة، لأنّنا لا ننظر إليها على أنّها مجرد دلالات ومضامين لغويّة، وإنما هي إنجازات وأغراض تواصليّة، ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعيّة أو فرديّة بالكلمات، والتأثير في المخاطب بحمله على فعلٍ أو تركه، أو تقرير حكم من الأحكام، أو توكيده، أو التشكيك فيه، أو نفيه، أو وعد المتكلم للمخاطب، أو وعيده، أو سؤاله واستخباره عن شيءٍ، أو إبرام عقدٍ من العقود، أو فسخه، ومجرد الإفصاح عن حالة نفسيّة معينة ... وسواها. فمن هذا المنظور لا تكون اللغة مجرد أداة للتواصل كما تتصورها المدارس الوظيفيّة، أو رموزًا للتعبير عن الفكر كما تتصورها المدارس التوليديّة التحويليّة، وإنما هي أداة للتغيير وصنع الأحداث والتأثير في المخاطب.
ومن التراكيب التداولية التي استعملها الإمام (علیه السلام) وسائل استمالة وتأثير في المتلقي بكثرة أسلوب (الإغراء والتحذير)، وهما أسلوبان يتفقان في مجمل أحكامهما النحوية، ويفترقان في المعنى، لذا جمعهما النحاة في فصل واحد، فعرفوا التحذير بأنَّهُ: " تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبه" (2)، فيقوم هذا الفعل على أساس التنبيه والأمر.
ص: 338
1- Esthetiue de La communication ,p:95 - 96.
2- الأساليب الإنشائية في النحو العربيّ، عبد السلام هارون / 152، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط3، 1981 م.
والاجتناب كما قال سيبويه (1)، أو الدعوة إلى الاجتناب، وتعدُّ تلك هي الفائدة المرجوّة منه.
أما الإغراء فهو تنبيه المخاطب على أمر محمود؛ ليلزمه أو ليفعله (2)، فيقوم على أساس التنبيه والدعوة إلى الفعل على سبيل الترغيب والتشويق لا على سبيل الإلزام.
إنَّ كلا الأسلوبين لا يمكن فهمه والتحقق من مقصوده، ولا ينبئ عن فائدة إلّا في مسرح لغويّ مناسب، أي مقام مكتمل الإطراف من مرسل ومستقبل وظروف خاصة تلف الخطاب، أي أنَّهما ذوا مضمون اجتماعيّ، جاء أسلوب الإغراء في قوله (علیه السلام): " فَاللهَ اللهَ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ" (3)أي اتقوا الله، فنصب لفظ الجلالة على المفعولية بفعل محذوف، وجعل تكرير اللفظ نائباً عن الفعل المحذوف، ودالّا عليه (4)، وذهب بعض الشراح إلى أنَّ العبارة هنا من باب التحذير، والتقدير: (خافوا الله) أو (احذروا الله) أو (اتقوا الله)، وذهب إلى هذا الرأي الراونديّ والكيدريّ وابن ميثم ومحمد جواد مغنية، وهو الرأي الأرجح عند الباحث؛ لأنَّ التقديرات كلّها قريبة من معنى التحذير، ومثل هذا قوله (علیه السلام): " اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ. اللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ. وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ. وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ. وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا. وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ." (5) وذهب جميع شراح النهج إلى أنّ 3.
ص: 339
1- ينظر الكتاب 1/ 273 - 274.
2- ينظر: شرح شذور الذهب، ابن هشام الأنصاري / 246، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، المكتبة المصرية، ط 1، 1995م.
3- هج البلاغة، خطبة / 192/ 295.
4- ذهب إلى هذا الرأي من شراح النهج كلّ من الخوئيّ ومحمد الفضل إبراهيم.
5- نهج البلاغة، كتاب/ 47/ 422 - 423.
الأسلوب هنا أسلوب التحذير وخالفهم ابن أبي الحديد الذي ذهب إلى انتصاب (الله الله) على الإغراء.
ومن أقوال أمير المؤمنين (علیه السلام) التي اتفق الشراح على أنّها من باب الإغراء قوله (علیه السلام): " الْعَمَلَ الْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ، وَ الِاسْتِقَامَةَ الِاسْتِقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ " (1) أي إلزموا العمل، وكرر الاسم لينوب أحد اللفظين عن الفعل المقدر، وذهب ابن أبي الحديد إلى أنَّ اللفظ الأول هو القائم مقام الفعل؛ لأنَّهُ في رتبته (2) وعلل أبو البركات الأنباريّ بأنَّ كون الأولى أولى بالقيام مقام الفعل، لأنّ الذي يقوم مقام الفعل ينبغي أن يكون مقدماً (3) و في قوله (علیه السلام): " فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ، وَ الْجِدَّ الْجِدَّ أَيُّهَا الْغَافِلُ" (4) جاءت الأمثلة منصوبة بفعل مقدر وجوبًا أو جوازًا بحسب مكوّنات التركيب (5)، ونلاحظ هنا أنّ صياغة بنية التحذير جاءت على وفق أصوات منسوقة نسقاً معيناً، شكلّت بنية لغويّة موائمة لبنية اجتماعيّة أو مقامية، درج عليها الناس في كلّ زمان ومكان، لذلك ضمّن الإمام (علیه السلام) كلامه بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) فاطر/ 14، أي لا يخبرك بالأمور على حقيقتها إلّا العالم بكنهها والعارف بها، ويعني نفسه (علیه السلام)، وهذه الآية صالحة لتوصيل رسالة التحذير والتنبيه من الخطيب إلى السامعين، وسُمِّيَ هذا الأسلوب ب (أسلوب التحذير) إشارةً واضحةً إلى هذا النوع من الخطاب، لأنَّ التحذير هو التخويف أو طلب التحذير من شيء، يحتمل.
ص: 340
1- نهج البلاغة، خطبة / 253/176.
2- ينظر: شرح نهج البلاغة ج / 10 - 25 وذهب إلى هذا الرأي جمهور النحويين.
3- ينظر: أسرار العربيّة، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمّد الأنباري (ت 577 ه) / 155 تحقيق: محمد بهجة البيطار، دمشق، مطبعة الترقّي - 1377 ه - 1957م.
4- نهج البلاغة خطبة / 153/ 215.
5- اتفق النحاة على أنّ النصّ في التحذير والإغراء إنما هو بعامل مقدر وجوبًا أو جوازًا (بحسب الحال) كما اتفقوا على أنَّهُ فعل أمر أو ما في معناه، والأمر في كل أحواله خطاب مباشر بحكم معناه ومبناه.
منه ومعه وقوع ضرر أو أذىً، أو كما قال الخضريّ في حاشيته على شرح ابن عقيل: "التحذير هو التبعيد عن الشيء " (1) وبخلافه الإغراء الذي يعني: " التسلط على الشيء" (2).
وممّا تقدم تبيّن أن أسلوبي (الإغراء والتحذير) كليهما مقاما صرف، لا ينشئان ولا يوظفان إلّا في ظروف اجتماعيّة توائم بنيتها هذه الأساليب، بدليل أنَّ مكوِّنًا من مكوِّنات بنيتها اللغويّة لا يمكن تصوره أو حدوثه إلّا في كلام حي منطوق، هذا المكوِّن هو التطريز الصوتيّ، الذي يلف المنطوق كلّه، المتمثل بالتنغيم وموسيقى الكلام وطرائق إلقائه، وهما من الأفعال الكلاميّ، لأنّهما يرميان إلى التأثير في المتلقي واستمالته وحمله على أداء فعلٍ ما، فإذا رغب المتكلم من المخاطب في أن يتجنب أمرًا مكروهًا أدى رغبته تلك بالتحذير وإذا أراد منه أن يفعل أمرًا محمودًا أدى له تلك الرغبة بالإغراء، و هما من صنف الأمريات.
إنَّ مجرد التمثيل الأسلوبيّ (التحذير والإغراء) يقع على صورة معينة، تنبئ عن صفة أو قلق أو انزعاج في حال التحذير، وعن التماس أو حث للشيء في حال الإغراء، ولا يبعد خلو أسلوب (التحذير) عند إلقائه من إشارات جسميّة، كالتلويح أو الإشارة باليد (مع رفع الصوت عادةً) مصاحبة له، وهذا يعني مراعاة المقام بكلِّ ظروفه وملابساته، هو الفارق بين أسلوبي التحذير والإغراء، أو قلْ إنَّ الفرق الجوهريّ بينهما، هو أنَّ الإغراء دعوة إلى الفعل والتحذير دعوة إلى الترك، وفي كلِّ منهما دعوة إلى الاستمالة والتأثير، بعد أن علمنا تطابقهما في الأحكام النحوية (3)..
ص: 341
1- شرح شذور الذهب، ابن هشام الانصاريّ / 246، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، المكتبة المصرية، ط 1، 1995 م.
2- نفسه / 346.
3- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد شبر / 105 - 106.
ومن وسائل الاستمالة التداوليّة في نهج البلاغة استعمال الإمام (علیه السلام) الأبعاد الحواريّة في التواصل اللسانيّ، للتأثير في المتلقي، فالبعد الحواريّ ضروريّ، إذ لا يمكن أن نبلغ شيئًا بغير وجود الآخر، بحيث لا يكون الآخر فقط مستقبلًا أو سامعًا محايدًا، بل يكون فاعلًا أي سائلًا و مجيباً في الآن نفسه، فالقول الإشكاليّ المقدم من طرف المتكلم (بنحوٍ ما) هو موجه إلى مستمعٍ هو نفسه يحمل تساؤلات في ذهنه، وحين يستقبل القول تتفاعل تساؤلاته معه تساؤلات وإجابات المتكلم، وفي هذا السياق يورد الجاحظ ما يقارب هذه الفكرة فيقول: المفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفعل (1) وفي أثناء هذه العملية التفاعليّة تتحدد الاختلافات الإشكالية التفاعليّة للأقوال بوصفها افتراضات متبادلة داخل الحوار، ممّا يسمح بتحديد مجموعة من الأبعاد الحواريّة التي تميز حوارًا من آخر، وهي:
1 - الحوار الواضح: ويكون فيه القول واضحًا، أي سؤال وجواب من غير أن تتفرع عنهما أقوال أُخرى، ففي جواب الإمام علي (علیه السلام) حينما سأله أحد أصحابه: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقُّ به؟ أجاب قائلًا: " يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ، إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِ، تُرْسِلُ فِي غَيْر سَدَدٍ، وَ لَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ، وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ: أَمَّا الِاسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ بِالرَّسُولِ (صلی الله علیه وآله) نَوْطاً فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ؛ وَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ الْمَعْوَدُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةِ:
وَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ *** وَلَكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّوَاحِلى 1.
ص: 342
1- ينظر: البيان والتبين 11/1.
وَهَلُمَّ الخُطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ، وَلَا غَرْوَوَالله! فَيَا لَهُ خَطْبًا يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ " (1).
والحوار هنا لا يرقى إلى مستوى الاختلافات الإشكالية، ويكون ذا أبعاد حواريّة ضعيفة، لا تفتح هامشًا للافتراض والتأويل، يمثل الحوار هنا كلّ الأقوال الواضحة التي لا تثير تساؤلات في الغالب.
ومن لطائف هذا النصِّ قوله (علیه السلام): " فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ، وَلَا غَرْوَ وَاللَّهَ! فَيَا لَهُ خَطْبًا يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ "، فهو يشير إلى ما كان عنده من الحزن والأسفَ لتقدم من سلف عليه، فلم يقنع الدهر له بذلك، حتى جعل معاوية نظيرًا له، فضحك (علیه السلام) ممّا تحكم به الأقدار ويقتضيه تصرف الدهر وتقلبه، وذلك ضحك تعجبٍ و اعتبارٍ. ثم قال: (وَلَا غَرْوَوَالله)، أي ولا عجب والله، وبعدها فسر ذلك فقال: (فَيَا لَهُ خَطْباً يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ)! أي يستنفده ويفنيه، يقول: صار العجب لا عجب؛ لأنَّ هذا الخط استغرق التعج، فلم يبق منه ما يطلق عليه لفظ التعجب، وهذا من باب الإغراق والمبالغة في المبالغة (2).
2 - الحوار الإشكاليّ: يكون فيه القول افتراضًا منذ البداية، وتستدعي فيه الأسئلة أجوبة متنوعة يكون فيها للمتلقي والمتكلم هامشٌ من الحرية والاختيار والمعالجة من طريق الافتراض والتساؤل الإشكالي في هذا الحوار وقد لا يكون موجهاً إلى المستمع (المحاور)، فذات مرة سأل رجل الإمام (علیه السلام) قائلا أخبرنا عن الفتنة؟ وهل سألت عنها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فأجابه (علیه السلام): " إِنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ: «الم - أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ» عَلِمْتُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه.
ص: 343
1- نهج البلاغة، خطبة / 162 / 232، والبيت الشعريّ لأمرئ القيس بن حجر الكنديّ (ينظر: دیوانه/ 44).
2- ينظر: شرح نهج البلاغة 172/9.
وآله) بَيْنَ أَظْهُرِنَا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي أَخْبَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا؟ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ أُمَّتِي سَيُفْتَنُونَ بَعْدِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ لَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِدَ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ حِيزَتْ عَنِّي الشَّهَادَةُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتَ لِي أَبْشِرْ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ؟ فَقَالَ لِي إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ، فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذاً؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَ لَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَ الشُّكْرِ. وَ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ يَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ يَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِأَيِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ، أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّةٍ أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ" (1)، في هذا النصِّ مجموعة من التساؤلات بعضها ظاهرة في النصِّ وبعضها غير ظاهرة فذكر ابن أبي الحديد أنَّ الإمام كان يتكلم سلفًا عن الفتنة، لذلك ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عليكم بكتاب الله إذا وقع الأمر واختلط على الناس فقام له الرجل وسأله عن الفتنة، ثم ذكر خبرًا عن النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) رواه كثيرٌ من المحدّثين عن علي (علیه السلام)، أنَّ الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (إنّ الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب عليّ جهاد المشركين) قال: فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي كُتِبَ عليّ فيها الجهاد؟ (فقال): (قومٌ يشهدون أن لا اله إلّا الله وأني رسول الله، وهم مخالفون للسنة)، فقلت: يا رسول الله فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد: قال (صلی الله علیه و آله و سلم): (على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر) فقلت: يا رسول الله إنّك وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يجعلها بين يديك، قال (صلی الله علیه و آله و سلم): (فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين! أما أنّي وعدتك الشهادة، وستستشهد، تضرب على هذه فتخضب هذه - وأشار إلى هامة الرأس والشيبة - فكيف صبرك إذًا؟) 6.
ص: 344
1- نهج البلاغة، خطبة / 221/156.
قلت: يا رسول الله: ليس ذا بموطنٍ صبر، قال (صلی الله علیه و آله و سلم): أجل أصبت، فأعد للخصومة فإنّك مخاصم ... إلى آخر الخبر) (1).
في هذه الحوارية ترد مشكلات متعددة تتجلى فيها تأويلات وتفسيرات مختلفة فإنّا نجد المجيب هو نفسه السائل داخل السياق العام للحوار والإجابة قد ترد نحو سائل آخر (مفترض)، أو تعبر عن تساؤلات أُخرى من غير أن تعالج التساؤل الأول، وهنا تكمن حقيقة الحوار الإشكاليّ.
3 - الحوار الصامت: ويتم في الحالات التي يُطرح فيها سؤال مُشْكل من طرف المتكلم تُجاه مستمع موجود أو مفترض، أي نحو آخر غير محدد، لأنَّهُ ضمنيّ يمثل كلَّ واحد فينا، ويكون الاتفاق أو الاختلاف في هذا الحوار بالصمت، وعلى الرغم من ذلك تبقى العملية التواصليّة قائمة، قال (علیه السلام): " يَدَّعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ، كَذَبَ وَ الْعَظِيمِ، مَا بَالُهُ لَا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، وَ كُلُ رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ، وَ كُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلَّا خَوْفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ، يَرْجُو اللَّهَ فِي الْكَبِيرِ وَ يَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ، فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ؛ فَمَا بَالُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا يُصْنَعُ بِهِ لِعِبَادِهِ، أَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً، أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً؟ وَ كَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً، وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَ وَعْداً" (2).
أقسم الإمام (علیه السلام) على كذب هذا الزاعم (المفترض) فقال (والعظيم) ولم يقل والله العظيم تأكيداً لعظمة الله سبحانه، لأنَّ الموصوف إذا أُلقي وتُرك واعتمد على الصفة حتى أصبحت كالاسم، كان أدلُّ على تحقيق الصفة وأكثر تأثيرًا في المخاطب، 6.
ص: 345
1- ينظر: شرح نهج البلاغة 9/ 145.
2- نهج البلاغة، خطبة / 160/ 225 - 226.
و مراده (علیه السلام) هنا ليس شخصاً بعينه، بل كلُّ إنسان هذه صفته، فالخطاب له والحديث عنه.
إنَّ وسائل الحوار المستعملة في نهج البلاغة تشير إلى الإمكانات القوليّة المختلفة، التي تسمح للمخاطبين أن يستنتجوا، ويستدلوا، ويحاجوا، إنَّها وسائل تكشف عن مكمن السؤال في ما يقال من غير أن يقال مباشرة، وهي وسائل تداولية تابع فيها الإمام (علیه السلام) النهج القرآنيّ في القصص والمحادثات للتأثير في المتلقين، ومن ثم حافظ عليها المجتمع وتحولت إلى فنٍ من فنون الأدب كالمقامات والروايات والقصص ... وسواها.
ومن وسائل الاستمالة التّداوليّة استعمال الإمام الثنائيات التركيبيّة، وتأتي هذه الثنائيات في صور مختلفة من التقابل، وهو أسلوب واضح اعتاده أمير المؤمنين (علیه السلام) في خطبه للتأثير في المتلقين وإقناعهم، قال (علیه السلام): " إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَ إِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ؛ قَدْ وَكَّلَ بِذَلِكَ حَفَظَةً كِرَاماً لَا يُسْقِطُونَ حَقّاً وَ لَا يُثْبِتُونَ بَاطِلًا" (1)، في النصّ ثنائيتان جمليتان يصف الإمام (علیه السلام) عدل الله سبحانه وتعالى وعدل ملائكته الحفظة برصد أعمال الإنسان وتثبيتها.
وفي قوله (علیه السلام): "وَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ شِمَالًا ظَعْناً فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ وَ تَرْكاً لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ" (2)، فالثنائيّة بين اليمين والشمال ترمز إلى السبل الباطلة، فهنا الإمام يذكر قومًا من فرق الضلالة أخذوا يمينًا وشمالًا، أي ابتعدوا عن الطريق الوسطى التي هي منهاج الكتاب والسُّنَّة، ثم يأتي الإمام بثنائيّة تقابليّة يردف بها الثنائيّة الأولى مباشرته ليوضح للمتلقي سبب هذا الانحراف (ظَعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ، وَتَرْكًا لِذَاهِبِ الرُّشْدِ)، إذ جاء التوكيد في الثنائيّة بلفظي المصدر (ظَعْنًا، وَتَرْكًا) المنصوبين بعاملٍ غير لفظهما، و هو قوله: (أخذوا)..
ص: 346
1- نهج البلاغة، خطبة / 183/ 267.
2- نفسه: خطبة / 150/ 241.
ومن وسائل الاستمالة التّداوليّة توظيفُ الإمام التاريخ والتراث للتأثير في المتلقي، وقد أشرنا في أثناء البحث إلى بعضها (1)، قال (علیه السلام): " وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ وَ إِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرٍ بَيِّنٍ وَ تَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ" (2)، إشارة إلى الأُمم الماضية وبيان أنَّ الحلال واحد والحرام واحد، وأنَّ الأيام نفسها هي الأيام، فالمشهد واحد من حيث التقنيات مع اختلاف الشخوص والأمكنة والأزمنة.
ومن وسائل الاستمالة التّداوليّة استعمال الإمام أسلوب التكرار الوصفيّ بما يلائم كلَّ مجتمع فنراه يستعمل عبارة: (المرأة الحامل) مع أهل الكوفة لتباطئهم عن نصرة الحق، قال (علیه السلام): " يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ حَمَلَتْ، فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ وَ مَاتَ قَيِّمُهَا وَ طَالَ تَأَيُّمُهَا وَ وَرِثَهَا أَبْعَدُهَا" (3)، وقوله (علیه السلام) أيضًا: " قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا " (4)، ونراه أحيانًا يصف أهل الشام بعبارة: (جفاة، طغام) كما في قوله (علیه السلام): "جُفَاةٌ طَغَامٌ، وَعَبِيدٌ أَقْزَامٌ، جُمِعُوا مِنْ كُلَّ أَوْبٍ وَتُلُقِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ " (5)، وقوله (علیه السلام) أيضًا: " وَلَيْسَ عَجَبًا أَنَّ مُعَاوِيَةَ يَدْعُو الجُفَاةَ الطَّغامَ، فَيَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَعُونَةٍ وَلَا عَطَاءٍ" (6)، إشارة إلى جهلهم وقسوتهم وجفائهم.
ومن وسائل الاستمالة التّداوليّة استعمال الإمام (علیه السلام) ألفاظ المعجم الحجاجيّ الدينيّ، إذ يكاد أنْ يكون نهج البلاغة معجمًا دينيًا متكاملًا، استعمله (علیه السلام) في الحجاج والاستدلال ليؤثر في المتلقين، فنجده كثيرًا ما يحتج بلفظ القرآن، كما في قوله " ياهَمَّامُ 0.
ص: 347
1- ينظر: الفصل الثالث من هذا البحث، الظاهرة التنظيميّة / 141.
2- نهج البلاغة، خطبة / 183 / 267.
3- نهج البلاغة، خطبة / 101/71.
4- نفسه، خطبة / 97/ 143.
5- نهج البلاغة، خطبة / 238/ 358.
6- نفسه: خطبة / 180 / 260.
اتَّقِ اللهَ وَأَحْسِنُ (1): (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل / 128) "، وأحيانًا بمعنى اللفظ القرآنيّ كما في قوله (علیه السلام): " إإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَيَّنَ فِيهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ، فَخُذُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا" (2)، وأحياناً يحتج بنصِّ الحديث النبويّ الشريف كما قال (علیه السلام): " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً غَيْرَ مَجْهُولٍ وَ أَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَدْخُولٍ، وَ فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَ التَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا، فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لَا يَحِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ"(3)، فعبارة (المسلم من سلم المسلمون ...) (4) (لفظ الخبر النَّبويّ بعينه، وأحياناً يحتج بمضمونه كما في قوله (علیه السلام): " وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ، وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ" (5) إشارة إلى قول النبي (صلی الله علیه و آله): " من مات من غير إمام مات ميتة جاهلية " (6).
وهناك وسائل إقناع وتأثير أُخرى ذكرناها في فصول سابقة من قبيل استعماله (علیه السلام) الأمثال القصصيّة، والعبارات السياقيّة، والأعراف والتقاليد، والمُحرَّم اللغويّ، واستعمال الألفاظ الصحراويّة ذات المضامين المشتركة بين الموقفين ... وسواها. وربما تشترك معظم هذهِ الوسائل في عملية الإقناع والاستمالة والتأثير في المتلقي.).
ص: 348
1- نهج البلاغة، خطبة / 193/ 304.
2- نفسه، خطبة / 167/ 243.
3- نفسه.
4- أخرجه النسائيّ، كتاب الإيمان، باب صفة المؤمن (4495)
5- نهج البلاغة، خطبة / 152، ص / 213.
6- أخرجه أحمد في مسنده (16434)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (3/ 224).
الازدواج اللغويُّ (اللهجيُّ):
ظهر الازدواج اللغويّ عند العرب ظاهرة اجتماعيّة قبل الإسلام، إلّا إنَّنا نلحظ ظاهرة الازدواج اللغويّ بنحوٍ واضحٍ جلّي في المجتمع الإسلاميّ حينما انفتح على الثقافات والمجتمعات المحيطة به؛ نتيجةً لحروب الفتوحات الإسلامية، ودخول الأعاجم في الدين الإسلاميّ، فاختلطت الألسن المختلفة باللسان العربيّ الفصيح ونتيجةً لشيوع هذه الظاهرة، وتأثيرها في اللسان و الأدب العربيّ؛ وضع الإمام علي (علیه السلام) قواعد علوم اللغة العربيّة للحدِّ من انتشارها.
ظهر مصطلح الازدواج اللغويّ (Diglossie) في اللسانيات عام 1959م حين استعمله اللسانيّ الأمريكي شارل فررغيسون (charles fergason) وهو مصطلح إغريقي، تقيم الازدواجية التي يتحدث عنها شارل مقابلة بين ضربين من ضروب اللغة ترتفع منزلة إحداهما، وتُعدُّ المعيار الذي تكتب به لغة الأدب، ولكن يبقى التحدث بها عند الأقليةّ المتخصصين، وتحط منزلة الأُخرى التي يتحدث بها الأكثريّة، وهذه الازدواجية هي في الأساس مقترحات لسانيّ أمريكيّ آخر، وهو جوشوا فيشمان (fishman Josh) استنتج من طريقها أنَّ الازدواجية قد تشمل ثلاثة أضرب من ضروب اللغة (1).
تُعدّ هذه الظاهرة ظاهرة عالميّة، لكنها اكتسبت في المجتمع العربيّ الإسلاميّ سمة خاصة، تمثلت بشدّة حدّتها نظرًا لثبات أنظمة الفصحى من ناحية، وانطلاق العاميات من ناحية أُخرى، فضلاً عن عوامل سياسيّة واجتماعيّة وفكريّة، لكنها كغيرها من اللغات تأثرت بمختلف المراحل التي واكبت المجتمع منذ فجر الإسلام، فامتداد استعمال اللغة العربيّة مع الفتوحات الإسلامية واكب تسرب تراكيب وأصوات ليست من أصل اللغة، فظهر النحو والصرف حفاظاً على اللغة من هذا الانحراف، وكان
ص: 349
1- ينظر: حرب اللغات، لويس جان كالفي / 78، ترجمة: حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة ط 1، 2008.
المرجع في ذلك القرآن الكريم والأدب العربيّ، اللذين لم يتأثرا بالوافد من الألفاظ والتراكيب الأعجميّة إلّا ما كان يقع في منفعة اللغة وعلى وفق الأقيسة العربيّة.
والمثير علميًا - بهذا الصدد - أنَّ اللغة العربيّة تمكنت من استيعاب الفلسفة اليونانيّة والمحافظة عليها، بل التعليق عليها من غير أن تفقد بنيتها في الشكل والمضمون، وينطبق ذلك على نقل أدب الشعوب الشرقية كفارس والهند ويعود سبب ذلك إلى أنّ اللغة العربية كانت لغة حضارة في تلك المرحلة، فاللغة التي هي أقوى غالباً هي التي تستوعب أو تفرض نفسها على اللغات الضعيفة الأُخرى، ولا يعني ذلك أنَّ اللغة العربيّة لم تتعرض لنوع من الإفساد اللغويّ بفعل الجدل الذي ساد مختلف الفرق، التي أظهرت تأثرًا بالفلسفة اليونانيّة أو اعتراضًا على اللغة السائدة آنذاك في المجال الدينيّ بخاصة، وهو أمر أظهر تراجعًا في تطور اللغة العربيّة واستعمالاتها، ظهر جليًّا في مرحلة ما يُسمَّى (مرحلة الانحطاط)، فاللغة تنمو على قدر تطور أهلها في شتى المجالات والعكس صحيح.
والذي يبدو في نهج البلاغة هو ظاهرة الازدواج اللهجيّ، لأنَّ العرب تطلق على اللهجة لفظة (لغة)، وأنَّ اللهجات العربيّة التي استعملها الإمام في خطبه هي لهجات فصيحة، تابع فيها لغة القرآن الكريم تلك اللغة الموّحدة (المشتركة) بين لغات العرب ومن ثم أصبحت تلك الألفاظ متداولة في العربية الفصحى والفصيحة، ولم يجد الباحث ألفاظاً أعجمية عرّبها الإمام (علیه السلام) إلى اللغة العربيّة.
ومن ألفاظ الازدواج اللهجيّ قوله (علیه السلام): " وَمُذِلُّ مَنْ نَاوَاهُ وَغَالِبُ مَنْ عَادَاهُ ... " (1).
وأصل الكلمة (ناواه) مهموزة على لغة تميم، وقد ليّنها الإمام (علیه السلام) لأجل القرينة السجعيّة، قيل ناوأتُ الرجل مُناوأةً ونِوَاءًا، ويقال في المثل: (إذا ناوأت الرجل.
ص: 350
1- نهج البلاغة، خطبة / 90، ص / 124.
فاصبر) وجذرها اللغويّ (ن و أ)، جاء في الكتاب العزيز: (لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ) (1). أي لتنُئُ العُصْبَة بثقلها، و (ناءَ) بوزن بَاعَ لغة أخرى في (نأي) أي بَعُدَ (2).
ويُعدُّ الإمام علي (علیه السلام) أوّل من ليّن هذه اللفظة واستعملها في اللغة الفصحى، ومن ثم أصبح استعمالها شائعًا، وهذا من مرتكزات علم اللغة الحديث، الذي يهتم بالتغير اللغويّ على المستوى الاجتماعيّ، ويعود هذا التغير دائمًا إلى تجديد لفظيّ، يقبله المجتمع فيما بعد كظاهرة اجتماعيّة، وإلى جانب وجود تغيرات بدأت على مستوى الفرد ثم أصبحت على مستوى المجتمع، هناك تجديدات فرديّة ظلّت مرتبطةً بمجموعة أفراد، ولم تستسغْ اجتماعيًّا، فخرجت عن الدراسة في علم اللغة الحديث.
وفي موضع آخر من الخطبة نفسها يقول (علیه السلام): " ... لتناول علم ذاته ..." فلفظة (الذات) قد طال الكلام فيها كثيرًا عند أهل العربية، فأنكر قومٌ إطلاقها على الله تعالى وإضافتها إليه، أما إطلاقها فإنَّها لفظة تأنيث، والباري منزّه عن الأسماء والذوات المؤنثة، وأما إضافتها، فلأنّها عين الشيء، والشيء لا يضاف إلى نفسه.
وأجاز آخرون إطلاقها في الموردين مستشهدين بالشعر العربيّ القديم، قال خبيب الصحابيّ:
وذلك في ذات الإله وإنْ يشأ *** يبارك على أوصال شلْوٍ موّزعِ (3)
وقال النابغة:
محلتهم ذات الإله ودينهم *** قديمٌ فما يخشون غي العواقب (4).
ص: 351
1- سورة القصص، آية: 76.
2- ينظر مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازيّ (666 ه)، مادة (ناء)، تحقيق وضبط: حمزة فتح الله (ت 1336 ه) دار البصائر، مؤسسة الرسالة، 1987 م.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة، ج / 6، ص / 462.
4- ديوان النابغة الذبيانيّ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ص / 80، دار المعارف، مصر، ب.ت.
فضلًا عن أنَّها لفظة اصطلاحية متداولة، فجاز استعمالها، لا على أنَّها مؤنث (ذو)، بل تستعمل ارتجالًا في مسماها الذي عبر عنه أرباب النظر الإلهيّ كما استعملوا لفظتي الجوهر والعرض وغيرهما في غير ما كان أهل اللغة العربيّة يستعملونها فيها.
أما عن منعهم إضافة (الذات) إلى الله تعالى: لأنَّهُ من إضافة الشيء إلى نفسه، فمردود، فقد ورد في قولهم: أخذته نفسُهُ، أخذته عَيْنُهُ، فإِنَّهُ في الاتفاق جائز، وفيه إضافة الشيء إلى نفسِهِ (1). ومن مواطن الازدواج اللهجيّ في نهج البلاغة تشديد الحرف أو تخفيفه، جاء في قوله (علیه السلام): " ... إِذَا قَلَّصَتْ حَرْبُكُمْ وَشَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ ... " (2). فقد رويت لفظة (قَلَّصَتْ) بالتشديد لفظة (قَلَّصَتْ) بالتشديد والتخفيف، وفي كلا الموضعين لغةٌ، فمن رواها مشددة أرد انضمت واجتمعتْ، وذلك يكون أشدُّ لها وأصعبُ من أن تتفرق في مواطن متباعدة، ألّا ترى أنَّ الجيوش إذا اجتمعت كلّها، واصطدم الفيلقان، كان الأمر أصعب وأفظع من أن تكون كلّ كتيبة من تلك الجيوش تحارب كتيبة أُخرى في بلاد متفرقة ومتباعدة!؛ ذلك لإنَّ الاصطدام الكامل بين الجيشين هو الاستئصال الذي لا بقاءَ بعده
ومن رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت، من قولهم قَلَصَتْ البئر، أي ارتفع ماؤها إلى رأسها أو دونه، وهو ماء قالص وقليص (3).
وفي صفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول (علیه السلام): " ... فيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَفٍ وَشِفَاءٌ يَشْتَفٍ ...) (4).
جاءت لفظة (كفاءٌ) بالهمز، ولا وجه له هنا؛ لأنَّهُ من باب آخر، لكنه (علیه السلام) أتى بالهمز للمزاوجة بين (كفاء - وشفاء) كما قيل العذايا والعشايا، وكما.
ص: 352
1- ينظر: شرح نهج البلاغة، ج / 6، ص / 463.
2- نهج البلاغة، خطبة / 92، ص/ 138.
3- ينظر: شرح نهج البلاغة، ج 7، ص / 138.
4- نهج البلاغة، خطبة / 214، ص / 332.
قال الرسول (صلی الله علیه و آله): "مأزورات غير مأجورات" (1). فحصل انزياح في اللفظ لاتساق العبارة، فأتى بالهمز والوجه (الواو) للمزاوجة. والجدير بالذكر أنَّ بعض المواطن التي استعمل بها الإمام لغات غير لغة قريش، قد تابع فيها لغة القرآن الكريم من قبيل قوله (علیه السلام): " ... وَحَاشَ للَّهَ أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي ..." (2)، فعبارة: (حاش لله) بمعنى ما عاذ الله، والأصل إثبات الألف (حاشا)، وإنما أتبع أمير المؤمنين هنا المصحف الشريف، قال تعالى: ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (3).
وفي موضع آخر نراه (علیه السلام) يثبت الألف في غير موضعها: " ... لَا أَبَا لِغَيْرِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَالْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ الموْتَ أَوِ الذُّلَّ لَكُمْ ..." (4).
والأفصح في هذا الموضع (لا أبَ)، كما قال الشاعر:
أبي الإسلامُ لا أب لي سواهُ *** إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم (5)
قال ابن أبي الحديد: " وأما قولهم: لا أبًا لك، بثبات الألف فدون الأول بالفصاحة، كأنهم قصدوا الإضافة، وأقحموا اللام مزيدة مؤكدة، كما قالوا: يا تيمَ تيم عديّ، وهو غريب؛ لأنَّ حكم (لا) أن تعمل في النكرة فقط، وحكم الألف أن تثبت مع الإضافة، والإضافة تعرّف، فجتمع فيهما حكمان متنافيان، فصار من الشواذ كالملامح، والمذاكير، ولدى غدوة " (6)..
ص: 353
1- أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ماجاء في إتباع النساء بالجنائز (1578).
2- نهج البلاغة كتاب / 65، ص / 457.
3- سورة يوسف، آية: 31.
4- نهج البلاغة، خطبة/ 180، ص / 259.
5- لم أجد قائله في كتب الأدب.
6- شرح نهج البلاغة، ج / 10، ص 271.
وذهب أبو البقاء العكبريّ (ت 616 ه) إلى القول بالجواز من وجهين آخرين، أحدهما: أَنَّهُ أشبع فتحت الباء؛ فنشأة الألف والاسم باقٍ على تنكيره، والآخر: أن يكون استعمل (أباً) على لغة من قالها (أباً) في جميع أحوالها قال الشاعر:
إنَّ أباها وأبا أباها (1).
ويبدو أنَّ نشوء علوم اللغة العربية في العراق نابعٌ من اختلاف أهل هذا المصر فيما بينهم، فالتركيبة الذهنيّة العامة تتسم بقوة البصر ودقة النظر في مسائل الدين والدنيا، وما ذلك الاختلاف إلّا استجابة لمتطلبات العقل الجمعيّ؛ لأنَّ المعروف عن أهل الكوفة أنَّهم شتات من أقوام مختلفة وألسن متنوعة تجمعت في معسكر الكوفة بخلاف أهل الحجاز، إذ فرق ابن أبي الحديد بين هذين المصرين بقوله: " إنّ هؤلاء من أهل العراق وساكني الكوفة، وطينة العراق ما زالت تنبت أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة، وأهل هذا الإقليم أهل بصرٍ وتدقيق ونظر، وبحث عن الآراء والعقائد، وشبهة معترضة في المذاهب، وقد كان منهم في أيام الأكاسرة من تشبه بالأكاسرة، وليس طينة أهل الحجاز هذه الطينة، ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان، والغالب على أهل الحجاز الجفاء والعجرفية وخشونة الطبع، ومن سكن المدن منهم كأهل مكة والمدينة والطائف، فطباعهم قريبة من طباع أهل البادية بالمجاورة، ولم يكن فيهم من قبل حكيم ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدل، ولا موقع شبهة ولا مبتدع نحلة، ولهذا نجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن الإمام علي (علیه السلام) في العراق والكوفة، لا في أيام مقامه في المدينة، وهي أكثر عمره" (2).
فمن الطبيعيّ أن تنتشر ظاهرة الازدواج اللهجيّ في العراق لتعدد قبائل جند الكوفة ووجود المذاهب الجدلية..
ص: 354
1- نسب العينيو السيد المرتضى لأبي النجم العجليّ، ونسبه الجوهريّ لرؤبة العجاج، ينظر: شرح ابن عقيل / ج.
2- شرح نهج البلاغة، ج / 7، ص / 38.
(1)
ولما كانت نصوص نهج البلاغة هي المختارات من أقوال أمير المؤمنين (علیه السلام) في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة (اللغة الفصحى)، لم يجد الباحث سوى ظاهرة الازدواج اللهجيّ الممدوح التي أثرت في اللغة العربيّة وأغنتها بالفصيح من القول، على وفق اللهجات العربيّة الأصيلة (1)، ولا نستطيع في أي شكل من أشكال المجتمع أن نغير حدود اللغة، ولا طبيعتها ولا وظائفها من غير أن نسبب تغيرات أُخرى ربما تكون غير مقصودة، ذلك أنَّ اللغة وطيدة الصلة بأفكار الناس وأحاسيسهم وأعمالهم، وأنّها أساسيّة جدّا، وعميقة الأثر في كلِّ السلوك الإنسانيّ، في حياة الإنسان فردًا، وفي حياته الاجتماعيّة، حتى أنً تغيرات كهذه التي تخلق ثورة لغوية لا بُدَّ أن تخلق ضعفاً وتوترًا وقلقًا اجتماعيًّا، واختلافات في الفكر والإحساس والعمل (2).3
ص: 355
1- للمزيد من مواضع الازدواج اللهجيّ، ينظر: شرح نهج البلاغة، 30/9، خطبة / 138 (رضَعَ، ورضِع)، 9/ 86، خطبة / 149، (أضمحل، امضحل) 9 / 102، خطبة / 152 (طُلَّ، أطِلّ، طَلّ)، 9 / 199، خطبة / 169 (عِبْدان، عُبْدان، عبيد، عباد، عبدَاء، عُبْدَي، معبوداء، عُبد) 10 / 265، خطبة 192 (تعاهدوا، وتهدّو) ... وسواها.
2- ينظر: اللغة والمجتمع، م. م لويس جاكسون / 23
الاستنتاجات
أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث في دراسته:
1 - إنَّ فكرة المجتمع في نهج البلاغة لها مكان مرموق بين ما اشتمل عليه من موضوعات فمحور عظمة هذا الكتاب هو إيمان منشئه المطلق بكرامة الإنسان، وحقه المقدس في الحياة الحرَّة الشريفة، إذ ليس من المعقول أن يكون نهج البلاغة قد ولد نتيجة اختراع فرديّ من غير اعتماد على معطيات اجتماعيّة للفرد والجماعة، ويظهر ذلك جليّاً في العلاقة الدالة بين مضمون هذا النوع الأدبي وأكثر الجوانب أهمية في الحياة الاجتماعيّة.
2 - تقترب مبادئ مدرسة النقد الجديد التي ظهرت في فرنسا عام 1965م من النقد الذي وجهه الإمام (علیه السلام) إلى المجتمعات (أفراداً وجماعات).
3 - انطلق الإمام (علیه السلام) في تنشئته للمجتمع من منظور إسلاميّ، تجسد في نشأته (علیه السلام) الاجتماعيّة، إذ لا يخلو نهج البلاغة من التوجيهات التربويّة التي تُعنى بتشكيل عقل الطفل وتنمية ملكته، إذ أثبتت الدراسة تأكيد الإمام نظرية (فطريّة اللغة) وأنَّ الفرد ينشأ فيجد بين يديه نظاماً لغويّاً يسير عليه مجتمعه، فيتلقاه عنه تلقياً بطريقة التعلم والمحاكاة مثلما يتلقى سائر النظم الاجتماعيّة الأُخرى، وفي ذلك تفنيد لنظرية (دارون) التطوريّة؛ لأننا لا نلحظ أنَّ اللغة قد تطورت في تخاطب الحيوان من بدايتها حتى اليوم.
4 - يرى الإمام (علیه السلام) أنَّ مُقوِّم الكلام هو العقل، وأنَّ الطفل لديه قدرة غير متكاملة على التعقل والفهم، وهذا دلبلٌ على ارتكاز ما أثبتته النظرية اللغويّة الحديثة التي ترى أنَّ اللغة ليست مجرد التعبير عن الفكر، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية التفكير وتكوينه، وأنَّ عملية التفكر مستحيلة من غير اللغة على ما اسس له الإمام (علیه السلام).
5 - تجسدت في شخصيّة الإمام علي (علیه السلام) أنماطٌ سلوكيّة متعددة اختلفت وتنوعت، بحسب المجتمعات التي عاش فيها، وظهر هذا الاختلاف والتَّنوع في الوظائف اللغوية التي استعملها الإمام في المواقف الكلاميّة المختلفة.
ص: 357
6 - إنَّ الفرد المُبدع يستطيع بالوقوف على بنية الذات الجمعيّ أن يتأمل المواقف والأحداث، وأن يختار ما يريد من المقولات الاجتماعيَّة التي تشع من أفق ذلك المُبدع من حيث إنَّ المُبدع العبقري يُعدُّ في طليعة الأفراد الذين يحاولون تكوين ذات جماعيَّة تتجاوز الذات الفرديَّة.
7 - اتخذ الإمام (علیه السلام) عدة أنماط من السلوك الاجتماعيّ في حياته، فاتسمت نصوص نهج البلاغة بالتَّنوع والاختلاف في الألفاظ والتراكيب تبعًا لاختلاف المضامين وتنوعها، كل بحسب المرحلة التي قيلت فيها تلك النصوص إجمالًا، بشخصية الإمام (علیه السلام) من جانب، وثقافات تلك المجتمعات وأحوالها من جانب آخر.
8 - سبق الإمام (علیه السلام) كتَّاب أوربا ومفكريها الإداريين الذين ظهرت بواكير علم الإدارة الحديث على أيديهم وفي كتاباتهم في تشريع الوزارات في ضوء الاستناد إلى قاعدة: (نطاق الاشراف)، التي تعني تحديد عدد المرؤوسين الذين يستطيع الرئيس السيطرة عليهم، وكلما كان هذا النطاق صغيراً حقق أبعاداً أكثر للسيطرة والمراقبة وتحقيق الأهداف العامة، واليوم نرى عدد الوزارت قد بلغ الأربعين وزارةً.
9 - جاء الإسلام بمفاهيمه الإنسانيَّة الجديدة، التي أعطت الحياة الاجتماعيَّة ما رفع شأن العامل والصانع، بعد ما كان احتقار الحرف والمهن عرفًا اجتماعيًّا سائدًا في المجتمع الجاهليّ، وجعل من تلك الأفكار والظواهر المختلفة موضعاً للسخريَّة والرفض.
10 - مثلت بيعة الإمام للخلافة أوّل إصلاحٍ سياسيٍّ أحدثه الإمام، إذ أجمعت الأمة وفي أشرف مكان وهو المسجد على بيعته - رجالًا ونساءً - فمنح ذلك الإمام محور السُّلطة العقلانيَّة القانونيَّة، على أساس حدوث عملية تعاقد اجتماعيّ حقيقيّ بين الحاكم والمحكوم عبر آلية جديدة (آلية البيعة).
11 - لو تأملنا الجانب السِّياسيّ في خطب الإمام (علیه السلام) بمجملها لا نجد الحرب هدفًا عنده، إنَّما الاجتماع والتعاون والتعايش السلميّ هو الهدف، والدفاع عن الدين وشرعيته ليست دعوة إلى الحرب وتأجيج نارها، إنَّما هي إصلاح واقع الهيكل الاجتماعيّ، وتطبيق الشريعة، ورسم الصورة للمسيرة البشريَّة في حياتها.
ص: 358
12 - إِنَّ النظام السِّياسيّ في فكر الإمام مبنيّ أساسًا على مبدأ ربط السِّياسة بالدين، وعلى هذا فمن الطبيعيّ أن نفهم من قول الإمام (علیه السلام) قوله: " من ساس نفسه أدرك السياسة " (1)، وهذا يعني أنَّ السِّياسة تبدأ من الذات وتنطلق إلى المجتمع.
13 - إنّ مفهوم السياسة في الإسلام ليس فيه مبدأ: (الغاية تسوغ الوسيلة)، وإنَّما العكس من ذلك، أي مبدأ: (لا يطاع الله من حيث يعصى) (2) وهذا مبدأ علي (علیه السلام) في الحكم السِّياسيّ، إذ إنَّ المبادئ ثابتة لا تتغير مع تغيُّر المصالح.
14 - بيّنَ الإمام (علیه السلام) في كتابه لمالك الاشتر دستوريًّا الخطوط الرئيسة للحكومة، وكأنه (علیه السلام) قد أجرى دراسة واقعيَّة مستفيضة لمفهوم الحكومة على أرضٍ وطئتها عدة حكومات متعاقبة، تمثل تلك الخطوط الرئيسة للحكومة الأصول العامة للحكم، التي لا يمكن أحداً أن يُشرِّع فيها، لأنَّ الحكومة في الإسلام ليست ملكيَّة أو مستباحة، وكذلك ليست ديمقراطيَّة، بمعنى أنَّ الشعب بممثليه المنتخبين يُشرِّع القوانين، وإنَّما إرادة الشعب في الإسلام مقيدة بحكم الله ورسوله، والشريعة صاحب السلطان.
15 - أراد الإمام من ذكر صفات القاضي وسماته تصحيح مسار البنية الاجتماعيَّة بنحوٍ عامٍ، والبنية القضائية بنحوٍ خاصٍ؛ لأنَّ الشروط الواجب توافرها في القاضي منذ نُشُوء الدولة الإسلاميَّة في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تكن كافية في ردِّ المظالم عن المظلومين، وربما وقع المحذور في القضاء كما وقع في بقية نُظُم البنية الاجتماعيَّة في عهد الخليفة الثالث، ويكشف ذلك عن مهارة الإمام علي (علیه السلام) القضائيَّةٍ والتشريعيَّةِ، فهذه السماتُ بمنزلةِ الأُسسِ العامةِ في (فقهِ القضاةِ).
16 - يُعدُّ الإمام عليٌ (علیه السلام) أوّل مَنْ قضى على السبب الأوّل من أسباب انحراف القضاة، إذ خطا خطوةً مبدئيَّةً نحو فصل القضاة عن السُّلطة التَّنفيذيَّة، كي.
ص: 359
1- عيون الحكم، الواسطي / 431
2- السياسة من واقع الإسلام، صادق الشيرازي / 23، بيروت، ط 4، 2003م.
لا يتأثر القضاة بأصحابها، وفصل القضاء عن السُّلطة التَّنفيذيَّة هو من قوانين المدنيات الحديثة؛ لأنَّ فيه سبباً من أسباب التَّسوية بين البشر - أمام قضاءٍ يتولاهُ عالمٌ ذو خلقٍ كريمٍ، متمتعٌ بالحصانةِ.
17 - لقد وعى الإمام (علیه السلام) الواقع المرّ الذي فرزته تراكمات السِّياسات الاقتصاديَّة المخطئة، وهو أوّل من كشف عن أنّ الفقر والغنى مشكلة اجتماعيَّة خطيرة. وعلى هذا الأساس من الوعي جعل (علیه السلام) الإصلاح الاقتصاديّ أساسًا للإصلاح الاجتماعيّ.
18 - استعمل الإمام (علیه السلام) التَّقسيم الطبقيّ على أساس الوظيفة الاجتماعيَّة العلي بالدرجة الأولى، وهناك تقسيم أخر يتم داخل كلِّ طبقةٍ من الطبقات، وهو التَّقسيم على أساس المثل الأعلى، والتَّقسيم الأوّل لا يتتبع حكمًا تقويميّا على الشخص المنتسب إلى الطبقة، بخلاف التَّقسيم الثاني فهو الذي يتتبع حكماً تفويضيّاً عليه.
19 - ونهجُ البلاغةِ حافلٌ بالظاهرةِ التنظيميةِ، فهو مظهرُ تنظيمٍ متكاملٌ، يبدأ بتنظيم الفرد وينتهي بتنظيم المجتمع، وتُعدُّ الأُسرة من مظاهر التنظيم الاجتماعيّ المهمة فيه، والمؤسسة الصغرى والأكثر أهمية في عملية التنشئة الاجتماعيّة؛ لأنّها تشارك بالقدر الأكبر في الإشراف على النّمو الاجتماعيّ للفرد، وتكوين شخصيته، وتوجيه سلوكه.
20 - تؤكد الإشارات التاريخية أنَّ الإمام (علیه السلام) كان يعرف اللغات، ومنها (لغة الزط، والنبطيّة، والفارسيّة)، بل إنَّ الإمام كان يعرف لغة (لهجة) قيس وتميم والحجاز وكنعان ... وسواها من لغات العرب.
21 - تأثر الإمام علي (علیه السلام) بأساليب الأدباء العرب قبل الإسلام شعرًا ونثرًا، فاقتبس مفردات ومصطلحات، وانتفع بأفكار قائليها، وإنتاج مجتمعاتهم الأدبية والعلمية، ولا يخفى ما لهذا كلِّهِ من أثرٍ بليغٍ في نهضةِ لغةِ نهج البلاغةِ وتهذيبها، واتساع نطاقها، وزيادة ثروتها.
22 - إنَّ الأعراف والتقاليد والعادات التي تمثلت بالعبارات المثليّة في نهج البلاغة، هي من مخترعات المجتمع العربيّ الجاهليّ، وهذا يدلُّ على تأثر لغة
ص: 360
نهج البلاغة بتلك المواقف والأحداث، حتى أصبح نهج البلاغة سجلًا صادقًا لتاريخ القبائل العربية قبل الإسلام وبعده، بل مثّل نهج البلاغة سجلاً لحضارات أُمم خلت قبل ظهور المجتمع العربيّ.
23 - اتبع الإمام (علیه السلام) النّهج القرآنيّ في ظاهرة المُحرَّم اللغويّ، فاستبدل بالألفاظ المحرمة اجتماعياً ألفاظاً مقبولةٍ، تدلُّ عليه.
24 - استعمل الإمام (علیه السلام) وسائل إقناع (إبلاغيّة وإمتاعيّة) للتأثير في المتلقي من قبيل استعمال التراكيب النحويّة المتداولة، والأسلوبيّة، والتوظيفيّة، والأمثال القصصيّة، والعبارات السياقيّة، والأعراف والتقاليد، والمُحرَّم اللغويّ، وتوظيف التأريخ، واستعمال الألفاظ الصحراويّة ذات المضامين المشتركة بين الموقفين، واستعمال المعجم الدينيّ الحجاجيّ، واستعمال الخطاب المتعدد الأبعاد ... وغير ذلك.
25 - أحدث الإمام (علیه السلام) تأثيرًا في المستمع المقصود، فعلى مستوى التعبير بلغت خطبه أعلى مراتب الفصاحة، تمثلت بتشكيل سلسلة من الأصوات اللغويّة لها نظام معلوم وثابت، وكذلك على مستوى الانجاز وعلى مستوى الإجابة، باستعمال المسار الحجاجيّ المؤثر والناجح على وفق الطرح الإشكالي والنتيجة.
26 - أظهرت الدراسة استعمال الإمام أنواعاً مختلفة من الأنماط الأسلوبية، منها: الاجتماعيّة والمجازيّة والتاريخيّة، والرمزيّة والواقعيّة والوعظيّة والفقهيّة، والذهنيّة ... على وفق ما تسمى اليوم بقاعدة (الاستلزام) التي عمد إليها جرايس - أحد منظري التداوليّة - وعلى وفق (مبدأ التعاون) المفترض بين المتكلم والمخاطب.
ص: 361
المصادر والمراجع
اشارة
* القرآن الكريم.
* الاتجاه الفكريّ عند الإمام (علیه السلام)، د. رحيم محمد سالم، ط 1، مركز دراسات الشهيدين الصدرين،بغداد 2007 م.
* الاختصاص، الشيخ محمد بن محمد المفيد (ت/ 413 ه)، إيران، 1379 ه.
* الإدارة في الإسلام، المنهجية والتطبيق والقواعد، د. فهمي خليفة الفهداويّ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان - الأردن، ط 2، 2001 م.
* أساسيات التوافق النفسيّ والاضطرابات السلوكية والانفعالية (الأسس والنظريات) د. صالح حسن أحمد الداهريّ، ط 1، دار صفاء - للنشر والتوزيع، عمان، 2008 م.
* الأساليب الإنشائية في النحو العربيّ، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجيّ، القاهرة ط 3، 1981 م.
* أسرار العربيّة، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمّد الأنباريّ (ت 577 ه)، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دمشق، مطبعة الترقّي - 1377 ه - 1957 م.
* الإسلام وإيران الشيخ مرتضى مطهريّ، ترجمة: هادي الغرويّ، 1985 م.
* أصوات وإشارات - دراسة علم اللغة، أ. كوندرانوق، ص نقله عن الانكليزية أدور يوحنا، بغداد، 1970 م.
* أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، تأسيس "نحو النص"، محمد الشاوش، المؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، 2001م، ب.ت.
* أصول الكافيّ، الكلينيّ محمد بن يعقوب (ت 329 ه)، تحقيق: علي أكبر غفاريّ، ط 8، طهران، 1388 ه.
* أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د. نايف خرما، مكتبة اللغة العربية، بغداد - شارع المتنبيّ - 1978 م.
* الاعجاز العلميّ عند الإمام علي (عليه السلام)، د. لبيب بيضون، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ط 1، 2005 م.
* أعلام نهج البلاغة، السرخسيّ (علي بن ناصر، ق 6)، ط1، طهران، 1415ه.
ص: 363
* الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسن (ت 356 ه)، مصر - (1323 ه).
* اقتصادنا، السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية النجف الأشرف 1 - 2003 م.
* الاقتضاء في التداول اللسانيّ، عادل فخوريّ، مجلة الفكر، الكويت، م / 20، ع / 1989 م.
* الامالي: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ، دار الثقافة - قم المقدسة، 1414 ه.
* الامالي، إسماعيل بن القاسم القاليّ (ت 356 ه)، تحقيق: إسماعيل يوسف ذياب القاهرة، (1953 - 1954م).
* الإمام على أسد الإسلام وقديسه روكس بن زايد العزيزيّ، ط 2، بيروت، (1399 ه - 1979 م)
* الإمام علي بن أبي طالب، نظرة عصرية جديدة، محمد عمارة وآخرون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1974 م.
* الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، جورج جرداق، دار مكتبة صعصعة، البحرين، ط 1، 2003م.
* الأمثال في القرآن الكريم محمد جابر الفياض دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988 م.
* الانثربولوجيا الاجتماعية، د. عاطف وصفي دار النهضة العربية للنشر والطباعة بيروت، ط3، 1981 م.
* الإنصاف في مسائل الخلاف محمد عبد الرحمن ابن الأنباري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد دار الفکر بيروت (1407 - 1987م).
* انفتاح النسق اللسانيّ محي الدين محسب، ط 1، دار الكتاب الجديد 2008 م.
* أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف ب (كتاب الفروق)، شهاب الدين أحمد بن محمد القرافيّ، تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2001 م.
* البرغماتية وعلم التركيب، عثمان طالب، الملتقى الدوليّ الثالث في اللسانيات / الجامعية التونسية - تونس / 1985 م.
ص: 364
بلاغة الخطاب وعلم النصّ، د. صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت، ط 1، (1413 ه - 1992 م).
* البنيوية التكوينية والنقد الأدبيّ مجلة آفاق مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط1، 1984 م.
* البيان الشيوعي كارل ماركس وفريدك انجلس، دراسة: هرمان دونکر، دار الفارابيّ، ط 1، 1900 م.
* البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محجوب الجاحظ (255 ه)، تحقيق: د. حسن السندوبيّ، المطبعة التجارية الكبرى، ط 1، 1926م.
* تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهريّ (ت / 400ه - )، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة، 1956م.
* التاريخ الإسلاميّ العام د. علي إبراهيم حسن، ط 3، القاهرة، 1963 م.
* تاريخ الأمم والملوك، الطبريّ، الاعلميّ، بيروت.
* تاريخ أهل البيت، كبار المحدثين والمؤرخين، تحقيق: رضا الحسينيّ، ط1، 1410 ه.
* تاريخ دمشق لابن عساكر (علي بن الحسين / ت 571 ه)، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، 1415 ه.
* تاريخ الكوفة منتديات شط العرب، بحث منشور على شبكة الانترنيت.
* تاريخ اليعقوبي، أحمد بن يعقوب اليعقوبيّ (ت / 284 ه)، دار صادر بيروت.
* تحف العقول عن آل الرسول، الشيخ أبو محمد الحسن بن علي الحرانيّ، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ط 1، 1963م.
* التحليل الاجتماعيّ للأدب، السيد يسين، ط 3، مكتبة مدبوليّ، القاهرة، 1988م. * التداولية عند علماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الافعال الكلامية في التراث اللسان العربيّ الدكتور مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط / 1، 2005 م.
* التداولية اليوم، روبل آن و موشلار جاك ترجمة: سيف الدين دغفوس ومحمد الشيبانيّ (بيروت، دار الطليعة، ط 1، 2003)
* التراكيب الإعلامية في اللغة العربية، د. حنان إسماعيل عمايره دار وائل للنشر عمان، ط 1، 2006 م.
ص: 365
* التراكيب اللغوية في العربية، دراسة وصفية تطبيقية، د. هادي نهر، مطبعة الرشاد بغداد / 1987 م.
* التفسير النفسيّ للأدب، د. عز الدين إسماعيل، دار المعارف، مصر، 1963 م.
* التفكير اللسانيّ في الحضارة العربية، د. عبد السلام المسديّ، الدار العربية للكتا، لبنان، تونس، 1981 م.
* التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، محمد مفتاح، المركز الثقافيّ العربي، بيروت، ط1، 1994 م.
* تهذيب اللغة، الأزهريّ (ت 370 ه)، تحقيق لجنة من المحققين، الدار المصرية للتأليف والنشر، مطابع سجل العرب (د.ت).
* التنظيم الاجتماعي، ثقافة التنظيم وتطبيقاته البيروقراطية، د. متعب مناف جاسم، محاضرات أُلقيت على طلبة الدكتوراه في قسم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة بغداد، (2004 م - 2005 م).
* التنظيم الاجتماعيّ / السلطة والثوابت و التواصل - شكلية التنظيم وفاعلية الاتصال، د. متعب مناف، محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه في قسم الاجتماع كلية الآداب، بغداد، 2004، 2005م.
* التواصل نظريات ومقاربات جاكسون، ترجمة: عز الدين الخطابيّ وزهور حوتي تقديم: عبد الكريم غريب، منشورات عالم التربية، ط 1، 2007 م.
* المعجم الكبير، سليمان بن حمد الطبرانيّ (ت 360 ه) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيّ، بغداد - 1379 ه.
* أمثال العرب، المفضل بن محمد الضَّبيّ (ت/ 168 ه)، القسطنطينية، 1979 م.
* جمهرة الأمثال أبو هلال العسكريّ، الحسن بن عبد الله (ت/ بعد 395 ه)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، وعبد الحميد قطامش، 1384 ه.
* جمهورية الحكمة في نهج البلاغة، د. حسن عباس حسن نصر الله، دار القاری للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، (1427 ه - 2006 م).
* حاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشّمسيّة، الشريف علي بن محمد الجرجانيّ، القاهرة، مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ، 1948م.
ص: 366
الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، أمينة الدهريّ، شركة النشر والتوزيع المدارس - الدار البيضاء، ط 1، 1432 ه - 2011 م.
* حجاجية التأويل في البلاغة المعاصرة، محمد ولد سالم الامين، وما يليها، منشورات المركز العالميّ لدراسات الكتاب الأخضر، طرابلس، ط 1، 2004.
* حرب اللغات، لويس جان كالفي، ترجمة: حسن حمزة المنظمة العربية للترجمة، ط 1، 2008 م.
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهانيّ، مصر - الخانجيّ.
* الخصائص، ابو الفتح عثمان بن جني (ت / 392 ه)، تحقيق: محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية العامة، ط 12، 1990 م.
* خصائص التركيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، د. محمود أبو موسى، دار التضامن، مصر، ط 2، 1980 م.
* الخطاب، سارة ميدز، ترجمة: يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، الجزائر 2004 م.
* الخطاب القرآنيّ دراسة في البُعد التداوليّ، د. مؤيد آل صوینت، بيروت - لبنان مكتبة الحضارات، ط 1 (1431 ه - 2010 م).
* الخطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، د. أحمد المتوكل، الدار العربية للعلوم، ناشرون الاختلاف، الجزائر، ط 1، 2010.
* دراسات في نهج البلاغة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط 4، (1422 ه - 2001 م).
* دراسة المجتمع، د. مصطفى الخشاب مكتبة الانجلو المصريّة، ط 2، 1970 م.
* الدر المنثور جلال الدين السيوطيّ (ت 911 ه)، دار المعرفة - بيروت، ط 1، (1369 ه - 1945 م).
دعائم الإسلام، النعمان بن محمد التميميّ المغربيّ (ت 363 ه)، تحقيق: أصف بن علي، مصر - 1963 م.
* دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانيّ (ت: 471 ه)، تعليق وشرح: محمد عبد المنعم خفاجة، مطبعة الفجال الجديد، القاهرة، 1969 م.
ص: 367
• دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانيّ (471 ه)، دار الكتاب العربيّ، تحقيق: د. محمد التنجيّ، بيروت، ط 2، 1995م.
* دلالة الالفاظ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1980م.
* دلیل سوسيو لسانیات، فلوريان كولماس، ترجمة: د. خالد الأشهب ود. ماجدولين النهيبيّ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، بيروت، 2009 م.
* الديمقراطية والتربية، جون ديوي، ترجمة: لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر - القاهرة، مطبعة المقدم، ط 2، 1954 م.
* دور الكلمة في اللغة، استيفن اولمان ترجمة د. كمال محمد بشر، ط 10 - 1986 م.
* الدين والسياسة، نظريات الحكم في الفكر السياسيّ الإسلاميّ، مصطفى جعفر وآخرون، بحث منشور في مجلة المنهاج التابعة لمركز الغدير للدراسات الإسلامية، بيروت، 2003 م.
* ديوان أمرى القيس، دار صادر، بيروت (1392 - 1972م).
* ديوان الشنفرى (ضمن مجموعة الطرائف الأدبية)، لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر / 1937 م.
* ديوان المتنبي شرحه وكتب هوامشه: مصطفى اسبيتيّ، دار الكتب العلمية بيروت، ط 4، 2009 م.
* ديوان النابغة الذبيانيّ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر ب.ت.
* الراعي والرعية، توفيق الفكيكيّ، المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة، ط 3، بغداد، 1990 م.
* ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشريّ (ت 538 ه).
* روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، أبو حاتم محمد أبن حبان البستيّ، شرح وتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد القفيّ دار الكتب العلمية بيروت (د.ت).
* سلسلة قراءات في انطباعية نهج البلاغة، علي حسين الخباز، العتبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية و الثقافية - شعبة الإعلام، ط 1 / 2000 م.
ص: 368
* سنن الترمذيّ، محمد بن عيسى الترمذيّ (ت / 279 ه)، دار الفكر بيروت، (1403 ه - 1983 م).
* السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقيّ (ت/ 458 ه)، الهند، 1352 ه.
* سوسيولوجيا ماكس فيبر، جوليان فروند، مركز الإنماء القوميّ، بيروت، د.ت.
* السياسات اللغوية، لويس جان كالفي ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 1، الجزائر العاصمة (1430ه - 2009 م).
* السياسة الإدارية في فكر الإمام علي بن أبي طالب بين الأصالة والمعاصرة، د. خضير كاظم حمود، مؤسسة الباقر، بيروت
* السياسة من واقع الإسلام صادق الشيرازيّ، بيروت، ط 4، 2003م.
* السيرة النبويّة، ابن هشام محمد بن إسحاق المطلبيّ (ت 151 ه)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد المجلد الأول، القاهرة، 1383 ه.
* شرح ابن عقيل ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيليّ المصريّ الهمذانيّ (769 ه)، تحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفکر، دمشق، ط 2، 1985 م.
* شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيّ (ت / 421 ه)، نشرة احمد أمين، ط 2، القاهرة، (1378 ه - 2006 م).
* شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاريّ، ضبطه وصححه: عبد الرحمن البرقوقيّ مطبعة الرّحمانية، مصر، 1929 م.
* شرح شذور الذهب ابن هشام الأنصاريّ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ط 1، 1978 م.
* شرح شذور الذهب ابن هشام الانصاريّ، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، المكتبة المصرية، ط 2، 1995 م.
* شرح نهج البلاغة، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائنيّ الشهير بابن أبي الحديد المعتزليّ (656 ه)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار أحياء التراث العربيّ، ط 2، ج 1 - ج 7 (1385 ه - 1965 م)، ج 8 (1386 ه - 1966 م)، ج 9 - ج 10 (1386 ه - 1967 م)، ج 9 - ج 20 (1387 ه - 1966).
ص: 369
* شرح نهج البلاغة، محمد عبده، بیروت، لبنان.
* شظايا لسانية، د. مجيد الماشطة، مطبعة السلام، البصرة، ط 1 / 2007م.
* شعر الكميت بن زيد الأسديّ، (ثلاثة أقسام في جزأين)، جمع داود سلوم (ت / 2010 م)، النجف الأشرف 1969 م.
* شعر النابغة الجعديّ، نسخة على نفقة العالم الجليل الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني منشورات المكتبة الإسلامية 1964 م.
* الصاحبيّ في فقه اللغة وسنن العربيّة في كلامها، أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا (ت/ 395 ه)، تحقيق: أحمد صقر، مكتبة ومطبعة دار أحباء الكتب العربية، د. ت
* صحيح البخاريّ، محمد بن إسماعيل البخاريّ، تقديم فضيلة الشيخ أحمد محمد شاکر، دار الجيل، بيروت، (د.ت).
* صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيريّ النيسابوريّ (261 ه)، تحقيق وتعليق: محمود فؤاد عبد الباقي، دار أحياء التراث العربيّ، بيروت، ب.ت.
* الصورة والصيرورة، نهاد الموسى دار الشروق للنشر، عمان، ط 1، 2003 م.
* طبقات المجتمع، اندرية جوسان ترجمة: الدكتور محمد بدوي، دار سعادة - مصر.
* الطواطم والمحرم، سيجموند فروید، ترجمة: جورج طرابيشيّ دار الطليعة للطباعة والنشر، ب.ت.
* عبقرية الإمام علي (علیه السلام) عباس محمود العقاد، دار المعارف، مصر، ط 5، 1981م.
* العقد الفريد، أحمد بن عبد ربه، مصر، الأزهريّ، 1928م.
* علم الاجتماع الحضريّ ومشكلات التهجير والتغير والتنمية د. قباري محمد إسماعيل منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985 م.
* علم الاجتماع الدينيّ، د. أحمد الخشاب مكتبة القاهرة الحديثة، ط 3، 1970 م.
* علم الاجتماع في ضوء المنهج الإسلاميّ، د. محمد البستانيّ، ط 1، قم 1335 ه.ش.
* علم الاجتماع القانونيّ والضبط الاجتماعيّ، د. إبراهيم أبو الغار، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1984 م.
* علم الاجتماع والإسلام، بواين تيرنر، دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ترجمة: د. أبو بكر قادر، دار القلم بيروت، ط 1، 1987 م.
ص: 370
* علم الاجتماع ومدارسه، مصطفى الخشاب لجنة التأليف والترجمة والنشر 1965، الكتاب الثانيّ.
* علم الدلالة، د.احمد مختار عمر، الكويت، 1982 م.
* علم اللغة الاجتماعيّ، د.هدسن، ترجمة: د. محمود عياد، عالم الكتب، القاهرة، ط 2، 199 م.
* علم اللغة الاجتماعيّ عند العرب، هادي نهر الجامعة المستنصرية، ط 1، 1988 م.
* علم اللغة الاجتماعي - المدخل، د. كمال محمد بشر، دار غريب للطباعة والنشر (ب.ت).
* علم اللغة العربية، د. محمود فهمي حجازيّ، نشر جامعة الكويت، 1973م.
* علم اللغة المعاصر - مقدمات وتطبيقات د. يحيى عبابنة ود. آمنة الزعبيّ، دار الكتاب الثقافيّ، أربد - الأردن، ط 1، 2005 م.
* علم اللغة من منظور معرفي، د. موفق،الحمداني، عمان / دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط 1، (1425 ه - 2004 م).
* علم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب البلاغة، علم اللغة النصيّ برند شبلنر، ترجمه وعلق عليه د. محمود جاد الرب الدار الفنية للنشر والتوزيع، ط 1، 1987 م.
* علم النفس الاجتماعيّ، د. شاكر محاميد، ط 1، مطبعة المدى، الأردن عمان (1422 - 2003 م).
* علم النفس التجريبيّ، وليم باينز، ترجمة: د. عبد الفتاح محمد، المكتب العلميّ للنشر والتوزيع، الإسكندرية - مصر، 1997 م.
* علم النفس الصناعيّ، د. عويد سلطان المشعان مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع دولة الأمارات، ط 1، 1994 م.
* علي إمام المتقين عبد الرحمن الشرقاويّ، بيروت 1985 م.
* علي بن أبي طالب سلطة الحق، عزيز السيد جاسم، مؤسسة الانتشار العربيّ، بيروت، ط 1، 1997 م.
* عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، دكتور عبد السلام عشير افريقيا الشرق.
ص: 371
* عيون أخبار الرضا، محمد بن علي الصدوق (ت / 381 ه)، تحقيق: حسين الأعلميّ، ط 1، بيروت، 1404 ه.
* عيون الحكم، علي بن محمد اللّيثيّ الواسطيّ (ت/ ق.6 ه)، ط 1، دار الحديث، قم، 1376 ش.
* الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفيّ الكوفيّ (ت / 283 ه)، تحقيق: جلال الدين المحدث، ط2 مجلدان، قم.
* غرر الحكم ودرر الكلم، جمال الدين محمد الخوانساريّ (ت/ ق. 12 ه)، فارسي - عربي، ط 1، طهران.
* غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّ (ت / 224 ه)، الهند 1976 ه.
* فجر الإسلام أحمد أمين، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط 1، 1996 م.
* فقه اللغة وأسرار العربية، أبو المنصور الثعالبيّ (ت / 429 ه)، تحقيق ومراجعة: عبد الرزاق المهديّ، دار أحياء التراث العربيّ، بيروت، لبنان، ط 1، 1422 ه -
2002 م).
* فقه اللغة وعنف اللسان في المنطقة العربية، بحث منشور في كتاب اللسان العربيّ وإشكالية التلقي، عبد الرحمن العزيّ، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربيّ، رقم / 55، ط 1، بيروت، 2007 م.
* الفهرست، ابن النديم، تحقيق: رضا تجدد، قم.
* في السياسة الشرعية، د. عبد الله النفيس، الكويت - 1984 م.
* في ظلال نهج البلاغة محمد جواد مغنية، ط 1، 1427 ه - ت مطبعة ستار - قم.
* في أصول الحوار و تجديد علم الكلام المركز الثقافيّ الغربيّ، الدار البيضاء - ط / 2 - 2000 م.
* في الفكر الاجتماعيّ عند الإمام (علیه السلام)، عبد الرضا الزيديّ، ط 1، 1998م، منشورات ذوي القربى.
* قاموس علم الاجتماع، د. عبد الهادي الجوهريّ، الهيئة المصرية للكتاب، 1979 م.
ص: 372
* القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ (ت/ 729 - 817 ه)، إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشيّ، دار أحياء التراث العربيّ، بيروت - لبنان ط 2، (1424 ه - 2003 م).
* قصة الحضارة، ديورانت، ول وايريل ترجمة: محمد بدران، بیروت، 1988 م.
* المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي، دار العلم للملايين، بيروت 1971 م.
* قضاء أمير المؤمنين، محمد باقر جعفر، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1970 م.
* القضاء في الإسلام، د. عطية مصطفى مشرفة شركة الشرق الأوسط للطباعة مصر، ط 1، 1966م.
* قضايا أمير المؤمنين (علیه السلام)، أبو إسحاق الكوفيّ، مؤسسة أمير المؤمنين، النجف الأشرف، د.ت.
* القيادة والتنظيم، د. هوشيار معروف، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط 1، 1992م.
* الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس محمد بن يزيد (285 ه) المبرد، مراجعة لجنة من المحققين مؤسسة المعارف بيروت، 1386 م.
* الكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان (ت / 180 ه)، تحقيق عبد السلام محمد هارون بولاق القاهرة، 1316 ه.
* لباب الآداب، أسامة بن منقذ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الجيل، بيروت، ط 1 (1411 ه - 1991 م)
* لسان العرب، ابن منظور (ت - ه) دار صادر للطباعة، بيروت، ط 3، 1906 م.
* اللسان والميزان أو التكوثر العقليّ، د. طه عبد الرحمن المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت، ط 1، 1988 م.
* اللغة، فندريس، ترجمة: الدوخليّ والقصاص، القاهرة، 1950 م.
* اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973 م.
* اللغة في الثقافة والمجتمع د. محمود أبو زيد، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، 2006 م.
ص: 373
اللغة والجماعة في المغرب العربيّ، جلبير غرانغيوم، ترجمة: محمد اسليم كتاب منشور على شبكة الانترنيت، موقع
http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/communaute.htm
* اللغة والمجتمع علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة (1971). * اللغة والمجتمع، م. م. جاكسون ترجمة: د. تمام حسان عالم الكتب القاهرة، ط 1، 2003 م.
* اللغة وقضايا المجتمع د. محمد السيد علوان، دار المعرفة الجامعية، ط 1، 1998م. * ما هو الأدب؟، جانبول سارتير، ترجمة جورج طرابيشي - المكتب التجاري بيروت.
* ما هي السيميولوجيا، بارنار توسان، ترجمة: محمد نظيف افريقيا الشرقية، الدار البيضاء، ط 2، 2000م.
* مبادئ الإدارة، تحليل للوظائف والمهمات الإدارية هارولد كونتز وسيرل أودويل ترجمة: محمد فتحي عمر، مكتبة لندن، ط 1، 1982 م.
* المجتمع، ر.م ماكفير وشارلز بيدج ترجمة: علي أحمد عيسى، مكتبة النهضة المصرية، ط 3، 1974 م.
* المجتمع العربي الإسلاميّ، الحياة الاقتصادية والاجتماعية، د. الحبيب الجنحانيّ سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد ستمبر (319)، 2005م.
* مجمع الأمثال أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانيّ النيسابوريّ (ت / 518 ه)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد دار المعرفة بيروت ب.ت.
* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثميّ علي بن أبي بكر (ت / 807 ه)، تحرير: العراقيّ وابن حجر، القاهرة - 1353 ه.
* مدخل إلى علم أجتماع الأدب، د. سعدي ضاويّ، دار الفكر العربيّ، بيروت، 1994 م.
* المحرم اللغويّ، د. محمد كشاش، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، ط1، (1426 ه - 2005 م)
* المحكم ابن سيده علي بن إسماعيل (ت 458 ه)، تحقيق: جماعة، القاهرة (1958 - 1972)
ص: 374
* محمد في مكة، مونتجري وات، ترجمة: د. عبد الرحمن الشيخ وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002م.
* مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيّ (666 ه)، تحقيق وضبط: حمزة فتح الله (ت 1336 ه) دار البصائر، مؤسسة الرسالة، 1987 م.
* المدخل إلى علم الاجتماع، د. غريب أحمد وآخرون، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ط 1، 1996 م.
* المستقصى في أمثال العرب، جار الله الزمخشريّ المقدمة، عنی به محمد عبد الرحمن خان لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة العثمانية، دائرة المعارف حیدر آباد الدكن الهند، 1962 م.
* مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت / 241 ه)، دار صادر بيروت.
* معارج نهج البلاغة، علي بن أحمد البيهقيّ (ت / ق 6 ه)، ط 1، قم، (1409 ه - 1988 م).
* المعجم في اعلام التربية والعلوم الإنسانية، عبد الكريم غریب، منشورات عالم التربية / الدار البيضاء، 2007 م.
* معجم الشعراء، محمد بن عمران المرزبانيّ، (ت / 382 ه)، تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاج، دار أحياء الكتب العربية، 1960 م.
* معجم العلوم الاجتماعية، ناتاليا يفريموفا Natalya (fremova وتوفيق سلوم، دار التقدم موسكو، ط 1، 1992 م.
* المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، إشراف: عبد السلام محمد هارون، المكتبة العلمية، طهران، ب.ت.
* مع نهج البلاغة - دراسة و معجم، د. إبراهيم السامرائيّ، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان، ط 1، 1987 م.
* المعنى وظلال المعنى - أنظمة الدلالة في العربية، د. محمد محمد يونس علي، دار المدار الإسلاميّ، بيروت، ط 2، 2007 م.
* المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، د. خليل أحمد خليل، دار الطليعة للنشر التوزيع، بيروت، د.ت.
ص: 375
مفهوم إسلاميّ جديد لعلم الاجتماع، د. محمد علوان دار ومكتبة الهلال - بيروت - دار الشرق جدة للنشر والتوزيع والطباعة، 1429 ه - 2008 م.
* مقاتل الطالبين، علي بن الحسين الملقب بابي الفرج الأصفهانيّ (ت 356 ه)، تحقيق كاظم المظفر ط 2، المكتبة الحيدرية النجف.
* المقاربة التداولية ارمينكو فرانسواز، ترجمة: سعيد علوش، الرباط، مركز الإنماء القوميّ، 1986 م.
* المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، ب.ت.
* المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، بیروت، دار القلم، ط 1، 1978 م.
* ملامح من عبقرية الإمام، مهدي محبوبة، ط 1، بيروت، (ب.ت).
* مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب محمد بن علي (ت / 588 ه)، 3 مجلدات، المطبعة الحيدرية النجف، (1376 ه - 1956 م).
* مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة، د.نعمة رحيم العزاويّ، منشورات المجمع العلميّ العراقيّ، 1421 ه - 2001 م.
* مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، بريجيته بارتشت، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ترجمة: أ.د. سعد حسن بحيريّ، القاهرة، ط1، 2004 م.
* من لا يحضره الفقيه محمد بن علي الصدوق (ت / 381 ه)، تحقيق: علي أكبر غفاريّ، ط 4، قم، 1404 ه ق.
* موسوعة التاريخ الإسلامي، د. احمد شبلي مكتبة النهضة المصرية، ط 1، 1996 م.
* موسوعة الحضارة العربية العصر الإسلاميّ، د. قصي الحسينيّ، دار مكتبة العصر الهلال بيروت، ط 1، 2005 م.
* النحو العربي والدرس الحديث، د. عبده الراجحيّ، دار النهضة العربية، 1989م.
* النصّ والسِّياق - استقصاء البحث في الخطاب الدلاليّ التداوليّ فان دايك ترجمة: عبد القادر قنينيّ، أفريقيا الشرق، بيروت، ط 1، 2000 م.
* النظام السياسي الإسلامي، مقارنا بالدولة القانونية، منير حميد البياتيّ، ط 2، د.ت. * النظام السياسيّ في إسلام احمد يعقوب بحث منشور على شبكة الانترنيت.
ص: 376
* النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم، د. السيد محمد الحسينيّ، دار المعارف مصر ط 5، 1985م.
* النظم الإسلامية، نشأتها وتطورها، د. صبحي الصالح، ط 6 - بيروت.
* نقد الفكر الاجتماعيّ المعاصر، د. معن خليل،عمر، دار الآفاق الجديدة، بيروت 1982 م.
* نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريّ (ت / 732 ه)، دار الكتب المؤسسة المصريّة للتأليف والترجمة والنشر القاهرة، ب.ت.
* النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين المبارك بن محمد بن الاثير (ت / 606 ه)، تحقيق: طاهر أحمد الزاويّ ومحمود الطناحيّ، مصر، 1963 م.
* نهج البلاغة، منتدى دار الإيمان، مركز الإشعاع الإسلاميّ، شبكة الانترنيت.
* نهج البلاغة الثاني، الشيخ جعفر الحائري، ط 1، مؤسسة دار الهجرة، (ب.ت)، 1410 ه.
* نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام)، ضبط نصّه: د. صبحي الصالح، دار الحديث للطباعة والنشر، قم، ط 3، (1426 ق - 1384 ش).
* نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط 1، 1990م.
* نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: الشيخ محمد باقر المحمودي، مطبعة النّعمان النجف الاشرف، ط 1، 1387 ه - 1968 م.
* الهداية الكبرى الحسين بن حمدان الخصيبيّ (ت 334 ه)، ط 4، مؤسسة البلاغ، لبنان، 1411 ه - 1991 م.
المجلات والدوريات:
* الأسباب الحقيقية وراء العنف في كينيا، جاكلين كلوب، ترجمة: أمل الشرقي، بحث منشور على شبكة الانترنيت.
* البحث اللسانيّ و السيميائيّ، طه عبد الرحمن (بحث) في ندوة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط - جامعة محمد الخامس / 1401 ه.
ص: 377
* تحليل الخطاب العربي، بحوث مختارة، جامعة فيلادليفيا / كلية الآداب، عمان، ط1، 1998 م.
* تحليل الخطاب عند سارة ميلز، من إنتاج النصّ إلى تسويقه، رابح طبجون، بحث منشور في مجلة الفصول، العدد /77 - شتاء ربيع 2010 م.
* دراسات في نهج البلاغة، د. علي إبراهيم، بحث منشور على شبكة الانترنت.
* قرائن المخاطبة والاقتباس في الخطاب الوسيط المعاصر، طلال وهبت، بحث منشور في مجلة فصول، العدد / 77 - شتاء ربيع 2010 م.
* مفهوم الخطاب في النظرية النقدية المعاصرة، عبد الرحمن حجازيّ (بحث) مجلة علامات النادي الأدبيّ - جدة، ج / 57، م 15 (1426 ه - 2005 م).
* مقاربة تداولية دراسة لغوية، ليلى آل حمد المملكة العربية السعودية، بحث منشور على شبكة الأنترنت.
* المنهج التداوليّ في مقاربة الخطاب، المفهوم والمبادئ والحدود، نواري سعودي أبو زيد بحث منشور في مجلة فصول، العدد / 77، سنة / 2010.
* النسا والقطيع وليد حمارنه، مجلة الفكر العربيّ، من ص 85 وما بعدها، العدد / 19، السنة الثالثة، 1981 م.
الرسائل والأطاريح:
* الاستدلال في نهج البلاغة، دراسة أسلوبية، فاطمة كريم رسن، أطروحة دكتوراه في كلية التربية للبنات - جامعة بغداد / 1430 ه - 2009 م.
* التنظيم الاجتماعيّ في الفكر الإسلاميّ، فكر الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام) أنموذجا - دراسة تحليلية، نضال عيسى كرين، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب - قسم الاجتماع في جامعة بغداد، 2008 م.
* الخطاب والوعي، دراسة تحليلية في بنية الخطاب في نهج البلاغة، د. عبد الحسنيّ عبد الرضا العمريّ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة البصرة.
* المنحى الاجتماعي في لسان العرب محمد صنكور، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة المستنصريّة، غير منشورة.
ص: 378
المصادر الأجنبية
* Chaim perelman. Leman rhetorique. vrin.
* DICTIONNAIRE MARABOUT SOLIOLOGIE TOME.
* Francoise Armengaud: La pragmatique،puf،edition.
* George Gurritch sociology of Law London.
* La communication - paragmatique pour le dis courslitteraire - les timescales de la lin quistique.
* Lalien leuy bruls les functions mentales dans les societes primitives ies grdnd texts dela sociologie modeme.
* LULIO MNDIETA YNUNE THEORIEDES GROUES SOCIAUX.
* Michel Meyer. principia Rhetorica. fayard.
* Olivier Reboul. Introduction a la rhetorique. PUF.
* PAVIS ET MOORE DICT MARA BOUT: SOCIOLOGIE TOME
Ruth Amossy. Largumentation dans la discours. Nathan.
The organization and reorganization of human speech perception Annual Review of Neuroscience.
ص: 379
ملخص الأطروحة باللغة الانجليزية
Nahj AL - Balagha:A
Sociolinguistic Study
A dissertation Submitted by:
Na'ma Dahash Ferhan Al - Ta'ie
To the Board of the Faculty of Education/ Ibn Rushd University of Baghdad, is part of the requirements of the degree Doctor of Philosophy in Arabic Language and Literature
SUPERVISED BY
DR. Prof.
Rahim Karim Al - Azzawi Na'ma
ص: 381
ABSTRACT
Research methodology required that the dissertation was to be divided into four chapters. Each chapter consisted of three sections. They were preceded by an introduction which presented the terminology and basic concepts in sociolinguistics. On the basis of the theory of (Awaidh - Almutaidh), applied by the Imam on his society the researcher devoted the first chapter to investigate the behavioural characteristics of Imam Ali and their impact on the society. Based on the belief that literary texts were not sufficient enough to reflect a society, the researcher found it necessary to study the individual originator and the circumstances surrounding the text as well. Accordingly chapter one was divided into three sections. Section one was devoted to (the social upbringing of Imam Ali) i.e. the application of Islamic theory on the Imam himself and later on the society. Section two came under the title of (behavioral patterns of Imam Ali as found in Nahj - Al Balagha) which was like the practical social application of the Imam himself. Section three studied (the impact of communities of the behavioural norms) and the interactive effects of these norms and communities upon the language of Nahj - Al - Balagha The second chapter tackles the (social structure and systems of construction). It is divided into three sections. The first section was devoted to the (administrative and economic) systems the second section was allocated to the (political and judicial) systems, and the third section was concerned with the social classifications found in Nahj Al - Balagha and their interdependencies.
This chapter represents the social structure of the government of the Imam according to the Islamic theory, including the reform of deviant, after the disclosure of the reasons for such deviations. This chapter includes a number of linguistic issues: the organization of the language policy of the society, the organization of the language of the contract and compact among nations and governments, and stating the generally used expressions in each layer of the society.
The third chapter is entitled (the social phenomena in Nahj – Al - Balagha) which was of three sections. The first section was devoted to the phenomenon of regulatory which in turn was subdivided into three subsections, namely: (family, clan and tribe).
ص: 383
The second section was concerned with the cultural phenomenon and the study of cultural heritage according to tradition customs and habits as manifested in these old communities which were implemented by the Imam in his speech. Section three was about the phenomenon of taboo in language which shows according to the Imam followers and the Quran approach in avoiding uttering the forbidden name explicitly, and replacing it with a good suggestive content word.
The fourth chapter dealt with the linguistic structure and its influence on the recipient. This chapter was divided into three sections: section one was about means of deliberative persuasion, section two was about means of deliberative influence and section three was devoted to the communicative dimension, its analysis, and types. It is worth mentioning that I met Dr. Mohamed Alooragi who had the theory of relativity in modern linguistics and who was devoted to the supervision of the research during my fellowship to the State of Morocco. I summarized the first three chapters to him and he admired the idea of the research and its plan and he actually planned the fourth chapter to me. I telephoned my supervisor and I took his consent and blessing. After I finished writing the chapter I handed it over to Dr. Alooragi as he kindly read it and praised the work I did.
One of the difficulties faced by the researcher was the lack of sources and references in sociolinguistics, and the lack of study which dealt with ancient societies according to their literary heritage and this subsequently made my study the basis of a new trend of this kind of research. I do not acknowledge that these pages reached a degree of perfection yet the researcher hoped that he gave the subject under study its due consideration as far as the efforts exerted and the use of scientific materials employed in the present thesis what raises my hope, and ignites the glow of my activity, and reduces the blame myself for what I saved myself the effort, and retained for asset access to useful scientific material that serve the thesis.
ص: 384